إذكر كلمة "مستشرق" في أي مكان تقريباً والأرجح انك ستسمع اسم برنارد لويس بوصفه أفضل تجسيد لهذا الامتياز الذي يدور حوله سجال ساخن. فان توصيف البروفيسور لويس الذي احتفل تواً بالقرن الأول من حياته، على انه "مستشرق" ليس مستغرباً بعد مساواة مجال اختصاصه، الشرق الأوسط الأكبر، بمفهوم "الشرق" منذ القرن الثامن عشر. وهناك ايضاً الحقيقة الماثلة في تأليف أكثر من 12 كتاباً تهاجم الباحث اليهودي الانكليزي أو تمدحه بوصفه قطباً من اقطاب الوسط الأكاديمي في الغرب.
ورغم اني اعتبر لقب "مستشرق" وسام شرف لمئات الرجال والنساء الذين، على امتداد أكثر من قرنين، ساعدوا شعوب الشرق الأوسط، بما فيها شعبي في ايران، على معرفة جوانب من تاريخها وثقافتها نستها أو تجاهلتها فاني اعتقد ان خلع اللقب على برنارد لويس سيكون عملا اختزالياً.
اعتبر المستشرقون التقليديون مثل هيرزفيلد وايفانوف وبتروشيفسكي ان "شرقه" هو خلفية حضارات ضامرة بلغت حدود تطورها وتحلق الآن بقيادة الطيار الآلي، إذا صح التعبير. وكان البعض مثل شاتوبريان أو بيير لوتي يبحثون عن الغرابة لاضفاء لون أو حتى حياة على ما كان بنظرهم الواقع الجامد للحياة الغربية. وذهب آخرون مثل شامبليون أو ادوارد براون لفك طلاسم الحروف الأبجدية القديمة أو نتاجات آداب ميتة. وفريق ثالث مثل هنري كوربين ولويس ماسينيون بحثوا عن طبقات مخفية لروحانية قديمة متجاهلين في الوقت نفسه "شرقهم" في وضعه اليوم والآن. وهناك آخرون مثل ماكس مالوان أو اندريه غودار، كان "الشرق" عندهم يتألف من حفريات آركيولوجية في المشرق أو بلاد فارس مع الوعد بعرض القطع الأثرية في متاحف غربية.
وفي قاعدة هرم "الاستشراق" كان لدينا ايضاً "الأتراك المحترفون" الذين كانت مهمتهم تملق "المستشرقين" من أجل الربح أو الغواية السياسية. والى هذه الفئة تنتمي الباحثة النازية، على ما في هذا التوصيف من تناقض، زيغريد هونكة التي دبجت كتاباً في 700 صفحة كي "تثبت" ان اوروبا تدين بكل شيء له قيمة الى "الشرق الاسلامي". وأصر البعض مثل روجيه غارودي على ان اعتناق الاسلام بالجملة وحده الذي يمكن ان ينقذ المسيحية من الانحدار والهلاك. وفي نهاية الطيف كان هناك من رأوا ان "الشرق" الاسلامي هو عدو الحضارة الحديثة اللدود، يجب ان يُكافح وان يُدمر (ستالين أوجد الرابطة السوفيتية للملحدين من أجل هذا الغرض).
| لقراء النص باللغة الانكليزية |
| THE "OREINTALIST" BLOWS 100 CANDLES |
 |
برنارد لويس لا تصح عليه أي فئة من هذه الفئات.
في الحقيقة من الصعب تصنيفه لأنه، في الأقل، كان نشيطاً على عدة مستويات مختلفة. وبادئ ذي بدء، كان لويس بكل تأكيد مؤرخاً ذا امتياز كبير له سجل من الأبحاث الأصلية، لا سيما في التراث السياسي والقانوني الضخم للامبراطورية العثمانية. وفي الوقت نفسه كان دارساً متحمساً للانقسامات الاسلامية وخاصة لاهوت "الغلاة" في المذهب الاسماعيلي وفروعه المتعددة. وبعد ان تعلم العربية والفارسية والتركية والعبرية تمكن من الاطلاع بصورة مباشرة على تراث "شرقه" المكتوب، الأمر الذي لم يكن بوسع "المستشرقين" الآخرين إلا ان يحسدوه عليه.
لعل الأهم من ذلك ان لويس سرعان ما أدرك ان الشرق الأوسط ليس مقبرة للحضارات والأديان بل موطن مجتمعات حية وديناميكة يمكن ان تتطور وتنمو في اتجاهات مختلفة وحتى متعاكسة احياناً.
وهكذا في حين ان لويس، بوصفه مؤرخاً، ركز على "ما كان موجودا وقتذاك" في المنطقة فانه أدرك تماماً واهتم بما هو "موجود هنا والآن" في مجتمعات الشرق الأوسط. وعززت صهيونته التي اكتسبها قبل ان يصبح باحثاً اهتمامه بما هو موجود الآن في المنطقة التي اخذت تتحول الى مركز نزاعات دولية متعددة بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة مع عودة اسرائيل المستقلة الى الظهور.
كما أصبح لويس، العلامة والمؤرخ والألسني والباحث، ما يسميه الفرنسيون "مثقفاً عمومياً"، وهو دور اكده في العقود الأخيرة من حياته، لا سيما بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر على الولايات المتحدة، وطنه الثاني بعيدا عن حبيبته انكلترا، ثم "تحرير" افغانستان والعراق في السنوات الأولى من القرن الجديد.
التزم البروفيسور لويس في اعماله عن التاريخ وترجماته من الأدب العربي والتركي والعبري والفارسي بأعلى معايير البحث العلمي التي جعلت الأسرة الأكاديمية الانكليزية نموذجاً يُقتدى للعالم على أمتداد أكثر من قرنين.
التقيتُ لويس في اوائل السبعينات خلال احدى زياراته للعاصمة الايرانية طهران، حين أُتيح له ان يقابل الشاه في جلسة طويلة. وفي مأدبة العشاء التي اقامها فريدون شقيق رئيس الوزراء وقتذاك أمير عباس هويدة، تحدث لويس عن اهتماماته لمجموعة من كبار المسؤولين والمثقفين. وأُعجبتُ بملاحظاته النقدية لأنها خرجت عن قواعد البروتوكول التي بموجبها يتعين على الضيوف الأجانب الذي يلتقون الشاه، ان يمدحوا حكمته ويرفعونها الى عنان السماء. وزار شيراز واصفهان حين تلقى هدايا من سجاد المدينتين وكافيارهما ثم طار عائدا الى بلده راضيا. وكان لويس ينتقدنا لأنه يحترمنا بل وحتى لأنه يحبنا بعض الشيء.
في السنوات اللاحقة لاحظتُ ان لويس يطبق المنهج نفسه على سائر الشعوب الأخرى التي يدرسها، لا سيما الأتراك والعرب. وبمعنى ما فانه كان أفضل صديق للمسلمين في الغرب لأنه لم يتملقهم قط كما تملقهم الرئيس باراك اوباما في خطابيه المؤسفين في اسطنبول والقاهرة. كما لم يحاول لويس التعاطف معهم من موقع الاستعلاء كما يفعل وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير مثلا بالتعامل معهم وكأنهم مراهقون يجب التسامح مع سلوكهم الغريب بغمزة عين وهزة رأس. وكان لويس، لحسن الحظ، متحررا من امبرالية الذنب التي تُعد الشعوب غير الغربية بموجبها شعوبا ًعاجزة حتى عن ارتكاب الأخطاء ودفع ثمنها.
ان نزاهة لويس ورفضه كل اشكال التزلف اكسبته الكثير من الأعداء لا سيما بين المثقفين الاسلاميين من اليسار الذين يتشبثون بلغو "لوم اميركا اولا" لتجنب أي نقد يستهدف مجتمعاتهم. ولكن كان هناك وما زال مثقفون وسياسيون مسلمون يقدرون صراحة البروفيسور ذي المئة العام من العمر حتى باسلوبه اللاذع. وأتذكر حفلة عشاء في اوائل الثمانينات في بيت تورغوت اوزال، رئيس تركيا لاحقا، عندما تحدث البروفيسور لويس الذي كان دائماً من انصار الجمهورية الكمالية بحماسة، قائلا للحضور الذي غالبيتهم من السياسيين والمثقفين الاتراك، ان العلمانية لا تعني سحق الدولة للدين. وفهم اوزال على الأقل مغزى الكلام، وأعتقد انه حفظه في ذهنه حين تسلم مقاليد الحكم.
وكان البروفيسور لويس يمارس الصراحة نفسها مع القادة الاسرائيليين ايضا حين نصحهم بألا يحاولوا التمادي في ما يطلبونه من الرئيس المصري انور السادات بعد ان اختار السلام. ولكنه نصح المصريين ايضاً من خلال اتصالاته مع مساعدي السادات، بأن يخففوا من خطابيتهم.
اختلفتُ مع برنارد لويس في نقطتين على امتداد سنوات.
الأولى عندما جادلتُ في الثمانيات بأن المجتمعات المسلمة في الغرب يمكن ان تصبح مراكز تنوير تشع "نورها" على بلدان المسلمين. واعترض لويس رافضاً الفكرة بوصفها فكرة ساذجة وبانغلوسية (مفرطة في التفاؤل). وبعد نحو ثلاثة عقود وحدوث الكثير في اوروبا واميركا الشمالية، يجب ان أعترف بأنه كان محقاً وأنا المخطئ. فان ما تصدّره المجتمعات المسلمة في الغرب من الظلام الى الشرق الأوسط اليوم أكثر مما يُصدر بالاتجاه المعاكس.
اختلافنا الثاني كان يتعلق باحتفاء البروفيسور لويس بمقال "صدام الحضارات" الذي نشرته مجلة اتلانتيك مونثلي واستوحاه صامويل هنتغنتون في كتابه الذي تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً بالعنوان نفسه. وكانت وجهة نظري تذهب الى ان الاسلام ليس حضارة بل دين أسهم في العديد من الحضارات المختلفة وان المشكلة اليوم هي تحويل الاسلام الى ايديولوجيا سياسية متطرفة تنظر الى الحضارة الحديثة على انها العدو. وفي الحقيقة ان وجهة نظري استوحت بعض اعمال لويس نفسه لا سيما عمله حول الاحتكاك التاريخي بين الاسلام والغرب وفي عهد اقرب فشل محاولات "التغريب" في عدة بلدان مسلمة، الذي كشف عنه بحذاقة في عمله "أين يكمن الخلل: صدام الاسلام والحداثة". وهكذا في حين ان الاسلام لا يتوافق بكل تأكيد مع الديمقراطية فان الديمقراطية ليست متنافرة مع الاسلام.
قرر برنارد لويس ان يدرس الشرق الأوسط في ثلاثينات القرن الماضي حين لم يكن احد تقريبا يهتم بالمنطقة. وفي حين ان احداثاً تاريخية وفرت السياق فان عمل لويس الفذ أسهم بقسط كبير في إبقاء المنطقة المضطربة في مركز الاهتمام الأكاديمي والسياسي خلال العقود الستة الماضية.
ترجمة: عبد الاله مجيد





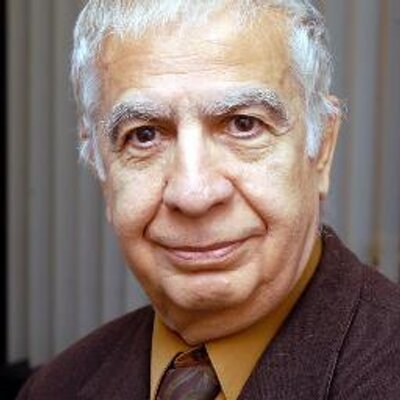












التعليقات