&
خلال العام الحاليـ 2016، عادت وسائل الإعلام الغربية تتحدث باستفاضة، وبتقدير كبير، عن الكاتب النمساوي ستيفان زفايغ (1881-1942).يعود ذلك إلى أسباب عدة. أولها الفيلم الذي أنجزته عن حياته الألمانية ماريا شرادار تحت عنوان:”ستيفان زفايغ، وداعا أوروبا". ويقوم الممثل الفرنسي الكسي منروجي بتقديم عرض في "مسرح الجيب" بحيّ منبارناس بباريس، مستوحى من قصته الشهيرة"أموك". كما تتصدر كتبه في مختلف المجلات، واجهات المكتبات الرفيعة في كل من روما، وبرلين، وباريس، ومدريد ، وأمستردام، وستوكهولم. وأمّا الأمر الثاني فهو أن هذا الكاتب الذي وصفه كاتب سيرته الأمركي جورج بروشنيك ب"الكاتب الغزير الإنتاج، وبالرجل الكيّس والمتأنق، وباليهودي التائه، وبالأليف المكتئب للمقهى"، هو "الكاتب الأوروبي" بامتياز. وعندما كانت البلدان الأوروبية تتقاتل وتتنافس بشراسة ووحشيّة ، كان هو يتنقل بين العواصم، والمدن، حالما بثقافة أوروبية. وكان يرتبط بعلاقات صداقة متينة مع مبدعين ومفكرين مرموقين من أمثال الشاعر البلجيكي إميل فارهاران، وداعية السلام الكاتب الفرنسي رومان رولاّن، وبالكاتب الروسي مكسيم غوركي، وبآخرين كثيرين. كما أنه كتب عن دستويفسكي، وعن نيتشه، وعن فرلين، وعن تولستوي، وعن رامبو، وعن بودلير، وعن رامبو...وإلى جانب القصة القصيرة التي كان بارعا فيها، كتب ستيفان زفايغ سيرة ماري أنطوانيت، وسيرة الرحالة الشهير ماجلان، وسيرة الفيلسوف الهولندي إيراسموس، صاحب كتاب:” مديح الجنون". وفي كتابه البديع:"عالم الأمس"، رسم صورة آسرة عن الحياة الأدبية والفنية والفكرية في ظل الإمبراطورية النمساوية-المجرية قبل إتنهيارها المدوي في نهاية الحرب الكونية الأولى.
وكان ستيفان زفايغ شاهدا على حوادث وأعاصير وكوارث عرفتها أوروبا خلال العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين. وكان يعتقد أن القارة العجوز ستنعم بالسلام بعد كارثة الحرب الكونية الأولى، غير أن طبول الحرب سرعان ما بدأت تقرع مُجددا حتى قبل أن يجفّ حبر "معاهدة فارساي". وعندما استولى النازيون على السلطة في ألمانيا، سارع العديد من معاصريه من الشعراء والكتاب والمفكرين، إلى الهرب إلى المنافي. أما هو فقد أبى ذلك. إلاّ أنّ المخاطر داهمته من كل جانب ليجد نفسه مجبرا على الفرار إلى البرازيل بصحبة زوجته الجميلة التي كانت تصغره بعشرين عاما. وهناك انتحر مطلع عام 1942، بعد أن إنعدم أمله في الأمن والسلام. وفي رسالة الوداع التي بعث بها إلى أصدقائه ومحبيه قبل رحيله المأساوي، كتب يقول:” قبل أن أغادر الحياة بمحض إرادتي، وبصفاء ذهنيّ كامل، أشعر بالرغبة في أن أؤدي واجبي الأخير. وأريد أوّلا أن أتوجه بالشكر إلى البرازيل، هذا البلد الرائع الذي منحني ومنح عملي، محطة مريحة فيها توفرت كل وسائل الضيافة. ومن يوم إلى آخر، تعلمت كيف أحبّه. ولا أظنّ أنني سأجد مكانا أفضل منه لأبني حياة جديدة بعد أن غرق عالم لغتي في العتمة، وانهارت أوروبا التي تمثل بالنسبة لي الفضاء الروحي".
في سنة من سنوات الأفول التي كانت تعيشها الإمبراطورية النمساوية-المجريّة، وتحديدا عام 1881، جاء ستيفان زفايغ إلى الدنيا. وهو ينتمي إلى عائلة من البورجوازية المتوسطة ، متخصّصة في صناعة النسيج. وكانت والدته من أصول إيطالية. لذا كانت تتكلم بإتقان اللغتين: لغة دانتي، ولغة غوته. وفي المدرسة الإبتدائية، كان الطفل ستيفان يشعر بالضجر والضيق. وكانت الدروس تعذّبه إذ أنه كان يشعر أنها ليست مفيدة له في أيّ شيء. وفي سنوات المراهقة، بدأ يقرض الشعر. وفي واحدة من قصائده الأولى، كتب يقول:” صدري مثل بحر في حالة هدوء.على الأمواج الصامتة تأتي الأبعاد المعتمة. والأحلام شبيهة بالنوارس".
بعد حصوله على شهادة الباكلوريا،
سافر إلى فرنسا التي كان قد تعلّم لغتها، ثم انتسب إلى كلية الآداب بجامعة فييينا. وفي هذه الفترة، شرع في كتابة رسائل إلى الشاعر البلجيكي إميل فارهران (1855-1916) الذي كان قد اكتشفه في سنوات المراهقة. وفي ما بعد سوف يرتبط معه بعلاقة صداقة متينة لسنوات طويلة.
مطلع القرن العشرين، وكان قد أصدر مجموعة شعرية بعنوان:”حبال الفضة"، ونشر العديد من المقالات والدراسات الأدبية، إنتقل إلى برلين بحثا عن المغامرة، وعن آفاق أوسع. وفي هذه الفترة، اهتم بترجمة كبار الشعراء الفرنسيين من أمثال، بودلير، وفرلي، ورامبو. وعن حياته البرلينية، كتب يقول:”ما كنت أبحث عنه في برلين، لم يكن لا دروسا، ولا أساتذة، وإنما شكلا أسمى وأكمل لحريتي الشخصيّة. ففي ذلك الوقت، كانت فيينا ما تزال مشدودة إلى الأشياء القديمة، مُقدّسة ماضيها، متّخذة هيئة حذرة تجاه الأجيال الشابة، والتجارب الجسورة، المحفوفة بالمخاطر. لكن في برلين التي كانت تتطور سريعا، وبحسب عبقيرتها الشخصيّة، فإن التجديد كان مرغوبا فيه".وبعد أن أكمل أطروحة الدكتوراة التي كانت حول فالسفة تانTaine، وذلك عام 1904، قام ستيفان زفايغ برحلات إلى إيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، وأصدر مجموعة قصصية. إلاّ أن الترجمة كانت تشغله أكثر من أيّ شيء آخر. لذلك أنجز ترجمة لقصائد إميل فارهران. وقد أتاحت له الترجمة التعرف على العديد من الشعراء والمبدعين الذين كانوا يطمحون إلى أن تنقل أعمالهم إلى لغة غوته. وفي عام 1905، زار إسبانيا، والجزائر، وأصدر كتابا عن بول فرلين. وفي مطلعه كتب يقول:”لقد اخترق فرلين العالم مثل طفل، بتلك السذاجة الكبيرة والحقيقية التي يمتلكها الطفل، والتي يعتبرها شووبنهاور، العلامة الأساسية الأكثر أهميّة في طبيعة العبقرية”. أمّا عن رامبو الذي كان قد نقل مختارات من قصائده إلى اللغة الألمانيّة، فقد كتب عنه يقول:” يمكن أن يكون أرتور رامبو غريبا وفريدا من نوعه فقط بسبب حياته وحدها، وبسبب احتقاره العنيف لأية ثقافة ، وبطريقته التي يُجْهز بها على كلّ عنصر أوروبيّ، وبحياة غريزيّة وسط دوائر الأخلاق، وبفردانيّة لا يمكن ترويضها أبدا. إنه في أيّامنا هذه، بطل الحرية الداخليّة، والغريزة الخارجة عن القانون".
في عام 1908، بحثا عن المغامرة الخلاّقة، سافر ستيفان زفايغ إلى آسيا ليمضي هناك سنة كاملة، متنقّلا بين بورما، وسيلان، والهند التي كتب عنها يقول:”تركتها-أي الهند-وفي نفسي شعور بالوحشة والإحباط، لم أكنْ أنتظره أبدا. فقد أفزعني فقر تلك الكائنات الهزيلة الضامرة، وتلك الجدية الخالية من الإبتسامة، والتي كنت أعاينها في النظرات السوداء، وتلك الرتابة التي عادة ما تكون قاسية ومرعبة في المشاهد الطبيعية، خصوصا ذلك الإنفصال الصارم والحاد بين الطبقات والأجناس، والذي كنت قد عاينت نماذج منه على ظهر الباخرة". وعند عودته من آسيا، انشغل ستيفان زفايغ بترجمة أعمال إميل فارهران.كما كتب مقدمة للأعمال الكاملة للروائي البريطاني شارل ديكنز التي كانت قد صدرت باللغة الألمانيّة. وفي عام 1911، سافر إلى كندا، وكوبا، والولايات المتحدة الأمريكية، مُقتفيا آثار الشاعر الأمريكي والت ويتمن، صاحب ديوان:”أوراق العشب". عند عودته من تلك الرحلة التي عاشها كمغامرة معرفيّة، التقى بداعية السلام الكاتب الفرنسي رومان رولان. وكان لعرض مسرحيته:”البنت على ضفّة البحر"، في مسرح فيينا الشهير Burgtheater عام 1912، تأثير كبير على مسيرته الإبداعية. لئذلك كتب يقول:”حلم كلذ كاتب في فيينا أن تقدم له مسرحية على ركح Burgtheater إذ أنّ ذلك يمنحه قيمة كبيرة، وشرفا كبيرا، ويتيح له حضور التظاهرات الثقافية الكبيرة مجانا". وفي نفس السنة، 1912، ارتبط بعلاقة مع فريديريكه فون فيستارنيتز التي كانت مطلقة، وأمّا لطفلين. ومثله كانت يهوديّة متحررة، تتوق إلى العلاقات الخالية من التعقيدات التي تفرضها التقاليد الصارمة. وكان في بلجيكا ضيفا على صديقه الشاعر إميل فراهران لماّ فاجاته الحرب الكونية الأولى. نفكتب إلى أصدقائه يقول:”صداقتنا لم تعد مجدية الآن طالما أن شعوبنا تتحارب وتتقاتل. غير أن هذه الصداقة ستكون أثمن مرتين بعد الحرب. في أوقات الفعل، يكون الصمت أفضل. لا تنسوني بسبب الواجبات التي علينا أن نؤديها. وسأظل وفيّالا لكم. وداعا يا أصدقائي! وداعا يا رفاقي في الخارج!”. وقد ردّ رومان رولّان على تلك الرسالة قائلا:”أنا أكثر وفاء منك لأوربا يا عزيزي ستيفان زفايغ،ولن أقول وداعا لأي واحد من أصدقائي". وفي عام 1916، نشر ستيفان زفايغ في الصحف الألمانية والفرنسية والسويسرية مقالا بعنوان:”قلعة بابل" جاء فيه ما يلي:”أعتقد أن وقت فعل جماعي لم يحن بعد، والإضطراب الذي ألقى به الله في النفوس مايزال كبيرا. وسوف تمرّ سنوات طويلة قبل أن يشرع إخوة الأمس في بلورة عمل ضدّ اللانهاية في جوّ من المنافسة اللطيفة. وعلينا أن نعود إلى حظيرة العمل ، كلّ واحد في موقعه الذي تركه قبل نزول الكارثة".
وكانت الحرب الكونية الأولى على وشك الإنتهاء عندما استقر ستيفان زفايغ في مدينة سالسبورغ مع فريديريكه. وهناك كتب مسرحية:”جيريمي" التي هاجم فيها الحرب. وبعد أن أصدر كتابا جديدا حمل عنوان:”المعلمون الثلاثة" فيه تطرق إلى أعمال شارل ديكنز، وهونوري دو بلزاك، وفيدور دستويفسكي، إنشغل ستيفان زفايغ بكتابة سيرة رومان رولان منوّها بأعماله وبأفكاره الداعية للسلام بين الشعوب الأوروبية، مجدا خصاله الإنسانية، ووفاءه لمبادئه ولأصدقائه. وكانت نهاية الحرب الكونية الثانية كارثية. فقد انهارت الإمبراطورية النمساوية-المجرية لتقلص إلى بلد صغير هم النمسا الآن. وكان ذلك حدثا مؤلما بالنسبة لستيفان زفايغ الذي شعر أن إمبراطوريته الجميلة، التي كانت مترامية الأطراف، بلغات وبثقافات متعددة ومختلفة، ذابت في رمشة عين.
وبمناسبة مرور 100 عام على ميلاد ليون تولستوي ، سافر ستيفان زفايغ إلى روسا عام 1928 لحضور الإحتفالات المقامة في موسكو تكريما لصاحب "الحرب والسلم". ومن تلك الرحلة عاد بإحساس أنه كان "تحت دشّ اسكتلندي، بارد وساخن في نفس الوقت". وفي كتاب أصدره عن جوزيف فوشيه، أحد زعماء الثورة الفرنسية الحديديين والميكيافليين، هاجم ستيفان زفايغ رجال السياسة بحدة وعنف ، مشهّرا بجرائمهم، وبمؤامراتهم الدنيئة، وبجوعهم الدموي للسلطة. وفي ذلك كتب يقول:” في كلّ يوم نحن نعاين اللعبة المربكة والإجرامية أحيانا، للسياسة . إن الناس ذوي الأفكار الواسعة والأخلاقية، والمعتقدات التي لا تتزعزع، ليسوا هم المنتصرون، وإنما اللاعبون المحترفون الذين نسميهم ديبلوماسيين-هؤلاء الفنانون ذوي الأيادي الرشيقة الماهرة، والكلمات الفارغة، والأعصاب الجامدة". وفي رسالة بعث بها إلى صديقه رومان رولان بتاريخ 23 مارس-آذار 1929، كتب ستيفان زفايغ يقول:”ثمة ما يثير القرف والإشمئزاز. بل أن هناك شيئا كثيرا من هذا. فقد رأيت بلجيكا الغبية والثقيلة، وهولندا التي تتمرغ في الضجر رغم ثرائها، وبرلين، هذه الزوبعة من الترف، والعمل المحموم، والكبرياء. ولي حنين إلى روسيا، البلد الوحيد الجاد والمتحمس في قارتنا الأوروبية التي يهيمن عليها المال ويخنقها". لكن حين يتلقى رسالة من مكسيم غوركي يعلمه فيها ب"المصاعب التي يواجهها المثقفون الروس"، يغيّر ستيفان زفايغ موقفه تجاه روسيا الشيوعية، ويكتب قائلا:”لنبارك أننا نمتع بالحرية. لذا علينا أن نستغل هذا الكنز".
مطلع الثلاثينات من القرن الماضي، بدأ ستيفان زفايغ يشعر بالضيق والتشاؤم بسبب طغيان وهيجان لغة الحرب والإنتقام. وفي رسالة إلى رومان رولان، تحدث عن أوروبا الذاهبة إلى حتفها بخطى سريعة، وعن " الجنون الذي استبدّ بكلّ العقول". وبسبب المخاوف التي ازدادت ضراوة وعنفا بعد صعود النازيّون إلى السلطة في عام 1934، قرررستيفان زفايغ مغادرة بلاده ليعيش التيه والضياع. وفي البداية ، أمضى بضع سنوات متنقلا بين فرنسا وبريطانيا. ورغم الشهرة الواسعة التي كان يتمتع بها، ظل ّ ستيفان زفايغ متشائما من المستقبل، وأمامه كانت الآفاق تبدو مسدودة ومظلمة. وهذا ما تؤكده الفقرة التالية من مقال كتبه في تلك الفترة:”دائما وأبدا تتأكد لعنة كلّ الإيديولوجيّات الدينية والسياسية التي تتحول إلى نظم استبدادية وديكتاتورية. لكن حالما يكفّ المرء عن الوثوق بالقوة المتأصلة في حقيقته، ويلجأ إلى العنف الوحشيّ، فإنه يعلن الحرب على الحرية الإنسانيّة. ومهما كانت نوعيّة الفكرة، ومنذ اللحظة التي تُقْدم فيها هذه الفكرة على استعمال الإرهاب لتشكيل وبلورة معتقدات أخرى، فإنها تفقد مثاليتها. حتى الحقيقة الأكثر سموّا، تصبح جريمة ضد الفكر عندما يتمّ فرضها بالقوة".
في عام 1940، أي بعد إندلاع الحرب الكونية الثانية، غادر ستيفان زفايغ فرنسا ليتوجه إلى البرازيل، بعد أن حصل على الجنسية البريطانية. ومن منفاه، دأب على متابعة الأحداث والأوضاع العالمية التي كانت تزداد تدهورا يوما بعد آخر. وقبل أن ينتحر مع زوجته Lotte، كان ذلك يوم 22 فبراير-شباط- 1942، كتب يقول:”يمكنني أن أحافظ على روحي الأشدّ عمقا، وعلى مادتها التي لا يملكها إنسان آخر إلاّ أنا، وجسدي وصحتي، وأفكاري، ومشاعري، وعواطفي، من خطر أن يتمّ التضحية بها لصالح جنون الآخرين، ولمصالح لا علاقة لي بها؟ للإجابة على هذا السؤال ، نَّذَرَ Montaigne حياته وقوته كلها. وحبّا لهذه الحرية، تأمّل في نفسه، وراقب حركاته، وسكناته، ومشاعره. وسعيه الدؤوب لإنقاذ هذه الحرية، في وقت المذلّة الكونيّة أمام الإيديولوجيات والأحزاب، يجعل Montaigne بالنسبة لنا اليوم، صديقا وأخا أكثر من أيّ فنّان ومن أي مبدع آخر".











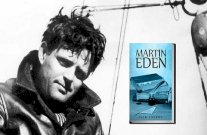
التعليقات