أول اختراع مسجل باسم الادارة الأميركية في سجل المعارضة السورية هو "الفصائل المعتدلة"، استقتها طبعًا من كل لغو الاعتدال "العربي" المستدام منذ نكبة 1948 حتى آخر برميل ممانع ينقض على مواطنين سوريين في مكان ما بقلب العروبة النابض.
إنه لغو، لا محالة. فالاعتدال كان دائمًا قميص عثمان "الرجعية" العربية في تجنبها الاحتكاك العسكري بإسرائيل. فلو غضضنا الطرف قليلًا عن دول الطوق، حين كانت دولًا وحين كانت طوقًا، كانت بقية الدول العربية، من المشرق إلى المغرب، تنادي بالعداء مع إسرائيل، لكنها كانت في كل مرة تجري فيها انتخابات إسرائيلية، تصوم نهارًا وتصلي ليلًا لينجح حزب العمل "المعتدل"، ليختبىء المعتدلون العرب وراء إصبع شيمون بيريز "المعتدل"، مبررين به اعتدالهم، أي نأيهم بأنفسهم عن الصراع العربي الاسرائيلي. فكان أن انتقى العقل العربي المنفصم كلمتي "صقور" و"حمائم"، وحملهما على كتفيه دهرًا، مناديًا بنصرة الحمائم، بالرغم من أن كل الحروب العربية – الاسرائيلية حصلت في عهود العمل "المعتدل".
حوّلت كامب دايفيد مصر إلى دولة "اعتدال" عربي، حاول طعنها خالد الاسلمبولي حين قتل انور السادات على منصة عرضه العسكري، الذي كان يتذكر من خلاله أيام "التطرف". وحولت معاهدة وادي عربة الأردن إلى مملكة "اعتدال" عربي، كما حول الدخول الأميركي إلى العراق في العام 2003 هذا البلد إلى بلد "الاعتدال" العربي. كل هذا ناجم من تسليمنا جدلًا بأن أي من هذه الدول كانت تريد فعليًا تحرير فلسطين.
بعد اجتياح إسرائيل للبنان في العام 1982، صارت منظمة التحرير الفلسطينية باطلة، وانتحى الفلسطينيون ناحية التطرف الديني، طالما أنه البديل الوحيد لعشرات آلاف الصفحات التي طبعتها مطابع بيروت عن العقائد اليسارية المناضلة في سبيل حق العودة وتقرير المصير.
بقيت سوريا، "الشوكة" في حلق إسرائيل والرجعية العربية، بحسب كتب القومية التي أنشأ عليها نظام البعث أجياله السورية، ابتداءً بالطلائع حتى الرجال والنساء، الذين تربوا على "سوريا الأسد"، و"نسور في السماء أسود على الأرض". شرب السوريون من الكأس البعثية 40 عامًا، بلا توقف، وبلا تأفف، إذ يعرفون مصير المتأففين، لكن بقي الجولان "محتلًا"، والحدود آمنة لا خطر منها.&
تغير الوضع. إنه اليوم زمن آخر. زمن لا مكان فيه لاعتدال، ولو كان بلا معنى. والزمن هذا لم يبدأ في 11 آذار (مارس) 2011، يوم أطلق "أسود الأرض" رصاصهم على أطفال درعا، بل بدأ حين نزل آية الله الخميني سلم الطائرة الفرنسية في مطار طهران، فاستقبلته الحشود حينها بصرخة كاد العالم ينساها اليوم، لولا أن أستعادها عبد الملك الحوثي في اليمن: "الموت لأمريكا".
إنه الزمن الشيعي. وفي الزمن الشيعي لا مكان للاعتدال، مهما بحثت أميركا، ومهما فتشت إسرائيل، ومهما نعّم حسن روحاني صوته مخاطبًا السعودية وغيرها في الخليج.
إنه الزمن الشيعي بامتياز، إذ تمكن علي خامنئي من تصدير الثورة الاسلامية إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن وبعض البحرين. إلا أن سوريا تبقى الجوهرة في التاج الامبراطوري الفارسي، الذي ذكّر به اليوم علي يونسي، مستشار حسن روحاني، إذ قال إن إيران تعتبر نفسها مسؤولة عن المنطقة والمدافعة عن شعوبها التي تشكل جزءًا من إيران، وستقف بوجه التطرف الإسلامي والتكفير والإلحاد والعثمانيين الجدد والوهابيين والغرب والصهيونية... وكل هؤلاء ملمومون في سوريا، التي يهتم لها نظام الملالي في إيران أكثر من اهتمامه بالأهواز.
إنه الزمن الشيعي الذي يلي فورًا الزمن الاسرائيلي. فكما دفعت إسرائيل الفلسطينيين إلى حماس والجهاد، واللبنانيين إلى حركة أمل ثم حركة أمل الاسلامية ثم حزب الله، هكذا تفعل إيران بسنة سوريا وسائر المشرق، إذ تحشرهم في الزاوية، وتجبرهم على اتباع العقلية المتطرفة، ليكونوا مثالها، سيًا لها، فتجعل منهم ندًا لها كي تستمر في الحياة، فيستمر زمنها، طالما أنها أقوى ميدانيًا، كما تظن.
لا معتدلين في سوريا، فقد أفنتهم إيران وقتلهم حزب الله. واليوم، تكمل الولايات المتحدة عملية الافناء والقتل، والدفع نحو هاوية التطرف، من خلال صفقات كبرى عقدتها مع إيران، تطلق يد طهران في المنطقة، حتى اليمن. أما المقاتلون "المعتدلون" في بقايا الجيش السوري الحر وبعض الفصائل التي لم تبايع القاعدة أو داعش بعد، فيعرفون حق المعرفة أن معاداة أميركا أفضل لهم من مصادقتها، طالما أنها تقرأ بعد في صخيفة عربية يعود تاريخها إلى أربعة عقود من الزمان، وكأن العصر والأوان توقفا عندها في أيام اتكالها على ما تسميه "الاعتدال العربي" في تسوية القضية الفسلطينية.
لا معتدلين سنة في سوريا، وهم يتآكلون سريعًا في لبنان، ويتحالفون مع القاعدة في اليمن، ومع داعش في العراق... هكذا تريدهم إيران، وقودًا لأحلامها الامبراطورية، تبريرًا لسياستها. وهكذا يريدهم حزب الله، راكعين عند أقدام الجنرال المظفر قاسم سليماني.
إعتدال؟!.. اعتدال دي تبقى..









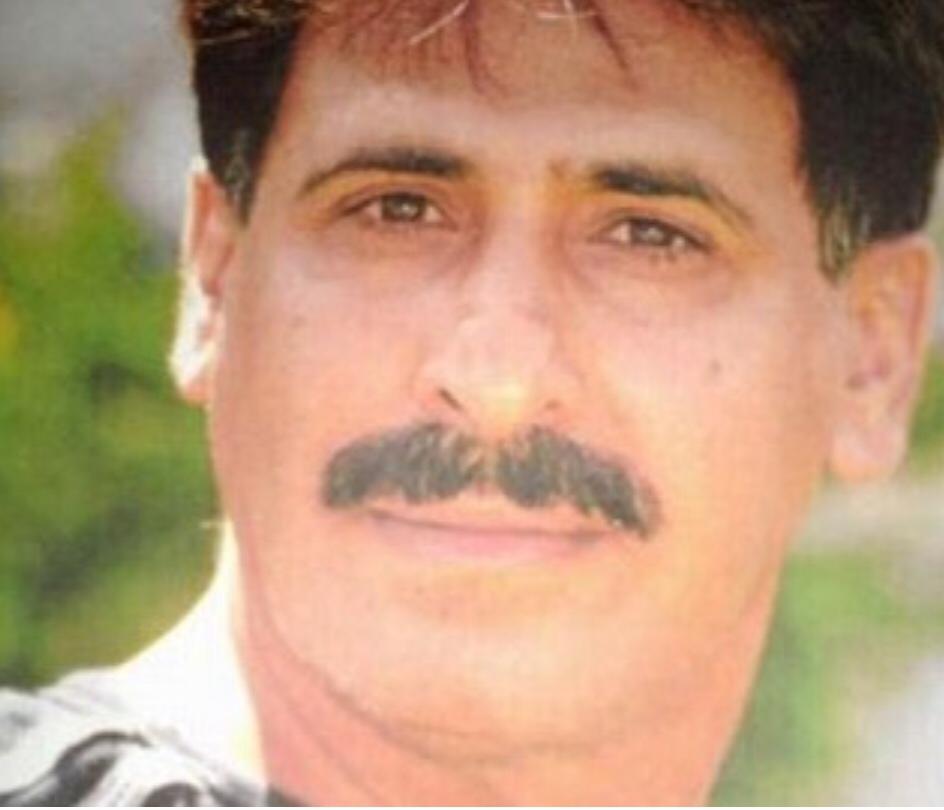














التعليقات