من حق كل إنسان أن يختار منظومته الإيمانية والعقائدية، ومن واجب المجتمع والسلطة حماية هذا الحق الفردي الإنساني، وتهيئة الظروف الملائمة لممارسة المواطن شعائره الدينية، والتعبير عنها، وعن آراءه الفكرية والثقافية والسياسية. لكن ما ليس من حقه- فذلك بغي وظلم وعدوان- أن يفرض معتقداته على الآخرين، أو أن تتحول تلك المعتقدات إلى أداة قهر ومحاباة وتمييز، بدعوى الأخوّة أو المحبة في الدين، أو أن تتحول إلى مشروع سياسي يفرض بالقوة أو بالاحتيال على الناس، بحجة نشر دين الله، والدفاع عن تعاليم الله، وإقامة حكم الله، أو بادعاء أنه المشروع السماوي الأفضل الذي ينشر المساواة والخير بين الناس. فيجرد الناس من حريتهم وحقهم في التعبير والاختيار.
من المعروف أنه كلما ازداد عجز الإنسان وجهله، كلما ازدادت حاجته للغيب والقوى الخفية، يحتمي بها، ويترجى منها السكينة والمساعدة والخلاص. ولا توجد في العالم منطقة ولا مجتمعات، كمنطقتنا ومجتمعاتنا تزدحم بالأديان والمذاهب والمعتقدات، ويحتل فيها الدين المقام الأول، ويلعب دورا أساسيا مركزيا، ويتربع على عرش المنظومة الثقافية السياسية، والعلاقات الاجتماعية البشرية، والمفاهيم الأخلاقية والحقوقية. وهو أيضا الخلفية الرئيسية لعقول العامة والخاصة، والمتعلمين والأميين، والمعارضين والموالين، والعدوانيين والمسالمين. فعلى أساسه (الدين) تقوّم الأفعال والأقوال، ومنه تصاغ المناهج التربوية، والقوانين المدنية والجزائية والتجارية، والتشريعات. وذلك بالرغم من عدم التزام كثير من الناس بأركان الدين، والتعاليم الدينية، إلا أنهم يدّعون ويتظاهرون- توجسا واتقاء أو نفاقا- بالتقوى والورع والتعلق بأهداب الدين، وما يؤكد ذلك تفاقم الفساد في ممارسات وعلاقات الناس، وانتشار التسول الأخلاقي والفكري والسياسي، وتفشي الجهل والغرور، والرشوة والكذب، والغش والاحتيال، وازدياد عدد الجرائم، وأكل المال الحرام.
إن تاريخ الأحزاب الدينية السياسية عامة، وبشكل خاص في البلاد العربية، تاريخ غير مشجع على الإطلاق، إن لم نقل تاريخا ملوثا بالقمع والفاقة والعزلة والتجهيل والدماء. ومخاطر الأحزاب الدينية السياسية مهما كانت مسمياتها وخلفياتها وانتماءاتها، تتأتى من منظومتها الفكرية والمعرفية الثابتة التي لا تتغير ولا تتطور. بينما الحياة في تجدد وتبدل وتحديث مستمر.
كما إنها تخلط بين المقدس والمدنس، بين الإلهي المنزّه، وبين السياسي الذي لا يأبه بالوسيلة- ويلعب أحيانا بالثلاث ورقات- لتحقيق الأهداف والغايات الأرضية الخاصة. فتختلق الذرائع، وتلتف على التعاليم، وتلوى عنق النصوص، لتطوّع الدين من أجل تحقيق مآربها ومصالحها، بل قل مصالح قادتها وأبنائهم وعوائلهم وعشائرهم.
كما إنها باستثناء الشعارات الضبابية الغيبية التي تستجدي عواطف العوام والبسطاء وتحتال عليهم، لا تمتلك أية برامج عملية واقعية لحل المشكلات الاقتصادية والتعليمية والصحية والسكانية والمعيشية التي تتفاقم يوما إثر يوم. فلا حل لديها لمسألة السكن، ولا حل لديها لمسألة البطالة، ولا حل لديها لمسألة الفقر، ولا حل لمسألة التعليم، ولا حل لتفشي الفساد، وشعارها الدائم والوحيد والمكرر هو: الحل بالعودة إلى الدين، والاتكال على الإله.
إن ألد أعداء الأحزاب الدينية السياسية هي الديمقراطية التي تعني حكم الشعب. فهذه المقولة- من حيث المبدأ- تتعارض وتتناقض على طول الخط مع مفهوم الحاكمية الإلهية التي تتبناها هذه الأحزاب. وحجتها أن الشعب قد يريد شيئا مخالفا لتعاليم الإله والدين! ولهذا فإن أولى مهامها بعد استلام الحكم وأد الديمقراطية المصادرة حاليا. بمعنى أنها تقضى على كل أمل شعبي بالوصول إليها.
إن حقوق الإنسان المغيبة حاليا، ستسيل دماءها في ظل سلطة الأحزاب الدينية. فمن وجهة نظر هذه الأحزاب: الحقوق كلها للإله. أي أنها ستدفن أي أمل للناس بامتلاك حق الاختيار، وحرية الاعتقاد، و حق التعبير. لأن تلك الحقوق تخالف عقيدتها وتوجهاتها التي تقضي بتعميم عقيدة واحدة، وتعاليم ومفاهيم دينية وثقافية واحدة. وهي بذلك لن تحترم أي تعدد للأديان والمذاهب التي تذخر بها منطقتنا ومجتمعاتنا. ولن تحمي، بل لن تفسح المجال، إن لم نقل ستقمع الآراء الأخرى التي بتنوعها وتعددها تغني المجتمع وتطور البلاد.
كما أن الأحزاب الدينية تعادي مفهوم الوحدة الوطنية، على اعتبار أن الرابطة الأقوى والأمثل بين الناس هي رابطة الدين، لا رابط الأرض والتاريخ وإرادة العيش المشترك. ففي عقيدتها أن لا مصلحة مشتركة في العيش، بين أتباع دينها أو مذهبها، وبين غيرهم من الناس. إلا إذا كان هؤلاء الناس تحت سلطتها، خدما وبقرة حلوبا لها. فهي بذلك تنفث روح الفرقة والكراهية، وتنشر الخوف والنفاق والتقية، وتفتت المجتمع والوطن.
[email protected]
اية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه









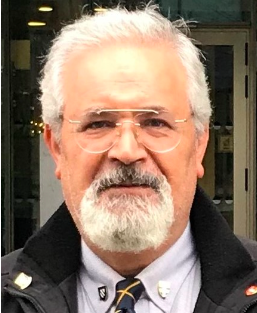

















التعليقات