أصبح العالم العربي، والشرق الأوسط بوجه عام، محور الاهتمام الدولي منذ أحداث 2001 التي خلقت صورة معينة لهذه المنطقة تركز على أن تأخر الإصلاح السياسي والاجتماعي فيها جعلها منبعاً للإرهاب. لم تكن المنطقة خارج نطاق الاهتمام الدولي قبل عام 2001، ولكن التغير الذي حدث هو أن قضيتي الإرهاب والإصلاح احتلتا بؤرة هذا الاهتمام من ناحية، وأن القضايا الإقليمية الأقدم وفي مقدمتها قضية فلسطين باتت في مرتبة تالية لقضيتي الإصلاح والإرهاب من ناحية أخرى.
ويحاول العرب، بدرجات متباينة، التفاعل مع هذا التغير الذي اختلفوا على تقويم إيجابياته وسلبياته، فلم تكن قضيتا الإرهاب والإصلاح غائبتين في الرؤية العربية العامة لمستقبل المنطقة قبل أحداث 2001، فقد ضرب الإرهاب بعض بلادهم وفرض نفسه على جدول أعمالهم طوال العقد الأخير في القرن الماضي.
كما خطت دول عربية في العقد نفسه عدة خطوات على طريق الإصلاح، وخصوصاً الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وإذا كان الاتجاه إلى إصلاح سياسي اتسم بالبطء، فقد ارتبط ذلك بعوامل داخلية وإقليمية أهمها تصاعد الإرهاب في أواخر الثمانينيات والحاجة إلى تحقيق تعبئة مجتمعية في مواجهته، والأثر السلبي لتجربة الجزائر بعد انتخابات 1991.
فالإرهاب والإصلاح هما قضيتان رئيسيتان بالفعل من زاوية مستقبل المنطقة وشعوبها، ولكن الاهتمام الدولي المتزايد بهما لن يكون في مصلحة المنطقة والعالم إذا جاء على حساب القضايا الإقليمية التي حكمت مسار الشرق الأوسط لفترة طويلة، وعلى رأسها قضية فلسطين والآثار المترتبة عليها. فالنظرة المتوازنة إلى هذه القضايا مجتمعة، وإلى العلاقة الموضوعية بينها ضرورية لخلق وضع أفضل في المنطقة.
فالإصلاح لا يحدث في فراغ، وإنما في بيئة سياسية-اجتماعية- ثقافية تتأثر بقضايا المنطقة. فإذا بقيت هذه القضايا دون حل، لابد أن يكون لها تأثير سلبي على الإصلاح، لأنها تخلق شعوراً متزايداً بالإحباط والغضب. فقد أدت ثورة الاتصالات إلى ربط عدد متزايد من الناس في العالم العربي بالتطورات اليومية لقضايا المنطقة. وفي غياب قدر كافٍ من الوعي والثقافة السياسية الديمقراطية تصبح الأجواء مهيأة لقبول وتفضيل المواقف الأكثر تطرفاً وجموحاً. وفي مثل هذه البيئة يتعذر التنافس الديمقراطي الحقيقي بين سياسات وبرامج، وعندئذ يصبح الخطاب الأكثر تطرفاً هو الرابح مسبقاً، بعد أن وفرت له المسألة العراقية مادة إضافية تعين أصحابه على خطف قطار الإصلاح وتحويله إلى مسار آخر.
هذه البيئة المانعة للتنافس المفتوح، وبالتالي لبلوغ الإصلاح محطة الاختيار الشعبي الحر، تفرض اتباع منهج تدريجي في تحقيق هذا الإصلاح. ولكن المخاطر النابعة من البيئة السياسية- الاجتماعية ليست ذريعة لتأجيل الإصلاح أو رفع لافتته بدون مضمونها، لأن هذا يؤدي إلى تفاقمها وليس إلى تقليصها. فإذا كان الإصلاح الفوري الذي يفتقد المقومات اللازمة له يمثل قفزة إلى المجهول وبالتالي خطراً على المستقبل، فتأجيل الإصلاح كلياً لا يقل خطراً. وهنا يبرز منهج الإصلاح التدريجي الذي يكتسب جديته من وضوح معالمه وتحديد أفق زمني واضح له. كما أن هذا الإصلاح يمكن أن يمضي بشكل أفضل كلما حدث تقدم في حل القضايا الكبرى في المنطقة، وخصوصاً قضية فلسطين.
وهذه العلاقة بين الإصلاح في الدول العربية وقضايا المنطقة سبق أن أكدتها وثيقة الإسكندرية (مارس 2004) في الجزء التمهيدي عندما أشارت إلى أنه "ينبغي ألا يحجب الإصلاح الداخلي أهمية معالجة القضايا الإقليمية التي تفرض نفسها على جدول أعمالنا، وفي مقدمتها الحل العادل للقضية الفلسطينية طبقاً للمواثيق الدولية.. وتأكيد استقلال العراق والحفاظ على وحدة أراضيه، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وحل المشكلات الحدودية بالطرق السلمية دون أن تكون هذه المشكلات ذريعة للتدخل الأجنبي في شؤون المنطقة العربية".
وإلى جانب تدرج الإصلاح في الدول العربية، فإن تفاوت مستوى التطور السياسي والاجتماعي لابد أن ينعكس على مسار الإصلاح في كل من هذه الدول، الأمر الذي يتعذر معه الحديث عن "أجندة" موحدة تصلح لها جميعها أو تطبق فيها كلها بالكيفية نفسها. ولكن يمكن الحديث عن هدف عام للإصلاح هو تهيئة الظروف التي تتيح للشعوب التعبير عن نفسها بحرية وإطلاق طاقاتها والمشاركة الفاعلة في إدارة شؤونها واختيار حكوماتها بشكل دوري وإبداء الرأي في السياسات التي تمس حياتها دون تمييز بين مواطنيها على أساس من الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس.
وعلى هذا الأساس، يمكن أن نطمح إلى تأثير متبادل بين قضية الإصلاح والقضايا الإقليمية في الشرق الأوسط. فالتقدم خطوة في حل قضية فلسطين بصفة خاصة يوفر إمكانات أفضل لبرامج الإصلاح في الدول العربية. كما أن كل تقدم على طريق الإصلاح يجعل الرأي العام في هذه الدول أكثر اهتماماً بالأوضاع الداخلية من خلال الآفاق التي بدأت تُفتح أمامه للمشاركة في إدارة شؤونه. وربما تصبح قطاعات يعتد بها منه أقل تأثراً بالخطاب المتشدد الذي يحول الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يوماً بعد يوم إلى صراع ديني، وتصير بالتالي أكثر وعياً بحقائق الواقع. ومثل هذا التغير في البيئة الداخلية قد يجعل الرأي العام في البلاد العربية أكثر استعداداً بدرجة أو بأخرى لقبول تسوية تقوم على حل وسط يحكمه واقع غياب التوازن بين طرفي الصراع.
ويقتضي ذلك فتح حوار عربي على مختلف المستويات حول صيغة تسوية القضية الفلسطينية وما تنطوي عليه من تفاصيل، وعدم الاكتفاء بالخطوط العامة التي تدعم بطبيعتها الميل إلى الاختزال والوقوف عند ظاهر الأمور وبالتالي التمسك بشعارات يصعب تجاوزها بدون الدخول في عمق القضايا الأساسية للتسوية.
وأول ما ينبغي تجاوزه، في هذه العملية، هو الموقف القائل إننا نقبل ما يقبله الفلسطينيون، فهم ليسوا متفقين على ما يقبلونه وما يرفضونه. كما أن الدعم الحقيقي لهم يتطلب مساعدتهم في تطوير وبلورة الصيغة أو الصيغ الممكنة لحل وسط تاريخي تقوم على أساسه الدولة الفلسطينية. كما أن القضيتين الأكثر تعقيداً والأشد عرقلة للجهود السلمية، وهما القدس واللاجئون، ليستا محض فلسطينيتين. وإذا كانت بعض المبادرات السلمية، وخصوصاً مبادرة جنيف 2003، قدمت صيغة ممكنة للتسوية في معظم القضايا الخلافية الكبرى، فقد ظلت هاتان القضيتان هما محور الاعتراض عليها من قوى وفئات واسعة على الجانبين، وليس فقط على الجانب الفلسطيني. ولذلك فإن طرح قضيتي القدس واللاجئين لجدل عام مستمر انطلاقاً من الصيغة المتضمنة في مبادرة جنيف، وسعياً إلى تعديلها أو تطويرها أو طرح صيغ حل وسط أخرى، هو أمر ضروري لدفع الجهود التي يمكن أن تجعل السلام البعيد الآن أقرب منالاً. وفي كل الأحوال ينبغي أن يتطرق الحوار حول المستقبل إلى شكل المنطقة في حالة إحراز تقدم نحو السلام.
فالمنطق الذي تقوم عليه عملية التسوية لأي صراع هو إحلال السلام في نهاية الأمر، أي علاقات سلمية، والعلاقات العربية- الإسرائيلية ليست استثناء من هذه القاعدة العامة. ولكن يصعب تحديد الشكل النهائي لهذه العلاقات، التي ستتفاوت بالضرورة بين كل بلد عربي وإسرائيل وفقاً للظروف الموضوعية في الأساس. ولكن المعطيات الراهنة إقليمياً ودولياً ترجح تنامي هذه العلاقات في حالة السلام، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال.
فالمحدد الأول لمستقبل هذه العلاقات هو التسوية السلمية نفسها ومدى القبول بها على الجانبين، وحجم المعارضة التي ستبقى ضدها. فكلما اتسع نطاق القبول بها، ازدادت فرص بناء علاقات أقوى لأن الظروف الموضوعية في عصر العولمة تخلق مصالح متبادلة جديدة لا يحتاج التعامل معها إلى إعادة تعريف المصالح الاستراتيجية، ونموذج المناطق الصناعية المؤهلة "كويز" مثال على ذلك. فهذا النموذج للعلاقة الاقتصادية بين مصر، والأردن من قبل، وإسرائيل لا يتعارض مع اعتبار التكامل الاقتصادي مصلحة استراتيجية للعالم العربي، بالرغم من الإخفاق المستمر في هذا المجال، بل يمكن للمناطق الصناعية المؤهلة في مصر والأردن أن تخلق فرصاً أفضل لهذا التكامل، إذا أقبل مستثمرون من دول عربية أخرى على إقامة مشروعات مشتركة مع مستثمرين مصريين وأردنيين في هذه المناطق للاستفادة من فرص التصدير إلى الولايات المتحدة.
إن شرقاً أوسط جديداً يبنى على الإصلاح الداخلي في بلاده ومحاصرة الإرهاب الذي يهدد مستقبل شعوبه، وحل وسط تاريخي لقضية فلسطين، ويشهد استعادة العراق واستقراره وبناء نظام ديمقراطي فيه، إنما يمثل الصورة التي ينبغي أن تتضافر الجهود لتحقيقها في عام 2005 الذي بدأ مبشراً بأن يكون أفضل حالاً من الأعوام السابقة. ولكن هذه الصورة ستبقى مجرد صورة نتطلع إليها ما لم يحدث توافق على وجود علاقة بين القضايا "الجديدة" وأهمها الإصلاح والقضايا "القديمة" وفي مقدمتها قضية فلسطين. فمن الصعب أن يدخل العرب عصراً جديداً من باب الإصلاح بدون حسم قضية كان لها أثر لا يُنكر في تأخير اقترابهم من هذا العصر. وهذه صورة ربما تظل بعيدة إذا لم يحدث توافق عربي ودولي - أميركي بصفة خاصة- على وجود علاقة بين القضايا الجديدة وعلى رأسها الإصلاح والإرهاب والقضايا القديمة وفي مقدمتها قضية فلسطين.
- آخر تحديث :







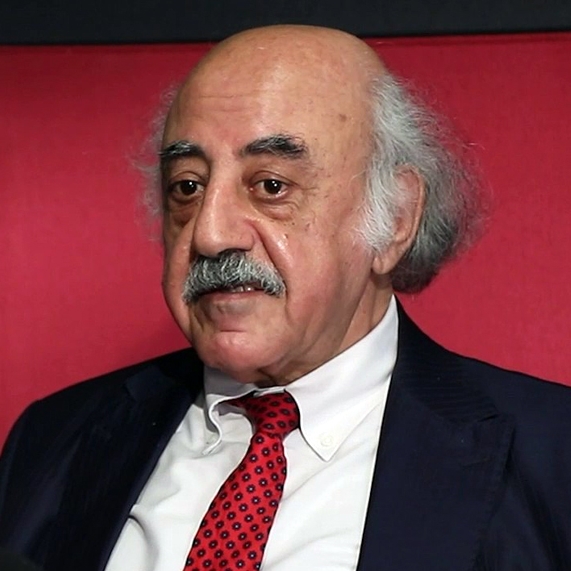












التعليقات