&
بسرعة، انقضى رمضان، ومر عيد الفطر. وعادت الأيام الى ايقاعها المعتاد، لأكثر من اسبوع استعدنا نحن سكان القاهرة أيامها الخمسينية والستينية.
عندما كان سكان مصر كلها أقل من سكان القاهرة الآن حيث يقيم بها عشرون مليونا بخلاف من يدخلها ويخرج منها يوميا ويقدر عدد هؤلاء ثلاثة أو أربعة ملايين. لا أحد يعرف على وجه الدقة فلا توجد بيانات دقيقة يمكن الرجوع اليها.
يطيب لي في أيام العيد النزول نهارا الى شوارع المدينة، عدد السيارات أقل، كثافة المارة أخف. أجوس خلال الطرق، عبر المدينة القديمة، وبقدر استعادتي لسنوات المدينة التي كانت أقل زحاما وضجيجا مما هي عليه الآن، بقدر ما استعيد مسافات من زمني الخاص، تلك الساعات التي مررت بها أو مرت بي.
ليست الأعياد والأيام والشهور الخاصة الا علامات بارزة، ومحطات نتطلع صوبها أو نحن اليها على طريق وجودنا، وبلا شك فإن رمضان من أبرز تلك العلامات، كذلك عيد الفطر المتصل به الذي يعقبه، أذكر الآن هذا البيت الجميل من الشعر الأندلسي يرد في موشح مازال يتردد في الغناء القديم (أتت سرعة ومضت بغتة..) حقا لقد حلت أيام رمضان الوادعة. العامرة بالود. ومضت سرعة وبغتة. أهذا ما يقع حقا أم أنه ما يخيل الي. أكاد أوقن أن احساس المرء بالزمن يتغير مع الزمن، يبدو في العقود الثلاثة الأولى من العمر ابطأ، أرسخ اقامة، ربما لان النظر يتطلع الى الامام، يكون الغد غالباً على الآن، الآتي ممتد، وبالتالي حضور الماضي أقل، حتى اذا أمعن المضي واجتاز الثلاثين، بدأ الالتفات الى الوراء. ومن يمعن النظر فيما كان ينشغل عما هو كائن، وبالتالي لا ينتبه الى ما يجري، هكذا من حين الى حين ينتبه الى مضي اسبوع أو شهر أو سنة. ربما يفسر ذلك الاحساس بمرور الوقت بغتة مع تقدم العمر. هكذا استعيد ما كان.
مع بدء الأيام العشرة الأواخر من رمضان، مع اصغائي الى أشهر أغنيات الوداع.. (ما أوحش الله منك يا شهر الصيام) أو (والله لسه بدري بدري يا شهر الصيام).
حتى يبدأ شعوري بانقضاء الوقت، وبدء زوال الشهر الفضيل، وبخيالي القديم أرى الشيخ رمضان. والغالب عليه البياض، يحزم أمتعته ويبدأ التأهب مفسحا الزمان والمكان للعيد، لشهر شوال والذي يغلب عليه اسم العيد عندي. في الصبا نتطلع الى قرب العيد، والى ما يرتبط به من مباهج، أهمها ارتباطه بالجديد، الملابس الجديدة، أيا كان مستوى العائلة المادي فلابد أن يرتدي الابناء ملابس جديدة، وبالتحديد الابناء، من المفضل ان يرتدي الوالدان جديداً، لكن ربما يقع استثناء، أما الاطفال فمن العلامات غير المستحبة أن يأتي العيد وهم في ثياب قديمة، حتى وان كانت تبدو متماسكة، في الاربعينيات أو الخمسينيات، كانت مصادر الملابس الجديدة بالنسبة لنا في الجمالية وغيرها من مناطق سكنى الطبقة المتوسطة بشرائحها المختلفة متاجر شارعي الموسكي والسكة الجديدة، وهما في الواقع شارع واحد ذو ثلاث مراحل، يبدأ من ميدان العتبة الخضراء، وينتهي في ميدان الحسين، المرحلة الأولى من الميدان حتى شارع الخليج الذي أطلق عليه فيما بعد شارع بورسعيد وكان الخليج الناصري يجري مكانه ليزود القاهرة بالماء ثم تم ردمه في السنة العاشرة من القرن الماضي، المرحلة التالية تبدأ من شارع الخليج وتنتهي عند شارع المعز لدين الله، حيث يبدأ سوق الصاغة الشهير المتخصص في الذهب، أما الثالثة، فتبدأ من المعز وتنتهي في ميدان الحسين، وتعد جزءا أصيلا من القاهرة الفاطمية، كانت المتاجر على الجانبين تعرض أفضل ما لديها. وكان القسم الأول ومازال متخصصا في محلات الملابس الجاهزة والأقمشة، ويتفرع من درب ضيق، متخصص في عرض المنتجات الجلدية، خاصة الحقائب والمحافظ والأحزمة، أما الأحذية فلها متاجر أخرى تقع بين محلات الجزء الأول، مما أذكره معرض كبير، واجهة عريضة لشركة (بيضافون) المتخصصة في الأسطوانات، كان عند مدخلها تمثالان بالحجم الطبيعي من الخشب لمحمد عبدالوهاب وأم كلثوم، وفي طفولتي المبكرة كانت رؤيتي لهما تؤجج خيالي وتنشطه، كنت أتخيل أن الحياة تدب فيما أراه من تماثيل ورسوم، وانها تتحرك لممارسة أنشطتها بعد انصراف القوم، ومما لعب دورا مهماً في تنمية ذاكرتي البصرية الاعلانات عن أفلام السينما. وكانت تعلق في الشوارع. وكان أحد أماكنها الثابتة ناصية شارع قصر الشوق. ومماعلق بذاكرتي مجموعة من اللوحات كانت تحكي قصة شمشون ودليلة، تمت الى عشرينات القرن الماضي، مطبوعة. كانت معلقة الى جدران وكان لمسح واصلاح الأحذية في شارع الازهر، ومازال قائما حتى الآن، ولا تزال اللوحات معلقة الا ان الغبار علاها، وتشقق الزجاج الذي كان يغطيها، أما ما كنت أتخيله حولها فلم يعد له أثر، كلما استمعت الى تسجيل قديم الآن يبدأ بتلك العبارة:
(أسطوانات بيضافون تقدم...)
أتذكر على الفور هذا المعرض الذي زال الآن، وتمثالي عبدالوهاب وأم كلثوم، وكل مايحيطهما من زمان أو مكان، كان ميدان العتبة فاصلا بين قاهرتنا القديمة والقاهرة الرومية التي بدأ تحفيظها وبناؤها في القرن التاسع عشر على نموذج باريس، وظل معظم سكانها من الأجانب حتى الخمسينيات من القرن الماضي، كانت مخازن ومعارض الملابس الاغلى ثمنا، المستوردة من فرنسا، تقع في شارع فؤاد كما يطلق عليه القوم حتى الآن رغم ان اسمه تغير رسميا بعد الثورة الى شارع ستة وعشرين يوليو، كان الانتقال من القاهرة القديمة الى وسط البلد يحدث عندي تأثيرا أقوى من ذلك الذي أشعر به الآن اذ أسافر من القاهرة الى باريس أو احدى العواصم الأوروبية، رغم أن المدينة واحدة الا أن العالمين كانا متباينين تماما.
اعتاد الوالد أن يتعامل مع متجر يبيع الملابس الجاهزة في الجزء الثاني من الشارع، وكان أحد العاملين به يسكن منزلا مجاورا لنا في الحارة، كان أصلع، جاد المظهر، وكان شقيقه مدرسا للغة العربية بمدرسة عبدالرحمن كتخدا الابتدائية، أما ابنته الهيفاء، جميلة التقاسيم، فقد خفق لها قلبي مبكرا، ولم تعرف حتى الآن بمشاعري لها التي كانت تنتمي الى الحب العذري، ليست الملابس الجديدة المتاجر المتخصصة تعرض نماذج شتى العربات والقطارات والترامويات وكان معظمها يدار بالزمبلك، آلة صغيرة داخل كل منها تملأ بمفتاح صغير، وعندئذ تنطلق القاطرة أو العربة ولكم اثارت هذه اللعب خيالي أيضا.
منذ بدء الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، تعبق الحارة برائحة الفانيليا المستخدمة في الكعك والبسكويت، يعمل فرن الحاج نصيف الذي يتوسط الحارة لمدة أربع وعشرين ساعة، ويشتد الزحام امامها. وينتظر الرجال والنساء. الفتيان والفتيات للحصول على صاجات الكعك الفارغة، ويلتزم الحاج نصيف نظاما صارما لا مجال فيه للوساطات أو الخواطر، كل في دوره ولكم انفقت من ساعات انتظار امام الفرن حتى أعود بصاجين أو ثلاثة الى أمي التي كانت تتفرغ لخبز الكعك والبسكويت والغريبة، كانت تقول (عادة.. ربنا ما يقطعها..) تعني عادة ألفها القوم. هذا دعاء سمعته كثيرا، ولم أعرف معناه الا عندما انقطعت عادة ما مع مرور الزمن وهدمه لعادات أو تغيير هيئاتها أو أشكالها.
الملابس الجديدة، لعبة جديدة، من أهم العادات اللازمة للعيد، لكن أهم علامة، صلاة العيد، نستيقظ فجرا، انشراح وبهجة، ذلك اننا سنصحب الوالد الى مسجد الحسين القريب، رغم وجود مسجد عند مدخل الدرب، مسجد سيدي مرزوق الأحمدي تلميذ سيدي أحمد البدوي المتصوف الأشهر. الا أن الوالد الكريم حرص دائما على تأدية الصلاة في مسجد مولانا وسيدنا، كنا نحرص على الذهاب مبكرين، اذ كان المسجد يغلق أبوابه بعد وصول الرئيس جمال عبدالناصر والذي كان يؤدي صلاة العيدين في مسجد الامام الحسين، وكان يدخل من الباب المطل على الميدان، وكنا ندخل من أحد الأبواب الجانبية. وفور انتهاء الصلاة نسرع بالخروج مع آلاف المصلين لنتخذ موقعنا إما في الميدان أو في شارع الازهر لنرى جمال عبدالناصر ويرانا، لنحييه ويحيينا، وكانت طلته قوية، مؤثرة، جميلة، بها يشرق العيد، وتتقد بهجتنا.
عندما كان سكان مصر كلها أقل من سكان القاهرة الآن حيث يقيم بها عشرون مليونا بخلاف من يدخلها ويخرج منها يوميا ويقدر عدد هؤلاء ثلاثة أو أربعة ملايين. لا أحد يعرف على وجه الدقة فلا توجد بيانات دقيقة يمكن الرجوع اليها.
يطيب لي في أيام العيد النزول نهارا الى شوارع المدينة، عدد السيارات أقل، كثافة المارة أخف. أجوس خلال الطرق، عبر المدينة القديمة، وبقدر استعادتي لسنوات المدينة التي كانت أقل زحاما وضجيجا مما هي عليه الآن، بقدر ما استعيد مسافات من زمني الخاص، تلك الساعات التي مررت بها أو مرت بي.
ليست الأعياد والأيام والشهور الخاصة الا علامات بارزة، ومحطات نتطلع صوبها أو نحن اليها على طريق وجودنا، وبلا شك فإن رمضان من أبرز تلك العلامات، كذلك عيد الفطر المتصل به الذي يعقبه، أذكر الآن هذا البيت الجميل من الشعر الأندلسي يرد في موشح مازال يتردد في الغناء القديم (أتت سرعة ومضت بغتة..) حقا لقد حلت أيام رمضان الوادعة. العامرة بالود. ومضت سرعة وبغتة. أهذا ما يقع حقا أم أنه ما يخيل الي. أكاد أوقن أن احساس المرء بالزمن يتغير مع الزمن، يبدو في العقود الثلاثة الأولى من العمر ابطأ، أرسخ اقامة، ربما لان النظر يتطلع الى الامام، يكون الغد غالباً على الآن، الآتي ممتد، وبالتالي حضور الماضي أقل، حتى اذا أمعن المضي واجتاز الثلاثين، بدأ الالتفات الى الوراء. ومن يمعن النظر فيما كان ينشغل عما هو كائن، وبالتالي لا ينتبه الى ما يجري، هكذا من حين الى حين ينتبه الى مضي اسبوع أو شهر أو سنة. ربما يفسر ذلك الاحساس بمرور الوقت بغتة مع تقدم العمر. هكذا استعيد ما كان.
مع بدء الأيام العشرة الأواخر من رمضان، مع اصغائي الى أشهر أغنيات الوداع.. (ما أوحش الله منك يا شهر الصيام) أو (والله لسه بدري بدري يا شهر الصيام).
حتى يبدأ شعوري بانقضاء الوقت، وبدء زوال الشهر الفضيل، وبخيالي القديم أرى الشيخ رمضان. والغالب عليه البياض، يحزم أمتعته ويبدأ التأهب مفسحا الزمان والمكان للعيد، لشهر شوال والذي يغلب عليه اسم العيد عندي. في الصبا نتطلع الى قرب العيد، والى ما يرتبط به من مباهج، أهمها ارتباطه بالجديد، الملابس الجديدة، أيا كان مستوى العائلة المادي فلابد أن يرتدي الابناء ملابس جديدة، وبالتحديد الابناء، من المفضل ان يرتدي الوالدان جديداً، لكن ربما يقع استثناء، أما الاطفال فمن العلامات غير المستحبة أن يأتي العيد وهم في ثياب قديمة، حتى وان كانت تبدو متماسكة، في الاربعينيات أو الخمسينيات، كانت مصادر الملابس الجديدة بالنسبة لنا في الجمالية وغيرها من مناطق سكنى الطبقة المتوسطة بشرائحها المختلفة متاجر شارعي الموسكي والسكة الجديدة، وهما في الواقع شارع واحد ذو ثلاث مراحل، يبدأ من ميدان العتبة الخضراء، وينتهي في ميدان الحسين، المرحلة الأولى من الميدان حتى شارع الخليج الذي أطلق عليه فيما بعد شارع بورسعيد وكان الخليج الناصري يجري مكانه ليزود القاهرة بالماء ثم تم ردمه في السنة العاشرة من القرن الماضي، المرحلة التالية تبدأ من شارع الخليج وتنتهي عند شارع المعز لدين الله، حيث يبدأ سوق الصاغة الشهير المتخصص في الذهب، أما الثالثة، فتبدأ من المعز وتنتهي في ميدان الحسين، وتعد جزءا أصيلا من القاهرة الفاطمية، كانت المتاجر على الجانبين تعرض أفضل ما لديها. وكان القسم الأول ومازال متخصصا في محلات الملابس الجاهزة والأقمشة، ويتفرع من درب ضيق، متخصص في عرض المنتجات الجلدية، خاصة الحقائب والمحافظ والأحزمة، أما الأحذية فلها متاجر أخرى تقع بين محلات الجزء الأول، مما أذكره معرض كبير، واجهة عريضة لشركة (بيضافون) المتخصصة في الأسطوانات، كان عند مدخلها تمثالان بالحجم الطبيعي من الخشب لمحمد عبدالوهاب وأم كلثوم، وفي طفولتي المبكرة كانت رؤيتي لهما تؤجج خيالي وتنشطه، كنت أتخيل أن الحياة تدب فيما أراه من تماثيل ورسوم، وانها تتحرك لممارسة أنشطتها بعد انصراف القوم، ومما لعب دورا مهماً في تنمية ذاكرتي البصرية الاعلانات عن أفلام السينما. وكانت تعلق في الشوارع. وكان أحد أماكنها الثابتة ناصية شارع قصر الشوق. ومماعلق بذاكرتي مجموعة من اللوحات كانت تحكي قصة شمشون ودليلة، تمت الى عشرينات القرن الماضي، مطبوعة. كانت معلقة الى جدران وكان لمسح واصلاح الأحذية في شارع الازهر، ومازال قائما حتى الآن، ولا تزال اللوحات معلقة الا ان الغبار علاها، وتشقق الزجاج الذي كان يغطيها، أما ما كنت أتخيله حولها فلم يعد له أثر، كلما استمعت الى تسجيل قديم الآن يبدأ بتلك العبارة:
(أسطوانات بيضافون تقدم...)
أتذكر على الفور هذا المعرض الذي زال الآن، وتمثالي عبدالوهاب وأم كلثوم، وكل مايحيطهما من زمان أو مكان، كان ميدان العتبة فاصلا بين قاهرتنا القديمة والقاهرة الرومية التي بدأ تحفيظها وبناؤها في القرن التاسع عشر على نموذج باريس، وظل معظم سكانها من الأجانب حتى الخمسينيات من القرن الماضي، كانت مخازن ومعارض الملابس الاغلى ثمنا، المستوردة من فرنسا، تقع في شارع فؤاد كما يطلق عليه القوم حتى الآن رغم ان اسمه تغير رسميا بعد الثورة الى شارع ستة وعشرين يوليو، كان الانتقال من القاهرة القديمة الى وسط البلد يحدث عندي تأثيرا أقوى من ذلك الذي أشعر به الآن اذ أسافر من القاهرة الى باريس أو احدى العواصم الأوروبية، رغم أن المدينة واحدة الا أن العالمين كانا متباينين تماما.
اعتاد الوالد أن يتعامل مع متجر يبيع الملابس الجاهزة في الجزء الثاني من الشارع، وكان أحد العاملين به يسكن منزلا مجاورا لنا في الحارة، كان أصلع، جاد المظهر، وكان شقيقه مدرسا للغة العربية بمدرسة عبدالرحمن كتخدا الابتدائية، أما ابنته الهيفاء، جميلة التقاسيم، فقد خفق لها قلبي مبكرا، ولم تعرف حتى الآن بمشاعري لها التي كانت تنتمي الى الحب العذري، ليست الملابس الجديدة المتاجر المتخصصة تعرض نماذج شتى العربات والقطارات والترامويات وكان معظمها يدار بالزمبلك، آلة صغيرة داخل كل منها تملأ بمفتاح صغير، وعندئذ تنطلق القاطرة أو العربة ولكم اثارت هذه اللعب خيالي أيضا.
منذ بدء الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، تعبق الحارة برائحة الفانيليا المستخدمة في الكعك والبسكويت، يعمل فرن الحاج نصيف الذي يتوسط الحارة لمدة أربع وعشرين ساعة، ويشتد الزحام امامها. وينتظر الرجال والنساء. الفتيان والفتيات للحصول على صاجات الكعك الفارغة، ويلتزم الحاج نصيف نظاما صارما لا مجال فيه للوساطات أو الخواطر، كل في دوره ولكم انفقت من ساعات انتظار امام الفرن حتى أعود بصاجين أو ثلاثة الى أمي التي كانت تتفرغ لخبز الكعك والبسكويت والغريبة، كانت تقول (عادة.. ربنا ما يقطعها..) تعني عادة ألفها القوم. هذا دعاء سمعته كثيرا، ولم أعرف معناه الا عندما انقطعت عادة ما مع مرور الزمن وهدمه لعادات أو تغيير هيئاتها أو أشكالها.
الملابس الجديدة، لعبة جديدة، من أهم العادات اللازمة للعيد، لكن أهم علامة، صلاة العيد، نستيقظ فجرا، انشراح وبهجة، ذلك اننا سنصحب الوالد الى مسجد الحسين القريب، رغم وجود مسجد عند مدخل الدرب، مسجد سيدي مرزوق الأحمدي تلميذ سيدي أحمد البدوي المتصوف الأشهر. الا أن الوالد الكريم حرص دائما على تأدية الصلاة في مسجد مولانا وسيدنا، كنا نحرص على الذهاب مبكرين، اذ كان المسجد يغلق أبوابه بعد وصول الرئيس جمال عبدالناصر والذي كان يؤدي صلاة العيدين في مسجد الامام الحسين، وكان يدخل من الباب المطل على الميدان، وكنا ندخل من أحد الأبواب الجانبية. وفور انتهاء الصلاة نسرع بالخروج مع آلاف المصلين لنتخذ موقعنا إما في الميدان أو في شارع الازهر لنرى جمال عبدالناصر ويرانا، لنحييه ويحيينا، وكانت طلته قوية، مؤثرة، جميلة، بها يشرق العيد، وتتقد بهجتنا.
(البيان)







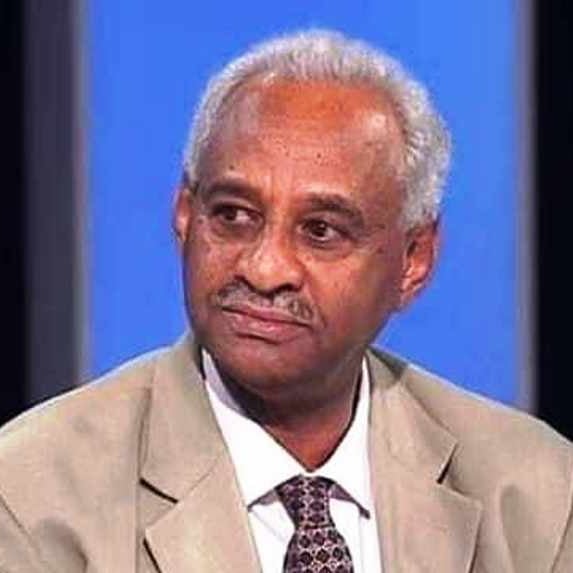













التعليقات