كيف يمكن الوقوف على تمييز واضح لفكرة الإنجاز، تلك التي تتصدر المشهد العربي برمته، حتى تجد الجميع يتحدث عنها من دون أن يكون لها وقعا في المعطى الاجتماعي. وهكذا يكون الانجاز بمثابة الفاصل وليس الرابط بين الوعي والواقع، وعي يقوم على الانفصال والتوزع والتشتت، وواقع يعيش حالات الانشطار والوهن والفزع والخواف من كل شيء وأي شيء.إنها لحظة الانتشاء تلك التي يتقمصها السياسي والاجتماعي، باعتبار محاولة الربط بين تلبية الحاجات المباشرة التي تفرضها طبيعة الوظيفة، التي تحصلت عليها القوى الفاعلة في المجتمع. وهكذا تقع فكرة الانجاز تحت طائلة الفراغ المعنوي، حيث الانفصال الواضح عن المعطيات الاجتماعية والرسوخ عند مفصل الإكسسوار والإضافة السطحية، تلك التي تكون في أحسن أحوالها وقد توافقت مع معطيات الثقافة الشعبية، حيث التفاعل الهائل مع ثقافة الاتصال، ومدى التأثير في إبراز مجال الشكلي على المضمون.
تقمصات اللحظة
توقف العرب طويلا عند ترصد التناقضات التي يزخر بها الواقع، وبات الموضوع يمثل شغفا ورغبة عارمة، تلبي حاجات الكثير من المشتغلين في ترصد الظواهر التاريخية، حتى تحول الموضوع إلى هوس يقرب إلى الظاهرة المرضية، حيث العائق والركام والتناقض والعبء والنقص والشك، فيما بقي الانجاز على مستواه القديم، من دون نقصان، إن لم يكن وقد تفاقمت الحال فيه، ليصل معدل الفشل فيه وقد تفاقم إلى مستويات مفزعة، لا يتبدى التأثير فيها سوى في المجال الاجتماعي، حيث الإحباط والقهر والتراجع، وتنامي الفعاليات التي يتم ارتهان مجمل الفعاليات فيها إلى النقد المرير، فيما تلوذ القراءة الفاعلة في الزاوية القصية النائية، عن المدركات والمحفزات الحقيقية و الأصيلة. ومن هذا الواقع باتت مفردة (الإنجاز) ومن كثرة ما تم ترديدها على المسامع، بمثابة النكتة السمجة، والتي لا ينجم عنها سوى الغثيان و التبرم والسخرية المرة.
توقف العرب طويلا عند ترصد التناقضات التي يزخر بها الواقع، وبات الموضوع يمثل شغفا ورغبة عارمة، تلبي حاجات الكثير من المشتغلين في ترصد الظواهر التاريخية، حتى تحول الموضوع إلى هوس يقرب إلى الظاهرة المرضية، حيث العائق والركام والتناقض والعبء والنقص والشك، فيما بقي الانجاز على مستواه القديم، من دون نقصان، إن لم يكن وقد تفاقمت الحال فيه، ليصل معدل الفشل فيه وقد تفاقم إلى مستويات مفزعة، لا يتبدى التأثير فيها سوى في المجال الاجتماعي، حيث الإحباط والقهر والتراجع، وتنامي الفعاليات التي يتم ارتهان مجمل الفعاليات فيها إلى النقد المرير، فيما تلوذ القراءة الفاعلة في الزاوية القصية النائية، عن المدركات والمحفزات الحقيقية و الأصيلة. ومن هذا الواقع باتت مفردة (الإنجاز) ومن كثرة ما تم ترديدها على المسامع، بمثابة النكتة السمجة، والتي لا ينجم عنها سوى الغثيان و التبرم والسخرية المرة.
الإنجاز شعبيا
لم تعد لمفردة الانجاز، وعلى الرغم من القيم الايجابية التي تختزن بها، من تأثير في الواقع العربي، بعد أن فقدت رصيدها، وصارت رهنا لترصد الإنتاج المجزوء والمرتهن للعقلية الفردية والواقعة في إسار التقليد، فيما تم نبذ القراءة الراصدة لآليات الإنتاج، حتى لم يعد يستبان الخيط الفاصل والشعرة الرقيقة بين الإصلاح بوصفه برنامجا يسعى إلى التغيير، والترقيع ذلك المحتوى الجاثم على العقل. وإذا كانت الحضارات والمجتمعات قد قيض لها الوقوف على الإمساك بلحظة التفاعل التاريخي، والفوز بالانتقال من وضع الخضوع والتسليم والتلقي السلبي، عبر تقديم منجزات العقل، فإن الفاصل الذي يرسف فيعه العرب اليوم، يبقى يعيش لحظة التردد في حسم الموقف بين ثنائية( سيادة الأفكار) و (طريقة التفكي).
كيف لأمة أن تتعايش مع مضمون الإنجاز، وهي ما انفكت تعاني من ويلات سيادة المضمون الراسخ والثابت للأفكار، وكيف لعقلية أن تتفاعل مع الواقع وهي تعاني من حضورية التفكير الجاهز والمعلب، إنها الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية والعنصرية، تلك التي تغشى بحضورها عل المجمل من المضامين، فيما يتنادى ويتصارخ الكثير من الناقدين، بأهمية الخروج من إسار اللحظة الراهنة التي يعيشها العرب.لحظة حرجة تلك التي يعاني منها العرب، لا شك في هذا، ولكن كيف السبيل للخروج من وهدتها وسيطرتها المقيتة، هل بالدعاء أم بالإدعاء بأن الواقع العربي مازال فيه الرمق من الخير والسماحة والنبالة والفروسية، وأن ما يحدث في هذا الراهن المقيت، لا يعدو أن يكون مجرد عرض زائل وليل لا بد له أن ينجلي.
لم تعد لمفردة الانجاز، وعلى الرغم من القيم الايجابية التي تختزن بها، من تأثير في الواقع العربي، بعد أن فقدت رصيدها، وصارت رهنا لترصد الإنتاج المجزوء والمرتهن للعقلية الفردية والواقعة في إسار التقليد، فيما تم نبذ القراءة الراصدة لآليات الإنتاج، حتى لم يعد يستبان الخيط الفاصل والشعرة الرقيقة بين الإصلاح بوصفه برنامجا يسعى إلى التغيير، والترقيع ذلك المحتوى الجاثم على العقل. وإذا كانت الحضارات والمجتمعات قد قيض لها الوقوف على الإمساك بلحظة التفاعل التاريخي، والفوز بالانتقال من وضع الخضوع والتسليم والتلقي السلبي، عبر تقديم منجزات العقل، فإن الفاصل الذي يرسف فيعه العرب اليوم، يبقى يعيش لحظة التردد في حسم الموقف بين ثنائية( سيادة الأفكار) و (طريقة التفكي).
كيف لأمة أن تتعايش مع مضمون الإنجاز، وهي ما انفكت تعاني من ويلات سيادة المضمون الراسخ والثابت للأفكار، وكيف لعقلية أن تتفاعل مع الواقع وهي تعاني من حضورية التفكير الجاهز والمعلب، إنها الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية والعنصرية، تلك التي تغشى بحضورها عل المجمل من المضامين، فيما يتنادى ويتصارخ الكثير من الناقدين، بأهمية الخروج من إسار اللحظة الراهنة التي يعيشها العرب.لحظة حرجة تلك التي يعاني منها العرب، لا شك في هذا، ولكن كيف السبيل للخروج من وهدتها وسيطرتها المقيتة، هل بالدعاء أم بالإدعاء بأن الواقع العربي مازال فيه الرمق من الخير والسماحة والنبالة والفروسية، وأن ما يحدث في هذا الراهن المقيت، لا يعدو أن يكون مجرد عرض زائل وليل لا بد له أن ينجلي.
إنجاز الآخر
قيض للمجتمعات والحضارات المختلفة أن تعيش لحظات التحول الكبرى عبر تقديم طريقة التفكير على حساب الأفكار السائدة، وهكذا كان تفاعل الغرب الذي قيض له أن يحصد ثمار الإنجاز، عبر الخلاص من نمط التفكير الأسطوري القائم على التلقي الفج، وتقديم منهج الاستدلال العقلي الذي دشنه الفيلسوف طاليس، إنه المنهج الكلي الساعي نحو تثبيت معالم الطريقة التي يتم فيها التفاعل مع آليات إنتاج الأفكار، وليس الخضوع القهري لبريق الفكرة، وعبر هذا الحفز جاء مفهوم التطور الذي تفاعل مع المحتوى السائد في التنظيم الاجتماعي، عبر لحظات التعاقب الطبيعي، حيث الفرز الواضح والدقيق لمفهوم التطورية التي أبرزت قوانينها في النظام الفكري المفتوح، فيما بقيت مجتمعات التبعية تعيش انغلاقها المفجع في تفاعيل التاريخانية الثابتة والمنغلقة، باعتبار التشكيكية والصوفية، فيما يبقى العلمي وقد عانى من العزل والإقصاء.
بين الثابت المطلق والمتحول المطلق، تكمن أزمة العقل العربي، حيث الانكباب المرير على الثابت التاريخاني، فيما تبقى المجتمعات الحية تقوم على الخلاص من هذا الثابت المليء بالتناقض والسعي الحثيث نحو التغير، عبر ترصدات المجال التاريخي والتطلع نحو تثبيت معالم الانتظام لأساليب التفكير وطرائق البحث المتجددة، إنه الوعي بالصيرورة الروحية، تلك التي تضافرت فيها جهود المدارس الغربية من الحياة الفرنسية والبراغماتية الإنكليزية والتاريخية الألمانية، وتكللت فيه المساعي نحو تفعيل دور الثقافة المؤسساتية، وجعلها في صميم عملية التغيير والتحول بعيدا عن الأنساق البنيوية الثابتة والراسخة.
قيض للمجتمعات والحضارات المختلفة أن تعيش لحظات التحول الكبرى عبر تقديم طريقة التفكير على حساب الأفكار السائدة، وهكذا كان تفاعل الغرب الذي قيض له أن يحصد ثمار الإنجاز، عبر الخلاص من نمط التفكير الأسطوري القائم على التلقي الفج، وتقديم منهج الاستدلال العقلي الذي دشنه الفيلسوف طاليس، إنه المنهج الكلي الساعي نحو تثبيت معالم الطريقة التي يتم فيها التفاعل مع آليات إنتاج الأفكار، وليس الخضوع القهري لبريق الفكرة، وعبر هذا الحفز جاء مفهوم التطور الذي تفاعل مع المحتوى السائد في التنظيم الاجتماعي، عبر لحظات التعاقب الطبيعي، حيث الفرز الواضح والدقيق لمفهوم التطورية التي أبرزت قوانينها في النظام الفكري المفتوح، فيما بقيت مجتمعات التبعية تعيش انغلاقها المفجع في تفاعيل التاريخانية الثابتة والمنغلقة، باعتبار التشكيكية والصوفية، فيما يبقى العلمي وقد عانى من العزل والإقصاء.
بين الثابت المطلق والمتحول المطلق، تكمن أزمة العقل العربي، حيث الانكباب المرير على الثابت التاريخاني، فيما تبقى المجتمعات الحية تقوم على الخلاص من هذا الثابت المليء بالتناقض والسعي الحثيث نحو التغير، عبر ترصدات المجال التاريخي والتطلع نحو تثبيت معالم الانتظام لأساليب التفكير وطرائق البحث المتجددة، إنه الوعي بالصيرورة الروحية، تلك التي تضافرت فيها جهود المدارس الغربية من الحياة الفرنسية والبراغماتية الإنكليزية والتاريخية الألمانية، وتكللت فيه المساعي نحو تفعيل دور الثقافة المؤسساتية، وجعلها في صميم عملية التغيير والتحول بعيدا عن الأنساق البنيوية الثابتة والراسخة.




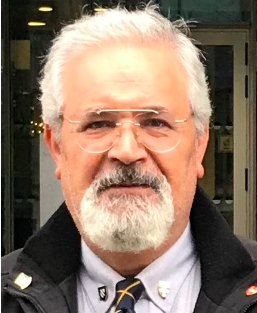

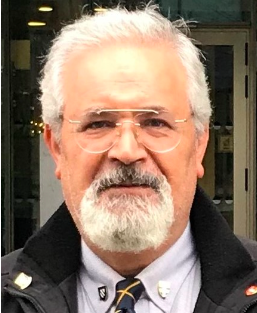












التعليقات