اقترع مجلس النواب الأميركي بأكثرية ساحقة ضد قرار محكمة العدل الدولية الخاص بالعواقب القانونية للجدار الإسرائيلي. تضمّن الموقف الأميركي مغالطات كثيرة وبدائية. وعبّر عن قلة اكتراث استثنائية بأعلى هيئة قضائية دولية. اتهم نواب أميركيون زملاءهم بانحياز أعمى إلى الاحتلال. ذكّروا بأنه كان ممكناً الجمع بين lt;lt;الصداقةgt;gt; لإسرائيل ورؤية الفلسطينيين كشعب...
كيف يفترض بالإعلام، العربي تحديداً، رؤية هذه الواقعة وروايتها؟ هل يمكن لأي مخيلة اكتشاف طريقة في التعاطي لا تقود إلى تعميق الرفض العربي، والكراهية، لسياسة أميركا الخارجية؟ أليس أرقى أنواع الحياد، هنا، هو الانحياز الكامل إلى لاهاي على حساب واشنطن؟
وقع الحدث بعد انتهاء أعمال مؤتمر الدوحة الباحث في lt;lt;الإعلام في عالم متغيّرgt;gt; وفي معايير النزاهة والدقة والموضوعية وصلاتها بالتعددية. ومع أن المؤتمر جمع عشرات المهتمين فإنه لم يتحوّل إلى مناظرة ثنائية lt;lt;نحن همgt;gt; لوفرة الحضور الآسيوي والأفريقي ولمساهمات إعلاميين غربيين نقديين. صحيح أن lt;lt;قناة الجزيرةgt;gt; كانت حاضرة بقوة في ذهن المتحاورين وبعض مداخلاتهم إلا أن النقاش امتد ليطال معنى أن يكون المرء إعلامياً اليوم في زمن الانشطار المزعوم بين خير وشر انتدب كل واحد منهما بقعة جغرافية، ذات لون قومي وديني، يستوطنها.
يمكن تحديد بعض العناصر التي حددت الإطار العام للمؤتمر.
أولاً لقد بات محسوماً أن العالمين العربي والإسلامي هما مركز اهتمام استثنائي سيمتد لأجيال لاحقة. قد لا يخطر في بال أحد عقد أو حضور مؤتمر دولي عن الإعلام في الهند أو أميركا اللاتينية. فالمنطقة، منطقتنا، تحتل وستحتل مركز الصدارة في الأحداث بعدما حوّلت واشنطن تفجيرات 11 أيلول إلى lt;lt;الحدث التأسيسيgt;gt; لعالم جديد. يُراد للأضواء المسلطة علينا أن تعمي الأبصار.
ثانياً الغريب أن هذه الأضواء تزعم اكتشاف، بين أمور أخرى، lt;lt;العجز الديموقراطيgt;gt; لدى العرب والمسلمين. لا بل إن العقيدة المتحكّمة بأيديولوجيي الحرب بعد 11 أيلول تقول إن هذا العجز، بالضبط، سبب التفجيرات وما تلاها. لا علاقة للسياسات الخارجية بالأمر. ثمة مرض عضال يأكل شعوباً وأنظمة وأفراداً ويعبّر عن نفسه بكراهية عمياء حيال آخرين لا ذنب لهم إلا نجاحهم وازدهارهم وتمتعهم بنمط حياة معيّن. ومع أن هذه هي العقيدة المعلنة فإن التعبير عنها يأخذ، شكلاً، عنوان lt;lt;الإصلاحgt;gt; وتوسيع مساحة الحريات، في حين أنها تترجم نفسها، عملياً، بالتبرّم من الاستخدام lt;lt;السيئgt;gt; لأي هامش حرية. يبدو أن هناك من يطالب العرب، ليس بالموضوعية، وإنما بسلوك مازوشي يعلي كراهية الذات (وعدم الانتماء) إلى مرتبة عالية.
ثالثاً اللافت أن الذين يلقون الدروس من السياسيين والإعلاميين، الأميركيين خاصة، هم، بالضبط، الذين نظموا واحدة من أكبر حملات التضليل، قصداً أو غفلة. لقد دخل الإعلام الأميركي والأوروبي، بعد 11 أيلول، وبمناسبة الحرب على العراق، في أزمة عميقة لم يخرج منها تماماً. ومع أن محاولات خجولة للنقد الذاتي تجري هنا وهناك فإنها، على أهميتها، لم تلامس جوهر المشكلة واكتفت بما هو lt;lt;تقنيgt;gt; عوض الغوص في شبكة المصالح المتعارضة. لم يكن ما حصل هفوة قادت إلى خطأ بسيط. إن ما جرى هو تزوير للديموقراطية في بلدان بما أسفر عن نشوب حرب تلامس نقطة شديدة الحساسية في العلاقات الكونية. ومن الواجب أن نتساءل عمّا إذا كان الوقوع في هذه الأخطاء (المتعمّدة؟) ممكناً لولا الارتكاز على النظرية القائلة بأن الحروب باتت تكلف lt;lt;صفر قتلىgt;gt; في صفوف من يشنها، فما المشكلة، إذاً، في الاستفادة من هذا الترف؟
رابعاً حقق الإعلام العربي الاعتراضي، والفضائي منه خاصة، اختراقاً حقيقياً. أثبت أن العولمة الإعلامية طريق ذو اتجاهين يمكن لمن يريد أن يسلكه وأن يصل وأن ينجح. تعرّض الاحتكار الإعلامي الكوني لنكسة. انتصرت تعددية ما يبدو أنها مصدر انزعاج خاصة بعد فشل حملات العلاقات العامة وبعد فشل lt;lt;الحرةgt;gt; حتى في إثارة الغثيان (اللامبالاة المهذبة هي أقسى عقوبة في حق وسيلة إعلامية).
خامساً إذا كان الإعلام الغربي العريق خارجاً (؟) من أزمة صدقية فإن الإعلام العربي، في المقابل، يعاني مشكلة نمو، لا بل مشاكل نمو يمكن الاستفاضة في عرضها وشرحها. غير أن ذلك لا يمنع القول إننا أمام لحظة توازن دقيقة. وتقضي الحقيقة التأكيد على أن التوازن الإجمالي في المجال الإعلامي يفوق، بما لا يقاس، مثيله في المجال العسكري أو السياسي أو الاقتصادي. إن حصتنا في التبادل الإعلامي العالمي أرقى منها في التبادل التجاري. وحضورنا الإعلامي حيال lt;lt;الآخرgt;gt; أفضل من أدائنا العسكري والسياسي. ولعل السبب في ذلك هو أن دور الشعوب أكبر في التوازن الإعلامي في حين أن التوازنات السابقة حصيلة lt;lt;جهدgt;gt; حكومات عاجزة. يبقى أن هذه lt;lt;اللحظةgt;gt; هشة. لا مؤسسات تحميها. ولا رأي عاماً منظماً. ولا مجتمعات مدنية حيوية. وهي هشة، أيضاً، لأنها تمثل lt;lt;طليعةgt;gt; لا تردفها قوى. إن التوازن الإعلامي الذي تحقق ناتئ، ولأنه كذلك، فهو عرضة لتواطؤات قد تودي به وقد تنجح في استغلال أخطائه وتجاوزاته بوأده. هناك من يدرك أن الصمت شرط من شروط الجريمة الكاملة التي ترتكب. وهناك من بات يتضايق حتى من تحول العرب إلى مجرد lt;lt;ظاهرة صوتيةgt;gt;. وهناك من يرفض الاعتراف بأن الحشرجات التي تدوّي هي حشرجات جسم يتعرض للخنق. يجب الاعتراف بأن تطلّب الموضوعية صعب إلا أنه، فعلاً، الخيار الوحيد.
ربما يكون lt;lt;معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنىgt;gt; (الملحق بlt;lt;إيباكgt;gt;) أول من حذّر. رأى، في دراسة شهيرة، وراء التصدع العربي سريان مياه في المجاري العميقة توجد رأياً عاماً يتوحد وينقسم حيال قضايا تكتشف فيها الأمة وحدة مصيرها. التحذير صحيح نسبياً. نسبياً فقط لأن ثنائية الإعلام الرأي العام لا تنفع إذا بقيت معلقة وغير مستندة إلى حياة سياسية جديرة بهذا الاسم. إن هذه الحياة هي ما نفتقده في بلادنا، وما يمكن لوم الإعلام على أنه لم يؤد واجبه كاملاً في إيجادها. إعلامنا تغلب عليه التعبوية في حين أننا وصلنا إلى هذه الهزائم من قدر أعلى من التعبئة. من دون الوعي والتنظيم يتحوّل التحريض إلى تعويض والمواطن إلى مستهلك حزين لصور المآسي المتتالية.
ردم هذه الثغرة، وهذه ليست مهمة الإعلاميين وحدهم، يفتح باب التقدم. لكن هذا lt;lt;الردمgt;gt; يمر بحماية القدر المتحقق من lt;lt;التوازن الإعلاميgt;gt;. أما الحماية فالطريق إليها عقلنة للأداء بحيث يصبح الألم مدعاة للتفكير وليس للصراخ فقط.
- آخر تحديث :







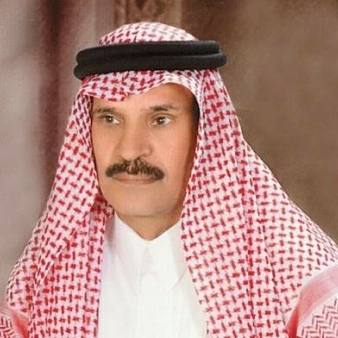






التعليقات