خليل علي حيدر
أين نحن من العالم؟ متى ينتهي الانحدار؟ أي دور للمثقف؟ بهذه الأسئلة، وغيرها، حاورت صحيفة quot;الحياةquot; المفكر التونسي ومدير المنظمة العربية للترجمة د. طاهر لبيب. (الحياة، 6/2/2006). يبدو د. لبيب مستاءً أشد الاستياء من المثقف العربي الذي، كما يعتبره، قد تخلى عن مسؤولياته الفكرية ورسالته الحقيقية، وانغمس في ملذات الدنيا!
من بين هؤلاء نموذج يطلق عليه quot;المثقف المقاولquot;، المصر على حضور كل المناسبات، وادعاء الفهم في كل الأمور. بينما كلما ازدادت الحياة تعقيداً، والعلم تشعباً، تضاعفت ثقته بنفسه وربما التهوين من شأن الآخرين:
quot;ولاشك أنك لاحظت بروز طفرة مفاجئة من الخبراء العرب في القانون الدولي والاستراتيجيات والإرهاب والديمقراطيات والحركات الإسلامية والنسائية... مما حوّل أشخاصاً قد تعجب كيف تحولوا، بين عشية وضحاها، إلى خبراء، وأنت تعلم أن معارفهم لم تتغير عما كانت عليه قبل أن يصبحوا خبراء... أصبح ضرورياً التمييز بين المفكر والمثقف... المفكر يتحدث أقل مما يلزم والمثقف أكثر مما يلزمquot;.
ولاشك أن ملاحظات د. لبيب الانتقادية صائبة بعض الشيء، فهناك فعلاً في حياتنا الثقافية quot;المثقف المقاولquot; المستميت من أجل البروز والمستفيد من كل الفرص والمتحدث في كل موضوع. ومن بين هؤلاء، كما نلمس جميعاً في أكثر من ندوة، من يكرر نفسه وquot;يسلقquot; البحوث، ولكن هناك كذلك من تراه في أكثر من مكان، ويبقى رغم ذلك محافظاً على عمقه وثرائه الفكري.
ثم إن الكثير من اللقاءات والندوات الثقافية العربية لا ينعقد لبحث القضايا والبت في الخلافات فحسب! بل هي كذلك مناسبات اجتماعية أو ثقافية، للقاء رجال ونساء، بل وحتى أدعياء، الثقافة والفكر!
انتقد د. لبيب في اللقاء quot;الخطاب العربي السائدquot;، فهذا الخطاب، كما قال، quot;لايزال يعيش ثنائينات تقليدية لا هو قادر على حلها ولا هو قادر على التخلي عنها، من نوع الأصالة والمعاصرة أو التراث والحداثةquot;. وانتقد المفكر التونسي حرص هذا الخطاب على افتعال الجمع بين المتعارضات والتوفيق بين المتناقضات، quot;ولو كانت معادلة مستحيلة، فكرياً وعملياًquot;.
ولا يميل المثقف عادة، بل وكذلك عامة الناس، إلى البت في هذه الثنائيات، فنحن في الواقع، quot;تراكميونquot; نحتفظ بالقديم والحديث، والمستهلك والجديد دون أن نجرؤ على اتخاذ أي موقف قاطع. بينما، يقول د. لبيب، quot;من دون قطيعة فكرية ومعرفية مع الثنائيات التقليدية قد يكون هناك تحديث، ولكن لن تكون هناك حداثةquot;!
والتمييز بين التحديث والحداثة مهم جداً وملفت للنظر في مجتمعاتنا وبخاصة في دول الخليج، فالكثير منا رجالاً ونساء، يعيش في أحدث البيوت ويدرس في أفضل وأحدث الجامعات ويتعامل مع أحدث الآلات ويتعرض لأحدث الأفكار، وتبقى شخصيته وبنية فكرة بعيدة عن الحداثة! بل ربما رأيت بعض هؤلاء في غاية الانغلاق والتشدد وquot;القروسطيةquot;!
وهناك جانب ثانٍ لهذه الأزمة، يتمثل في احتمائنا الدائم بالخصوصية، فهناك مثلاً خصوصية عربية وخصوصية إسلامية، وهناك كما لا يخفى عشرون خصوصية عربية ونيف، بعدد الدول العربية، وضعف هذا العدد وأكثر من خصوصيات مجتمعات العالم الإسلامي، يعني، بالعامية، quot;ما نخلصquot;!
ويرى د. لبيب -أن اللجوء إلى الخصوصية لا ينفع، quot;لأن التمسك بها قد يعني التمسك بخصوصيات التخلف. أما إذا كانت الخصوصية بالمعنى التاريخي، فالخصوصية ليست حكراً على العرب، كل المجتمعات لها خصوصياتها، بما فيها تلك التي أحدثت قطيعة في تاريخها أدخلتها الحداثةquot;.
وتحدث د. لبيب في المقابلة عن التسامح والانفتاح والحوار quot;مع الآخرquot;، وقال إن الثقافة العربية كانت في الماضي تعترف بما كانت تسميه quot;الأمم العظيمةquot;، كاليونانية والهندية والصينية والفارسية، التي أخذت عنها جميعاً الحكمة والعلم والصنعة، وذلك عندما كانت الثقافة العربية واثقة من نفسها. ونرى أن الجاحظ مثلاً، وأبا حيان التوحيدي يعترفان لبعض هذه الأمم والثقافات بخصال قد لا يرونها في العربيquot;. العربي دائم الشكوى من quot;الآخرquot; وبخاصة الغربي، ولكن، يتساءل د. لبيب: quot;هل يعرف العربي الآخر حقاً؟ لقد طال تشكيه من تشويه صورته -لدى الغرب- ولكنه لا يسأل بجدية عن تشويه صورة الآخر لديهquot;.
ويتساءل المفكر التونسي: quot;ماذا أوجد من آليات المعرفة العلمية، وكم أنشأ من مؤسسات بحثية لمعرفة هذا الآخر ولفهم رؤيته ولتفسير مواقفه؟ لا شيء خارج المتفرقات المدرسية أو الإعلامية ودعايات السياسة أو إسقاطات الوجدانquot;.
ويضرب د. لبيب في هذا المجال مثالاً مهماً للغاية، محرج لكل الباحثين والأكاديميين العرب، ممن نالوا شهاداتهم في مجال الاجتماع من أوروبا: quot;أعطيك مثالاً ملموساً: ليس هناك، في حدود علمي، أطروحة دكتوراه واحدة في علم الاجتماع من بين ما أعده الطلاب العرب في الجامعات الأوروبية، خلال نصف قرن، موضوعها مجتمع أوروبي. وإذا صادف أن كانت هناك استثناءات نادرة فليس لها مردود معرفي معروف، هذا في حين أن الباحث الأوروبي إذا جاء إلى بلد عربي، فلدراسة هذا المجتمع لا لدراسة مجتمعه الأصلي. أما المؤسسات الأوروبية الأميركية والإسرائيلية المتصلة بالعالم العربي، فعددها وتنوعها يقابلهما فراغ عربي غريبquot;.
لقد تضاربت مواقفنا كما هو معروف من الغرب بين كُره معادٍ وحب راضٍ... وحيرة بين الموقفين! وموقف الحيرة هذا نجد بداياته واضحة مثلاً في لقاء مؤرخ مثل الجبرتي مع حملة نابليون على مصر، فنراه (لا يخفي غضبه على المستعمرين الفرنسيين، بل يصفهم بـquot;الكفرة المعتدينquot; وأمثالها من الصفات التي لا تكشف عن الغضب وحده، بل تكشف كذلك عن المغايرة والاختلاف في الدين والسلوك والعادات والتقاليد. لكن هذا كله لا يمنعه من امتداح حبهم للعلم واختراعهم فيه، وحبهم لأهله وتيسير سبلهم في البحث والتجريب، واستغلال العلم في ابتكار أدوات تيسير العمل، وعدالتهم مع العمال، ثم عدالتهم في محاكماتهم، وبخاصة محاكمة quot;سليمان الحلبيquot; قاتل quot;كليبرquot; وشركائه. كما نجد الاتجاه نفسه عند الطهطاوي وخير الدين التونسي، وإن أضافا الإعجاب بالنظام السياسي الأوروبي، وبخاصة فكرة تقييد الحكومة عن طريق المجالس النيابية، فوصف الطهطاوي السلطات السياسية في فرنسا، وترجم دستورها.
وهكذا، بدأ هذا الاتجاه في التفرع إلى روافد، يحمل كل رافد قضية من قضايا المجتمع العربي المسلم، حتى ليمكن القول إن الدعوة إلى التجديد، بتأثير من أوروبا، غطت جميع مجالات حياتنا). (انظر: الرحلة إلى الغرب في الرواية العربية الحديثة، د. عصام بهي، القاهرة، 1988، ص 12).
وإذا نظرنا في واقعنا المعاصر، وهذا التشابك المتواصل منذ نصف قرن في العلاقات العربية- الأميركية مثلاً، وهذه الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة، وانقسام الكتاب والإعلاميين بين مادح لأميركا وقادح لها، لزاد عجبنا من إهمالنا الفكري وارتجالنا الثقافي. إذ كيف تكون هذه العلاقة مع الولايات المتحدة بهذه الأهمية القصوى، وبهذا الاتساع الشامل، وكيف تعتمد معظم البلدان العربية على أميركا بشكل من الأشكال، بينما ليس في هذا العالم العربي مركز واحد عصري... لدراسة الولايات المتحدة بشكل موضوعي؟
ولماذا يعمد طلاب الدكتوراه العرب في الجامعات الأميركية إلى اختيار مواضيع مصرية ولبنانية وسودانية وخليجية، لكتابة أطروحاتهم، بينما لم أقابل حتى الآن دارساً أميركياً واحداً لا يريد أن يبحث جانباً معيناً من المجتمع أو السياسة أو الثقافة أو المرأة أو الأقليات... في العالم العربي؟
بل الأسوأ من هذا، أن الكثير من هؤلاء الطلاب العرب في الجامعات الأميركية، لا يختارون مواضيع عربية مبتكرة، ولا يبحثون في قضايا ملحة، بل يتجنبون مثل هذه المواضيع متجهين إلى بحوث تقليدية مكررة لا تسمن ولا تغني من جوع. وإذ نال بعض هؤلاء شهادة الدكتوراه، وعاد إلى بلاده، كان ذلك آخر عهده بالبحث والدراسة والمتابعة! بل ربما آثر الانضمام إلى حزب سياسي أو جماعة أصولية متزمتة ليدعم جيش الغوغاء في العالم العربي!
- آخر تحديث :





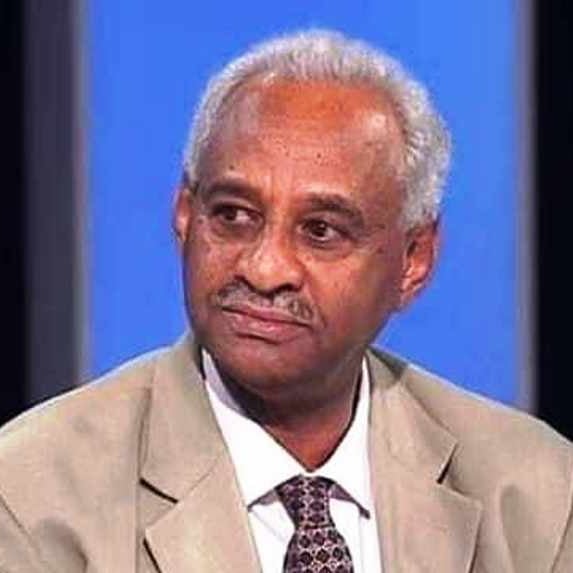















التعليقات