عبدالواحد الأنصاري&
ما كان ينبغي لي أن أخصص مراجعة لكتاب قديم عن مكة والمدينة، فهذا النوع من الكتب يحتاج إليه القارئ السعودي والخليجي والعربي والمسلم أيّما حاجة، ومن المفترض أن يكون الناشئ قد فرغ منه منذ وقت طويل، لولا انصراف القراء إلى الترجَمات وإضرابهم عن قراءة كتب التاريخ، بل إن عهد بعضهم بالتاريخ يرجع إلى تلك الملخصات الصغيرة التي كانوا يتلقونها في مراحل التعليم الأولى.
فلنتصور الآن أن مثقفًا غربيًا لم يقرأ كتابًا واحدًا عن أثينا وإسبارطة، ولا عن روما والقسطنطينية، فهل يكون وصفه بأنه مثقفٌ وصفًا صحيحًا ودقيقًا؟
حين كتب الروائي اليوناني نيكوس كانتزاكي مذكراته: «تقرير إلى غريكو» حرص على أن يعود من اليونان إلى الجذور التوراتية الأولى، ومن تلك الجذور إلى اليونان من جديد، ولم يتناسَ أساطير أجداده، وغاراتهم على السفن القديمة المبحرة إلى مكة.
يقول كازنتزاكي: أحس أن جدي الأكبر ما زال يعيش في دمي، وأعتقد أنه الوحيد بينهم الذي يعيش بحيوية أعنف في شراييني، كان رأسه حليقًا فوق الجبهة، وله جديلة طويلة من الخلف، وكان رفيقًا للقراصنة الجزائريين، ومعهم طافَ البحار القصية. لقد بنوا مخابئهم في جزر غرابوسا المهجورة في الطرف الغربي كريت. ومن هناك كانوا يحزمون أشرعتهم السوداء، ويصادمون السفن العابرة؛ بعضها كان يبحر إلى مكة بحمولة من الحجاج المسلمين، وأخرى تبحر بالمسيحيين إلى ديارهم، وكان القراصنة يزعقون وهم يلقون كلاباتهم ويقفزون على السفينة وبلطاتهم في أيديهم. كانوا يذبحون الشيوخ، ويأخذون الشبان أرقاء، وينقلبون على النساء، ثم يعودون للاختباء في غرابوسا وشواربهم مبللة بالدماء وأنفاس النساء. وكانوا في أحيان أخرى ينقضون على الزوارق الغنية المحملة بالتوابل التي كانت تظهر من الشرق. ولا يزال العجائز يتذكرون من يقال من أن جزيرة كريت بأسرها كانت تفوح منها روائح القرفة وجوز الطيب؛ لأن جدي الرجل ذا الجديلة قد نهب سفينة محملة بالتوابل. ولما لم يجد وسيلة لتوزيعها فقد أرسلها إلى كل قرى كريت هدايا لأبنائه وبناته بالمعمودية. وكم أثارني أن أسمع من عجوز كريتي تجاوز المئة عن هذا الحادث منذ سنوات قليلة؛ ذلك أنني، دون أن أعرف السبب، كنت دائمًا أحب أن أحتفظ بأنبوب من القرفة وبعض بذور الطيب معي في رحلاتي، وأمامي على طاولة الكتابة. وبالاستماع إلى الأصوات الخبيئة في أعماقي كلما نجحت في متابعة الدم بدلًا من العقل... كنت أصل بيقين إلى أقصى بداياتي.
هكذا لا ينسى كازنتزاكي ولا غيره من أساطين الأدب والفنون في أوروبا حكايات أسلافهم وأمجادهم، ولو كانت فيها رائحة القرفة ممزوجة بدماء الأبرياء وصرخات الثكالى، يتذكرونها باعتزاز ويشعرون بأنها تجري في دمائهم، ويستفيقون من منامهم ليستنشقوها في أواخر السحَر، لكن كثيرًا من مثقفينا مشغولون بقراءة النصوص المترجمة عن استنشاق عبق أسلافهم.
يتحدث كتاب «مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول» عن تشكيل القبائل العربية في الجاهلية وطبقاتها، من أحرار صرحاء، وموالٍ وعتقاء، وأرقاء، وعن حركة هذه الطبقات في المجتمع المكي ودورتها الاجتماعية والاقتصادية، ويروي أن العرب كانوا يعتقدون أن المقتول إذا لم يدرَك ثأره ينبعث على قبره طائر اسمه: «الهامة» ينادي بثأره شاكيًا الظمأ، ولا يسكت حتى يؤخذ بثأره. وفي مثل هذا يقول الشاعر: «له هامةٌ تدعو إذا الليل جنّها: بني عامرٍ هل للهلاليّ ثائرُ»؟
ستقرأ في هذا الكتاب ما يقفّ له شعر الجِلد عن نشأة قبائل مكة وما حولها من القرى والبوادي، وعاداتهم وعهودهم وحروبهم، وما يحملونه على ذممهم من أثقال، وستقرأ عن حماية الجوار، وخوض الحروب من أجل شرف السمعة، وتقرأ عن الحليف ومكانته، حتى إنه رويَ أن الحليف كان يرث السدس من جميع المال في أول الإسلام، ثم نُسخ ذلك ونُقل من الإرث إلى الهبة أو الوصية، وبقي على الأحلاف حتى بعد الإسلام حق النصرة والنصيحة والرفادة والعقل والولاء والمشورة.
فهل نجد بيننا كازنتزاكيًا عربيًا يا ترى؟!
&







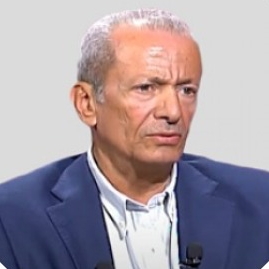













التعليقات