عبد الإله بلقزيز
لم يكن لدينا، في الوطن العربيّ، تقدير دقيق لحجم الإعضال الذي تشكّله مسألة الاندماج الاجتماعيّ والوطنيّ في البلاد العربيّة، إلاّ حين تفجّرت الأزمة اللبنانيّة في شكل حربٍ أهليّة، بدءاً من ربيع العام 1975، وانفجرت معها نزاعات العصبيّات الدمويّة فأودت بالأمن والاستقرار وقادت إلى إضعاف الدولة وتقسّم الطوائف لأجهزتها ومؤسّساتها. ونكاد لا نجد إلاّ القليل من نصوص المفكرين العرب الذين نبّهوا، مبكّراً، إلى القنابل الموقوتة التي ينطوي عليها التكوين الاجتماعيّ العصبويّ الفسيفسائيّ، في بعض البلدان، والتي تهدّد بالانفجار في وجه الجميع عند حدوث أيّ أزمةٍ سياسيّة حادّة؛ وذلك عين ما حصل في لبنان. أمّا السواد الأعظم من الكتّاب والسياسيّین فما كان يحْفِل بالمسألة، لأنّه لم يكن يقدِّر أن يكون لها كلّ ذلك التأثير الهائل في الاجتماع السياسيّ.
نعم، ما من شكّ في أنّ نخب الفكر والسياسة أدركتْ أنّ التكوين الاجتماعيّ، في قسمٍ من البلدان العربيّة، يعاني قدراً من الهشاشة وعُسْر الترابط، وأنّ الإدراك هذا سابق، في الزمان، لحدث الحرب الأهليّة اللبنانيّة. غير أنّ العِلم بوجود بنية طائفيّة في لبنان، أو قبليّة في اليمن، أو أقواميّة في العراق، أو طائفيّة-عرقيّة في السودان، أو عشائريّة في الأردن... شيء، والتحسّب لاحتمالات انفجار تناقضاتها وهزِّ الاستقرار الوطنيّ شيء آخر؛ فلقد بدا التحسّب ذاك خارج الأفق الذهنيّ للنخب آنذاك.
مَأْتى ذلك الاستصغار لشأن البنى الأهليّة العصبويّة، في وعي النخب، من الاعتقاد بأنّ أمرها لا يعدو أن يكون شيئاً من بقايا النظام الاجتماعيّ التقليديّ القدیم، وأنّ تبديدها مسألة وقتٍ تتطلبه عمليّة التصنيع والتحديث والتمدين والدمج الذي تقوم به السلطة المركزيّة للدولة، وأنّ هذه العملية جارية وساريةُ المفاعيل وسيتمخّض عنها، قطعاً، إنهاء تلك الروابط التقليديّة التي تشدّ الناس إلى بعضهم في «هويّات» مغلقة. والحقّ أنّ بعض ذلك الاعتقاد ما كان وهماً أو أمراً من قبيل الينبغيّات؛ ذلك أنّ التحديث والتمدين والدمج كانت تفعل فعلها، في الواقع الماديّ، وكان يتولّد منها - تدريجاً- بعض التماسك الاجتماعيّ والتَّبنْيُنِ المتزايد لشخصيّةٍ وطنيّةٍ جمعيّة ولولاءٍ وطنيّ جامع. وما من شكٍّ في أنّ ذلك النجاح النسبيّ في الحدّ من الآثار السلبيّة للاجتماع الأهليّ العصبويّ التقليديّ (نقول الحدّ من آثاره السلبيّة ولا نقول مغالبته) إنما نجح في البلدان العربيّة التي قامت فيها دول وأنظمة سياسيّة قويّة، ونهضت فيها الدول بدورٍ رعائيّ مركزيّ. أمّا حيث كانت الدولة ضعيفة، أو كان نظامُها السياسيّ قائماً على علاقات عصبويّة، أو متحيّزة لفريقٍ من رعاياها ضدّ آخر، فما كانت لتملك ما ترُدّ به علی ضغط العصبيات على الاجتماع السياسيّ، ولا أن تتفادى انفجار الانقسام والصراع الأهليّ فيها؛ كما حصل في لبنان والسودان.
غير أنّ الذي لم يستوعبه الاعتقاد ذاك، بقدرة التحديث على تبديد التقليد، أنّ نمط التحديث الذي ورثتْهُ النخبُ المحليّة عن الحقبة الكولونياليّة لا يشبه نظيرَه في الغرب؛ أعني في تقويضه للعلاقات التقليديّة السابقة - في الاجتماع والسياسة والاقتصاد- وإنّما هو نمط يميل إلى الإبقاء على ذلك التقليد وإعادة إنتاجه في شكلٍ يبدو معه وكأنّه يجاوِرُهُ ويتعايش معه. هكذا سادتِ العلاقاتُ الرأسماليّة نظام الإنتاج في بلداننا من دون أن تقضيَ على الإقطاعة والحرفة والاقتصاد البيتيّ والرعويّ، فوُجدت جميعُها في المشهد الإنتاجي. وهكذا قامت الدولة الحديثة بمؤسّساتها ودستورها وبرلمانها ونظام الاقتراع من دون أن تقطع، تماماً، مع تقاليد الدولة السلطانيّة. ولم يكُنِ التحديث، دائماً، في موقع القوّة الذي يسمح له بكسب الصراع. ولمّا كانتِ الدولة هي مَن يمثّله ويقوده، فقد كان عليها أن تحسب - دائماً- لقوی التقليد ومصالحها فتداهنها، ولكن من دون أن تُدرِك أنّ هذه ستنقلب عليها في أيّ فرصة يدبّ فيها الوهن في جسم الدولة.
اليوم؛ بعد الاحتلال الأمريكيّ للعراق وفي امتداد النتائج الكارثيّة ل «الربيع العربيّ»، تشهد العلاقات الطوائفيّة والمذهبيّة والعشائريّة والعرقيّة اندفاعة لا سابق لها نحو التعمّم والترسّخ. انتقلت الصراعات من الطوائف إلى المذاهب داخلها، ومن القبائل إلى العشائر، ومن المناطق إلى العائلات؛ ثمّ أصبحت كلّ وحدةٍ جديدة (عشيرة، مذهب...) ساحة صراعٍ داخليّ، فتبدّدت بذلك البقيّةُ الباقية من أواصر الوحدة الوطنيّة. والأدهى والأمَرّ أنّ المنزع العصبويّ هذا بات يتغدّى من نخب السياسة نفسها؛ هذه التي باتت تستسهل «التوافق» على قواعد لاقتسام السلطة على أساس الاحتصاص الطائفيّ والمذهبيّ والقبليّ. ماذا يجري في عراق ما بعد الاحتلال غير العمل بهندسة بريمر للنظام الطائفيّ - المذهبيّ؟ ماذا نسمع في سوريا وليبيا - بعد لبنان- غير الحديث عن حصّة هذه العصبيّة أو تلك في السلطة؟
&







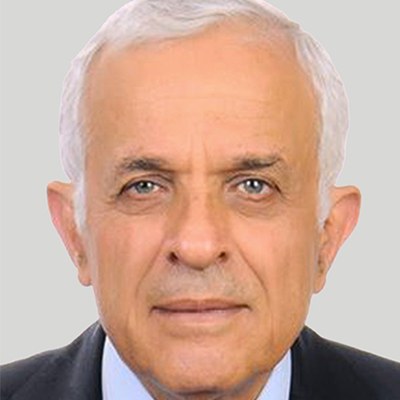













التعليقات