في آخر إحصائية لمنظمة الأمم المتحدة كان عدد المغتربين من مختلف الجنسيات، الذين هاجروا أو نزحوا من أوطانهم بسبب الحروب والعنف والاضطهاد والفقر، قد وصل إلى 80 مليون شخص. ودعت مفوضية اللاجئين إلى أن يكون العقد الحالي 2021 - 2030 عقد تغيير لحماية اللاجئين ومساعدتهم على الاندماج في المخيمات الجديدة، من دون أن تفكر المفوضية في أن أكثر من نصف أعداد اللاجئين يريدون من الأمم المتحدة أن تضمن عودتهم إلى بلدانهم ومدنهم ومنازلهم، وسلامتهم، وتوفير أعمال مناسبة لكل لاجئ بالغ.
«هل فاتك القطار؟» عنوان كتاب صدر في الأردن قبل عامين من تأليف مناف محمد صالح. وأبلغ ما فيه الإهداء الذي استفتح الكاتب فيه موضوعه وقال فيه: «الإهداء إلى كل طفل ألجأته ظروف الحرب إلى ترك بلده ليستوطن خيمة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. إلى كل عزيز قوم ذُلّ، كان ناهياً آمراً في بلده، فَرَدّهُ الدهر مَنْهِياً مأموراً في بلاد الغربة، وديار النزوح».
ربما تقترح مفوضية اللاجئين على منظمة «ناسا» الأميركية للفضاء الخارجي اختيار وطن فضائي يستوعب هؤلاء اللاجئين، بدلاً من «الإزعاج» الذي يسببونه لدول اللجوء حيث اتهامات «الإرهاب» جاهزة بدون أي دليل. ويمكن تسمية هذا الوطن الفضائي «سبيس لاند» أو «يونيفرس لاند» أو «نيو ميدل إيست».
هناك أقوال عربية كثيرة عن «الغربة» منها «أنها أوجاع لا يعلم بها إلا من عاشها»، و«الغربة أسباب تُفقد الأحباب والأصحاب... والعمر يجري فيها كالسحاب». و«في غربة عن أهلٍ وعن أحبة وعن وطن، نصمد لحظة ونتهاوى لحظة، نبتسم لحظة ونبكي سنوات». و«في الغربة لا تستطيع أن تدعي امتلاكك شيئا، فيها أنت لا تملك سوى الأحلام». وهناك قصائد كثيرة عن أوجاع الغربة، منها ما قاله شاعر مجهول:
بك يا زمان أشكو غربتي- إن كانت الشكوى تداوي مهجتي
قلبي تساوره الهموم توجعاً- ويزيد همي إن خلوت بظلمتي
إن الغريب سقته أيام الأسى- كأس المرارة في سنين الغربة
الطريف هو ما قالته الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي: «الناس تحسدك دائماً على شيء لا يستحق الحسد؛ حتى على الغربة يحسدونك كأنما التشرّد مكسب».
صدق أو لا تصدق: انتهى الزمن الذي يخاف فيه أهلنا في الوطن علينا نحن اللاجئين من الغربة، بينما نخاف نحن في غربتنا على أهلنا هناك!
في عَمان جمعت المخرجة الأردنية ندى دوماني قبل أكثر من عشر سنوات أربع شخصيات عراقية مهاجرة في فيلم تسجيلي بسيط وأنيق ويقول جملاً مفيدة. إنهم النحات الشهير محمد غني حكمت الذي توفي في عام 2011 في العاصمة الأردنية عمان، والرسام د. بلاسم محمد، والإعلامية ميسون الموسوي، والمهندسة المعمارية أمل الخضيري.
ويشترك الأربعة في حديث المشاعر عن الغربة والمكان. عنوان العمل الفني: «رحلة المكان»، وأنتجته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ووضع موسيقاه الفنان زياد الأوسي الذي يشارك في حديث المشاعر بآلة العود.
كان بإمكان المخرجة أن تستفيد من «معادلات صورية» لدعم مادتها الكلامية عن بغداد ونهر دجلة والسمك المسكوف والمهاجرين، لكنها آثرت أن تترك للصمت الحزين مساحة زمنية للتعبير عن المشاعر المكبوتة داخل نفوس وضمائر الأربعة. كانت دموع بعضهم تقول الكثير، وهم (يدارونها)، لكن دموع العراقيين، رجالاً ونساء وأطفالاً، صارت علم بلدهم الممزق والمشتعل والمدمر والمهيمن عليه.
يقول النحات محمد غني حكمت مستسلماً وهادئاً: «الذي صار صار، والذي حدث حدث، وأنا متفائل، سأرجع يوماً وأعيد يد تمثال شهريار التي بترها الغوغاء، وسأرجع يوماً وأعيد رأس تمثال المتنبي الذي قطعه الرعاع. وهكذا، كل ما تم هدمه يمكن إصلاحه. هذا أملي... وأنا متفائل». لكن محمد غني حكمت، رحل إلى العالم السفلي الذي تحدث عنه جلجامش في ملحمته. لم يعد إلى العراق، وما زالت يد شهريار مبتورة، وما زال رأس المتنبي مقطوعاً، بل صار قطع الرؤوس وبتر الأيادي عنواناً لمرحلة حمراء مُغبَرة، مثل «عجاج» العراق الأحمر الذي يحجب الشمس.
حتى اللحظات الأخيرة من عمر الفنان البغدادي، الكرخي، محمد غني حكمت، كانت مسكونة بأمل العودة، مثل أهلنا الفلسطينيين، وهو الذي قال في الفيلم التسجيلي: «أمنيتي أن أزرع العراق كله بالتماثيل». لكنه استدرك بأنه يمكن أن يقنع بتمثال واحد هو السندباد البحري ورحلاته السبع. «فالسندباد كان ينهض بعد كل مرة يقع فيها. يقع وينهض». العراق نفسه كان يقع وينهض، منذ عهد ما قبل التاريخ إلى الاحتلال الأميركي ثم الهيمنة الإيرانية مروراً بالغزاة من كل صنف ولون. كان حلم محمد غني حكمت أن يضع تمثال السندباد وسط نهر دجلة فوق طوافة عائمة، يرتفع وينخفض حسب حركة المياه والرياح. كل عراقي اليوم في الخارج هو سندباد بري وليس بحرياً... أو شيئاً من هذا القبيل.
إلا أن الرسام والأستاذ في أكاديمية الفنون الجميلة الدكتور بلاسم محمد له وجهة نظر تبدو مختلفة، لكنها متفقة في المعنى العام، فهو يقول في الفيلم التسجيلي: «لون العراق هو الترابي. حتى حضارته لم تُعَمَّر طويلاً بينما عُمِّرت الحضارات الأخرى لأنها حجرية فظلت شاخصة. من أجمل ما في العراق أن هذا التراب يتموج ويتغير ويتلون، وهذه الألوان زُرعت في ذاكرتي بحيث أصبحَتْ شبه مصافٍ لتنقية الأشياء؛ ولذلك يظهر التراب معي في الرسم والتخطيط والكتابة أيضاً، بمعنى كتابة ترابية وألوان ترابية. هذا الوضوح العالي ليست له قيمة في بلدان أخرى؛ لأن كل الأشياء عندهم واضحة؛ فضبابية العراق تشعرني بالمتعة. لا أحد يستطيع الآن في هذه المحنة أن يقول شيئاً ويدلي بحلول بسبب لون العراق الترابي. لقد تغيرت أمور كثيرة في البلد ومنها نظرتنا وآراؤنا. الغربة بالنسبة لي فكرة عودة فقط وليست فكرة منفى».
محنة الإعلامية د. ميسون الموسوي من لون آخر؛ فهي هُجّرت من منزلها في بغداد، وهُجّرت من وطنها العراق، صادروا منزلها ونهبوا محتوياته، وتركوها بلا هوية ولا صور ولا أوراق. وهي تعتقد «أن العراقي بشكل خاص لا يملأ عينيه إلا بلده مهما اغترب؛ فمهما بعدتُ سأعود إلى بغداد. لقد فرض علينا الأمر الواقع أن نهاجر، لكننا سنظل نحمل هويته».
لم تصدق السيدة أمل الخضيري المهندسة المعمارية ما رأته حين وصلت إلى منزلها في بغداد. «رأيت كل شيء وقد تحول إلى رماد. الناس يدوسون على الصور والكتب، ليس في بيتي فقط، في بيت الحكمة والجامعات والمكتبات أيضاً. امتلأ نهر دجلة بالجثث، حتى النهر تقلص وتحول إلى ساقية. شيء مؤلم أن يصل الإنسان إلى هذا الدرك. لماذا؟! كل يوم بالنسبة لنا جرح عميق، وأمل في أن يندمل».
في الفيلم القصير عن الغربة الذي شاهدته منذ سنوات تتردد كلمات مألوفة ومحفورة في الذاكرة من نوع: طَلّع النخيل، ورد الياسمين، عطر الرازقي، السمك المسكوف، دجلة، الفرات، شط العرب.
كلمات، كما يقول نزار قباني على لسان ماجدة الرومي، ليست كالكلمات.
- آخر تحديث :






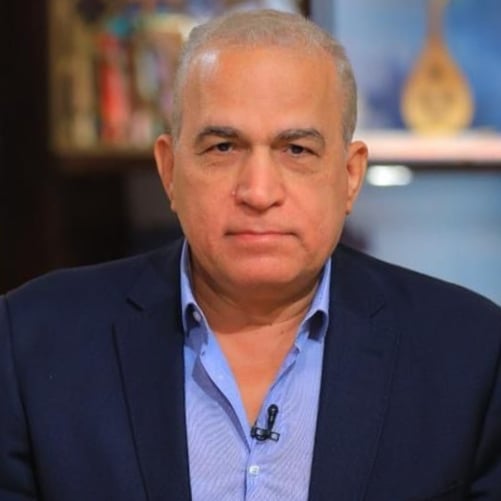













التعليقات