كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول الصدمات التي تتعرض لها الاقتصادات الغربية، جراء ما تفرضه من عقوبات قاسية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. والحرب، أي حرب، في الأغلب ما تفرز عواقب لم تكن في الحسبان. وكلما طالت الحرب، كان هناك أرجحية كبيرة لنتائج غير متوقعة تعاكس الأهداف الأساسية وراء شنها. وتنطبق هذه المعادلة ليس فقط على مسرح العمليات العسكرية، بل يشمل وقعها الإجراءات التي تتخذها الأطراف المتصارعة لدعم المعركة.
لنأخذ على سبيل المثال سيل وجبات ورزم الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الدول الغربية على روسيا. في مستهل الحرب كان هناك حماس منقطع النظير للذهاب بالحصار إلى أقصى حد ممكن، وصرنا نقرأ ونسمع أن الإجراءات الغربية لمعاقبة روسيا اقتصاديا ستؤتي أكلها عاجلا، لأنها من القسوة ما لم يشهد التاريخ له مثيلا. ويكون قد مضى على الحرب في أوروبا 163 يوما عندما ينشر المقال في الخامس من آب (أغسطس) من هذا الشهر.
وسبحان مغير الأحوال، حيث لا نلحظ أي أثر للحمية والهبة الراسخة والوحدة التي لا ينفك عراها التي، وحسب الساسة الغربيين، قلما وصلها الغرب منذ الحرب العالمية الثانية.
كانت التوقعات في الأيام الـ 100 الأولى من الحرب أن الحصار الاقتصادي "الخانق" سيجبر روسيا على الانكفاء أو حتى الركوع ليس نتيجة ضغط عسكري، بل لأن اقتصادها لن يكون في إمكانه تحمل تصدعات وصدمات الحصار.
وفي الجانب الروسي، ذهبت الآمال في تحقيق نصر سريع أدراج الريح، وصار الجيش الروسي الجبار يقضم في أوكرانيا بالأمتار، وأضحت العاصمة كييف منيعة الوصول، في أقل تقدير حتى الآن.
وأظن أن كثيرا منا، وحتى روسيا ذاتها، لم تتوقع أن الغرب سيهب لمساعدة أوكرانيا عسكريا إلى درجة أن يتحول الصراع إلى مسألة تقرير المصير بالنسبة إلى الطرفين.
لقد استثمر الغرب كثيرا لمساعدة أوكرانيا ليس فقط لمقاومة الجيش الروسي، بل دحره إن أمكن. لقد قدمت الولايات المتحدة وحدها 60 مليار دولار للجهد الحربي الأوكراني، ما يوازي الميزانية السنوية التي تخصصها موسكو لوزارة الدفاع.
واستثمر الغرب حزمة بعد حزمة من العقوبات على روسيا وإن أحصيناها فإنها تعد بالآلاف. وإن كان الغرب أفلح في تثبيت أقدام الجيش الأوكراني من خلال تزويده بدفعات من الأسلحة والمعدات، فإنه واجه ويواجه صدمة كبيرة بسبب المقاطعة الاقتصادية التي فرضها على روسيا. حصار روسيا له وجهان: الأول يصيب المستهدف "وهو موسكو"، والثاني يرتد وبالا على الذين يقفون وراءه.
سيدخل حصار روسيا التاريخ ليس فقط لعدم صدقية فارضيه، بل نفاقهم أيضا، لأنهم نفذوا ما هو ممكن وتركوا ما قد يؤثر فيهم خارج إطار العقوبات مثل النفط والغاز. يخشى الغربيون أنفسهم اليوم من عواقب إخراج حصة روسيا من الإنتاج العالمي للطاقة الأحفورية، التي هي كبيرة جدا، لأن تبعات هكذا إجراء تفوق طاقة تحمل اقتصاداتهم. وفجأة رأى الغرب نفسه فيما يشبه معضلة سببها لنفسه بنفسه.
الطاقة عماد الصناعة والاقتصاد والرفاهية في الغرب. ويعزو الاقتصاديون صعود الغرب الصاروخي بعد الحرب العالمية الثانية كي يتبوأ عرش الاقتصاد العالمي إلى سهولة حصوله على الطاقة الأحفورية وبأسعار منخفضة. والطاقة الأحفورية من أهم أركان الصناعة لسهولة نقلها وبكميات هائلة "مثلا أنابيب نقل الغاز والنفط والناقلات العملاقة" وكذلك لسهولة استثمارها، وعلى الخصوص الغاز، لتوليد الكهرباء والتدفئة ودوران عجلات صناعات عملاقة وأساسية للاقتصاد مثل الكيماويات والحديد والصلب.
فجأة، وبعد أكثر من سبعة عقود من السيطرة على تجارة الطاقة العالمية، يرى الغرب أن الدفة بدأت تفلت من يديه بسبب عدم صدقية سياساته والفشل في استقراء العواقب. واليوم هناك شبه يقين في الغرب أن تكلفة مقاطعة روسيا لم تعد تتحملها موسكو وحدها وأن الحصار الاقتصادي بدأ يأخذ منحى خارج التوقعات.
وأتت هذه الصدمة، التي بدأ الساسة والاقتصاديون يتحدثون عنها علانية، في وقت كان الغرب يعد العدة لسياسة حازمة تجاه الصين ضمن استراتيجية ما يطلقون عليها "الانفكاك" decoupling في مسعى إلى حرمان التنين الصيني من تحقيق حلمه بالتربع على عرش الاقتصاد العالمي.
وهنا أيضا، كان الغرب يعاني قصر نظر، حيث صارت الصين في أفضل وضع من حيث الحصول على موارد الطاقة الرخيصة والمتاحة بعد أن وجهت روسيا صادراتها صوب بكين بأسعار يسيل لعاب الغرب لها. إن كانت أسعار الطاقة الرخيصة وراء النهوض الصناعي الخارق للغرب، فإن سياسة المقاطعة التي يتبعها الغرب جعلت الصين تنعم بما كان الغرب ينعم به لعقود.
وها هي أصوات مؤثرة في الغرب تدعو إلى مراجعة الحسابات، لأن ما يرد إلى الصين من طاقة رخيصة بسبب الحصارات الغربية سيرفعها إلى أكبر اقتصاد في العالم أسرع من المتوقع.
المقاطعة الغربية لروسيا تفرز صدامات كبيرة للغرب وتظهر أن للحصار وجهين، وتؤكد أن من يملك الطاقة اليوم يملك قرار التحكم في مصير العالم.
- آخر تحديث :







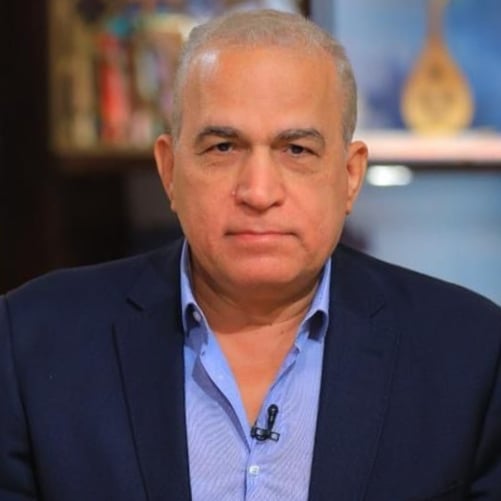













التعليقات