عندما نستمع إلى أنين المرأة وشكواها، نعتقد أن السماء ستقع على الأرض، وأن الرجل سيف القدر على رقاب كل النساء، وأن الدنيا تدور دورتها في غضون ثوانٍ فلا وقت للتفكير والتقاط الأنفاس، وخاصة في هذين العقدين من الزمان بعد أن كانت الأعراف والشيم والمروءة دستورا أخلاقيا تقوم عليه الأسرة والنسب والمصاهرة، فاهتزت الأسر وكثر الطلاق وتيتم الأطفال.
ولعل هذه إشكالية اجتماعية قُتلت بحثا، وعجت بها قاعات الندوات والمؤتمرات، وذهبت التوصيات أدراج الرياح، فلا مكان للحُب في زمن يشح فيه الحَب. والحُب والحَب كلمتان متشابهتان في رسمهما مختلفتان في رقمهما بين الفتحة والضمة، فلم يأتِ هذا التشابه الدقيق إلا لتأثير بعضهما على الآخر وخاصة الأخير، حيث يكمل بعضهما الآخر في تزاوج يقطن الروح قبل الجسد وخاصة في زمن تغلب عليه المادة وارتفع فيه سقف الطموحات سريعة الإيقاع غير الممكنة في أغلب الأحيان!
ولنا أن نتساءل عن الحُب -معنى واصطلاحا- لكي ما تقوى أواصره، فإذا كان ذلك كذلك تكاملت روابط الكلمتين وحمل كل منهما الآخر على جناحه نحو السلامة، فهل ندرك معنى الحُب وتأثيراته؟ وهل نشتغل على سقياه؟
إن مفهوم الحُب عند أفلاطون -الذي أسس فلسفة الحب العميقة- هو أكثر جدلية وأكبر تعقيدا، إلا أنه اعتمد على مزاوجة فكرية جدلية للمتناقضات: الفقر والثراء، الحكمة والجهل، الفظاظة والتطلع للجمال، الموت والخلود، ولا نبالغ إن قلنا إنه قد شكل للثقافة مرتكزا ونقطة انطلاق لجميع محاولات التأويل النظري لمعنى الحب!
والحب في مضمونه عهد ووعد وتفانٍ، عقد غير مبرم يتحمله كلا الطرفين حتى يظل أمانة ثقيلة يتحملانها وما أثقله من حمل لا يعيه الإنسان نفسه، ولذلك يكون الشقاء نتاج سلوك همجي نتاجه ذلك المارد الجبار الذي يجعل الواحد منا يتقلب بين اللذة والكدر وبين السعادة والشقاء!
وقد ارتبط الحُب في كنهه بالعودة إلى الفردوس المفقود، والسعي الدائم إلى استعادته، فيقول (فياتشيسلاف شستاكوف) في كتابه فلسفة الحب: "الحُب السعي الأبدي ويرتبط بالخلود، فمن الحيوانات، مثلها مثل الإنسان، المحكومة بالموت أن تسعى إلى الخلود والأبدية قدر المستطاع".
لكن للحب نصيب كبير في الحركة الديناميكية، بين العاطفة والعقل، فيقع بين ميزان كليهما؛ ولذا كان للثراء والفقر في زمن طغيان المادة تقلبات نلحظها تعمل على تدمير الأسر وتقذف بالأطفال على قارعة البؤس المحتوم جراء الافتقار إلى اتزان كفتي المتناقضين بين الحكمة والجهل، والتي أشار لها أفلاطون في متناقضات تعريفه، بين العقل وتدبرات الحكمة!
لم يكن الحُب في القلب بحسب المفهوم (المثيولوجي) بحسب ما وجدته من نتائج بحثي (البعد الخامس) والاستقصاء عن مكامن العاطفة والوجدان، حين تمخض البحث عن مكمن الوجدان وتقلبه في منطقة الرأس (الأميجدالا) هذا الجهاز الذي يفرز مادة الدوبامين فيبعث على البهجة أو العكس بحسب نشاط هذا الجهاز الخطير ولذا وُضع في الرأس لكي يتلامس ميزان العقل مع العاطفة والوجدان، ومن هنا كان الجمع بين كل المتناقضات التي وضعها أفلاطون.
ومن هنا أصبحت العلاقات العاطفية الأسرية في تدهور نتاج اختلال هذا الميزان ونتاج تمحور الجهل بالمعنى وتمرجحه بين كفتي العلم والجهل أو قل بين المعرفة والحكمة تحت تأثير سطوة الفلسفة المادية التي أصبحت فيها المادة سيدا، جعلت نفسها معيار الفرد بين الفقر والثراء، جعلت الفرد يكتسب قيمته منها فتسيدت المادة على القيمة وتشيأ الإنسان.
وحينما نعود إلى معنى "التشيؤ" (Reification) فهو يعني تحول العلاقات بين البشر إلى ما يشبه العلاقات بين الأشياء (علاقات آلية غير شخصية) ومعاملة الناس باعتبارهم موضعا للتبادل. وحينما يتشيأ الإنسان، فإنه سينظر إلى مجتمعه وتاريخه باعتبارهما قوى غريبة عنه، تشبه قوى الطبيعة (المادية) تفرض على الإنسان فرضا من الخارج وتصبح العلاقات الإنسانية أشياء تتجاوز التحكم الإنساني فيصبح مفعولا به لا فاعلا، وقمة التشيؤ هي تطبيق مبادئ الترشيد الأدائي والحسابات الدقيقة في كافة مجالات الحياة.
ولهذا كان رأي أحد الفلاسفة الكبار هو أن التشيؤ هو حينما يصبح الإنسان عبدا للمادة، فتصبح هي المتحكم الأوحد في مسار حياته وحينها تخفت موازين القيمة الإنسانية والقيمة والمادة هما في صراع دائم في عصرنا هذا مما يجعل الحُب تحت وطأة الحَب، هاتان الكلمتان المتطابقان تتأرجحان، إن لم تغلب الأخيرة بشكل كبير!
إن ما يهمنا من كتابة هذه السطور-التي لو استفضنا فيها لحملتنا على إنشاء مجلد كبير- لما تتعرض له الأسرة العربية من خطر داهم جراء تفكك العلاقات الإنسانية والأسرية بشكل خاص، وهو المعول الأول في هدم البنية الاجتماعية التي تقوم عليها الدولة في نهاية المطاف؛ هذه العلاقات التي يتحكم فيها الحَب على حساب الحُب، والتطلع غير المبرر للمادة والطموح السريع غير المرتب، والواثب غير المدروس، المهيمن غير المنتظم، والمطلوب غير المستحق، كل هذه المتناقضات هي ما عملت على تغيير شكل هرم البنية الاجتماعية.
وفي نهاية هذا المقال آن لنا أن نتساءل: لماذا كان أهلونا بالأمس القريب يعيشون في رغد المشاعر ونحيا نحن أطفالا بين ضفتي عائلة سعيدة مستقرة؟ ولعل الجواب يكمن في أمرين مهمين وهما: عدم تفشي المادية في مجتمعاتنا بهذا الشكل المقيت، وثانيهما هو التفاف الأهل بين الأعراف والتقاليد والأحكام العرفية وعلو معنى المروءة واتقاء مفهوم العيب وبغض اللوم الذي هو السوط الشديد الذي كان يخشاه المجتمع العربي ويسعى دوما إلى تجنبه. كما أن من الضروري وضع الطفل في أولى اعتبارات الحياة وخاصة في مراحله الأولى من تكوين شخصيته، كل ذلك إذا ما سادت قيمة الحُب على الحب، أو قُل القيمة على المادة.












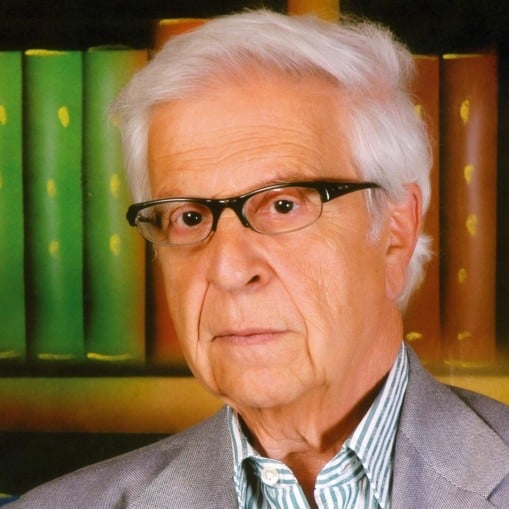




التعليقات