quot;من دفتر الصمتquot; إلى quot;رباعية الفرحquot;
أول ما قرأت للشاعر الكبير محمد عفيفي مطر كانت مجموعته quot;أنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرتquot; فانبهرت حينها بهذا الأسلوب الجديد في كتابة القصيدة الذي لا يمكن أن يصل له إلا شاعراً متمرساً في كتابة الشعر، ثم وجدت في غزة -الشحيحة بالكتب- مجموعة أخرى له هي quot;احتفالات المومياء المتوحشةquot; وعاد انبهاري بقصيدة محمد عفيفي مطر من حيث صورتها الفنية ولغتها وتركيبها البنيوي، وأخذت أبحث بعدها عن أي كتب له أو حتى قصائد متناثرة في المجلات، وحين بدأت أكتب النقد كنت أطمح للكتابة عنه يوماً ما لكني كنت أخشى الاقتراب من شعره المعقد والكثيف كغابة، فكنت أؤجل دوماً متعللاً بقلة الكتب المتاحة لكن الفرصة جاءت أخيراً وصار لا مناص من الكتابة.
حين قرأت مؤخراً مجموعاته quot;شهادة البكاء في زمن الضحكquot; و quot;من دفتر الصمتquot; وquot;رباعية الفرحquot; ndash; وهذا كل ما أتيح لي من كتبه- لاحظت أني أقرأ لشاعرين هما معاً محمد عفيفي مطر، وليس في الأمر شيزوفرينيا شعرية بقدر ما هو تطور طبيعي لشاعر يكتب الشعر منذ الستينات وحتى يومنا هذا. لقد مر شاعرنا بمرحلة شعرية أولى يمكن أن أسميها تقليدية أثـّر عليه شعر التفعيلة السائد في الخمسينات والستينات في الفترة التي أسميها مرحلة الحداثة العربية، ثم كان انتقاله لمرحلة ثانية أكثر تطوراً ربما جاءت تأثراً بجماعة quot;شعرquot; التي نشر في مجلتها، تلك الجماعة التي دشـّنت مرحلة ما بعد الحداثة العربية حيث وصلت عندهم تجارب قصيدة النثر إلى اكتمالها أكثر من سابقيهم منذ الأربعينات. وأظن أن شاعرنا كان أكثر تأثراً بأدونيس نجم هذه الجماعة لكن أدونيسيته كانت مصرية صافية، فالأثر الأدونيسي الضعيف (مقارنة بمجمل أعماله) كان معجوناً بملامح مصرية ريفية غالبة حيث الأرض والمطر والطمي والنهر..الخ. لكن لا توجد فواصل حاسمة بين المرحلتين، فلا يمكن تصنيف أي مجموعة من مجموعاته ضمن مرحلة معينة، فالتداخل والتمازج ظل حاضراً في أغلب الدواوين.
 من دفتر الصمتquot;
من دفتر الصمتquot;
في هذه المجموعة quot;من دفتر الصمتquot; تتبدى بوضوح المرحلة التقليدية الحداثية حيث كانت أولى مجموعات الشاعر -على حد علمي ndash; التي طغت فيها سمات الشعر التفعيلي السائد منذ الخمسينات ولم تكن اخترقته بعد جماعة quot;شعرquot; بالشكل الكافي، أول ما نلاحظ من هذه السمات هو الحضور الزائد للقافية والتي لم يستطع التفعيليون التخلص منها تماماً حتى وقتنا هذا. إننا نقر بحضورها العفوي لكن ما حدث عند شاعرنا -وعند كثيرين حتى لا نظلمه- كان تقصداً فيما يبدو وهو يضعف القصيدة في رأي التجريبيين أمثالنا، وإن كنا نقرّ تجريبية مطر الشعرية عموماً، فمثلاً في قصيدته quot;مكابدات كيخوتيةquot; يقول:
هذه الريح التي تولد في بئر الثواني
تخلع الوجه الذي رثّ،
وتلقيه إلى شدق الثواني
والثواني تلد الريح ولا تشبع من لحم الوجوه
وعلى وجهكَ ... في الليل العميق
غبطة ماردة..
حين أقمت الدار في ليل العروق
صرتَ طاحون العظام
حينما تسكر نلتف ببرد من سلام
يرحب العالم، يهتز لنا قلب صديق
هذا التتابع في القوافي لا يحتمله القارئ صاحب الذائقة المغايرة، بل لا يحتمله شاعرنا في تطوره اللاحق. ثم يتبدى ملمح آخر ليس تقليدياً تماماً فهو ما زال حاضراً حتى في قصيدة النثر والشعر الحر وأقصد بذلك الغنائية الإنشادية ونضرب مثلاً منها من قصيدته التي تحمل نفس عنوان المجموعة وعنوان فرعي أيضاً هو quot;الشاعر والهزيمةquot; حيث يقول:
لو أعشبت مقبرتي القديمة
أو أثمرت صفصافة السموم
فإنني أقوم
مضرج القصائد
مغمغماً بما استرقت من دفاتر القيامة
لكن إنشاد الشاعر هنا ليس بطولياً بل يمكن أن نسميه ضد-بطولي وهذا غريب في زمن المد القومي وشعاراتها الحماسية التي تناسب قصائد أشعار المقاومة آنذاك، لكن يبدو أنه يحقق ما قاله رامبو من أن الشاعر نبيّ، فهو يتنبأ مبكراً بالهزيمة (ونلاحظ العنوان الفرعي) التي ربما كان آخر المتنبئين بها وقبيلها بقليل نجيب محفوظ في ثرثرته فوق النيل. وهذه الهزيمة ليست مقتصرة على هذه القصيدة أو هذه المجموعة بل يلمحها قارؤه في كل مجموعاته غالباً. فالهزيمة التي بدأت بالنكسة لم يمحها انتصار أكتوبر بل استمرت في اجتياح بيروت وحرب الخليج وسقوط بغداد ومآسي فلسطين. محمد عفيفي مطر كان شاعراً بواقعه بامتياز ولم يحاول ككثيرين أن يجمـّل الهزيمة ويحولها انتصاراً رغم أن هذا لم يلقه في هوة السوداوية والكآبة، بل كان محكوماً بالأمل ndash; على حد تعبير الراحل سعد الله ونوس- وهذا ما سنتحدث عنه لاحقاً. أيضاً نلاحظ عند شاعرنا التكرار الزائد أحياناً الذي يمكن أن نعده من بقايا الإرث التفعيلي، طبعاً من المتعارف عليه أن لكل شاعر معجمه الشعري ورغماً عنه أحياناً، لكن تكرار المفردات والأجواء يكون مملاً أحياناً حتى وإن كان موظفاً في القصيدة. ومن الثيمات المتكررة عند شاعرنا النهد، الأرض، النار والتراب..الخ. خاصة مفردات الطبيعة التي تربى بينها. ربما يكون لسمات تقليدية الشاعر شكل تناصـّاته ورموزه فهنا نجد حضوراً لأسماء كتـّاب غربيين مثل لوركا وأساطير مثل زيوس وأديان مثل أيوب إلى آخره من مفردات وتناصّات استهلكت كثيراً في أشعار تفعيليي الخمسينات والستينات البائدة.
إذا ما أردنا أن نتحدث عن ما بعد حداثيته في هذا الديوان أو مجموعاته الشعرية إجمالاً فسنلاحظ وعي الشاعر المبكر للتكنيك الشكلي، فمنذ بداياته وهو يصر على التجريب في الشكل، وغالباً ما يقطّع قصيدته إلى مقاطع مشهدية تجعل تقريباً من كل مقطع قصيدة فكأنه يكوّن لوحة فسيفسائية أو جدارية شعرية، وأحياناً يعطي كل مقطع عنواناً فرعياً.
والشاعر محمد عفيفي مطر تتنازعه الغنائية الحداثية والدرامية المابعد حداثية، فأحياناً يميل للإنشاد وأحياناً تتنازعه أصوات أخرى داخل شعره، بل وقد يحدث هذا في القصيدة نفسها، وأغلب مجموعته هذه مشاهد أشبه بسيناريو سردي وقد ربطت سابقاً في مقال لي عن مجموعة quot;السدى قطرة قطرةquot; للشاعر محمد حسيب القاضي بين الأسلوب السينمائي كما يسميه صلاح فضل أو شعر اللقطة كما يسميه كمال أبو ديب وبين السرد الذي تحدث عنه كثير من النقاد في قصيدة النثر والشعر الحر (من الوزن والقافية)، وقسـّمت في ذلك المقال الصورة البصرية السينمائية في القصيدة إلى ثلاثة أنواع: السرد، السيناريو، الدراما. ومطر شاعر يتميز بلغته الشعرية السينمائية وأرى أنه ربما سبق في ذلك أمل دنقل الذي يرى صلاح فضل أنه أول شاعر سينمائي مصري. فقصائد مطر لا تخلو من هذه الأنواع الثلاثة، ولا تحصى الأمثلة على ذلك ونكتفي بقصيدة quot;عذراء الصمت والصمتquot; مثالاً على السرد، فالقصيدة تحكي قصة فتاة بلسان الراوي تنتظر حبيبها الذي نسمع صوته بنفسه، فيقول الشاعر:
ومن تل إلى تل
تغـّرب أهلك الفقراء في الليل
وعاماً بعد عام تذبل الكرمة
شهوراً ثم تخضر
وهم -في الريح ndash; لم تطفئ لهيب ظمائهم خمر
بكائياتهم غرستْ قوافيها بقلب الليل
تستسقيه بعض سحائب الرحمة.
وكذلك السيناريو يحتل حيزاً في بناء قصيدته، من ذلك قوله في قصيدته quot;الدوامةquot;:
الشارع الممدود ريح
تيارها يهتز حول الأبنية
حملت عباءته رنيناً في ضريح
شهقاته دقت تمام الثامنة
يرسم مطر هنا سيناريوهاً شعرياً خلال قصيدته من أجل إضفاء مناخاً مناسباً ليتضافر مع العناصر الأخرى من أجل توصيل رسالته فتصبح القصيدة هنا كأنها فيلماً سينمائياً حيث موسيقى القافية والسرد والحوار..الخ. أما الدرامية أو الحوار فحدّث ولا حرج، فالقصيدة التي تحدثنا عنها سابقاً quot;عذراء الصمت والصمتquot; تحوي صوتيْن شعريين هما صوت الراوي وصوت البطل، أما المرأة فلا نسمع صوتها إلا في النهاية، وكأنها شهرزاد الصامتة أو الخرساء التي لا تحكي الحكاية بل ثمة راوٍ يحكيها عنها، فكما أن مطر ضد بطولي في قصائده هو أيضاً يحب أن يمارس المعارضة الأدبية أو ما يسمى بالإنجليزية Parody وهو من أنماط الكتابة ما بعد الحداثية في الأدب الغربي وفي الأدب العربي أيضاً برأيي. إن مطر يقلب الحكاية فالذكر هو من يتكلم هنا وشهرزاد بدل أن تصمت في النهاية تبدأ بالحديث. يقول quot;شهريارquot; مطر:
(أنا المتسول العريان
تركتُ دمي لما في الأرض من نصُب
يطاردني العساكر والمصابيح الضبابية
فجأتُ مفزعاً.. قد خانني قلبي
خذي عني الجراب الفارغ المقطوع
هبيني كسرة من خبزك الأخضر
هبيني كوبة من مائك الدموي يعشب
لونها في أضلعي الجوفاء.)
حتى quot;شهريارquot; هنا هو ضد شهريار الذي نعرفه فليس بملك متسلط بل متسول عريان يستجدي كسرة الخبز وقد يكون في هذا إيحاءاً بأمنية أو نبوءة بسقوط الطواغيت. وكل نوع سينمائي (السرد، السيناريو، الحوار) كنت قد قسمته في دراستي لمجموعة quot;السدى قطرة قطرةquot; بدوره إلى ثلاث أنواع: الأول هو النوع البانورامي حين تطغى التقنية على القصيدة كلها، كما في القصة/ القصيدة (حسب عبارة إدوار الخراط) وهي هنا مثلاً في quot;عذراء الصمت والصمتquot;، والنوع الثاني هو الداخلي حين تحتل التقنية جزءاً من القصيدة كما في قصيدة quot;في أرض الموتquot; حيث يقول في مقطع quot;العاصفة- أصواتquot; ولاحظوا الدرامية في كلمة أصوات:
-: عيناك الواسعتان
بهوان انفتحا في غابات الفضة والأقمار
-: موالك رمح يزحف في زغب النهدين
ويغمغم في بئر الأسرار
-: طفلتنا تزرع في عينيها شجر النار
-: قريتنا تأكل فاكهة الأحجار
كي ترضعنا رأس المسمار
والنوع الثالث هو النوع الجانبي الذي تكون فيه التقنية على هامش القصيدة، أي على جانبها ونجد هذا مثلاً في quot;عذراء الصمت والصمتquot; والذي ذكرناه سابقاً على لسان الذكر البطل أو بالأحرى اللابطل.
الصورة الفنية عند أي شاعر هي جواز مروره للحداثة (بمعنى التجديد وليس المرحلة) في رأيي، بل إن من قرأ الكتاب الرائع للناقد بورا الذي ترجمته المترجمة الرائعة سلافة حجاوي يجد أنه وضع الصورة الفنية كمعيار للقصيدة الحداثية وعلى أساسها اختار سبعة من أعظم شعراء الغرب رغم تحفظي على أنه نسي أو تناسى أن يذكر أو يفرد فصلاً لأعظم الشعراء الصوريين ومؤسس المدرسة الصورية عزرا باوند، ربما بسبب خطيئة باوند المعروفة وهي فاشيته. وحين نتحدث خاصة عن محمد عفيفي مطر لا نستطيع أن ننسى صورته الفنية التي كانت أشد عناصر شعره هيمنة عليّ وعلى القارئ عامة في ما أظن. من ذلك قوله في قصيدته quot;تحت السماء البيضاءquot;:
خذيني الآن في بوابة الفيضان
لأدخل في الربيع الأبيض المغروس بين العرق والعرق
فأرقص في ابيضاض الريح والبرق
لأنسى ما تحجر من لغات الأرض في رئتي
وأمشي في الحقول البيض أملأ من جداولها
وغرينها المقدس ليل جمجمتي
وأركض في قرار النبع أقطف زهرة اللبن
فيسكرني عصير الشمس وهي تطير تحت سمائها البيضاء..
إذا ما تركنا الشكل وتحدثنا عن مضمون أشعار مطر لا مناص من أن نبدأ من غوصه في تراب بلده وأرضها الخصبة خاصة قريته التي سكن فيها وترعرع وهي (رملة الأنجب) على ما أظن والتي رأيناه تلفزيونياً يمشي بين أشجارها وآثارها، فللطبيعة المصرية حضور قوي وهو حين يذكر النيل والتراب لا يذكر الحاضر فقط بل يمتد إلى تراثه الفرعوني فنجده مثلاً يذكر في ديوانه quot;احتفالات المومياء المتوحشةquot; الإله أخنوم الذي خلق البشر حسب الأسطورة المصرية القديمة، أما في هذا الديوان فنجده يقول في قصيدة quot;أرض الموتquot; في المقطع 1 بعنوان quot;الفتاةquot;:
نزلت واغتسلتْ ndash; ذات مساء صيفي- في قلب النهر
فانهدلت أشجار الصفصاف
سكبت خضرتها في العينين الواسعتين
وانكسرت أسرار الكرمة في الشفتين
وانعقد عصير الشجر الطيب في النهدين
وحقول القمح تفض سنابلها في الصوت
وزهور اللبخ تحطّ حريراً في غيطان
الزغب المشمس والأسرار
والطمي الذائب في طبق البلور
يتوهج بالألوان السبعة، يثمر في الصيف الجسدي الأسمر
مفتتحاً صيف التكوين..
لكن شاعرنا كعادته يريد أن يكون متمرداً لا منتمياً فالطبيعة اليوتوبيا عند الشعراء الآخرين سواء الرومانسيين أو الثوريين أو غيرهم تغدو عنده أرض موت، ونجدها دائماً مقترنة في أشعاره بالجوع والألم. هل السبب في ذلك قديم قدم التاريخ حين كان نهر النيل يفيض فيجلب مع الطمي الخصب كما يجلب الخراب والدمار؟
في قصيدته quot;مذكرات إبريقquot; نجد جواً أسطورياً دينياً حيث يتحدث الشاعر عن اثنان هما حسب قوله quot;عجوز لم تعد أنثى وشيخاً أطفأت أيامه الطرقاتquot; كأنهما آدم وحواء، فيقول أحدهما للآخر:quot;ونمرق فوق قنطرة الرؤى للطينة الأولىquot;، وquot;سوف نذوق طعم الحنطة الأولىquot;، ومما يؤكد أنه آدم قوله: quot;تسوّلنا طوال اليوم فاستعصت على أفواهنا اللقمةquot; إنه آدم الذي نزل الأرض يتعب فيها ويشقى بعد أن كان مرتاحاً في الجنة، ومما يؤكد أنها حواء قولها: quot;ولم أعثر على ولد يطاوعنيquot; إن الولد المقصود هو قابيل كما يقول شاعرنا في موضع آخر من القصيدة quot;فكم ضمته بين مراشف التفاح حواءquot; وهنا يتبدى الاسم صراحة بل إن البعض يقول أن شجرة الخلد التي أكلا منها هي شجرة التفاح، وبعضهم يقول الحنطة التي ذكرناها سابقاً. ويتبدى قابيل صراحة أيضاً في موضع آخر، أما هابيل فهو حسب الشاعر quot;صبي أخضر العينين في الظلماء يحتضرquot;، كما يذكر الشاعر حية الأرض التي تمثل بها الشيطان لإغواء حواء ndash; حسب القصة المعروفة- إن شاعرنا يعيد رسم قصة الخليقة في هذا العالم الأرضي مرة أخرى ولكن بشكل أكثر قتامة، حيث يصبح أشبه بعالم سفلي -حسب قوله. ونلاحظ أن المقطع الأول من المتتابعة الأولى في قصيدته quot;مكابدات كيخوتيةquot; تحوي جواً مشابهاً حين يقول:
رياح الرغبة الأولى
تزلزلني وتفتح بابها الأسود
على فرعين يهتزان بالتفاح والحيـّات
هنا يلمح باكتشاف الجنس حين أخذا يداريان عوراتهما بأوراق الجنة، لكن في جو مأساوي مليئاً بالشهوات المتمثلة بالتفاح وبأكثر من حية، كما يقول في موضع آخر: quot;فيزهر في دمي التفاح، تلهث في دمي حيةquot;.
الحكاية الشعبية بنت الأسطورة وحفيدتها ولشعر محمد عفيفي مطر نصيباً كبيراً منها، وتحوي مجموعته ثلاث حكايات شعبية، الأولى في قصيدته quot;عذراء الصمت والصمتquot; التي ذكرناها سابقاً حيث حبيب يكابد وحبيبة تنتظر كما نجد في أغلب الثيمات الشعبية التي درسها الناقد الروسي فلاديمير بروب بشكل مفصل، والحكاية الثانية نجدها في قصيدة quot;في أرض الموتquot; بين الفتاة والفتى وتوحي بالجو الشعبي مفردات الطبيعة من شجر وطمي وسنبل وساقية خشبية..الخ. أما الحكاية الشعبية الثالثة فنجدها في quot;من حوارات الصاعقة الخضراءquot; بعنوان فرعي quot;حسن وجليلةquot; الذي يستدعي في ذاكرتنا الحكاية الشعبية المعروفة الشاطر حسن وست الحسن وأيضاً حكاية حسن ونعيمة. ولا مجال طبعاً لاقتباس القصائد/ الحكايات الثلاث.
ثنائية الجنس/ الموت حاضرة في مجموعة الشاعر خاصة في الحكايات الشعبية الثلاث، ففي الحكاية الأولى وبعد مطلع الغزل والنسيب ndash; وكأنه يضاهي الجاهليون- الذي يتحدث عن العينين والنهدين نجد انقلاباً مفاجئاً حيث الخناجر والدم والجوع الأخضر العينين..الخ. أما في الحكاية الثانية فيتبدى الموت من عنوانها quot;في أرض الموتquot; بعنوان فرعي quot;منظر قتلquot; فبعد أن يحكي الشاعر عن الفتاة ndash; وقد اقتبسنا المشهد سابقاً- وعن الفتى وأصوات الآخرين ينقلب أيضاً المشهد إلى آخر دموي عن جسد عارٍ مقطوع الرأس وعن شاعر قتيل..الخ. أما الحكاية الثالثة فنكتفي بذكر عبارة موجزة بليغة ذكرها في ثنايا قصيدته quot;والتفت اللذات بالرعبquot; حيث عبرت عن الحب بين حسن وجليلة في ظروف مأساوية يتخللها الموت والدم. والحديث عن الجنس والموت يقودنا للحديث عن شعر الجسد الذي يعده كمال أبو ديب نمطاً ما بعد حداثي حيث يغدو غير متعلقاً بوطن. نضرب مثالاً من حكايته الثالثة حيث يقول:
خلال دمي توهج وجهك الزهري وارتعشت
عروق الطمي بالعشب
وفجـّرني عبيرك طحلباً ومواسماً تهتز تحت عباءة النبت
وموسيقى أراقت ماءها الصيفي في قلبي
لتنبت في سواقي الشعر والأحزان سروة
عامي العشرين
وفي عينيك من جميزتي ظل، ومن تاريخها
دوامة الصمت
حتى شعر الجسد عند مطر مصرياً صرفاً، فالمرأة هنا هي امرأة ريفية مجبولة بماء النيل والشجر النابت على ضفافه.
الشاعر محمد عفيفي مطر شاعر سوداوي كانت الكآبة دافع لاستفزاز إبداعه كما حدث مع الكثير من المبدعين في الغرب والشرق، وحتى في عناوين قصائده مثل quot;جريمة في غرناطةquot; وغيرها، فعالمه عالم الخطيئة والجوع..الخ، ويقول في قصيدته quot;حمدون القصـّارquot;: quot;نفسي الأمارة بالأشعارquot;، حيث يغدو اقتراف الشعر كاقتراف السوء أو الخطيئة وهذا هو بالفعل الشعر الفاضح عن مكنون الذات والمجتمع خاصة عالمه السفلي. وقد تكررت كلمة صمت كثيراً في مجموعته بل سمـّى مجموعته quot;من دفتر الصمتquot; فجعل الصمت حاضراً مرتين في عنوان إحدى القصائد quot;عذراء الصمت والصمتquot; وفي هذا كله مفارقة فديوانه صرخة وليس صمتاً، وربما قصد بالصمت هنا المسكوت عنه (المصموت) الذي يبوح به.
في قصيدته quot;الوجه الهاربquot; الأخيرة لا يحتاج الأمر إلى فطنة لندرك أن شاعرنا هو الهارب بحثاً عن يوتوبيا وأرض فاضلة، إنه في سفر ndash;كما يقول في قصيدته- ومجتمعه معه كذلك وذلك من أجل عصير الطحلب القمري والشعر وغناء البحر والجميز والحنطة..الخ، مما افتقده في غابة الأسمنت التي تزحف على الريف. ولكن هل ثمة أمل؟ إنه يقول في نفس القصيدة quot;وفي جنبي تنطفئ البشاراتquot; فهل هو متشائم؟ لكنه لا يلبث أن يعود فيقول في المقطع الأخير:
أكاد أراكِ في العتمة
وخلف نوافذ البلور
أكاد أراك فوق المقعد المخفي في كل
القطارات التي تأتي من المجهول أو تمضي
وأسمع صوتك الفضي
يصلصل في عروق الأرض حتى يورق العالم
هنا نسأل أنفسنا هل يكون محمد عفيفي مطر متشائل آخر حسب لغة إميل حبيبي؟
quot;رباعية الفرحquot;
في quot;من دفتر الصمتquot; رأينا كيف احتلت السوداوية المشهد الشعري، لكن ثمة تناقض نوعاً ما مع quot;رباعية الفرحquot; حيث تبدى الفرح كنقيض للألم والموت منذ العنوان، وأقول نوعاً ما لأن مازال للموت حضوره القوي بل يقول الشاعر في quot;فرح بالترابquot;: quot;ذلك أوان الفرح والترابquot;، هنا أيضاً التشاؤل الذي تحدثنا عنه وهذا له علاقته بثنائية الجنس والموت التي ذكرناها أيضاً سابقاً ونجدها حاضرة هنا أيضاً خاصة في quot;كتاب المنفى والمدينةquot;، نستطيع أن نقول أن ثمة تطور في المضمون حدث مع quot;رباعية الفرحquot; فصار للأمل حضوراً أكبر كان الدافع فيه ثورياً وصوفياً معاً كما سنرى. وقد اخترت هذه المجموعة لأنها تبدأ منذ عنوانها بالأمل الذي كان الشاعر يبحث عنه في نهاية quot;من دفتر الصمتquot;. ويقول الشاعر في قصيدته الأولى من المجموعة quot;كتاب المنفى والمدينةquot;:
أعرف أن الأرض والمملكة
التي سوف تجيء
لمـّا تزل في شجر الظلام
تفاحة معلقة.
أعرف أنها بوابة مؤصدة بعيدة
لكنني أشمها في برعم الصيف،
أذوقها في المطر البريء،أسمعها تضحك
في اصطدام السيف بالهواء
يعود هنا تشاؤل الشاعر وتجتمع الضحكة مع نقيضها السيف، والتفاحة بالظلام، إنه على يقين من أن يوتوبيا موجودة في مكان ما رغم أنه ما زال بعيداً عنها، ورغم أنه يحيا في عالم الطواغيت والموت والعذاب، وهذا المزيج من الأمل والألم (لاحظوا نفس الحروف) هو ما يجعله يقول في quot;فرح بالنارquot;: quot;وتعروه غاشية الفجر بالفرح المتفجعquot;، حتى الفرح عنده صار متفجعاً، ويقول في موضع آخر من نفس المقطع: quot;لبست من الرعب دراعةquot;، هذه الدراعة هي الأمل والفرح، وأحياناً يكون الحلم هو طريقه وبداية الخلاص فيقول في quot;فرح بالنارquot;: quot;قفص كل شيء وأفق يفتحه الحلمquot; ويقول في quot;فرح بالهواءquot;: quot;حلم جميع هو الأفقquot;، كما يقول في quot;فرح بالترابquot;: quot;وأحلامي طيور متوحشة فاجأها الليل بالحيرة ونداء المسافةquot;. إنه مصر على سوداويته فحتى حلمه يشبهه بطير متوحش.
صرخات الشاعر الشعرية من أجل الخلاص من واقعنا المأزوم خاصة العربي بعد عقود من التيه والهزيمة ليست مجرد تهويمات أو شطحات للنائمين، بل إنه يدلنا عبر لغة شعرية سياسية (ليست خطابية) الطريق إلى الأرض الفاضلة واليوتوبيا التي يحلم بها منذ مجموعته الشعرية الأولى حتى الأخيرة، وهذا الطريق أو السفر قد يكون عنده هو الغاية ذاتها فإن كان يتحدث في quot;من دفتر الصمتquot; عن انتقاله من سفر إلى سفر فإنه في quot;رباعية الفرحquot; وفي quot;فرح بالماءquot; يقول: quot;أشاركه شهوات التنقل في جسد الأرضquot; هذا السفر والتنقل أصبح له شهوته في حد ذاته وصار هو الغاية والوسيلة. وهذه الوسيلة تتفرع إلى ثلاث شعب الأولى هي الكتابة والقصيدة حيث يقول في quot;فرح بالترابquot;: quot;القصيدة في رماد القلب توشك أن تبلّ عظامهاquot; هنا يجعل من القصيدة عنقاء تخرج من رماد قلبه الذي احترق بويلات زمانه، ثم يقول في نفس القصيدة quot;مهرتك استهل صهيلها في غابر العشق المكتم في القصيدةquot; هنا المكبوت عنه يبزغ في القصيدة، وفي نفس القصيدة يقول quot;يعلو الكلام ويخلع أوزانهquot; والمعنى واضح طبعاً فزلزال الواقع خلع أوزان اللغة والشعر فهذا ما يتبدى صارخاً في شعر محمد عفيفي مطر، ويفرد مطر في quot;فرح بالنارquot; مقطعاً طويلاً من ست مقاطع فرعية عن الكتابة ولا مجال لاقتطافها كلها، لكنه يقول في بدايتها: quot;قلت حصن الكتابة آخر ما يملك الملك المتوحد، تلتم فيه خيول الدم المتحولquot;، الملك المتوحد هو طبعاً شاعرنا الذي يعتبر شعره شهادة للموت والخراب في عصره، كما يعتبره حصناً أو خلاصاً. لكن ليس كل الكتابات ككتابات مطر وأشباهه من الصارخين في البريّة العربية، فثمة كتابات تمثل الدعارة الفكرية وشعارات جوفاء يضحك بها الساسة وحاشيتهم من المثقفين الفاسدين على ذقون الشعوب، لذا نجده يقول مباشرة بعد المقطع السابق: quot;كان الزمان زمان الكلاب التي اغتلمت بالكتابات فانطلقت تتهارشquot;، ويقول فيما بعد: quot;يتساقط معنى الكلامquot; وquot;تساقط لحم المعاجم عن عظم هيكلها الهشquot; وquot;يرتد وحش الكلامquot;..إلى آخره من صور بشعة تصور ثقافة الخواء الهزيلة السائدة التي أصبحت وحشاً يهددنا ويهدد تراثنا. هذه الكتابة واللغة تقترن دوماً عند الشاعر بالوطن فيقول في quot;فرح بالترابquot;:
نزق الغيوم وشهوة الرقص المباغت في انفساح
الأرض باللغة الجموح وشهقة الشبق المصلصل في
الصهيل وفي الكتاب
قلت: أنظري للغيم .. كوني مهرة الملكوت وهو
يشكـّل اللغة الحميمة في لسانك وامنحي لغتي المذوبة فيه
من لغة مقطرة القبائل والصهيل..
وكنت تجهش بالقصيدة ...
يكثف الشاعر هنا حديثه عن اللغة فيكررها أربع مرات كما يذكر القصيدة ويربط جموح اللغة بانفساح الأرض، أي بالحرية، فثورة اللغة عنده وجموحها وانطلاقها وتفجيرها مقترناً عنده بثورة الشعب وهذا ما يذكرنا بأدونيس وبياناته، وحديثه أن شعر الثورة والمقاومة الحقيقي ليس الشعر الخطابي بل هو الشعر الحداثي بل المابعد حداثي التثويري في صوَره ورؤاه. ويقول شاعرنا في quot;فرح بالترابquot; متسائلاً في فزع: quot;هل هذا هو اقتران الوطن بالنفي واللغة بفزع الكهوف؟!quot; إن اللغة والوطن من هواجس الشاعر المزمنة وتحرير اللغة من تراكمات السائد هو معادل موضوعي عنده لتحرير الوطن ليس من الاحتلال والاستعمار فقط بل ومن الظلم والطواغيت أيضاً.
الوطن كما رأينا حاضراً دوماً في قصيدة محمد عفيفي مطر ويتمثل عنده دوماً في مفردات طبيعته ومناخاته النفسية، والثورة من أجل تحرير هذا الوطن هي إحدى شعب الطريق إلى الأمل وفي هذه المجموعة يبشر الشاعر في quot;فرح بالنارquot; بـquot;خراب الممالكquot; حسب تعبيره أو بـquot;السقوط عن العرشquot; في quot;فرح بالماءquot;، وهو لا يقصد الملكية المعروفة فقط فالجمهوريات أيضاً أصبحت ملكية في نظامها الوراثي، حتى الغربية منها، وهؤلاء الملوك/ الرؤساء هم من أفسدوا الوطن في رأيه فيقول في quot;فرح بالترابquot; :
فهل أنتِ امرأة لأن الملوك يزدحمون بين القميص
وبين تضاريس الجسد
أم أن الملوك يحاصرونك لأنك امرأة
إن المرأة هنا هي الوطن حسب المفهوم التقليدي في شعر المقاومة. وفي quot;من دفتر الصمتquot; وquot;رباعية الفرحquot; نجد الحديث المتكرر عن الجوع والألم الذي استدعى لديه الثورة والدعوة لها، فيقول في quot;فرح بالماءquot;: quot;فليسقط ما استعلوا به وامتلكوا الأرض وليدمدم عليهم غضب الشعب بما أجرمواquot;. ويتمثل عنده الثائر أو الأمل بشخصية ابتدعها يسميها quot;ملك الوقتquot; والمغزى واضح في اللقب فهو يريد من الشعب أن يكون سيد لحظته الثورية التي لن توصله بسهولة إلى النصر فالطريق وعرة محفوفة بالأشواك يقول عنها في quot;فرح بالنارquot;: quot;المسافة بيني وبين بلادي وعرشي دم وتماسيح ونار!!quot;. ولكن هذا لا يجعله خائفاً ويطلب من الشعب ألا يخاف ويقول له بعد ما سبق بسطور شعرية :
فاضربي يا شموس الكوابيس في خشب العرش
وليسرح السوس فالأرض بوابة والردى في
البلاد الطريق،
الحريق المفاجئ داومة تتمدد في أفق الاحتمالات،
والشمس تسرع .. كانت تفرّ الأقاليم من تحتها
تتداخل مخطوطة الرمل في أحرف الماء
والورق المتطاير يلتف في مصحف الخلق
والشمس تسرع أبعد منا وأقرب
والوقت يرفع نيرانه الفوضوية، يحمل آيات
غربته وطناً للولادات والاحتمالات..
والشمس تسرع أبعد منا وأقرب..
هذه الفوضى التي يذكرها الشاعر هي فوضى الثورة، أما الحريق والنيران فهي نار الحرية أيضاً وليس عبثاً أن أورد ذلك بعنوان ذو مغزى quot;فرح بالنارquot;. إن شاعرنا يبشر بمملكة بديلة فيقول في quot;فرح بالنارquot; أيضاً : quot;مملكتي الضد، رؤيا اصطخاب من الاحتمالاتquot; إنه يريد أن يكون لا منتمياً وصوتاً لشريحة الصعاليك الخارجين عن طاعة القبيلة وعلى الخانعين للسلطة الظالمة والغاشمة، ويطرح quot;ملك الوقتquot; مقابل الملك/الطاغوت، وتصل به ذروة النشوة بالثورة والحلم بالتغيير أن يصرخ في نهاية المفتتح الثاني من quot;فرح بالترابquot; قائلاً: quot;فينقلب كل شيء ينقلب كل شيءquot;.
أما الطريق الثالثة نحو الخلاص فيأتي من الصوفية ورغم طغيان الأثر الإسلامي على مجموعته إلا أن صوفيته ليست إسلامية فقط بل تمتد من quot;الإشراقيون الهرامسةquot; حتى quot;السهرورديquot; الذين يذكرهم في quot;كتاب المنفى والمدينةquot; كما يذكر quot;النفريquot; في quot;فرح بالترابquot;. وفي نفس القصيدة مقطع طويل يحيا فيه الشاعر مناخاً صوفياً خالصاً فيقول:
تذكرت ومن تحتي نهر الصور الحية يجري
والينابيع تواجشن كما أقضي..
تذكرت فجاءت كرة الأرض وجاءتني
السماوات وأبدلن ثياباً بثياب.
المزج بين خلائق الذاكرة وزواج ما ليس
ذكراً بالأنثى وما ليس أنثى بالذكر
وفرح القوى الأرضية وهبني قوة الاستحضار
بمدد من صور الذاكرة المهشمة
فاستحضرت من الأطعمة والصور والسماع
الطيب على ما أشتهي
وطال الوقوف في مقام quot;كنquot;
وامتلأ الفرح بالأسئلة الغضة
وتهدّل شجر الوجه بالهواجس الطازجة
وبراعم الحيرة المنتبهة
فعرفت أني على المعراج أتمشى في مقصورة
اليقين الأوحد
واتسعت دائرة الأرض.
إن يوتوبيا الشاعر هنا يوتوبيا صوفية وهي يوتوبيا داخلية ليست في عالم آخر وإذا كان quot;من دفتر الصمتquot; تحدث عن سفر إلى بلاد بعيدة في خارج المكان فإنه هنا يتحدث عن سفر في الذات إلى مقام quot;كنquot;، ونجد الصوفية في مواضع أخرى مثل قوله في quot;فرح بالنارquot;: quot;أعضائي هي الأرض الوسيعة والخليقة قبضة من طينتي والناس أبنائيquot;، كما يقول في quot;فرح بالنارquot; أيضاً : quot;واحدة أنتِ والكون أسماء وجهكquot; ويقول في quot;فرح بالترابquot;: quot;هذا هو الواحد.. ملتفاً بالفرادة، منتشر وكثيرquot; مما يستدعي لدينا عبارة النفري المشهورة -خاصة بعد أن جعلها أدونيس عنوان أحد دواوينه- وهي quot;مفرد بصيغة الجمعquot;. وكما أن الوطن يقترن عند شاعرنا باللغة فإنه كذلك يقترن مع الصوفية، والرابط بينهما هو الأرض فالأرض هي الوطن الذي نحيا به وتكونت أجسادنا من مائه وطعامه كما أن الأرض أيضاً والطبيعة عامة هي مثلنا نحن البشر صيغة من صيغ الوجود الإلهي حسب التصور الصوفي. والشاعر يتماهى صوفياً ووطنياً مع أرضه، فيقول: quot;هل قلت أن الأرض أقرب من دميquot; ويعيدها أيضاً في نفس المقطع من quot;فرح بالترابquot;: quot;والأرض أقرب من دمي.. فأنا اختيار الأرضquot;، ثم يصل بنا في نفس القصيدة إلى أبهى صور هذا التماهي وتحت عنوان فرعي quot;زيارةquot;:
طيناً من الطين انجبلت ففي دمي المركوز من
طبع التراب الحي:
فورة لازب، وتخمر الخلق البطيء،
ووقدة الفخار في وهج التحول، وانتشار الذرو في
حرية الحلم، وانفراط مسابح الفوضى حصى،
وصلابة الفولاذ في حدق الحجارة واليواقيت.
انخطفت بنشوة الحمـّى، الأوابد من وحوش
الطير تحملني وتمرق..
في حواصلها تعاين محنة
الملكوت والأرض الفسيحة..
هنا مشهد للخلق يذكرنا بالإله أخنوم الذي خلق البشر حسب الأسطورة الفرعونية وذكره شاعرنا في quot;احتفالات المومياء المتوحشةquot;، وفي هذا المشهد يتماهى شاعرنا مع الأرض التي هي من طين مثله ولعل هذا المقطع الشعري هو أروع ما كتب الشاعر في تجربته الشعرية حسب رأيي. وهذه الصوفية الوطنية ndash;إن صح التعبير- حاضرة أيضاً في مشهد الوضوء الجماعي أو الصلاة الجمعية في quot;فرح بالهواءquot; حيث الأرض والخلائق والطين..الخ، ولا مجال للاقتباس، يكفي أن نذكر قوله: quot;فكيف ارتوى طمي وجهك بي فهو طمي بلاديquot;.
وصوفيته فرضت عليه التأثر الديني في تناصـّاته فنجده يكرر في quot;كتاب المنفى والمدينةquot; عبارة quot;سلام هي حتى مطلع الفجر سلامquot; وفي هذا إشارة إلى ليلة القدر التي هي ليلة يوتوبية أيضاً حيث يستجاب فيها للمسلم بكل ما يشتهي، كما يذكر جزء quot;عمّquot; في quot;كتاب المنفى والمدينةquot; أيضاً، وفي quot;فرح بالماءquot; يتحدث عن أعجاز نخل أما في موضع آخر في quot;فرح بالماءquot; فيقتبس بجرأة -لم يفعلها ربما شاعر غيره- آية كاملة هي: quot;لقد مكر اللذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرونquot;. وفي تناصـّاته الدينية نجد شكلاً أرقى للتناص حيث الحوار معه بدلاً من استخدامه استخداماً عرضياً كما يفعل الكثيرون عادةً.
الطبيعة هي الوطن والأرض أيضاً وفي quot;رباعية الفرحquot; يستمر شاعرنا في الانغماس في طبيعيته الذي يتمثل خاصة في مطلع quot;فرح بالنارquot;:
ألتف بالشمس وغبار المسافات المفتوحة
أغسل جسدي بالقش ورغوة الغضب
وخناجر العشب المسننة
وأفتضّ أختام الريح وكمون الندى في البراعم.
يسكن النحل تحت إبطي وبين أصابعي تختبئ
الينابيع الخائفة
والأرض زجاجة تهشم ألوان الطيف وتذريها على
جسدي المعلـّق بين الجوع والربيع
أمتلئ شيئاً فشيئاً كاليقطين العسلي الأحمر المدلّى
فوق أهرامات التراب ومصاطب التحاريق
هنا تماهٍ آخر مع الطبيعة التي نراها في المجموعة من خلال مفردات البشنين والسمك والمراكب والغمام والصلصال..الخ. بل إن الطبيعة تشكل العالم الكلي لـquot;رباعية الفرحquot; حيث ينقسم الديوان إلى أربعة أقسام quot;فرح بالماءquot;، quot;فرح بالنارquot;، quot;فرح بالترابquot;، quot;فرح بالهواءquot; وهذه هي عناصر الطبيعة الأربعة منذ الفلسفة الطبيعية عند اليونانيين، ويبدو أن الشاعر قرأ جيداً هذه الفلسفة والفلسفة الإغريقية عامة حيث يحدثنا في quot;فرح بالترابquot; عن صديقه الفيلسوف زينون الإغريقي، وهو يربط بين الطبيعة والوطن من خلال الماء أيضاً حيث يقول في quot;فرح بالماءquot;: quot;هذا كرسي الإنسان ممدود بين مخاضتي الوطن الواسعquot; فهل يقصد المحيط إلى الخليج؟ كما أن للطبيعة ndash;والماء خصوصاً- علاقتهما بالدين والأسطورة فمن الماء خلق كل شيء حي، وهو محور عملية الخلق التي تشكل هاجساً من هواجس شاعرنا بل حتى قبل عملية الخلق وفي العماء البدائي كان الماء، ممثلاً في أقيانوس حسب الأسطورة الإغريقية أو آبسو حسب الأسطورة البابلية.
أحد أسباب اختياري لـ quot;رباعية الفرحquot; أن قصيدته الأولى quot;كتاب الأرض المنفى والمدينةquot; تحمل القديم وبذور الجديد، فنصفها قصيدة حداثية كتبت 1968، ونصفها الآخر قراءة ما بعد حداثية لنفس القصيدة كتبت في 1975. وأبرز ما احتفظ به الشاعر من مرحلته السابقة هي إنشاديته التي لا يستغني عنها كما يبدو، فيقول مثلاً في quot;فرح بالنارquot;:
أنا الخطى.. وفي دمي الطريق
أنا الذي تزرعه الكتابة
في الريح أو تطرحه في القشر
منطفئاً وساقطاً على نفسه،
وضارباً جبهته في الصخر
كي يفتح المجهول في مملكة الأشياء.
وهذا المقتطف هو من مقطع فرعي بعنوان quot;موّال من حدائق.. امرأةquot;، نجد فيه تكرار كلمة أنا التي تمثل الغنائية الشعرية حيث الصوت المفرد مقابل الدرامية البوليفونية، لكنه كما عوّدنا ذو إنشادية ضد بطولية فهو هنا منطفئاً وساقطاً وضارباً جبهته في الصخر. وأيضاً في quot;فرح بالنارquot; وقبل المواويل الثلاثة نجده يتحدث بلغة الأنا بل وتحدث عن اسم عائلته الشخصي quot;مطرquot; بشكل شعري:
ميم: يد مغلولة في طميها الواري
والزند في بازلته العاري
أوتاد نار السقط فيه
كهف البلاد المعتم الهاري
والطاء: عنقاء انتظار لبثتها في
زمان القش والأحطاب تأويلات ما
خطـّته في رق الوصايا مهرة النار
والراء: وشم السنبك المفطور من
سهد الرباط الصعب في ليل الثغور،
القوس في الشد، الهلال الفضة،
المهماز بين الأفق والينبوع، دمع
جمرة ما بين أجفاني
والمفردات في المقطع السابق مثل المهماز وسهد والسنبك وغيرها في مجموعته تدل على مدى ما وصل له الشاعر من غنىً في المفردات وثروة لغوية تراثية مقارنة مع quot;من دفتر الصمتquot; بل إنه ينحت من اللغة أحياناً كما فعل حين يقول: quot;والمدى قنفذته الرياحquot;، وفي مقطع quot;فرح بالماءquot; يقتبس مقطعاً طويلاً من شعر quot;جعفر بن علبة الحارثيquot;.
لكن الفصحى لا تنسيه الجو الشعبي الذي تفرضه طبيعة وطنه التي يحبها، فنجده في quot;فرح بالنارquot; يقتبس شكل الموال فيكتب ثلاث مواويل وربما للموال علاقة أيضاً بحبه للغنائية والإنشادية، خاصة أنه يكرر الأنا فيها. كما في المجموعة السابقة يظل لأدونيس صداه ولو بشكل ضعيف، فمثلاً يقول في quot;كتاب المنفى والمدينةquot;:
تلبس الشمس قميص الدم،
في ركبتها جرح بعرض الريح
والأفق ينابيع دم مفتوحة
بالطير والنخل
لكنه أيضاً يظل مخلصاً لمصريته وألمه، فيظل للدم والجرح والطير والنخل حضورهم.
يقول شاعرنا في quot;فرح بالترابquot;: quot;ينبجس السرابquot; وهنا تشاؤم حيث لا ماء بل سراب، والغريب أن شاعرنا يورد هذا في quot;فرح بالترابquot; وليس في quot;فرح بالماءquot; وربما السبب أن السراب يكون على تراب الصحراء. نتمنى أن ينبجس من شعر محمد عفيفي مطر أملاً للقارئ وليس سراباً في صحارينا العربية.




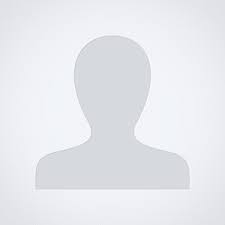
التعليقات