عبد الوهاب بدرخان
أسفرت الانتخابات في بريطانيا (قبل خمسة أيام) وفي العراق (قبل أكثر من شهرين) عن برلمانين معلّقين لا غالبية فيهما لأي حزب أو ائتلاف بمفرده كي ينبري لتشكيل حكومة جديدة. في بريطانيا عرفت النتائج وأعلنت خلال أقل من أربع وعشرين ساعة بعد إقفال صناديق الاقتراع، وحتى قبل إعلانها بدأ البحث في سيناريوهات الائتلاف الحكومي المحتمل، وشرع المعنيون مساء اليوم نفسه في اتصالات ولقاءات، لأن العرف يقضي بتقصير إقامة الحزب المهزوم في مقر السلطة إلى أقل مدة ممكنة، ولو كان الفوز واضحاً للحزب المنافس لكان على الزعيم الخاسر أن يغادر quot;10 داونينغ ستريتquot; صباح اليوم التالي للاقتراع بلا أي تأخير.
في العراق لا تزال النتائج موضع تشكيك، فبعد فرزٍ وعدٍّ إلكترونيين بوشر بفرزٍ وعدٍّ يدويين في بغداد وربما في سواها لاحقاً، وليس معروفاً متى ستعتمد النتائج رسميّاً ونهائيّاً، ومن لا تسقطه إعادة الفرز والعدّ لديه حظ كبير في أن تسقطه quot;هيئة العدالة والمساءلةquot;. وما دامت quot;الديمقراطية العراقيةquot; فتية، ولم تُبنَ فيها أعراف بعد، فإنها وجدت نفسها أمام فرصة ولو شكلية لإبداء أريحية في التعامل مع رسائل الناخبين كما انبثقت من صناديق الاقتراع. أي أن الجهة التي حلّت في المرتبة الأولى بعدد المقاعد تُعطى الفرصة لمحاولة إنشاء ائتلاف حكومي. لكن الذي حصل هو تحديداً الفارق بين جوردون براون ونوري المالكي. براون يستطيع الإصرار على وجود عرف سياسي يمنحه حق البحث عن صيغة حكومية تضمن له البقاء في الحكم، لكن النتائج أظهرت حصول منافسه زعيم حزب quot;المحافظينquot; على أكبر عدد من المقاعد والأصوات، لذا رضخ براون لرأي زعيم الحزب الثالث quot;الأحرار الديمقراطيينquot; بأن ديفيد كاميرون هو صاحب الحق في السعي أولاً إلى رئاسة الحكومة متحالفاً مع من يشاء.
قد تكون المقارنة ظالمة، وقد لا تكون موضوعية، وقد لا تصح في مجمل المعطيات، إلا أنها مغرية وذات مغزى نظراً إلى تزامن الحالتين. فمن شأن كل من براون والمالكي أن يتمسك بنواجذه بالمنصب، إلا أنهما لا يتساويان في الإمكانات، إذ ليست لدى براون quot;هيئة مساءلةquot; تعضده، ولا محكمة عليا تفتي له بما يرغب، ولا ميليشيات تفتعل مشاكل، ولا مؤسسات أمنية تدين بالولاء لشخصه، ولا حتى خشبة خلاص مذهبية تقلل من خسائره، ولا مرجعية في الداخل أو في الخارج تحسم الجدل والخلافات لمصلحته أو ما يقرب من مصلحته. لذلك كان على رئيس الوزراء البريطاني أن يستوعب كل ذلك ليخرج بموقف لا يتحدى فيه الناخبين ولا يعطي محازبيه آمالاً كاذبة. صحيح أنه، مثل المالكي، لم يفز ولم ينهزم بالمعنى السياسي لكنه خلافاً للمالكي يعترف بالمنطق الذي فرضه الاقتراع.
كانت الفكرة التي فرضت نفسها في لندن أن البرلمان المعلق ربما يثير التوقعات بإجراء انتخابات مبكرة، لكن بعد تجريب quot;حكومة أقليةquot; بقيادة quot;المحافظينquot;، أو quot;حكومة ائتلافيةquot; بقيادتهم أيضاً، وتكون القاعدة المسيّرة لها احترام المصلحة الوطنية. وكانت الرسالة الأولى التي تلقاها الوسط السياسي البريطاني تنطوي على أمرين: أولهما أن الاستياء الشعبي لا يميز بين الأحزاب بل يدينها جميعاً. والثاني أن النظام الانتخابي أصبح قديماً ومهترئاً وينبغي العمل لتحديثه أيّاً تكن سيناريوهات الحكم والحكومة. ومع ذلك، فإن المصلحة الوطنية لا تعني أبداً تجاوز المصلحة الحزبية، لكن الأهم أن هناك نظاماً، وأنه يجب أن يستمر في العمل وألا يؤدي التمسك بالمصلحة الحزبية إلى تعطيل مصالح البلد والناس.
بديهي أن أي تحالف بين quot;المحافظينquot; وquot;الأحرار الديمقراطيينquot; سيُبنى على لقائهما بهدف إضعاف حزب quot;العمالquot;. فكلاهما أمام فرصة مغرية، الأول يريد الحكم والثاني يريد ترسيخ مكانته في المشهد السياسي. هنا يختلف الإشكال العراقي في مفهومه للتوازن بين المصلحة الوطنية والمصلحة الفئوية. فالتحالف الشيعي (-الكردي) يريد إدامة الصيغة الحكومية الحالية لكن من دون المالكي، وبالأخص من دون ائتلاف إياد علاوي، إذ أن صاحب أكبر عدد من المقاعد سيدعى للمشاركة رفعاً للعتب. فحتى لو كان التحالف المتجدد يظهر رغبته في اجتذاب علاوي، إلا أن مجرد إنشاء هذا التحالف، بخلفياته الإقليمية يعني عمليّاً استبعاداً له. فالمصلحة الوطنية في القاموس العراقي، على رغم كل التنظير لـquot;الديمقراطية التوافقيةquot;، لا تشمل بالضرورة المصالحة الوطنية.





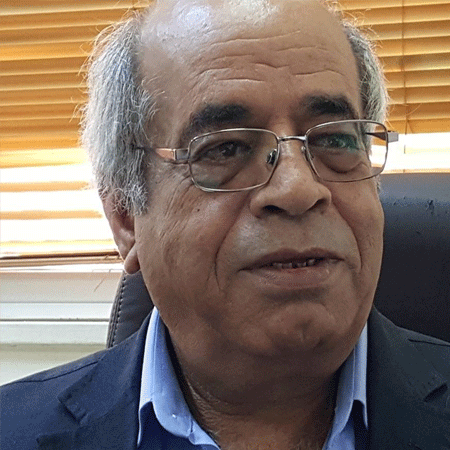







التعليقات