يشير الباحثون إلى أن مصطلح الأقليات يعتبر من المفاهيم الملتبسة، والتي كثيراً ما تستعمل بشكل غير دقيق للحديث عن وضعيات مختلفة، لذلك فقد اقترحوا أن يتم اعتماد البعد السياسي للمفهوم من أجل مناقشة المطالب الجماعية الخاصة، ومن هذا المنطلق السياسي يمكننا أن نتحدث عن الأقليات العرقية والثقافية واللغوية والدينية، من دون الانخراط في الاختلافات الاجتماعية المرتبطة بالجنس، والعمر، وغيرهما من الفروق الطبيعية التي تميز مختلف المجتمعات.
ونستطيع في هذا السياق أن ننطلق، كما يقول إيف بلاسيرو، من التعريف الذي اعتمدته الأمم المتحدة بخصوص الأقليات، والذي يشير في ديباجته إلى أن: الأقلية هي مجموعة تتميز بكونها أقل عدداً مقارنة بباقي سكان دولة من الدول، وتوجد في وضعية غير مهيمنة، بحيث يملك أعضاؤها بوصفهم مواطني الدولة وجهات نظر عرقية، دينية أو لغوية، وخصائص مختلفة عن تلك السائدة لدى السكان، وتُظهر ضمنياً شعوراً تضامنيا يهدف إلى المحافظة على ثقافتها، وتقاليدها، ودينها، ولسانها.
ويؤكد برتراند بادي أن الأقلية لا وجود لها إلا في مقابل نموذج من الهيمنة مؤسِّسٍ لمجتمع ما، يُميّز ما بين المعيار، وما يخرج عن سياقه، ما بين الشرعي وغير الشرعي الذي يحدّد الشروط اللازمة من أجل المشاركة السياسية الكاملة. ومن ثم، فإن وجود الأقلية يثير مشكلة تتعلق بحمايتها، وبضمان حقوقها، وبأنماط ممارستها لاستقلاليتها. وتطرح أيضاً على مستوى المجتمع كله إشكالية توافقها مع مبدأ وحدة الدولة، لكي تسهم الأقلية في ترسيخ سيادة الدولة وفي احترام مبدأ الأغلبية. وعندما يعمل المجتمع المتعدّد على تنظيم التعايش مع الأقلية، فإنه يحدّد بذلك شروط تقاسم المسؤولية السياسية، الأمر الذي يسمح بظهور أشكال من التأقلم مع نظام اجتماعي متكوِّن من أقلية مهيكلة ومنظمة؛ ويمكننا أن نتحدث بلغة المؤسسات عن أقلية انتخابية، وأخرى برلمانية، للإشارة إلى مجموعات انتخابية وحزبية لم تحصل على ما يكفي من الأصوات لممارسة السلطة.
وتحتل مشكلة الأقليات مساحة متزايدة في المشهد العالمي منذ نهاية الحرب الباردة، بخاصة في مناطق مثل التبت، وتيمور الشرقية، وكوسوفو، ومقاطعة كيبك، حيث بدأت معاناة الأقليات بالتجلي بشكل متزايد في مناطق مختلفة. ومن الواضح أن هذا التوجّه لن يشهد تراجعاً على المدى المنظور نتيجة للتضخيم الحاصل على مستوى التمثلات الهوياتية للمجموعات وشعورها المتنامي بتميّزها عن بقية السكان، ورغبتها في التطور بشكل مستقل حتى إن حدث ذلك على حساب سلطة الدولة؛ ومن الصعب حتى الآن تقديم حلول ملائمة لمشكلات الأقليات من دون المساس بسيادة المجتمعات، لاسيما مع تزايد النزعات الانفصالية التي تعمل على تشجيعها الكثير من القوى الكبرى.
ويحاول أوبير فيدرين، أن يميز من جهته بين معنيين من معاني مفهوم الأقلية، أي بين تصوّر كلاسيكي، وبين مقاربة معاصرة للمفهوم في الغرب؛ فالتصور الكلاسيكي والقانوني للمصطلح جرى تحديده بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بخاصة في أوروبا، وفي السياق الأممي المتعدّد الأطراف، كردّ فعل على الطريقة المتوحّشة التي عوملت بها الأقليات، العرقية واللغوية والدينية، منذ القدم، وخلال الحرب الكونية الثانية،وبعدها بسبب الهجرات الكبرى للسكان. وبهدف حماية الأقليات، فقد تم تأسيس، انطلاقاً من اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين، قانون خاص بها، لاسيما وأن الدول المتجانسة سكانياً، مثل اليابان، والكوريتين، تعتبر نادرة، أما في الحالات الأخرى، وحتى عندما لا يتعلق الأمر بالإمبراطوريات والدول المتعدّدة القوميات، فإن الأقليات تعتبر كثيرة.
أما التصور الذي بدأ يتبلور الآن، كما يضيف فيدرين، فيتعلق بأقليات من نوع آخر، بتأثير مباشر مما يحدث في أمريكا الشمالية، حيث بدأت تتشكل وتتصلب منذ عقدين، أو ثلاثة عقود، أقليات جنسية، والأمر لا يتعلق هنا بالنساء، ولا بالحركات النسوية التي غلبت على بعضها نزعة التطرف، ولكن بالأقليات المرتبطة بالحركات المثلية التي ترفض التصورات المجتمعية الخاصة بالأسرة التقليدية، وهي حركات فائقة النشاط، ونلاحظ أنها تتحالف أحياناً مع أقليات أخرى مثل الأقليات العرقية، والدينية.
ويقول أوبير فيدرين، في سياق متصل، إن هناك استثناءات تاريخية كانت تحظى فيها الأقليات بالاحترام والقبول، على غرار البورجوازية القبطية في مصر، ورغم ذلك فقد كانت هناك حالات وُظّفت فيها الأقليات، أو خضعت للاضطهاد، وربما للتصفية. وبموازاة ذلك بتنا نلاحظ في الدول الغربية أن أقليات تنتمي إلى مستعمرات سابقة لا تكتفي بالسعي إلى محاربة التمييز، ولكن للحصول أيضاً على حقوق تتعلق بالقدرة على الاعتراض على تشريعات لا تخدم مصالحها، والشيء نفسه يحدث في أمريكا مع الأقليات العرقية التي تطمح إلى إعادة كتابة التاريخ الوطني للأمة، وهناك حالات تستثمر فيها الأقليات نضالها من أجل رفض الاندماج في المجتمع، وتسعى إلى الحصول على أنظمة قانونية مستقلة.
ونتيجة لذلك، فقد انتقلت الأقليات في الحقبة المعاصرة من وضعية الإقصاء والإبادة، إلى وضعيات السيادة، من خلال تأسيس لوبيات، كما هو الحال عليه بالنسبة إلى الأقليات الدينية في أوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية.













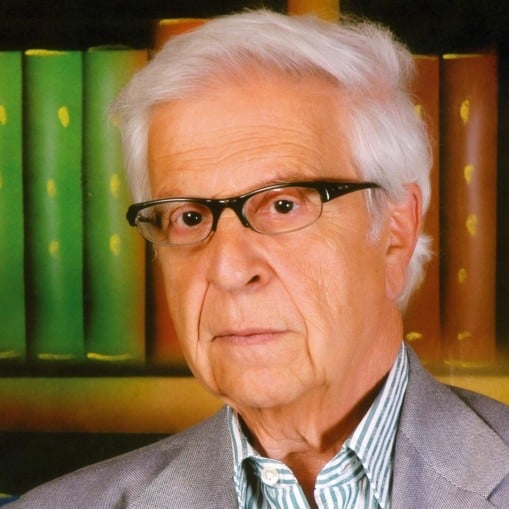


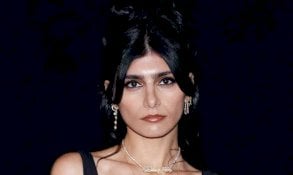
التعليقات