على كلّ شاعرٍ أن يشغّلَ الناقدَ الذي بداخله
الكتابةُ عن الشعر، في كلّ الأحوال، كتابةٌ شاقّة، ومسؤولة، وأمينة. فهي ليست تجديفاً أو مشاغبةً في لغةٍ مُشاعةٍ بقدر ما هي إعمالٌ في شاسعِ الخطابِ ومرجعياتهِ؛ وتتبع تنويعاته ومساراته وانعطافاتهِ وانحطاطه ونهوضه.. وما إلى ذلك من مآلاتٍ تحثّ القاريء على التطبّع بالبطءِ لرصدِ ما يطرأ. والمألوف أنّ الكتابةَ عن الشعر تتخذ غيرَ منهجٍ ومسلكٍ وبنية عند القراءة، ذلك أنّ الكتابة الشعرية بحدّ ذاتها تتفرّق بين الإشراق والغموض، ما يعني حياة النقد بين حدّي القبولِ والتأويلِ؛ بما تتسع له هذه الحياة من اهتمامٍ بالجمالِ أو السياقِ. كلٌّ لما يذهب له. هذا، يكونُ، لأنّ الكتابة عن الشعر هي إنّ انتبهنا جوابٌ على سؤالٍ، مثلما هي سؤالٌ على جوابٍ. لكنّ المؤكّدَ أنّ الكتابةَ عن الشعر كتابة شاقّة ومسؤولة أمام ندرة الجودة ، تفاقم التجريب والمحاولة، وبالتالي الإشكاليات. أو بصياغة أخرى: على كلّ شاعرٍ أن يشغّل الناقد الذي بداخله؛ لما في ذلك من مسؤولة لحوحة أمام غنى واتساعِ، أو ضعف وانغلاقِ الباعثِ، وفوضى الألوان، والتباسات الوصول، والخلط المربك بين يقين التجربة و ادعاءاتها لدى كاتبِ الأنا، المشيَّعة في فضاء المبعوثِ - النصّ. مرّة جديدةً، ثمة تجاه للكلامِ عن الشعر بمحفزاتٍ وبمطالباتٍ نابعة من حرصٍ أكيدٍ نربيه. ونابعةٍ، أيضا، من مطالباتِ الضرورة التي يسعى لحيازتها المَعْنِيُّ والشاعرُ؛ للحيولة دون بقاء الشاغرِ شاغراً في مقابل إطراد وتفاقم منتوج كتابة التجريبِ، وكتابة المحاولة. إذن، مطالبون، نحنُ، بالكلام عن تغيرّ موضوعاتِ واتجاهاتِ الكتابةِ ومدى اغتنائها بالفنّ، وقدرتها على انتاج الدلالات والمعاني. مُطالبونَ بالكلامِ عن ما للكتابة الجديدة، وما عليها من ملاحظاتٍ؛ على اعتبار أنّ "النقدَ كلامٌ على كلامٍ" كما جاء عند الجرجاني، واللسانيِّ لاحقاً.
***
إننا وباعتبارنا أحد شعراء الحركة الشبابية في غزة؛ نسعى جاهدين ما أمكن لنظلّ واحداً غير منفصلينَ عن الحركة، بل داخلين ومتصلينَ فيها ومتأثرين بحراكها؛ مدفوعين باهتمام جهة تناول جديدنا على المستوى الشعري. إننا أمام مطلبٍ ضروريٍّ؛ وهو تقديم خطاب نقدي يرافق الحركة الشعرية، وفي وسعنا الإطلاع على نتاجات متعددةٍ ومختلفةِ المستويات الشعرية لعددٍ من الشعراء الشباب، وهذا يعني التَحَرّك الحثيث في ميدان النقد، والسعى في الاتجاهاتِ الممكنة، من أجل خلق خطاب نقدي مترافق مع.. ومرافق لـ الشعرية المتدفقة في.. ومن واقع مؤلمٍ ناتجٍ عن ممارسات "الآخر". هذا الخطاب من شأنه أن يثير في المُراقبِ عدّةَ أسئلةٍ ضوئية؛ ستكشف وتحدّد وتشير إلى النواحي التصحيحة والاتجاهات التجديدية التي تتحقق بمعزل عن العادية السلبية التي تكرّستْ في داخل فلسطين على الأقل؛ والعاديةُ التي نُورِدُها، هنا، تَعني في أدقّ مَعانيها التكاثرَ والتفاقمَ النصوصي الهابط والاعلامي والأبوي، في مقابلِ الندرة وضعف المستوى النقدي. ونعني بالندرة الافتقار إلى خطاب نقدي صريح من شأنه، لو كان، أن يغرْبلُ ويُصَفّي ويُحدّدُ الهويّةَ الإبداعية الصادقة لمجموع الانتاجِ النصّي في الداخل. لا تتجه النيةُ لتلقين صَمتِ المشهدِ الأدبي الداخلي بعمومةِ وشخوصهِ وأمكنته وأزمنته درساً نقدياً يُعرّي قصورهم بحقهم وحقنا معاً، لكن كلّ ما نقصده هُو تقديم خطاب نقدي حيادي عبر تتبع جديد خطاب الحركة الشعرية الشبابية الراهنة في الداخل.
***
إنّ الذي يبعثُ على التفاؤل في هذه اللحظة الرديئة من عمر المشروع الوطني هو هذا الاحتفاء وهذه الإضاءة المنبعثة من راهن اللحظة المهمة من عمر المشروع الابداعي. لسْنا على رغبةٍ في تسيير الحديث بآلية عرْضٍ تاريخية؛ إنه لا يلزم في هذا الآن تقديم ببلوغرافيا بقدر ما يلزم توسيع عين الفحص والنقد من أجل التعرف على مسارِ الجديد الشعري، وذلك بالقراءة في عيّناتِ لحظة النصّ الغزي الراهن. هذه العيناتُ تعينُ على بناء موقف نقدي حريصٍ ومنتبهٍ للمفارقة الذكية: كلما اشتدّ هبوطُ السؤال الوطني، كلّما تعاظمَ نهوضُ السؤال الإبداعي؛ هذه العبارة ترجمةٌ إجرائية ملموسة للمفارقة الذكية التي تؤشّر على التحرّر بطريقة لافتة من إرث البيان الوطني الساخن؛ برغم تورّط المكان والزمان والمواطَنة في سؤال الهبوط الوطني. إن جديدَ هذه الانصرافات العملية التي تحُدثها عيناتُ الحركة الشعرية الشبابية الآن؛ كفيلةٌ بأن تُنْجِزَ لذاتها موقفاً تنظيرياً؛ إذا ما انتبه المعنيُّ قبل الدوجماطيقي لجدّة مسار ومؤشراتِ ومضامين واجتراحات الكتابة الشعرية في ظلّ هذا الراهن الوطني المهتوك.
السؤال إذن، لماذا لا يتحدّثُ الوطنُ بلسانٍ بلاغيّ جماهيري.. ونحنُ صِدقاً وواقع حالٍ الأشدّ تورّطاً، وانزعاجاً، من صلاة الشارع و اللسانِ الجهرية؟
شقّ مهمٌ، وبالغٌ اليقينِ من الإجابة ينهض على فقدانِ المصداقية والطمأنية جرّاءَ شُحّ المائدة السياسية ومرارةِ الإحراز السياسي؛ متمثلاً ذلك بصَكّ الغفران السياسي "الفالصو" -"أوسلو" على وجه الدقّة! الوجه الآخر لخطأ غزو الكويتِ؛ إذ الخطأن وجهان لحاجة واحدة أرادتها واحدية النظامِ العالمي الجديد بغية ترتيب المنطقة وصناعتها وإدارتها بما يتلاءم ومصالحها! مجرياتُ تلكَ الحاجة أبطلتْ صلاة الشارع واللسانِ الجهرية الأولى، أو كما نُقيّدُها في دفترِ النشاط الميداني بـ " بالانتفاضة الأولى 1987". شقّ آخر مترتّبٌ عن سابقه..بالغُ الانكسار، متصلٌ بمجريات الوقائع والأحداث القريبة، وهو: قيامُ صلاة الشارع الثانية الجهرية الدموية، أو كما نقيّدها في دفتر النشاط ذاته بـ"الانتفاضة الثانية سبتمبر/2000"، وما تتخلّله هذه الصلاةُ، (التي لم تتمكن للآن من تحقيق الغفران) من تدميرٍ وسلب للحياة ومكوناتها، وتعطّلٍ مباشرٍ لنشوء الدولة المأمولة، وفُرقةٍ جغرافية يُفرطُ في ممارستها الاحتلالُ؛ متزامناً هذا مع توسّعٍ أشمل وأعمّ لسؤال السقوط العربي جراء سقوط بغداد القريب. ما جعل ويجعل المنطقة بأسرها في تحوّلات لا تمنح (الغفرانَ المديد) لا السياسي ولا الميدانيّ للصلوات المعلنة جهاراً في وقتٍ شديد الحرج والبأس على كافّة الأصعدة الداخلية والدولية.
إن عافية الشارع في نشاطه الحالي تزدادُ سوءاً وتردّياً ملموساً من تقطّع صِلات المكانِ عن بعضه، وارتهانِ المواطن بسجنٍ جغرافيّ يصفه أحد شعراء غزة بـ"المتاهة الكافكاوية"(1)، الأمر الذي حَضّ الكتّابَ الجددَ على سلوك مسالك انتصارٍ أحرز اتجاهَ كتابة مضادة؛ تفصل كاتبها، وتبرّيءُ، ما استطاعت، فِعلَها وحضورَها من سطوةِ انعكاس المرآة الساخنة. لكنها تتشكّلُ من خلْطةٍ مُكثّفةٍ ومُعقّدةٍ من عناصر و علاقاتِ الإنسان بالمكان، ومن انعكاس الملموس، ومن تكاثر وتشعّبِ فرضيات وثبوتيات الموت، ومن انفصال الجسد الفيزيقي (المقترح)؛ في مقابل التمسّك بخيار اتجاه الكتابة المضادة، وتعزيز التواصل مع التجارب المحلّية المختلفة، وإغناءِ المشتركاتِ الشعرية البينية على صعيد التجريبِ في حقول الجمالية واللغة والنوعية؛ التي ساهمت في بذرها محلياً: مجلّة "عشتار"(2) عبر طرحها للمفاهيم والتوجهاتِ والضرورات الخاصة بقصيدة النثر والشعرية والذائقة، مترافقاً هذا مع اتجاه الأصوات للفضاء الالكتروني وشَغْلِ حيّز القطيعة بتواصل خلاقٍ مع لفيفٍ متنوعٍ من تجارب متعدّدة الجغرافيا والأجيال؛ وذلك للتخفيف من وطأةِ الانقطاع والتبدّد المحدقين بالجسد الفيزيقي(الجغرافي)، من جهة. ومتابعةً للاشراقات الأدبية العالمية عبرَ "اللازمة العصرية - الانترنت"، من جهة. والتحرّر من تعْويْقاتِ صرامةِ الحكمِ الدوجماطيقي الناجز سلفاً بحقّ المجرّبينِ الخارجين على الأنظمةِ والقوانين من جهة أخرى.
والحقّ، إنّ ما يخلقُ الحيرةَ والتيهَ، ها هنا، هو خُلوُّ الساحة المحلية من النقدِ؛ إلا من نوعين اثنين: النقد التأثري، والنقد الدوجماطيقي. وحتى هذان النوعان، إذا ما أمعنا النظرَ، شحيحا الكلامِ والحضور. ودعماً لذلك نُورد في هذا السياق اقتباساً من فصل مترجم للناقد الأمريكي "جويل إلياس سبينجارن" صاحب كتاب "النقد الجديد".. يقول فيه:"إنّ كلّ عصر يحوي نقداً مُذكّراً ونقداً أنثوياً..فالنقدُ المذكّرُ هو النقد الدوجماطيقي الذي يفرض معاييره على الأدب، والنقد الأنثوي هو النقد التأثري الذي يستجيب لإغراء الفن في نوع من النشوة.. وهكذا لا تفتأ المدرسة الدوجماطيقية تصوغ قواعدها في معايير جائرة ملؤها الاصطلاحات، ولا تفتأ المدرسة التأثرية تُضَللُ الأذواق في تيه المشاعر المتقلبة"(3) . و لـ"جوته" رأيٌ في هذا المضمار، حيث يرى أن: "ثمة نقد هدّام وآخر بناء أو خلاق، فالنقد الهدام هو ذلك النقد الذي يُقوّمُ الأدبَ ويتذوّقه بمعايير آلية، والنقدُ البنّاء هو ذلك الذي يحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما الذي كان الكاتبُ يريدُ التعبيرَ عنه؟ وإلى أيّ مدى أفلح في ذلك؟"(4) ولعلّنا نجد في معمار جسد النصّ المبعوث من عينات لحظة الكتابة الجديدة في قطاع غزة ما تريد أن تعبّر عنه هذه الثلة المسكونة بهاجس الشعرِ والكتابة، وتوْسِيعاً لمدى التكلّم عن جسد النصّ نقفُ على ملاحظةِ: أنّ لدى البعض الكثير ميلاً لكتابة مطّردةِ السطور، ومتصلة تغطي مساحة واسعة من حجم الصفحة البيضاء، مع اشتغالٍ على تقطيع وتفريقٍ أقلّ للنصوص. هذه الملاحظة على صلةٍ بما أوردناه، آنفاً، حول الكتابة المضادة للجسد الجغرافي المجزّأ. لكنْ لا يغيبُ عنا، أيضاً، أن نُرجعَ جزءاً، أساسياً، من مَيْلِ الكتّاب، لتغطية المساحة البيضاء، إلى انتمائهم وهوسهم بمقترحات رائجة حول كتابة ما يسمّى بـ"النصّ المفتوح"، ومن جانبٍ أقرب احتذاؤهم بأصواتٍ محلّية لها حضورُها المتّسع المرموق على مستوى كتابة قصيدة النثر. وهو ما يعني احتماء أو مكوثَ البعضِ الكثير الحكائي في مناطق كتابة غير فردية ليست من منظور شكلي وحسب؛ بل، أيضاً، من منظور جوهري له صلة قوية باللغة، ومستويات التركيب النحوي، وبـ ادخال المسرح الملحوظ في حركة النصّ. وربما يُعزى إدخالُ عناصر المسرح في النصّ إلى القراءة المشتركة لما يدور في الواقع وما يتابعه الشعراء بمختلف أطيافهم على اعتبار أن الواقعَ مسرحية متصلة المشاهدِ، محلياً وموسوعياً.
على أية حالٍ، فإنّ السمة المشتركة لهذه النصوص التي يقدمها الشعراء الجدد تتمثل في الحضور الطاغي للجسد كمتحرّكٍ لَدُنيّ في جهة الماضي الخاصّ، وكمحفّز يطلّ من مبعدةٍ فيزيقية أو تخيليّة، يدفع لكتابة الرغبةِ وأفعال الوصولِ الحلمي الناجز في حركة ماضٍ يكرسّه الكتاب في النصوص بشكل ملفت، في ظلّ الانفصال الفيزيقي الحقيقي المردوم بكتابة من الذاكرة والمتخيلة والأحلام.
انقر على ما يهمك:
عالم الأدب
الفن السابع
المسرح
شعر
قص
ملف قصيدة النثر
مكتبة إيلاف




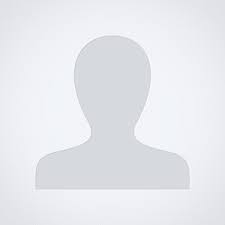
التعليقات