يوسف بزي
إنه الخوف. الخوف من تعاظم الشبه بين ما يحدث الآن وما حدث في الفترة الممتدة بين عام 1969 (اتفاق القاهرة) وعام 1973 (صدامات الجيش والفلسطينيين). شبه يكاد يكون كابوسياً، ولا طاقة للبنانيين على تصوّره، وربما ليست لهم القدرة على رده أو تغييره.
في تلك الحقبة، التي وصفها ببراعة وضاح شرارة quot;خروج الأهل على الدولةquot;، انتهت السجالات السياسية والاعلامية والتظاهرات، السلمية منها أو المشاغبة، بين فريق quot;سيادة لبنان استقلالquot; وفريق quot;العروبة وقدسية سلاح المقاومةquot; (الفلسطينية آنذاك)، الى نتيجة واحدة هي أن لا قدرة ولا بمستطاع أحدهما القبول بمطالب الآخر الفعلية أو المضمرة. وبالتالي أصبح الاحتكام والرجوع الى quot;الجماهيرquot; والى السلاح والى الشارع ضرورة حتمية.
وأوجه الشبه كثيرة، تلك التي أفضت في ربيع عام 1975 الى اندلاع الحرب. فنحن إزاء جسم سياسي غير برلماني، quot;جماهيريquot; وحزبي يعارض لإسقاط الجمهورية. ونحن أيضاً إزاء معارضة ذات لون طائفي محدد، quot;مشاركةquot; في الحكم والبرلمان ولديها منظمة مسلحة خاصة وإقطاعية جغرافية وسكانية. ونحن إزاء قوة فلسطينية (وسورية) داخل لبنان وعلى حدوده. ونحن أمام خلاف عميق وجذري على تعريف المؤسسات والأجهزة وعملها ودور الجيش وquot;المقاومةquot; والسلاح، وموقع لبنان من السياسات العربية الكثيرة والدور الاسرائيلي، إلخ.
وهذا كله مدعاة الى بدء المنازعات وتنافسها. والمفزع في الأمر، ان الاشارة الأولى لبدء quot;الخروج على الدولةquot; في مطلع السبعينات كانت في قرار النظام السوري فتح حدوده الغربية الجنوبية أمام التسلل الفلسطيني المسلح وإقفال هذه الحدود بوجه الشاحنات اللبنانية وحركة التصدير والترانزيت. وهذا السيناريو ذاته تكرر حرفياً في الأشهر المنصرمة، بل ان التكتيك السياسي نفسه المتمثل عام 1973 باعتكاف رئيس الحكومة السني صائب صلام، بوصفه ممثل التيار الاسلامي ـ العروبي، عاد في الآونة الأخيرة متكرراً مع quot;الاعتكافquot; الشيعي، وفي الحالين كان السبب quot;سلاح المقاومةquot; (الفلسطينية ثم الحزب الله) والتشجيع الاقليمي (الفلسطيني والسوري) وطبعاً تحت شعار التوازن والصلاحيات وquot;المشاركةquot;.
أما الدولة التي تنيط بنفسها الحفاظ على النظام الديموقراطي البرلماني وبصون quot;الوحدة الوطنيةquot; والسلم الأهلي وتعتصم بالأصول الدستورية والحقوقية، فتجد نفسها مكبلة بهذه الشروط التي وضعتها لنفسها، في حين يسوغ الطرف المعارض الأهلي والحزبي أفعاله وقراراته بمنأى عن أي اشتراط دستوري أو حقوقي، طالما أنه يتكئ على إرادة عروبية وايديولوجية قومية واسلامية جامحة لا ترى في الدولة الوطنية وصلاحياتها إلا الادارة الفنية والاجراءات العادية، فتفعل أفعالها بلا أي وازع وتقرر سياسات لا حسيب عليها ولا رقيب، طالما أن لا مرجعية دستورية لها وطالما أن السياسة تصبح مبنية على التغلب، أو على استغلال تكبيل الدولة لنفسها بقيود النظام، وتحررها هي من الحدود الدستورية والوطنية. (فيقول البارحة السيد حسن نصرالله: quot;أصلاً لدي مشكلة مع خريطة سايكس ـ بيكوquot; وquot;هل تحرير فلسطين بات تهمة؟quot;) بل ويسع لحزب الله، وسلاحه، أن يكون مستفيداً من quot;شراكتهquot; في الدولة، من دون الالتزام بقيودها وأصولها، وأن يكون في الوقت ذاته مقيماً على سياسات محلية وخارجية مستقلة وخاصة به، بمعزل عن الدولة وعن بقية اللبنانيين في آن واحد.
ومن quot;فتح لاندquot; الى quot;الجنوب المقاومquot;، ومن تحرير فلسطين الى تحرير quot;منطقةquot; شبعا، تتلبس المنازعات السياسية اللغة نفسها والانقسامات ذاتها. فمن حرية العمل الفدائي آنذاك، الى تغليب سلاح المقاومة على سيادة لبنان راهناً.
فبرنامج الاعتراض على الجمهورية ما زال هو عينه، أكان ذلك عام 1969 أو العام 1973 أو العام 2006: اتفاق الهدنة ساقط والسلام مع اسرائيل محرّم، وبالتالي من المستحيل منع اسرائيل عن العدوان ومن المستحيل قيام الجيش اللبناني بحرب خاسرة ومدمرة... إذاً، لتكن الأرض خارج مسؤولية الدولة وجزءاً من صراع أبدي تتكفله قوى مسلحة خاصة لا تبعة قانونية ولا سيادية على أعمالها.
ثم الحدود السورية، المتروكة لمشاعر الأخوة ووحدة المصير ولارادة العروبة التي تقدم الالتزام القومي وموجباته على وجود الدولة quot;الانفصاليةquot;.
ثم السلاح الفلسطيني الذي بحسب أهدافه المتخيلة quot;العودةquot; (أي تحرير فلسطين) فيبقى، بسبب قدسية هذه الأهداف، أقوى من شرعية سيادة الدولة، أما ومترتبات إدارة هذا السلاح التي تناط بالرعاية الاقلييمية، فلا احتجاج عليها ولا مانع لها حتى ولو باتت جزءاً شريكاً في تقرير السياسات الداخلية وطرفاً في النزاعات الأهلية وquot;خزيناًquot; احتياطياً لقوى الاعتراض تهدد به وتستقوي به وتتوحد معه إذا لزم الأمر.
أيضاً تستعين قوى الاعتراض على الجمهورية، حين لا يكفيها التمثيل السياسي الدستوري والمؤسساتي، بـquot;الجماهيرquot;. وهذه الأخيرة، رغم ضعفها التمثيلي الاجتماعي، تصبح أعلى صوتاً وقراراً من شرعية النظام والبنى الدستورية. وخلف هذه quot;الجماهيرquot; تهديد مستمر بالخروج عن الميثاق والصيغة على شكل التهديد بالعددية وبالمرجعية العروبية الاسلامية التي تظل دوماً قائمة بوجه السلطة الوطنية، المنبثقة عن التمثيل الاجتماعي والمدني.
أما المتغير الوحيد الذيي يسجل فهو أن العصبية الجنبلاطية تحولت من مقولة اعتبار لبنان quot;فيدرالية طوائف ودكاناً على البحرquot; الى مقولة اعتبار لبنان quot;وطناً نهائياً سيداً حراً مستقلاًquot;. وفي هذا التغير بعض الأمل بعودة الأهل الى الدولة، بعد خروج مديد قوض لبنان دولة ومجتمعاً زمناً طويلاً.









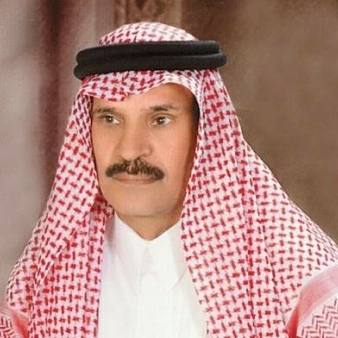





التعليقات