الجمعة 6 أبريل 2007
محمد السماك
على رغم أن إيران هي ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، فإنها تستورد أكثر من أربعين في المئة من حاجتها من المشتقات النفطية. والسبب في ذلك هو نقص كبير في مصافي التكرير. ويعني الاستيراد من الخارج ارتفاعاً في أسعار المحروقات وخاصة البنزين والمازوت، الأمر الذي يفوق القدرة الشرائية للمواطن الإيراني، ولذلك تدعم الدولة المشتقات النفطية بما يعادل 45 سنتاً أميركياً في كل ليتر. وهذا أعلى دعم في العالم توفره أي دولة لمواطنيها. لاشك في أن الدولة الإيرانية قادرة على تغطية هذا الدعم من خلال عائداتها النفطية، ولكن إلى متى؟ من أجل ذلك رصدت إيران مبلغ 15 مليار دولار لبناء مجموعة من محطات التكرير لتغطية حاجاتها المحلية. إلا أن قرار مجلس الأمن الدولي 1747 الذي يفرض عقوبات اقتصادية عليها، من شأنه أن يعطل أو على الأقل أن يؤخر بناء هذه المحطات. كما أن شركات النفط قد تعمد عملاً بهذا القرار إلى التوقف عن تصدير النفط المكرر إلى إيران، الأمر الذي يضاعف من مشاكل إيران الداخلية، بحيث يصح فيها قول الشاعر:
quot;كالعيس في البيداء يقتلها الظما... والماء فوق ظهورها محمولquot;!
وتحسباً لذلك تدرس الحكومة الإيرانية إجراءات تخفيض نسبة الدعم الذي تقدمه. وفي حساباتها أن هذا التخفيض لن يؤدي فقط إلى تخفيض التزاماتها المالية لدعم قطاع المحروقات، ولكنه سيؤدي إلى تخفيض الاستهلاك بنسبة 20 في المئة على الأقل. قد يبدو هذا الحل معقولاً ومفيداً في الاتجاهين. ولكنّ ثمة مخاوف من ارتدادات سلبية له.
من الارتدادات الاقتصادية أن تخفيض الدعم يعني ارتفاع أسعار المحروقات. وهو بدوره ما يعني زيادة التضخم. وهذا أمر غير شعبي على الإطلاق. ومن الارتدادات السياسية أن تخفيض الدعم يوجه طعنة مؤلمة إلى أحد أهم الشعارات الشعبية التي أوصلت الرئيس أحمدي نجاد إلى الرئاسة الإيرانية. وهو الشعار الذي يقول بوجوب توزيع العائدات النفطية على الشعب. وكان الدعم الذي توفره الدولة لأسعار المحروقات ترجمة عملية ولو جزئية لهذا الشعار. ولكن بدلاً من توسيع إطاره، قد تجد الدولة نفسها الآن مضطرة للارتداد عنه، الأمر الذي ينعكس سلباً على موقع الرئيس وحكومته.
ومن العجيب أن تتعرّض إيران للضغط بالسلاح الذي كان يمكن أن تستخدمه هي للضغط على الآخرين، وهو سلاح النفط. لقد لوّحت إيران باستعدادها في حال تعرّضها للعدوان لإقفال مضيق هرمز، الشريان الحيوي الأكبر لنفط الدول الخليجية. ومن أجل ذلك ترابط ثلاث حاملات طائرات (أميركيتان، وواحدة فرنسية) في مياه الخليج، إضافة إلى عدد من قطع الأسطولين الأميركي والبريطاني. ومن أجل ذلك أيضاً تبحث الدول الخليجية مشروعاً لمد خط جديد لأنابيب النفط يمر عبر سلطنة عمان ويصل مباشرة إلى بحر العرب، متجنبة مرور نفطها -ولو جزئياً- عبر المضيق المهدد بالإقفال. ومن الطبيعي ألا تنظر إيران بارتياح إلى هذا المشروع الجديد الذي قد ترى فيه محاولة للالتفاف عليها أو لتجريدها من أداة ضغط معاكس في مواجهة الضغوط التي تواجهها بسبب ملفها النووي. ولكن الدول العربية الخليجية تنظر إلى المشروع من زاوية أخرى. فهو يؤمّن استمرار ضخ نفطها -ولو بحده الأدنى- إلى الأسواق العالمية في حال نشوب أزمة تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز. ومع بقاء قضية الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) محتلة من طرف إيران، ومع تمسك دولة الإمارات العربية المتحدة بحقها الشرعي باسترجاع جزرها المحتلة، فإن دول مجلس التعاون التي أكدت مراراً على عروبة الجزر وعلى سيادة دولة الإمارات الشرعية عليها، لا تجد أي عامل مشجع لتأخير تنفيذ مشروع خط الأنابيب.
والواقع أن عدم الاطمئنان إلى إيران هو الذي فرض رسم خريطة جديدة لشبكة خطوط النفط والغاز من بحر قزوين ومن الدول المنتجة الأخرى في آسيا الوسطى. فمع أن الخط الذي يمر من هذه المناطق الجديدة المنتجة عبر إيران إلى الخليج هو الأقصر مسافة والأقل تكلفة والأسهل تنفيذاً، إلا أن شركات النفط والدول الغربية التي تقف وراءها عملت على مدّ خطين بتكلفة عالية لمجرد تجنّب المرور عبر إيران. الخط الأول يتجه غرباً نحو تركيا وعبرها إلى البحر المتوسط، أما الخط الثاني فيتجه جنوباً نحو أفغانستان وعبرها إلى المحيط الهندي. الخط الأول ينقل النفط إلى الدول الأوروبية، وينقل الخط الثاني النفط إلى دول جنوب شرق آسيا حتى اليابان. ولو تعاملت الدول وشركات النفط الغربية مع إيران بعكس ذلك، أي لو تعاملت معها كدولة مرور بكل ما يؤديه ذلك من مردود مالي ومعنوي وسياسي، لتبوّأت إيران كدولة منتجة وكدولة مرور معاً، موقعاً استراتيجياً في لعبة الأمم. ولربما وفّر لها ذلك دوراً إقليمياً ودولياً أكثر أهمية من الدور الذي تتطلع إليه من خلال ملفها النووي!
أما الآن، فان إيران تعاني من مشكلتين معاً نتيجة المقاطعة الدولية المفروضة عليها: المشكلة الأولى هي التوقف عن تزويدها بالمعدات التكنولوجية اللازمة التي تحتاج إليها للمضي قدماً في برنامج تخصيب اليورانيوم. أما المشكلة الثانية فهي افتقارها إلى عدد كافٍ من مصافي تكرير النفط الخام الذي تنتجه بما يكفي لسدّ حاجة أسواقها المحلية. أما كيف ستتمكن إيران من معالجة هاتين المشكلتين، أو أي منهما، وأي ثمن قد تضطر لتسديده، ولمن، ومتى؟ فإن ذلك كله يتوقف على القراءة الإيرانية للمتغيرات المستجدة على المعادلات السياسية الدولية.
أما أبرز هذه المتغيرات فهي: أولاً: على الصعيد العربي: لقد تفجّرت حروب أهلية في أربع من الدول العربية هي العراق والسودان وفلسطين والصومال. وهناك تخوّف من دفع -أو اندفاع لبنان نفسه أيضاً نحو هذه المأساة. ومع العجز العربي عن معالجة أي من هذه الفتن الداخلية يصبح الأمن القومي العربي في مهب الريح! ثانياً: على الصعيد الإقليمي: لقد تراجعت العلاقات العربية - الإيرانية (وحتى العلاقات السُّنية- الشيعية) بسبب الملف الإيراني النووي والتداعيات السياسية المرتبطة به. ولاشك في أن هذه التداعيات ستزداد حدة وخطورة عندما تصبح الدول العربية مضطرة -أو مختارة- للعمل بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار 1747 الذي ينص على فرض عقوبات على إيران. وهو أمر يعيد إلى الأذهان ما جرى مع ليبيا التي تعرّضت إلى عقوبات دولية التزمت بها ومارستها الدول العربية الأخرى لسنوات طويلة. ثالثاً: على الصعيد الدولي: أن الفشل الذريع الذي مُنيت به الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من خلال الكارثة الإنسانية والإسلامية والقومية والوطنية التي تسبّبت بوقوعها في العراق، أساء إلى سمعة الولايات المتحدة في العالمين العربي والإسلامي، وسحَبَ البقية الباقية من الصدقية في التعامل معها (إذا كانت بقيت هناك في الأساس صدقية). ويترافق هذا الأمر مع تحفّز الاتحاد الروسي للعودة إلى المنطقة التي كان يشكل لاعباً أساسياً فيها طوال العهد السوفييتي السابق. ولعل في الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس بوتين إلى المملكة العربية السعودية، وفي تصويت روسيا في مجلس الأمن الدولي إلى جانب قرار فرض عقوبات على إيران، ما يشير إلى طبيعة هذا الدور المتحفز.
من الواضح أن الولايات المتحدة تحاول الآن أن تستعيد بعض الثقة العربية من خلال التعامل بإيجابية (قد تكون مصطنعة وغير جدية) مع المبادرة العربية للتسوية السياسية في الشرق الأوسط التي أقرّتها القمة العربية في بيروت في عام 2002. ومما يؤكد على ذلك الموقف الإسرائيلي الجديد من هذه المبادرة، والذي انتقل من رفضها من حيث المبدأ، ومن تجاهلها كلياً طوال الأعوام الخمسة الماضية، إلى التحدث عن العوامل الايجابية والبنّاءة التي تتضمنها. لقد اكتشفت الولايات المتحدة أن المدخل العملي لتحقيق الانتصار أو على الأقل التقدم في الحرب على الإرهاب يتمثل في حل القضية الفلسطينية. ولعلها اكتشفت أيضاً -ولو متأخرة جداً- أن للعالم العربي وللعالم الإسلامي مصلحة أساسية في تحقيق هذا الانتصار، لما ألحقته الأعمال الإرهابية من أذى بصورة الإسلام، ومن ضرر بحقوق وبمصالح العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن الأسلوب الذي اعتمدته إدارة الرئيس بوش في شنّ حربها على الإرهاب لم يؤدِّ إلا إلى زيادة الأمر سوءاً، خاصة بعد احتلال أفغانستان والعراق.
وقد حالَ هذا الأمر دون قيام الدول العربية والإسلامية بدورها الأساسي والفعال في كبح جماح الإرهاب وأهله. بل إن هذا الأسلوب المدمر نقل ظاهرة الإرهاب إلى الدول العربية والإسلامية من إندونيسيا حتى المغرب مروراً بباكستان ومصر والسعودية وتركيا والجزائر. إن مبادرة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياستها الاحتلالية وفي عشوائية حربها على الإرهاب تفتح الباب واسعاً أمام متغيرات سياسية واسعة في المنطقة، وهو الأمر الذي يفترض أن تكون إيران مستعدة للتكيّف معه. غير أن هذا الأمر يبقى مجرد افتراض، طالما أن الرئيس أحمدي نجاد لا ينظر إلى هذه المتغيرات.. أو أنه يرفض أن يراها.







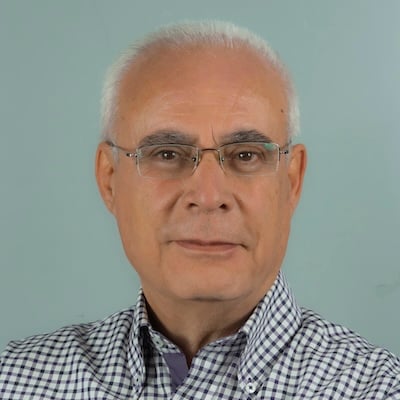


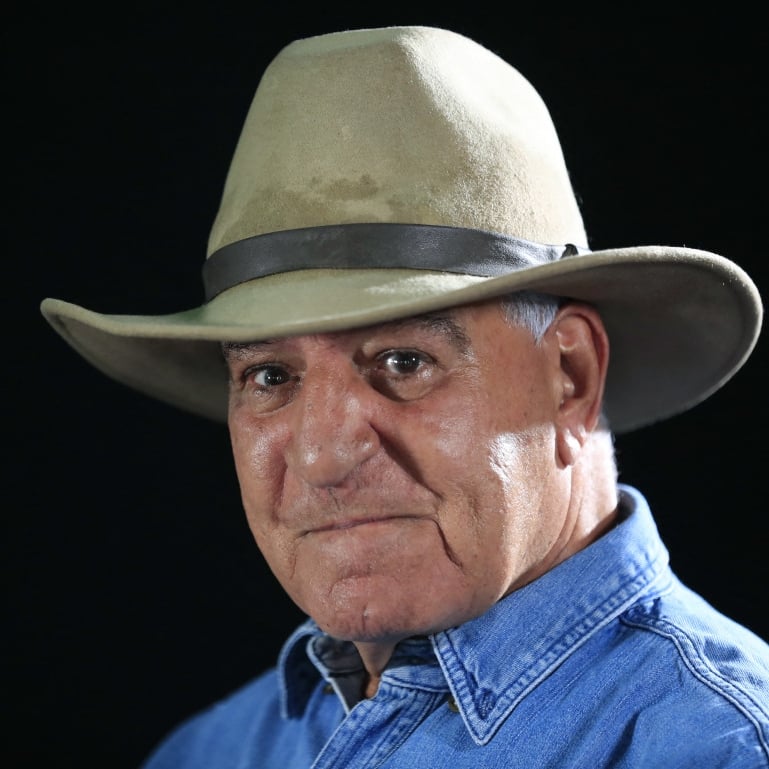
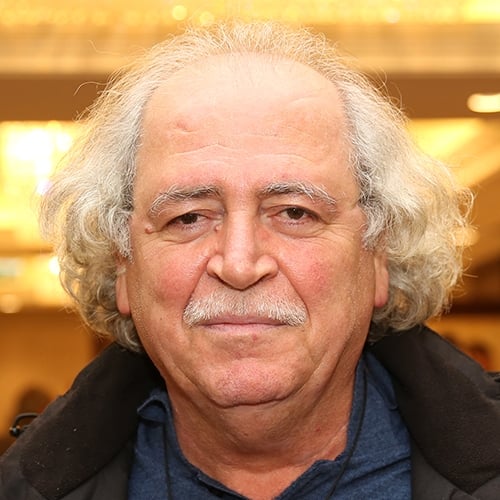

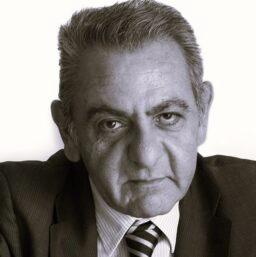
التعليقات