حازم صاغيّة
gt; يحظى الإضراب laquo;المطلبيّraquo; الأخير الذي شهده لبنان بدلالة تتجاوزه وتتعدّاه الى طريقة ذهنيّة سائدة لا تنقصها العراقة والجذور.
فالإضراب، كشكل تدخّليّ للتأثير في خريطة توزيع الثروة، وكضغط يُراد منه تزخيم مطلب ما وتعزيزه، يُفترض به وجود طرف آخر يناشده المضربون ويضغطون عليه آملين بدفعه الى التنازل والتراجع.
لكن الطرف المفترَض هذا مفترَض فحسب، أي أنه غير موجود. وهو ما لا يمكن أن يوجد ما دامت المؤسّسات الدستوريّة، رئاسةً وبرلماناً وحكومةً، معطّلة أو شبه معطّلة، فارغة أو شاغرة أو مقفلة أو معاقة. فكيف وأن البيئة السياسيّة التي يعبّر عنها المضربون، أو ينبثقون منها، هي إيّاها الحريصة على بقاء laquo;سلاح المقاومةraquo; في معزل عن تحرير الأرض واعتراف العالم به، والمتمسّكة دوماً بموقف راديكاليّ رافض حيال السلام مع الدولة العبريّة؟ أي أنها البيئة الحريصة على تجفيف الموارد التي يُراد توزيعها بدرجة من العدالة أعلى؟ ولا نأتي جديداً إذ نقول إن الحركات العمّاليّة في التاريخ الأوروبيّ هي أشدّ حركاته السياسيّة جنوحاً للسلام وإنهاء النزاعات وضبط توسّع الجيوش، إنفاقاً وثقافةً وواقعاً، لأن اهتمامها ينصبّ فعلاً على الطبقة العاملة ومصالحها.
في المقابل، فإن ما يجري عندنا ينطوي على شبهة كافية للظنّ بأن laquo;سياسةraquo; ما تتقنّع وتتلطّأ وراء المطلب الاقتصاديّ. فالمراد، في أوّل المطاف وآخره، إضعاف حكومة فؤاد السنيورة وتفعيل الثلث المعطّل من خارجها بعدما استحال ذلك، لأسباب معروفة، من داخلها. أما الاقتصاد، أو في الغد التعليم أو التربية أو الأشغال العامّة أو...، فلا أكثر من أدوات يتمّ توسّلها لبلوغ الغرض هذا. فالمهمّ تحطيم laquo;حكومة السنيورةraquo;، وبعد ذاك لكلّ حادث حديث.
لكن ما هو أبعد من ذلك، وهو ما يقف وراء ذلك، تجسّده طريقة في التفكير والسلوك تسبّق المعارضة، وجوداً ونشاطاً، على الدولة وسلطتها. فأنْ تعارض دولةً ممنوعةً من القيام، فهذا تكرار لمشهد سبق أن رأيناه من قبل مراراً. فقد كان هذا المبدأ، مثلاً لا حصراً، هو القائد والموجّه في الثمانينات حين استُنزفت laquo;دولة أمين الجميّلraquo;، في العاصمة والضاحية الجنوبيّة وجبل لبنان، من دون أن يوجد تصوّر واحد متبلور ومتماسك عن دولة بديل.
وعلى النحو هذا كرّت الانقلابات العسكريّة وتعاقبت، في الخمسينات والستينات، في دول عربيّة أخرى، لا سيّما منها سوريّة والعراق، كاشفةً عن الموقع الهزيل الذي تحتلّه الدولة وأفكار التنظيم الاجتماعيّ عموماً في أذهان laquo;نُخبناraquo; وفي سلوك جماعاتنا الأهليّة سواء بسواء.
بيد أن الانقلابات التي عبّرت عن تسبيق المعارضة على الدولة، انتهت الى انقلاب أخير أحلّ نظاماً استبداديّاً وطيداً وأنهى المعارضات من كلّ صنف. هذا ما رأيناه في بغداد عام 1968 الذي أعاد البعث الى سلطة لم يعرف، في 1963، كيف يتمسّك بها، في ما رأيناه، عام 1970، في دمشق، حين تولّت laquo;الحركة التصحيحيّةraquo; ضبط السلطة ومركزتها. أما في لبنان، حيث التنوّع الطائفيّ حائل دون الانقلاب العسكريّ، فعمل تسبيق المعارضة على الدولة لصالح إسقاط البلد كلّه ثمرة يانعة في حضن laquo;الراعي الإقليميّraquo;.
وقصارى القول إن المبدأ هذا، وهو بعيد عن السياسة بُعد الأرض عن السماء، مُفضٍ حتماً الى واحدة من بربريّتين: إما الاستبداد حيث يمكن الاستبداد، وإما الوصاية حيث يوجد laquo;وطنيّونraquo; غيورون يمهّدون الطرق للوصاية. وربّما كنّا اليوم نتاخم بربريّة ثالثة هي دمج للسابقتين، بحيث يبقى الوصيّ، وقد أُخرج جيشه، بعيداً، فيما تتولى عمليّاتِ النهش والتناهش قواه الداخليّة المسكونة بالاستبداد.












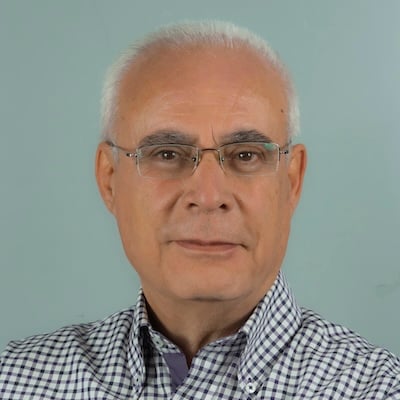

التعليقات