في الخطابات الدّينيّة المعاصرة(1/2)
إنّ معركة المشاركة السّياسيّة للمرأة العربيّة قديمة قدم مطالبة النّساء المصريّات بتخصيص مكان لهنّ في البرلمان المصريّ، وحصولهنّ كمستمعات على "مقصورة" في هذا البرلمان سنة 1925، ثمّ على مقصورتين. وهي معركة محتدمة متكرّرة، تكرّر محاولات النّساء الكويتيّات الحصول على موافقة مجلس الأمّة على حقّهنّ في التّصويت والتّرشّح، وقد وصلت هذه المحاولات فيما بين سنتي 1972و 1999 إلى عدد سبعة الخرافيّ، رغم أنّ الدّستور الكويتيّ ينصّ على المساواة بين النّساء والرّجال. وتدلّ نسب المشاركة في البلدان التي تتيح للمرأة بعض حقوقها السّياسيّة، على أنّ هذه المعركة متواصلة. فرغم ازدياد نسبة النّساء العاملات في البلدان العربيّة، وتضاعف نسب المتعلّمات، فإنّ مقياس تمكين المرأة المعتمد من قبل "برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ"، وهو حصيلة مؤشّرات متوسّط الدّخل للفرد، ونسبة النّساء في الوظائف المهنيّة، وحصّة النّساء في مقاعد البرلمان على التّوالي، "يكشف بوضوح أنّ البلدان العربيّة تعاني من نقص لافت للنّظر"، بحيث تأتي المنطقة العربيّة، رغم ثراء الكثير من بلدانها في المرتبة قبل الأخيرة بين مناطق العالم، ولم تقلّ عنها إلاّ إفريقيا جنوب الصّحراء. (1)وإذا قصرنا نظرنا على واحد من المؤشّرات التي تعكس بوضوح مشاركة المرأة في الحياة السّياسيّة هو نسبة تمثيل النّساء في البرلمنات العربيّة، وجدنا أنّ هذه النّسبة لا تتجاوز 5,7/ 100وهي أضعف نسبة تمثيل برلمانيّ للنّساء في العالم على الإطلاق (2). وقد ذكّرتني هذه النّسبة الضّئيلة بهذه المقصورة في البرلمان : بالرّكن الصّغير المخبوء المحتشم داخل الفضاء الواسع.
وغايتنا من هذا البحث هي النّظر في مكوّن من مكوّنات هذه الوضعيّة السّياسيّة للمرأة العربيّة، هو الخطاب الدّينيّ الذي تمّ إنتاجه عن أهليّة المرأة لهذه المشاركة. والخطاب ليس مجرّد قول يكشف أو يعبّر عن ممارسة، بل هو نفسه ممارسة وفعل في الواقع يسير وفق قواعد أو آليّات تخلق الموضوع وتضع الحدود والموانع والمعايير. فالسّلطة معطى أساسيّ في مفهوم الخطاب كما عمّقه ميشال فوكو : إنّ الخطاب "ليس فقط ما يترجم الصّراعات أو بنى الهيمنة، بل هو ما يُتصارع من أجله وما يتصارع به، وهو السّلطة التي يراد افتكاكها. (3) ولذلك فمن المهمّ اعتبار الخطاب الدّينيّ عن أهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة ممارسة خطابيّة سياسيّة تدخل في علاقات تفاعل مع الممارسات الأخرى وكثيرا ما تمثّل عائقا رمزيّا أو واقعيّا يحول دون هذه المشاركة، ومن هنا تتأتّى أهمّيّة دراستها وبيان آليّاتها، وبيان مناطق الصّمت والكبت ورفض التّفكير فيها.
ولكنّ أهميّة دراسة هذه الخطابات تتأتّى أيضا من الامتياز الخاصّ الذي تتمتّع به، خلافا للخطابات السّياسيّة الأخرى. إنّ الخطاب فعل وممارسة للسّلطة، إلاّ أنّ للخطاب الدّينيّ وضعيّة تلفّظ خاصّة تجعله أكثر قوّة وتسلّطا من الخطابات الأخرى : إنّه لا يستمدّ قوّته من قدرته الدّاخليّة على الإقناع فحسب بل من امتيازين :
-امتياز المتلفّظ بالخطاب عندما يكون من العلماء بالدّين الممثّلين لهيئة دينيّة، أو من شيوخ الإفتاء، أو من صنف الدّعاة الجدد الذين يلقون دروسا في الدّين من منابر الفضائيّات العربيّة، دون أن تكون لهم أحيانا صفات "الشّيوخ"، ودون أن يحدّ ذلك من قدرتهم على التّأثير في المتقبّلين من المؤمنين.
فهؤلاء المتلفّظون وإن كانوا بشرا يصيبون ويخطئون ويأوّلون، وتتنزّل دعواتهم في سياقات سياسيّة وتجاريّة لا علاقة لها بالدّين باعتباره تجربة روحيّة، فإنّ لهم سلطة رمزيّة يستمدّونها من وظيفتهم الخاصّة ومن إدارتهم على نحو من الأنحاء لشؤون المقدّس، ومن إنتاجهم لخطاب دينيّ ومن مراقبتهم للخطابات الأخرى التي تأتي لتنافس خطاباتهم. لا شكّ أن الفتاوى التي ينتجها هؤلاء المديرون للمقدّس اجتهادات شخصيّة غير ملزمة، بل هي متعارضة أحيانا مع القوانين المعمول بها في بلدانهم، إلاّ أنّ لهذه الاجتهادات والآراء قّوّة تأثير في مجتمعات تتّسم فيها الحياة السّياسيّة بالفقر وترتفع فيها نسبة الأمّيّة والأمّيّة السّياسيّة بحيث يعوّل النّاس على اجتهادات المفتين أكثر من تعويلهم على مداركهم العقليّة فيما يخصّ أبسط تفاصيل حياتهم اليوميّة بل وفيما يخصّ قضايا الشّأن العامّ.
-امتياز المرجعيّة التي يحيل إليها الخطاب، فالخطاب يكون أكثر تأثيرا في هذه المجتمعات إذا كانت حججه دينيّة أو تحيل إلى الدّين، أي إذا كانت تستند إلى القرآن والسّنّة وما أثر عن الصّحابة والتّابعين من "السّلف الصّالح".
فالحجّة الدّينيّة هي نوع من أنواع "حجج السّلطة" argument d'autoritéأي أنّها لا تستمدّ قوّة إقناعها من منطقها الخاصّ أو من تطابقها أو عدم تطابقها مع واقع ما، بل من موقع قائلها أو من المرجع المقدّس الذي أخذت منه وإليه تمّت إحالتها.
ونقصد بأهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة اعتبارها مساوية للرّجل مساواة تامّة في هذا المجال ومنحها الحقوق المترتّبة عن هذه المساواة التّامّة. ونقصد بالمشاركة السّياسيّة كلّ مظاهر الاهتمام بالشّأن العامّ كالانتخاب والتّرشّح وممارسة العمل الجمعيّاتيّ والنّقابيّ والتّعبير السّياسيّ بالتّظاهر في الأماكن العامّة والتّوقيع على العرائض والاعتراض على السّياسة المحلّيّة أو الإقليميّة أو الدّوليّة، ولكنّنا سنركّز بالخصوص على النّقطة الحسّاسة التي يحتد فيها التّوتّر بين مقرّرات الخطاب الدّينيّ والمطالب السّياسيّة النّسائيّة وهي تقلّد الوظائف التّسييريّة على مستوى السّلطتين التشّريعيّة والتّنفيذيّة. فالمشاركة السّياسيّة للمرأة تصبح إشكاليّة عندما تتعلٌّق بالزّعامة والرّئاسة.
فهناك منطقتان تحتدّ فيهما مقاومة مسار المساواة بين المرأة والرّجل، ومقاومة تيّار التّاريخ، هما الأحوال الشّخصيّة من ناحية وتقلّد المناصب التّسييريّة. يعود ذلك إلى أنّ في هذين المجالين بالذّات، لا في مجرّد الخروج للعمل أو للتّعلّم، يبرز بوضوح تقسيم الأدوار الجندريّة المكرّس باسم الشّريعة أو باسم "الخصوصيّات الثّقافيّة" أحيانا، أي تبرز بوضوح رئاسة الرّجل الذّكر، كما تبرز علاقة الانعكاس المرآتيّ بين الفضاءين الخاصّ والعامّ. رئاسة الرّجل في المجال البيتيّ مازالت مستمرّة تدعمها مجلاّت الأحوال الشّخصيّة وتذكر في أكثرها تطوّرا، أي في المجلّة التّونسيّة التي ما زالت تنصّ، رغم تطوّرها النّسبيّ، على أنّ "الأب هو رئيس العائلة". أّما رئاسة الرّجل في المجال العامّ فما زال لها أساس قانونيّ في بعض البلدان العربيّة. ولئن اضمحلّ هذا الأساس القانونيّ في أغلب البلدان الأخرى التي مكّنت النّساء من حقوقهنّ السّياسيّة، فإنّ ضعف النّسب المشار إليها يدلّ على أنّ القوانين والعقليّات لا تسير على نسق واحد، فكوكبة القيم والصّور المناهضة للمرأة ولمشاركتها في الحياة العامّة ما زالت فاعلة في سلوكنا المدنيّ وفي الخطابات التي ننتجها، وما زالت مؤثّرة عن وعي أو عن غير وعي في الممارسات الانتخابيّة والتّرشّحيّة للرّجال والنّساء على حدّ السّواء.
وسنقسّم دراستنا للخطاب الدّينيّ عن أهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة إلى ثلاثة أقسام : قسم ندرس فيه الحجج التي يقوم عليها هذا الخطاب، وقسم نخصّصه للقاع الأسطوريّ ولما نعتبره مكبوتا داخل هذا الخطاب، وقسم أخير نستشرف فيه ممكنات الانتقال من "ثقافة الفحولة" التي تكرّس دونيّة المرأة إلى ثقافة المواطنة.
1-الاستدلال الدّينيّ على أهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة
لا ندّعي في هذا البحث استقصاء ولا استيعابا لكلّ ما أنتج من خطابات دينيّة عن أهليّة المرأة، ولكنّ ما نلاحظه انطلاقا من العيّنات المتوفّرة لدينا هو غلبة الخطابات الدّينيّة التي تعترض على أهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة على الخطابات التي تحاول التّوفيق بين الاعتراض وعدم الاعتراض، أو تقف موقفا وسطا بين مرجعيّتين مختلفتين : مرجعيّة الفقه الإسلاميّ القديمة ومرجعيّة حقوق الإنسان الحديثة والمعاصرة.
أ-الخطاب الدّينيّ المعترض على أهليّة المرأة
قبل أن نعرض الحجج والآليّات الدّينيّة المقدّمة للاستدلال على عدم أهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة لا بدّ من النّظر في حجّة "عقليّة" تتردّد في هذا الخطاب وتتعلّق باعتبارات عن "طبيعة" المرأة واختلافها عن الرّجل.
أ1-الاعتبارات "الطّبيعيّة" أو عنف بناء الموضوع
إنّ المعطيات المتعلّقة بمفهوم غائم هو "طبيعة المرأة" تمثّل عنصرا قارّا في الفتاوى والآراء المنطلقة من مرجعيّة دينيّة، وهي تقوم بوظيفة دعم الحجج الدّينيّة ودعم أزليّتها، لأنّ عالم الطّبيعة يبدو عالما سرمديّا بمنأى عن التّحوّلات التّاريخيّة. يظهر الاستدلال على الحجج الدّينيّة بالحجّة الطّبيعيّة مثلا في إحدى فتاوى عبد العزيز بن باز رئيس هيئة البحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية سابقا. هذه الفتوى يبطل بها عمل المرأة عامّة وتولّيها المناصب العامّة خاصّة : "وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة لقوله صلى الله عليه وسلم : لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ..." (4)
وهذا الاتّكاء على حجّة "الطّبيعة" لم يكن يخلو منه الخطاب الدّينيّ القديم عن المرأة، فالقرطبيّ (ت1273م) صاحب كتاب "البيان في أحكام القرآن" مثلا يستدلّ على قوامة الرّجل على المرأة بمعطيات طبّيّة قديمة تقدّمها الثّقافة الفلسفيّة والطبّيّة السّائدة في ذلك العصر، وتتمثّل في نسبة الحرارة واليبوسة إلى الرّجل ونسبة الرّطوبة والبرودة إلى المرأة : يقول في شرح الآية 34 من سورة النّساء (5): "وقيل للرّجال زيادة قوّة في النّفس والطّبع ما ليس للنّساء، لأنّ طبع الرّجال غلب عليه الحرارة واليبوسة، فيكون فيه قوّة وشدّة، وطبع النّساء غلب عليه الرّطوبة والبرودة، فيكون فيه معنى اللّين والضّعف، فجعل لهم حقّ القيام عليهنّ بذلك، وبقوله تعالى : "وبما أنفقوا من أموالهم". (6)
فالنّساء حسب هذا التّصوّر القديم رجال ينقصهنّ العقل كما تنقصهنّ الحرارة الحيويّة التي تؤدّي إلى الاكتمال، وتدفع بالأعضاء التّناسليّة إلى الخارج.
إلاّ أنّ حجّة الطّبيعة لم تكن في رأينا مركزيّة لدى القدامى، لأنّ الأدوار الاجتماعيّة كانت واضحة لديهم ومبدأ قوامة الرّجل كان بديهيّا ومحلّ إجماع الفقهاء والمفسّرين. إنّما أصبحت هذه الحجّة هامّة ومركزيّة منذ أن تزعزع التّقسيم الاجتماعيّ التّقليديّ للأدوار وخرجت النّساء من خدورهنّ في مطلع القرن العشرين، وتأكّد فعل الخروج هذا في وعي الكثير من الرّجال والنّساء. وقد ظهرت كتابات السّلفيّين عن المرأة باعتبارها ردّة فعل على المخاطر التي يتعرّض إليها إليها الصّيغ العلائقيّة القديمة بسبب هذا الاختلال في تقسيم الأدوار (7). ونحن نرى أنّ ردّة الفعل هذه تستند إلى إيديولوجية جنسيّة اختلافيّة différentialiste تلحّ على الفوارق "الطّبيعيّة" بين النّساء والرّجال وتجتهد في إيجاد المعطيات الطّبيعيّة الجديدة والنّعوت الجديدة التي تميّز النّساء عن الرّجال، حتّى تبرّر تبعا لذلك بقاء الأدوار التّقليديّة والبنى العلائقيّة على حالها. ولعلّ ظهور تسمية "الجنس اللّطيف" مؤشّر على هذه الرّغبة الملحّة في إبراز الفوارق بين النّوعين الاجتماعيّين، وليس من الغريب أن تظهر هذه التّسمية في عنوان كتاب لأحد روّاد الفكر السّلفيّ، أقصد كتاب رشيد رضا الحامل عنوان "نداء إلى الجنس اللّطيف"، والمنشور سنة 1923.
وتؤدّي حجّة الطّبيعة في رأينا وظيفة أخرى خفيّة هي بناء موضوع الخطاب قبل الحديث عنه، وهي عمليّة تبقى غير مصرّح بها ويقدّمها صاحب الخطاب على أنّها من المسلّمات، أمّا مفكّك الخطاب فبإمكانه استخراجها على أنّها من "المفترضات" لا من المسلّمات. فاستخدام معطيات "بيولوجيّة" للاستدلال على وجود اختلاف جوهريّ بين المرأة والرّجل يفترض بناء لموضوع الخطاب على النّحو التّالي : النّساء والرّجال ليسوا كائنات اجتماعيّة تجمع بينها صيغ علائقيّة تاريخيّة ثقافيّة متحوّلة بالضّرورة، بل هي كائنات محدّدة سلفا وغير خاضعة للتّاريخ، والنّساء بالذّات لسن كائنات بشريّة متعدّدة الأبعاد بحيث تكون المرأة أمّا وزوجة وتكون كذلك امرأة عاملة أو غير ذلك، بل هي كائن محكوم بالبيولوجيا ومشدود إلى وظيفة الإنجاب وإدامة النّسل. وفي هذا الإقصاء للتّاريخ وللمصير ولتعدّد الأبعاد نجد آليّة أساسيّة من آليّات التّفكير الميتافيزيقيّ والمثاليّ ينقضها الفكر الحديث، وتنقضها خاصّة نظريّة "الجندر". فالجندر مقولة ثقافيّة وسياسيّة تختلف عن الجنس sex باعتباره معطى بيولوجيّا، وتعني الأدوار والاختلافات التي تقرّرها وتبنيها المجتمعات لكلّ من الرّجل والمرأة. فالبحث في الجندر يعوّض الماهويّة البيولوجيّة بالبنائيّة الثّقافيّة، بحيث يتبيّن لنا أنّ الاختلاف بين الرّجل والمرأة مبنيّ ثقافيا وإيديولوجيّا وليس نتيجة حتميّة بيولوجيّة.
والاتّكاء على مفهوم "الطّبيعة" يمكّن أيضا من بناء الثّنائيّات التّقابليّة التي ترسّخ هذا التّصوّر الماهويّ وتعطيه صورا أخرى جديدة غير صور الحرارة واليبوسة والبرودة والرّطوبة. ترك السّلفيّون والسّلفيّون الجدد هذه الثّنائيّة العتيقة إلى ثنائيّات أخرى أكثر إقناعا لمتقبّليهم المعاصرين : فالمرأة "عاطفيّة" والرّجل عقلانيّ، والرّجل قويّ والمرأة ضعيفة، أو "لطيفة" أو "رقيقة".
إلاّ أنّ هذا التّجديد للثّنائيّات يبقي على ثنائيّة قديمة قدم الفلسفة اليونانيّة وتتمثّل في اعتبار المرأة سلبيّة والرّجل إيجابيّا، وهو تصوّر ينطلق من تمثّلات القدامى عن العمليّة الجنسيّة ومن ثنائيّة تفاضليّة هامّة في الفكر الفلسفيّ القديم هي ثنائيّة الصّورة والمادّة. فقد اعتبر أرسطو الذّكر مانحا للصّورة، أي صورة النّسل من خلال منيّه، واعتبر المرأة موفّرة للمادّة من خلال دم حيضها، بحيث أنّ الذّكر يقوم بالدّور الإيجابيّ النّشيط وتقوم المرأة بدور الوعاء السّلبيّ. وانتهى من هذا الاستدلال إلى أنّ "الذّكر ذكر بفضل قدرته الخاصّة، والأنثى بفصل عجزها الخاصّ". (8)
هذه الثّنائيّة التي لم يعد لها من مبرّر في البيولوجيا الحديثة، يحتفظ بها السّلفيّون ولكنّهم يبعثونها في صورة جديدة توهم بالتّطابق بين رؤيتهم للمرأة ومقرّرات العلم الحديث : يقول الشّعراوي مستفيدا من معطيات البيولوجية الحديثة، وفي الوقت نفسه مؤوّلا إيّاها حسب ما تقتضيه الإيديولوجية الجنسيّة الاختلافيّة المشار إليها : "إنّ المواقعة بين الرّجل والمرأة يقوم الرّجل فيها بدور إيجابيّ لأنّه يقذف الحيوان المنويّ مؤهّلا للإخصاب، وهو في هذه الحال يبذل جهدا كبيرا ويسفح طاقة هائلة لقاء قذف هذه المحتويات الحيويّة، ولكنّ دور المرأة سلبيّ لأنّ إفرازاتها أثناء الممارسة الجنسيّة لا تحمل عنصر الحياة في توّها إنّما المقصود من هذه الإفرازات تشحيم الذّكر (القضيب) حتّى يسهل الإيلاج وحتّى لا تصادفه أيّة صعوبة أثناء الإتيان. ولا يحدث الحمل إلاّ عندما يلتحم الحيوان المنويّ مع البويضة وليس كلّ اتّصال جنسيّ تنزل فيه بويضة أنثى، إنّما تنزل هذه البويضة كلّ شهر بصفة دوريّة منتظمة. لذلك فالرّجل دوره إيجابيّ والمرأة دورها سلبيّ أو أقلّ إيجابيّة." (9)
ومن البديهيّ أنّ سلبيّة المرأة هذه من الماقبليّات المتنافرة مع مقتضيات المشاركة السّياسيّة باعتبارها فعلا إيجابيّا في الواقع، ولذلك فهي ترد على نحو غير صريح في في الحجج الطّاعنة في أهليّة المرأة لهذا الفعل الإيجابيّ : فليست عاطفيّة المرأة وطبيعتها وضعفها إلاّ صورا من صور هذه السّلبيّة.
ففي هذه المعطيات "البيولوجيّة" أو شبه البيولوجيّة نجد آليّة تبرير إيديولوجيّ هي من أقدم الآليّات وأبسطها، وتتمثّل في تحويل نظام الهيمنة البشريّة الثّقافيّة إلى نظام طبيعيّ سرمديّ.
أ2-الانتقال من الطّبيعيّ إلى الإلهيّ :
يتمّ إنتاج الموضوع، موضوع المرأة إذن عبر الماقبليّات "الطّبيعيّة" بحيث تكون المرأة كائنا بشريّا من نوع خاصّ، ذي بيولوجيا خاصّة تحدّ من "استعداداته الفطريّة" وتبعا لذلك تحدّ من مجالات تصرّفه. ثمّ تأتي أثناء ذلك الحجج الدّينيّة "النّّقليّة" باعتبارها حجج سلطة. وهنا نجد آليّة تبرير أخرى مكمّلة للآليّة الأولى : يتمّ تحويل نظام الهيمنة البشريّة الثّقافيّة إلى نظام طبيعيّ سرمديّ، ولمزيد الإقناع، يتمّ تحويل النّظام الطّبيعيّ السّرمديّ إلى نظام إلهيّ سرمديّ هو الآخر ولا يجوز تغييره أو الطّعن في أسسه. فمن السّهل أن نغيّر النّعوت، وأن نسمّي هذا النّظام الطّبيعيّ "إلهيّا" لإضفاء طابع القداسة اللاّتاريخيّة على ما هو تاريخيّ، وتسمية خروج النّساء إلى الحقل العامّ خروجا على إرادة اللّه : فممّا صرّح به علي بالحاج زعيم جبهة الإنقاذ بالجزائر (الفيس) أنّ "وظيفة المرأة هي إنجاب المسلمين. إذا تخلّت عن هذا الدّور، فإنّها تخلّ بنظام الله، وتتسبّب في نضوب معين الإسلام." (10)
والحجّتان النّقليّتان المعتمدتان عادة في الطّعن على أهليّة المرأة هما الحديثان المواليان :
-"النّساء ناقصات عقل ودين"، وفي هذا الحديث تذكير بالماقبليّات الطّبيعيّة القديمة (نقص العقل) وقد كانت سائدة في التّصوّرات القديمة عن المرأة. ومن المهمّ التّذكير بأنّ إحدى روايات هذا الحديث ترد في كتاب الحيض من صحيح البخاريّ، أي في كتاب يبحث في تبعات هذه الخاصّيةّ البيولوجيّة للمرأة التي انطلق منها أرسطو لبناء تصوّراته عن الإنجاب وعن المنزلة الدّونيّة للمرأة : "... ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرّجل الحازم من إحداكنّ. قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللّه؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرّجل؟ قلن : بلى. قال : فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم؟ قلن : بلى. قال : فذلك من نقصان دينها." (11)
يتمّ الرّبط بين الحيض ونقصان قيام المرأة بالتّكاليف الدّينيّة كما يتمّ الرّبط بين "طبيعة المرأة" وعدم أهليّتها للمشاركة السّياسيّة في الفتاوى المعاصرة. حجّة الطّبيعة (الحيض، نقصان العقل، طبيعة المرأة) تأتي لتبرّر وضعا اجتماعيّا ثقافيّا (شهادة المرأة التي تعدّ نصف شهادة الرّجل، عدم أهليّتها لتقلّد الأدوار التّسييريّة) يتحوّل إلى وضع مجسّد للإرادة الإلهيّة والنّظام الإلهيّ.
وقد كان هذا الحديث من أهمّ الحجج التي أوردها السّلفيّون الأوائل في خطابهم عن أهليّة المرأة للمشاركة في الحياة العامّة. فبمجرّد أن أسّس حسن البنّا جـماعة "الإخوان المسلمين" سنة 1928 شنّ هجـوما على حركة تحرير المرأة، ودعا المرأة إلى القيام بأدوارها التّقلـيديّة : " فمهمّة المرأة زوجها وأولادها.. أمّا ما يريد دعاة التّفرنج وأصحاب الهوى من حقوق الانتخاب والاشتغال بالمحاماة، فنردّ عليهم بأنّ الرّجال وهم أكمل عقلا من النّساء لم يحسنوا أداء هذا الحقّ، فكيف بالنّساء، وهنّ ناقصات عقل ودين." (12)
-الحديث السّياسيّ الذي يتنبّأ بخيبة المجموعات السّياسيّة التي تنصّب امرأة لقيادتها : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ..." وهو حديث قامت عالمة الاجتماع المغربيّة فاطمة مرنسيّ بتحقيق تاريخيّ متأنّ وشاقّ لتبيّن ظروف وضعه وعلاقته بالفتنة الكبرى وبمعارضي عائشة في خروجها من حجابها إبّان وقعة الجمل. (13) ونحن نرى أنّ العوامل التّاريخيّة البنيويّة أهمّ من العوامل الظّرفيّة الأحداثيّة في ظهور مثل هذا الحديث، فمنع المرأة من تولّي مهامّ الإمامة والسّلطنة والخلافة من النّتائج الطّبيعيّة المنجرّة عن الصّيغ العلائقيّة الأبويّة التي يكرّسها مبدأ قوامة الرّجال على النّساء ومبدأ حجاب المرأة، بالمعنى المؤسّسيّ للحجاب : أي الفصل بين عالم خاصّ تلزمه المرأة ومجال عامّ يتحرّك فيه الرّجل.
أ3-آليّات الفقه :
نظرا إلى عدم ورود آية تمنع المرأة صراحة من المشاركة السّياسيّة ومن تولّي المناصب السّياسيّة، ونظرا إلى ظهور مهامّ ووظائف سياسيّة جديدة مختلفة عن الوظائف التّقليديّة التي نظر فيها الفقه القديم، أنتج المعترضون على أهليّة المرأة فتاوى جديدة تستند إلى آليّات فقهيّة تقليديّة وتفضي إلى التّحريم، تحريم الانتخاب والتّرشّح على المرأة. وتتمثّل هذه الآليّات في ما يلي :
- القياس المتمثّل في قياس المشاركة السّياسيّة على "الإمامة والولاية والتّزكية"، وهي مهامّ قديمة لم تعد موجودة في أغلبيّة البلدان العربيّة لأنّها مرتبطة بتركيبات اجتماعيّة سياسيّة قديمة. وهذه المهامّ يشترط فيها الفقهاء القدامى الذّكورة، بل الذّكورة المتحقّقة، لأنّ "الخنثى المشكل" (الخنثى الذي لا يتبيّن جنسه بعد بلوغه) ليس له الأهليّة للقيام بهذه المهامّ. فقد قاس بعض المنتمين إلى تيّار النّهضة بتونس التّرشّح إلى عضويّة مجلس الأمّة على الولاية العامّة، وقاس الانتخاب على التّزكية : "عضويّة مجلس الأمّة ولاية عامّة لما فيها من سنّ القوانين، ومحاسبة السّلطة التّنفيذيّة، وما إلى ذلك من المهامّ المعروفة للسّلطة التّشريعيّة." والانتخاب "مشورة تتعلّق بذات الشّخص من حيث عدالته. وهذا النّوع من المشورة يسمّيه الفقهاء التّزكية، وهي من مستلزمات أهليّة الشّهادة ونحوها من الولايات العامّة..." و"ليس كلّ من تجوز شهادته تجوز تزكيته كما يقول العتيبيّ وابن رشد من كبار المالكيّة، ولا ينبغي لأحد أن يزكّي رجلا إلاّ رجل، قد رافقه في الأخذ والعطاء وسافر معه ورافقه. يقول مالك في المدوّنة عن صدور التّزكية من النّساء : لا تجوز تزكية النّساء في وجه من الوجوه، لا فيما تجوز فيه شهادتان ولا في غير ذلك، ولا يجوز للنّساء أن يزكّين النّساء ولا الرّجال، وليس للنّساء من التّزكية قليل ولا كثير." ويقول إمام الحرمين : "إنّ ما نعلمه قطعا أنّ النّساء لا مدخل لهنّ في تخيّر الإمام وعقد الإمامة، والنّساء لازمات خدورهنّ، مفوّضات أمورهنّ إلى الرّجال القوّامين عليهنّ." (14)
وهؤلاء الفقهاء الجدد يجتهدون بطريقة أخرى ليسحبوا مبدإ القوامة، وهو يهمّ المجال البيتيّ أساسا ويرتبط بالإنفاق، على المجال العامّ : فالقوامة "... لاتكون إلاّ على العاجز أو القاصر أو الضّعيف. والمرأة ضعيفة عاجزة، لذلك كان للرّجل القوامة التّامّة في جميع الشّؤون العامّة. وخصّه المولى عزّ وجلّ بالنّبوّة والرّسالة والخلافة والجهاد والآذان والخطبة وما إلى ذلك، وفرض طاعته على المرأة، ولم يفرض طاعتها عليه. وقال صلعم : لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة." (15)
-سدّ الذّرائع، أي أنّ الأمر الذي يفضي إلى أمر محرّم يكون محرّما. وهذه هي الآليّة المعتمدة في الفتوى التي تحمل عنوان" عمل المرأة من أعظم وسائل الزنا" (16) للشيخ عبد العزيز بن باز وهي تشمل عمل المرأة عموما لا مشاركتها السّياسيّة. فعمل المرأة ذريعة تفضي إلى مقصد ممنوع هو الزّنا، فحكمه حكم الزّنا.
- الإجماع مع سدّ الذّرائع، مع الملاحظ أنّ الإجماع مفهوم غامض اختلف القدامى حوله القدامى : أبطله المعتزلة والخوارج، وذهب الحنفيّون إلى أنّه إجماع الأمّة الذي يشمل كلّ المؤمنين وذهب ابن حزم إلى أنّه إجماع صحابة الرّسول فحسب... (17) ويمكن اعتبار الإجماع على أيّة حال آليّة من آليّات تأبيد حكم وارد في القرآن أو السّنّة، فحجّيّة الإجماع تتأسّس على نصّ من القرآن أو السّنّة. نجد إشارة إلى هذا المصدر في التّشريع في فتوى محمّد علي قطب الموالية : "أجمع الفقهاء الأقدمون على أنّ المرأة لا تتولّى الإمامة الكبرى (الخلافة) لقول الرّسول : لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة، ولأنّ هذه الوظيفة تتطلّب الاختلاط بالرّجال والخلوة معهم، ومفاوضتهم، وهذا محرّم شرعا، ولأسباب تتعلّق بتكوين المرأة نفسيّا وجسديّا. وأمّا ما عدا ذلك من الوظائف، فالشّأن فيها مختلف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أنّ المرأة محظور عليها شرعا أن تكون قاضية لأنّ ذلك يتطلّب كمال الرّأي وهي ناقصة العقل." (18)
إنّ قياس المشاركة السّياسيّة على أشكال تولّي السّلطة القديمة ينبني على رفض للتّاريخ وللواقع، وعلى مغالطات تاريخيّة سنبيّنها، فمفهوم المشاركة السّياسيّة ذو مرجعيّة ديمقراطيّة مناقضة تماما للمرجعيّة الفقهيّة. واعتماد إجماع القدامى المفترض على حلول طرحت على مجتمعات تفصلنا عنها مئات السّنين هو كذلك رفض للواقع وللتّاريخ. أمّا سدّ الذّرائع فله في رأينا بنية رُهابيّة هوسيّة : كلّ ما تقوم به المرأة يمكن أن يؤوّل على أنّه مؤدّ إلى الزّنا، بما في ذلك النّظر، بما ذلك كلّ كلمة وكلّ حركة. وهنا تكمن منطقة كارثيّة تؤدّي بالإنسان إلى التّأثّم من كلّ شيء وتحريم كلّ شيء، هي التي نجدها مثلا في ممارسة الطّالبان إزاء المرأة والثٌّقافة والفنّ.
ب-الخطاب الدّينيّ التّوفيقيّ
هناك موقف توفيقيّ أوّل يمثّله يوسف القرضاويّ الذي يحظى بشعبيّة كبيرة وبحصص كثيرة في إحدى أهمّ الفضائيّات العربيّة، فقد أفتى بجواز دخول النّساء للمجلس النيابي معلّلا ذلك بأنّ عدد النّساء في المجلس النّيابيّ لا بدّ أن يظلّ محدودا، وأفتى بمنع وصولهنّ إلى الولاية العامّة على الرّجال، أي رئاسة الدّولة. (19) وهذا يعني أنّ هذا المجتهد يصرّ على اعتبار رئاسة الجمهوريّة خلافة أو إمامة ينسحب عليها مبدأ اشتراط الذّكورة، الذي عمل به الفقهاء والأصوليّون في كلّ ما يتعلّق بالولايات الخاصّة والعامّة. الوقوف في الوسط بين الرّفض والإباحة يدلّ على تردّد بين المرجعيّة الحديثة والمرجعيّة القديمة، ونتيجته هي الإبقاء على التّمييز بين المرأة والرّجل رغم الحدّ الكمّيّ من مجالات التّمييز. إنّه موقف يبقى معارضا لنظريّة حقوق الإنسان إلاّ أنّه يشعر بالحرج إزاءها، وإن كان ينكرها. فالذي يقفز على حبلين متباعدين يكون في الغالب عرضة إلى السّقوط القيميّ المتمثّل في إنكار مبدإ المساواة التّامّة بين الرّجال والنّساء، وفي المراوغات التي تهدف إلى البحث عن الحظوة لدى الجميع : لدى النّساء المطالبات بالكرامة والمساواة، ولدى المتحفّظين على اكتساح المرأة المجالات التي ظلّت طويلا حكرا على الرّجال.
وهناك موقف تجديديّ لا يكتفي بإباحة العمل السّياسيّ للمرأة، بل يعتبره "واجبا". فقد دعت هبة رؤوف عزت إلى اعتبار العمل السياسى للمرأة "واجباً شرعياً يدخل إما في فروض العين أو فروض الكفاية. فلا تنفك عنه المرأة بحال، فشأنها في ذلك شأن الرجل لاشتراكهما في التوحيد والعبودية والاستخلاف وخضوعهما للسنن" (20). وربّما تنزّل هذا الرّأي في ما أصبح يسمّى بـ"النّسويّة الإسلاميّة"، وهو اتّجاه في التّفكير ينتصر إلى المرأة انطلاقا من مرجعيّة دينيّة، وينبني على محاولة توفيق صامت وغير منظّر له بين هذه المرجعيّة ومرجعيّة حقوق الإنسان الحديثة. وهذا الموقف الذي يعتبر العمل السّياسيّ واجبا دينيّا وإن كان يخدم قضيّة المرأة فهو يبقى غير مقنع لأنّه يعتمد على الإنكار : إنكار الاختلاف بين الماضي والحاضر، ويستعمل مفاهيم الفقه دون أن يعتمد آليّات الفقه بصفة واضحة. إنّه يعتمد على آليّة إيجاد شرعيّة قديمة لوضعيّة جديدة، ويريد أن يطوّر أحكام الفقه، فيقع في شراك الفقه. فالمنظومة الفقهيّة، رغم كلّ الاختلافات بين المذاهب والآراء، منظومة منسجمة وكلّ متكامل، وهي قائمة على مراتبيّة اجتماعيّة واضحة، أي على "هرم اجتماعيّ أعلاه الرّجل وتليه المرأة، ثمّ العبد ثمّ الأمة ثمّ الطّفل والمجنون. (21)ولذلك تقع هذه المجتهدة تحت طائلة الفقه : إنّها تجتهد وتفتي، ومن شروط الاجتهاد والإفتاء "البلوغ والذّكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعا، والكتابة والحرّيّة والبصر على الأشهر، والنّطق وغلبة الذّكر والاجتهاد في الأحكام الشّرعيّة وفروعها". (22)
فهل يمكن أن يكون الفقه، وهو منظومة قائمة على التّمييز، منطلقا للمطالبة السّياسيّة بالمساواة؟ هل يمكن أن نقف على عتبة الفقه دون أن ننزلق في هوّته الجاذبة؟ قد تُطمئن هذه الحلول النّفوس الحائرة المتأثّمة، فتساعدها على عيش تديّنها والتّأقلم مع الواقع الجديد في الوقت نفسه، ولكنّنا لا نظنّ أنّ بإمكانها تحقيق نقلة نوعيّة داخل الإسلام، ولا نظنّ أنّها قادرة على إنتاج مشروع مجتمعيّ يطلق المجال أمام الأفراد ليستنبطوا أشكال عيش جديدة، وأشكال حرّيّات أخرى وإمكانيّات أخرى في تجسيد المنزلة البشريّة. ما يتّسع في جميع هذه المواقف والآراء هو الماضي الذي يلاذ به من الحاضر، أو يتّخذ ملهما، أو يتعلّل به لإيجاد شرعيّة للحاضر.
يتبع
-------------------------------------------------
1 -انظر تقرير التّنمية البشريّة العربيّة لعام 2002 الصّادر عن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، ص26.
2 -Union interparlementaire : Les femmes dans les parlements : moyennes mondiales et régionales au 23 Déccembre 2002.
3 - Foucault Michel : L'Ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p12 sqq.
4 - ابن باز عبد العزيز ، الفتاوى المنشورة في موقعه من شبكة الأنترنيت : www.ibnbaz.org.sa.
5 -"الرّجال قوّمون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعض وبما أنفقوا بأموالهم فالصّالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اللّه واللاّتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا إنّ اللّه كان عليّا كبيرا."
6 - القرطبيّ : الجامع لأحكام القرآن، بيروت، دار إحياء التّراث، 1985، القرطبيّ : 2/1430.
7-انظر تحليلا للنّموذج الأحاديّ البيولوجيّ القديم الذي يجعل المرأة رجلا ناقصا والنّموذج الثّنويّ الحديث الذي يلحّ على الاختلاف الجنسيّ في :
Ben Slama Raja : "Le plein-genre" in Masculin/Féminin (gender), Paris, Editions La Découverte, 2004,
8 -انظر : موللير أوكين سوزان : النّساء في الفكر السّياسيّ الغربيّ، ترجمة إمام عبد الفتّاح إمام، القاهرة، المجلس الأعلى للثٌّافة، ص 103.
9 -شعراوي الإمام محمّد متولّي: الفتاوى : كلّ ما يهمّ المسلم في حياته ويومه وغده، أعدّه وعلّق عليه د. السّيّد الجميلي، ج1 بيروت، دار العودة، 1987، 1/19.
10 -Saadi Noureddine : "La loi au féminin : entre l'universel et le spécifique", in Droits des femmes au Maghreb : l'universel et le spécifique, Rabat, Friedrich Ebert Stitfung-Association démocratique des femmes du Maroc, p20.
11 -البخاريّ : الصّحيح، القاهرة، إدارة الطّبعة المديريّة، د.ت، 1/137.
12 -البنّا حسن : حديث الثّلاثاء، سجّلها وأعدّها أحمد عيسى عاشور، مكتبة القرآن، ص370.
13 -Mernissi Fatima : Le Harem politique : le prophète et les femmes, Albin Michel, 1997, pp
14 -الشّيخ حسين عبد الرّحمان، الصّباح الأسبوعيّ، 19 أوت 1985، ص 11 ، نقلا عن :
لطيف شكري : الإسلاميّون والمرأة : مشروع الاضطهاد، تونس، بيرم للنّشر 1988، ط2، ص 104.
15 - علي حبورة/ جلال الدّين بن عصمان، المعرفة عدد 4 سنة 4 ص32، نقلا عن المرجع السّابق، ص ص 103-104.
16-الموقع المذكور على الأنترنيت.
17 -Encyclopédie de l'Islam, 2e éd., IV/1048-1051 (Idjma', M. Bernard).
18 -قطب محمّد علي : بيعة النّساء للنّبيّ ص، مكتبة القرآن، ص 95.
19 - الأيام، 16 أغسطس 2002. نقلا عن بحث سبيكة النّجّار في "المشاركة السّياسيّة للمرأة العربيّة"، منشورات المعهد العربيّ لحقوق الإنسان، تحت الطّبع.
20 - زكي ميلاد : تجديد التفكير الديني في مسألة المرأة، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2001، ص 56.
21 -الشّرفي عبد المجيد : الإسلام والحداثة، تونس، دار الجنوب، 1998، ص 155.
22 -الجزيريّ : كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، بيروت 1998، 1/39.
أستاذة بكلّيّة الآداب منّوبة، تونس.




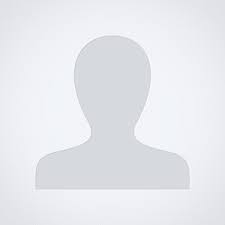
التعليقات