إن عالم القصة القصيرة يتشكل من مجموعة تجارب حسية و معارف إنسانية، يمتزج فيه الوعي و الخيال و اللغة. نستدل منه على زهرة ذابلة، لقاء حب، انهيار جسر، فاجعة موت، ابتسامة حزينة….. و نستنبط منه الفكرة التي تشدنا طويلا بأدوات مختلفة إلى أشياء مؤثرة، تؤثر فينا كمرآة لوجودنا في الزمن الذي نحياه، و الذي نقرأ عنه، الزمن يحددنا بإطاره القاسي أو الرقيق، و يغير مفاهيمنا للوجود، و يتفاعل معه الفكر متحديا أو منسجما، و كذلك يتفاعل معه القص ليتجسد الموقع الإنساني فيه، حيث يخضع لمتغيرات البيئة و المجتمع و السياسة، فيخلق ذلك الشعور الأعلى عند القاص، و ينعكس على نتاجه القصصي، و نظرته إلى كل ما يحيط به، فالقاص يستطيع أن يبني عالما في خياله أو يحطمه، إذ وحده يخضع للمؤثرات الموضوعية، تتراكم في ذهنه، و تتفجر في داخله أحاسيس ليصيغها في رؤيا محددة، و يبعثها إلى القارئ كنتاج تأمل أو تصور أو تداعي، و غالبا ما يكون القاص شاهد عيان للحدث أو جزء من الحدث أو أن ذلك حدث له بالذات، إذ أن هذا التشابك يتغلغل في فكر القاص، و يضطجع في ذاكرته، قد ينبعث في لحظات أو قد يتأجل لسنوات متراكمة، فينبعث بانعكاس انفعالي شرطي، إذ لابد أن ينبعث بلغة خاصة، فلا يوجد شئ غريب أن تلتقي أديبا مشهورا و قد أشيبت الدهور شعره، و أحنى الزمان ظهره أن يسهب في الحديث عن طفولته.
سأتطرق في هذه اللمحة إلى مرحلة الطفولة التي وردت في العديد من القصص القصيرة، و التي كتبت في المنفى كموضوع لوحدة التجانس، لأهمية الموضوع من جهة، و لطبيعة الترابط بين القاص و جذره الأصلي بمنهج معاينة النص ذاته، فالقارئ تجذبه القصة أو ينفر منها، يتعايش مع الكلمات، و المشاعر، و قد يقرأها بصوت مسموع، ثم يخاطب نفسه : ( هذا أنا ). ربما - أراد التعرف عما يجري في بقاع العالم، فيقرأ، و يتمتم ( هكذا يحدث هناك…هذا يشبه ما يحدث عندنا ) فينكفئ، و يقرأ من جديد، و ينضح عنده الألم الصادق، و يدرك تعاسة الإنسان، و اغترابه في مجتمعه، و في دائرة الكون التي ينتمي إليها، و تلاحقه مأساة الحروب و الجوع و الأمراض في عالم لا يستطيع أن يغير فيه شيئا،و تنضح عنده الخيبة، و المعرفة، و محاولات الشفاء من جروح الزمن الذي يؤذي أحاسيسه، و يواصل رحلته مع النص، و تتبدد عنده أشياء كثيرة، فيصبح ذهنه دائم التموج، مضطرب لا يهدأ، و لا يرتاح لحظة من اندفاعه، فيتشبه بمتسول في محطة قطار أو بائع سكاير، و هنا تغدو روحه شخصيات مختلفة تتوزع في أماكن مختلفة، و يظل يتقمص شخصيات القصة، لاسيما و تدمر مفاهيم تقليدية عنده، فينتمي تارة إلى المعقول و تارة أخرى إلى اللامعقول، و تبقى القصة تحفز ذهنه بإتقانها، و حبكتها المتينة، و أسلوبها الفعال، و لحظاتها المتقنة، و توغله في إيقاع رقيق، و تخضعه للمسات دقيقة بجودتها و أهميتها، و قد تخلق عنده حلما زاهيا أن يخفق بجناحين مثل طائر سماوي، فالقاص ذو القدرات اللامحدودة في عمق رؤيته للظواهر و الإنسان و الأشياء، التي يحدد موقفه منها، و هو يواجه أزمتها و مأزقها، منتهيا بخروج منطقي أو حل معقول للضياع و الغربة دون أن يفتعل حلا بائسا أو وهما ينخر في ذاكرة القارئ، ذلك يشد القارئ للكلمات، إذ ما ينفك يحذف في ذهنه، و يعدل، و يختصر، و قد يخلق لنفسه الإطار البهيج للنص، فيستجيب لقوة خفية تداعب روحه، و تحركها ليشغف بالنص شغفا سريا، و لتضفي شيئا جديدا لوجوده، و تجربته الحياتية - فكريا،سيكولوجيا _ خاصة إذا شعر أن ما يحدث ليس شيئا طارئا على الإطلاق، بل أن ما يحدث أقنعه بذات الوجود، و الإحساس، إذ أن القصة وحدة متجانسة بين القارئ و النص نفسه _ أنها كاملة في جمالها، تبعث على البهجة أحيانا، تبعث على الكآبة أحيانا أخرى _ فتصبح القصة بمضمونها و صيغتها مفهومة، قريبة إلى النفس حتى لو خرجت عن المألوف، حتى لو حملت في بينتها شيئا من الغموض أو لم تكشف عن كامل جسدها، فأبقى القاص جزءا منه خفيا يلوذ بمرونة التعبير، أي لا يبوح عن كامل مفاتنها، بل يلوح بها لتعمق العلاقة بين القارئ و النص، أما إذا كثرت الكلمات في القصة، و فاضت بالتكرار و الزيادة، فلا يبدي القارئ اهتماما، و يتململ، و تبدأ عيناه تجولان في أشياء الغرفة إذا كان يقرأ القصة في غرفته باعتبار أن الأشياء و الوجود أيضا وحدة متجانسة، فوحدة التجانس هي تآلف القارئ، و اندماجه مع النص من خلال خبرة المؤلف المعاشة و تجربته، ليدرك وجوده الإنساني، و يدرك ماهية الحدث و الظواهر و الأشياء في حقبة تاريخية، و انعكاسها عليه سلبا أو إيجابا.فقد كان مبدعي القصة و روادها المشهورين، حريصين على أن يحافظوا على وحدة التجانس، و ينقون القصة ذاتها من شوائبها، و إطالتها غير المجدية، و ترهلها، و يحافظوا على عنصر تركيبها، و إيقاعها، و يأججوا بؤرة التأثير و التركيز، و التناقض و الصراع في ذاكرة الإنسان، و وجوده، و هو يتوغل في المعنى المدرك الذي ترك انطباعا في أعماقه أو يبحث في شوارع ( دبلن ) عن الحوانيت التي ترك أصحابها الإرث الفني الخالد، و الانعكاس الجميل في ( دبليون ) لجيمس جويس، و كذلك تمكن تشيخوف بقدرته العجيبة أن يحافظ على وحدة التجانس هذه، و أن يدخل إلى روح القارئ ليضحكه أو يبكيه.
هنا بودي أن أستدرك شيئا مهما، هو أنني لا أستطيع أن أتطرق في هذه اللمحة إلا لبعض القصص التي في متناولي، حيث لم أحصل على آخر النتاجات لقصاصين عراقيين، لذلك اكتفي بالتطرق إلى أربع قصص قصيرة للزملاء إبراهيم أحمد، سلام إبراهيم، على عبد العال، محي الأشيقر، و سأعتمد المقارنة بين قصة إبراهيم أحمد و سلام إبراهيم، و أتناول قصة علي عبد العال و محي الأشيقر على انفراد، لنسهل عملية القراءة :
أولا : أن قصة ( انخطاف ) المنتقاة من كتاب ( التيه في أيس ) الصادرة عن دار المنفى عام 1999 شيدت على أساس الجمع بين الواقعية التاريخية و السائد في العادة الشرقية الموروثة اجتماعيا _ السلطة الأبوية _ لتترك آثارها النفسية على الصبي حليم، فيصاب بخيبة أمل، الذي ربما ظل يعاني من ألمها عمرا طويلا كلما تذكرها، إذ تنمو القصة، و تجعلنا ننتظر حدثا غريبا معينا، لابد أن يقع، و يسلب حليم البهجة، حيث تتصاعد التراجيديا بأخذ الخال الغزالة عنوة من البيت بالرغم من توسلات الجدة العجوز و الأم، و رغم تعلق حليم بها، و حبه لها بعد أن قضى أمتع أوقاته معها، و من يقرأ ( التيه في أيس ) يجد كما لو أن هناك تنبأ بحلول كارثة سوف تدمر البلاد من خلال تلك الشخصيات المتسلطة في العائلة و المجتمع التي رسم الكاتب لها خطوطا ذات مسار واضح، إذ ستعتمد عليها الدكتاتورية كشريحة اجتماعية _ اقتصادية مهيأة مسبقا في تثبيت أركانها و أجهزتها…لقد صاغ الكاتب قصته ضمن تجربته الإبداعية الطويلة في القصة، و تراكم معرفته في المعايشة، أراد لها التغير، و التجديد كأنه أراد أن يؤدي مسؤولية كبيرة إزاء واقع الإنسان العراقي الذي نشأ، و ترعرع، و هو يعاني من أزمة شاملة قاسية متوارثة ألا و هو الخضوع للسلطة المطلقة في البيت.
ثانيا : أن تتبعنا لتطور ( أزقة الروح ) المنتقاة من كتاب ( سرير الرمل ) الصادر من دار حوران عام 2000 للزميل سلام إبراهيم، تجعلنا في بادئ الأمر نتصور أنها قصة عادية مألوفة في الواقع الاجتماعي _ الاقتصادي لكن سرعان ما نكتشف أنها تتعرض إلى مصير تتصارع فيه الرغبة و الحاجة، حيث الأم تريد لأبنها أن يتعلم مهنة ليؤمن مستقبله في عالم يملأه التناقض، و الكفاح من أجل العيش، و الخال الذي يعمل عنده الابن ليس بحاجة إلى صبي حالم لا يتحمل خشونة العمل، و لا يطيق رائحة الخشب، لذلك يرغب فقط أن يهيم في شوارع المدينة ليمتلك حريته، و يحلق بخياله إلى عالم رحب،يضم حنانه و شوقه اللامحدود لمتعته، و انطلاقته كصبي، فهو لا يجد في نفوره الصارخ من قيده سوى تعلقه بالصبية بائعة الباقلاء، فيبحث عن شئ ليؤكد تعلقه بها، فلم ير في ذلك سوى أن يهديها وردة تلوذ بجيبه، ثم يكبر حلمه عندما يرمي الوردة إلى حضنها.أن هذه الصورة العذبة تثير حسنا و تعاطفنا مع العيون التي تلتقي بحرقة، و تزهو بالنظرات المتبادلة المقرونة بأمل مجهول في تصوير واقع يسمو فيه الصمت …و لكي يؤكد لنا القاص أن أجمل ما تتذكره هذه الشخصية ( الصبي ) بعد مرور ثلاثين عاما على الحدث هو أن تلوذ الوردة في جيبه، إذ يختم القصة قائلا : ( بعد ثلاثين عاما… ما زلت أنسل غفلة ممن حولي و في جيبي وردة ).
أوجه التشابه بين القصتين :
1-أن القصتين تدوران في مرحلة تاريخية واحدة بزمن متقارب، و هو منتصف الخمسينات، حيث الشارع العراقي يغلي و يضج بأحداث سياسية عارمة تمتد إلى الأربعينات، و حالة البلاد بائسة اقتصاديا، إذ الفقر و العوز و البطالة، و قد تجسد ذلك في القصتين بوصف جميل لبيوت الطين، فالشخصيات محرومة في وجود معذب و مهمل، أنها حقيقة أدركناها من القصتين، و هنا نجد أيضا الطموح المتلاشي تقريبا عند الصبيان.
2- يلاحظ أن هناك ميل واع جلي للكاتب العراقي في نبش الذاكرة ليستحضر أيام الصبا، و يستوحي منها الإحساس بالماضي كشيء يخص وجودنا الحاضر بعد أن أنهكتنا الدكتاتورية المقبورة بفواجع الحروب، و مآسيها، و بطشها بالشعب.هذا الاستحضار يتجلى بمراجعة التاريخ، و الاستدلال به للواقع المأساوي الذي تمر به البلاد.
3- أن البراءة عند الصبي إحساس جياش للانطلاق و اللعب و اللهو، و هو يفجر آمال الحب و التعلق بما هو جميل قريب إلى نفسه، لتزهو روحه، و ليندهش بأشياء لم تخطر على باله، و قد ورد ذلك في ( انخطاف )، ورد بتعبير مرن متناغم مع روح حليم، و لنقرأ مقطعا منها : ( و ينشده الصبي بالغزالة يتملى وجهها الجميل و يستغرق النظر معجبا بملامحها الدقيقة و يتلمس جسدها النحيف الرشيق و يمرر أصابعه على جلدها الناعم ذي اللون الذهبي )، و كذلك كما ورد في ( أزقة الروح ) من تعبير رشيق حسن، مستخدما الكاتب جمل قصيرة موحية ذات دلالة و رمز، و لنقرأ مقطعا منها : ( أيأس في صمت فأبدد قنوطي بالتيهان في برار المدينة.ألاحق عصافير برية تدور حولي، أجول بين سواقي الحقول، أجمع أعشاب الريحان و الخباز، و أسكن مسحورا السماء … ).
4- الخضوع للسلطة المطلقة ( السلطة الأبوية )، إذ يقف الصبي أمامها دون أن يستطيع أن يقاومها ، يقف مسلوب الإرادة لا قوة له تجاهها،و لا هناك أمل في تغيرها، و قد تجسدت تلك القوة بالخال، هذا نفس الشيء بالنسبة للمرأة التي تقف عاجزة، مهانة في أجواء هذه السلطة، كما ورد في قصة انخطاف : ( …فمال إليها صارخا و صفعها، إذ رأى حليم أمه تنكفئ باكية يهم بالهجوم على خاله لكنه يحس مرة أخرى انه متهدم و مشروخ مثل جدار بيتهم فيظل جامدا في مكانه …).
5- وحدة الترابط في القصتين تشدنا لنواجه الرحمة المعدومة، و لنواجه القسوة و السلطة الرهيبة التي تتحكم بالروح البريئة، فنظل نرى الأشياء مكشوفة، و نتعاطف كليا مع الصبي كأننا نرى الأحداث أمامنا، و نأمل بالخلاص من هذا التحكم الذي يسلب الإرادة الحرة للصبي.
أوجه الأختلاف :
أولا : أن قصة ( انخطاف ) أججت في نفوسنا عاطفة راقية تجاه حليم، ونبذ تام لتصرف الخال، فذبح الغزالة الذي صور لنا في بستان، و لم نعرف كيف تمت عملية الذبح، جعلنا نتألم لتلك الإرادة المسلوبة دون عون من أحد، و نتصور فاجعة وحشية، فهذا المشهد الذي لم نشاهده، جعلنا نتلوى، و نرى في خيالنا مصرع الغزالة، نراقب، و نعجز أن نقدم شيئا،رغم ذلك الأمل المتدفق عند الأم في نهاية القصة عندما يعود حليم إلى وضعه الطبيعي، و الأم تودعه بنظراتها البائسة ليذهب إلى المدرسة، و تقول : ( أية غزالة ينبغي أن تكون لك في هذه الدنيا ؟ ).
ثانيا : أما قصة ( أزقة الروح ) فلم تخرج عن إطار الإرادة المسلوبة التي حاد عنها الصبي، و انخلع جزئيا عن قانونها في التكوين، و يبدو أن الكاتب أرادها أن تكون ذلك، فترك الصبي الدكان، و وقف وحيدا ليصرخ في داخله : ( كنت مغتبطا لتحرري من القيد، و حزينا لأجل عيني أمي ).
نعود إلى السلطة الأبوية في المجتمع العراقي بكونها قاسية و حنونة إلى الحد الذي يجب على الطفل أن يحفظ قصيدة شعرية للبحتري أو المعري بالفترة الزمنية التي حددها الأب و إلا سيلاقي الابن التعنيف و الاستهزاء، و ربما الضرب بالعصا، و سيغضب الأب إذا لم يقبل الابن يد الأب في صباح مبكر من أول عيد رمضان و الحج، أنه سيغضب و لن يعطيه _ عيدية _ في الأعياد القادمة …و سلطة الأب حنونة إلى الحد الذي عنده يأسف الأب لبكاء ولده على ضياع _ دعبلة _ فيهب إلى الدكان المجاور لبيته ليشتري عشرة _ دعبلات _ لطفله كي يكف عن البكاء.
و هذه السلطة راسخة موروثة، راسخة منذ أن ترعرع أجدادنا في البادية، و ارتبطوا بغناء الحداء مع الإبل ، و صهيل الجياد، و قرقعة السيوف …و هي أيضا موروثة نمارسها جميعا، ليس لأننا معجبين بها، بل لأنها لا تفارقنا، و تشدنا إلى الماضي السحيق الذي نستمد مجدنا منه.
البعض يعتقد أن السلطة الأبوية داء البلاء في حياتنا كعراقيين إذ لا يمكن التخلي عنها بسبب عدم قدرتنا على فصلها عن روحنا، و الآخر يعتقد أنها أعطتنا الشجاعة و قوة التعلق بالأهل و العشيرة و الوطن لكونها موروثة من البادية، و تظهر انتمائنا القبلي الذي نفتخر به، أما أستاذنا المؤرخ و الباحث الاجتماعي الكبير علي الوردي، فقد قدم إلى العلوم الاجتماعية استدلال نظري عن أصل السلطة الأبوية الشرقية، و أسباب تأصلها فينا، و لماذا لا نستطيع التخلص منها.
هذا شأن يمس تاريخنا،و عاداتنا، و تقاليدنا،و معرفتنا التربوية، أما شأن الكاتب علي عبد العال في قصته ( موت بالزائدة الدودية ) المنشورة في مجموعة قصصية، عنوانها ( العنكبوت ) عام 1997 عن دار المنفى فيتناول مفهوم السلطة كظاهرة اجتماعية مر بها شخصيا، إلا أننا نجد أساسها في سمة الطبع، فيقدم لنا الكاتب تصويرا لشخصيتين، شخص مسلوب الإرادة _ الابن _ الذي يعلن تفوقه أثناء مرض والده بالزائدة الدودية، و شخص الأب صاحب السلطة المطلقة الذي يضعف،و يطلب العون من ابنه، فالكاتب لم يقدم عرضا متباينا فقط، و إنما يشير إلى الاحتدام الصارخ بين الشخصيتين، لعل الكاتب كان همه الوحيد أن يبين ذلك كغاية أساسية، و لتكون شخصية الأب في تأرجح تام ما بين القوة و الضعف، معتمدا بأسلوبه الممتع على _ المشهد الصوري _ السائد الآن في القصة الحديثة، مستدلا بذلك على أحاسيس، و بواعث هزته و هو في الخامسة عشرة من عمره التي أراد من خلالها أن يجذب القارئ ليعيش لحظات استثنائية، يفرح و يحزن، يتكلم مع نفسه بصوت مسموع أو خفي، فالحدث يهمه كما يهمه الخروج من الدائرة التي تطوق الجميع حتى ينتهي القارئ من القصة أشبه بخروج مشاهد من عرض مسرحي، يذهب، و يرجع في خياله إلى أيام الطفولة،يتذكر، و يسترجع الماضي، يتنهد، و يتابع عملية صراع بين أب و ابن كما أرادها الكاتب، لتتطور إلى موقف حاسم، ليس ليطيح الابن بأبيه في حلبة مصارعة، بل لينقذه من موت على وشك الوقوع، الذي أحسن القاص بلغته الرشيقة أن يبين بأن الجرأة الثابتة بإمكانها أن تحدث انعطاف و تغير في السلطة ذاتها، فالأب المصاب بالزائدة الدودية، و الراقد في مستشفى الجمهوري، يطلب جرعة ماء من ولده بعد إجراء العملية الجراحية، إلا أن إصرار الابن على عدم الاستجابة، ضعضع هذه السلطة بالرغم من أن الوصف اتسم بعاطفة جياشة من قبل الابن، و تميز بحنان متفرد ليفتت أي تناقض، و يتحد في مصير جديد، و هو الخوف من الموت و الفراق.لقد حاول الكاتب بهذا النمو التدريجي لانسيابية تتابع الحوار في غرفة صغيرة تحتوي على سريرين و نافذة و دلة ماء موضوعة على إفريز النافذة أن يؤجج مسألتين :
أولا : أن الأب مريض و المرض ضعف، كما ورد في النص، عندما يقول الأب : ( إنني ليس ضعيفا إلى هذا الحد ) ( لم يحن الوقت بعد كي تعاقبني، يا ولدي ).
ثانيا : أن السلطة يمكن أن تنهار في حالة الضعف، كما ورد في النص،عندما يقول الأب : ( هل أنت مصر على عدم إعطائي قليلا من الماء …لماذا تعذبني هكذا …؟ ألست أباك يا ولدي …هل أنت لا تحبني لأنني أضربك …؟ سوف لن أضربك بعد الآن …هيا ناولني الماء … ).
إلا أن السلطة الأبوية هي ممارسة و سلوك، و غالبا ما يتحملها الأبناء في المجتمعات الشرقية دون أن يفقدوا حبهم للأباء، و هذا ما تجسد في قصة ( موت بالزائدة الدودية )، فيما لو خضنا في عمق المفهوم ، و الذي يضعنا في شك بعودة السلطة في ظرفين كنتيجة منطقية لأي اضمحلال مؤقت :
الأول : بعد الشفاء من المرض ( مرحلة زمنية ).
الثاني : بعد الوصول إلى البيت ( المكان ).
أن القصة جعلتنا نرى مشهدا واقعيا، نستنبط منه فكرة واضحة، و نستدل أيضا إلى العوامل النفسية التي ضغطت على الكاتب كي يفرغ تراكم زمن بكلمات متناسقة، منسابة بدفء إلى الوعد الذي استحصله من أبيه، و هو يقول : ( سوف لن أضربك بعد الآن )، و كأنه يزرع أملا في روح الابن، و يضع زنبقة بيضاء في يده ، ليعيش جموحه، و يتحرر من خوفه، و اغترابه، و ينبعث من أعماقه عالم ملئ بالبراءة بطبيعته … لقد عرفنا كل شئ من القصة، و لم يحاول الكاتب أن يخفي علينا شيئا، و هذه ميزة _ المشهد الصوري _.
أما قصة محي الأشيقر ( ظل صغير ) المنشورة في مجموعته القصصية ( أصوات محذوفة )من دار فكرة للنشر و الطباعة عام 1994، ستأخذنا في مسار آخر ألا و هو الحدث، الذي ينتهي نهاية غريبة، فقد عالج القاص النواحي الفنية في قصة مكثفة، و حبكة مركبة، يتجلى فيها الموت، مرتبطا بلغة التراث الديني كمشهد ذهول يقودنا إلى العزاء، فالأشياء نقية سواء كانت حية _ العين _ أو جامدة _ الثياب _ و ربما كان الكاتب يرمز أيضا بهذه الأشياء إلى نقاوة الموت ليس كمصير فقط، و إنما حدوثه بصمت، و سرعة فائقة، فالقصة تتحدث عن طفل يرى سقوط أمه من أعلى إلى الحوش ( … قذفتها الريح، متدهورة من أعلى … )، هكذا يورد في القصة، و قد بلغت القصة مرادها بثالوث محدد _ صعود،هبوط، موت _ مما يعطي إيقاع محسوس للزمن، و تظل في غموض الزمن أيضا، إذ لم ندرك ذلك الانعكاس لنهاية الثالوث في عين مضيئة، كما أشارت القصة ( …لا أدري، سوى أن أمي مضطجعة بفسحة الحوش …)، و هذا الشكل من البنية صوب الموت كما في عين طفل كمساحة محايدة تقترب إلى رؤيا سريالية ببلاغتها في ذروة الصعود و الهبوط، و طور الموت الذي يحتظنه ظل، حيث يبدأ من القدمين اللذين يطوقهما خلخالان، و يمتد الظل في انسيابية الزمن برفق، و قد ورد بهذا التعبير (… و لكثافة الظل الذي راح يسيل برفق، برفق، برفق …)، ليلف كامل الجسد، و يحجبه عن أشعة الشمس، فهذه القصة تختلف عن القصص الثلاثة السابقة، إذ فيها المأساة و البراءة و الانعزال، إذ لم يكن في البيت سوى أم و طفلها، و قد تجرد المكان من أي صوت،و بقى الطفل جامدا أمام الموت، و حتى هذا الهبوط إلى الأرض لم يحدث أي صدى، فتبقى العين وحدها ترى، و تبقى الشاشة صامتة.
أن القصص بتنوعها امتازت بتمازج عناصر تركيبها و أسلوبها كوحدة فنية، لتعزز وطنيتها سواء كان ذلك في السلوك الإنساني لشخصيات القصص أو وصف المحيط، إذ أن أحداث القصص جرت في مدن متباعدة عن بعضها ( هيت، الديوانية،كربلاء )، و أعطت حيزا لبعض دلالات الطبيعة كمغزى مهم في القصة، و أن (انخطاف، أزقة الروح، موت بالزائدة الدودية ) جمعتها واقعية الخوف من السلطة الأبوية كحقيقة مدركة لأن كل شئ فيها واضح و مدرك بإحساس شامل للوجود، و لتؤكد القصص بان هناك أزمة محددة في المجتمع بتداعياتها و آلامها _ أزمة عذاب الطفل _ و لتقدم لنا رسالة لنبذ القسوة اتجاه الصغار، و لإزالة العذاب عنهم، و ليعيشوا حريتهم البريئة بحنان و حب، و ليفهم عالمهم الصغير.
( لم تكن عندي طفولة )، هكذا كان يردد تشيخوف بين زملائه الكتاب عندما كان يجري الحديث عن الطفولة، و هو الذي ترك أثره الكبير في الأدب العالمي، و ذات مرة زرت قبره في مقبرة العظماء في موسكو.كان قبره متواضعا بالنسبة إلى قبور الجنرالات و القادة السياسيين، فشاهده صخرة صغيرة، كتب عليها اسمه و تاريخ ميلاده و وفاته، إلا انه كان مغطى بالورود، التفتت زميلتي إلي، و قالت بصوت خافت : انه مات و هو لم يبلغ الخمسين من العمر، ثم صمتت برهة، تنهدت، وقالت بنبرة حزينة :كان مصابا بالسل في طفولته.هكذا فهمت لماذا لم تكن عنده طفولة، و لماذا أحب الأطفال، و حظي بصداقتهم .و كتب الكثير من القصص القصيرة عن معاناتهم بلغة شيقة تربطنا بوحدة التجانس، و تلبسنا الدهشة في طاقة إبداعية خلاقة يتفاعل معها القارئ، و يحقق متعته الجمالية الخالصة التي تضيف لوجوده عمقا و فهما يتجلى بانسجامه مع النص.




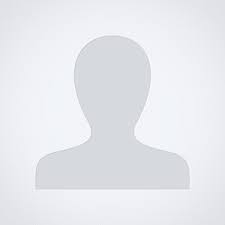
التعليقات