صراع الأقباط من أجل المساواة على مدى قرن (3/4)
تأليف: سناء حسن
عرض: نبيل عبد الملك
فى هذه المقالة نحاول عرض جزء هام من هذا الكتاب، وهو فى الواقع صلب موضوع البحث الميداني الذى قامت به الباحثة سناء حسن، وجاءت محتوياته تحت العناوين الرئيسية والفرعية التالية: (الجزء 2) حركة مدارس الأحد: ثوار وقديسون (الطبقة المتوسطة والإصلاح الكنسي)، الجذور والأغصان (نظير جيد فى مواجهة سعد عزيز)، الأباء المؤسسين المتحاربين (الأسقف شنوده، الأسقف صموئيل، الأب متى المسكين)؛ (الجزء 3) الكنيسة كمتحدث سياسي: التعامل مع الدولة المسلمة (البابا شنوده)؛ (الجزء 4) الكنيسة كمؤسسة إجتماعية إقتصادية: مركزة الإدارة الكنسية، حركة وبركة ( أرسانيوس الأسقف المثالي)، تجنيد أو إعداد الأساقفة؛ (الجزء 5) الكنيسة كعامل ثقافى: الثقافة والسيطرة (الإسلام هو الحل)، "المجيد والمقدس" (الأسقف موسى والمشاركة الإجتماعية للنشء)؛ (الجزء 6) سياسة الهوية: القومية الثقافية القبطية، الكنيسة كساحة قتال، الكنيسة كمدرج للدرس؛ (الجزء 7) ثلاثة أسئلة للقرن الحادى والعشرين : نحو كنيسة أكثر ديموقراطية؟، نحو دعم المرأة؟، الخاتمة: نحو أساس جديد للمساواة الوطنية؟
ثوار وقديسون: الطبقة المتوسطة والإصلاح الكنسي
تخبرنا الكاتبة عن الطبقة القبطية المتوسطة فى الثلاثنيات، والتى كانت قد تكونت من جموع الشباب الذين هاجروا من الصعيد (حيث كانت نسبة الأقباط تشكل 70% من تعدادهم العام فى مصر) إلى القاهرة والأسكندرية، منجذبين نحو فرص التعليم الحديث فى المدن. ولقد إنقسم التوجه الإجتماعى لأفراد هذه الطبقة نحو جماعتين، احداهما دينية، وهى الكنيسة والأخرى علمانية وهي حزب الوفد. ولقد لاحظ هؤلاء الشباب، وهم من أصول ريفية متدينة، مدى إحتقار قيادات حزب الوفد لرجال الدين، الأمر الذى سبب لهم صدمة كبيرة. ومع ذلك، فقد كان أسلوب الحياة الغربية، ومطالب الإصلاح التى طالب بها الوفديون، محل إعجاب هؤلاء الشباب، إذ توقعوا من وراءها التمتع بالمساواة، وخصوصا بسبب وجود بعض الأقباط بين قيادات الوفد.
وترصد الباحثة عملية الإصلاح الإداري الكنسي التى كان الصراع حولها محتدما بين رجال الدين والعلمانيين، وكانت قد بدأ أواخر القرن التاسع عشر، ونشأ عنه تكوين المجلس الملي والذى كان من أهم مهامه إدارة أوقاف الكنيسة للصرف منها على المؤسسات التعليمية والصحية والإجتماعية القبطية. وكان من أهم هذه المؤسسات جمعية التوفيق القبطية، التى سُميت على أسم الخديوى فى ذلك الوقت. ولم تقتصر جهود المجلس الملى على إنشاء المدارس والملاجئ والمستشفيات، بل شملت رفع مستوى تعليم الأكليروس، الذى لم يكن على المستوى اللائق بالعصر.
بمجئ الأربعينات، وبعد أن تخرجت جموع الشباب القبطي من الجامعات، ولم تجد لها أية فرصة للمساواة بزملائهم من المسلمين الذين تخرجوا معهم، كما لم تكن أمامهم أية فرصة للقيام بأي دور سياسي ذا أهمية، إضطرت الطبقة القبطية المتوسطة، الأكثر قربا من الكنيسة، والتى ورثت مكان الطبقة القبطية العليا من خريجي السربون وأكسفورد، أن تلعب دورها الإجتماعى، من خلال الكنيسة، بعيدا عن المجال السياسي.
فى تلك الفترة (1946 – 1954) كان الفساد قد دب فى إدارة الكنيسة، من خلال سكرتير البطريرك يوساب الثانى، المدعو ملك، الأمر الذى قوبل بالسخط والشكوى من عامة الأقباط، وبعض المطارنة، مما أدى إلى قيام مجموعة من الشباب القبطى من أعضاء جماعة الأمة القبطية بخطف البطريرك وإيداعه أحد الأديرة. على أن غالبية الأقباط لم توافق على إستخدام العنف كوسيلة للإصلاح، كما أن بعض قيادات مدارس الأحد لم توافق على أن يفرض المجلس الملى أية إصلاحات كنسية من من خارج المؤسسة الدينية ذاتها.
تقول سناء حسن لقد حدث الإصلاح الكنسى المنشود من خلال أعضاء من قيادات مدارس الأحد – من خريجي الجامعات - الذين دخلوا الأديرة، ثم صاروا أساقفة فيما بعد. وكان من أهم هؤلاء البابا شنوده، والأنبا صموئيل (أسقف الخدمات الإجتماعية الراحل) والأب/ متى المسكين. وكانت بداية هذه الحركة الإصلاحية الجديدة فى الستينات من القرن العشرين.
الجذور والأغصان
بالإضافة إلى فشل التجربة الليبرالية، ومن ثم عدم تمتع الأقباط بالمساواة مع المسلمين، وإعتبار ذلك عاملا لتوجه الأقباط إلى إحداث الإصلاح القبطي العام من خلال حركة مدارس الأحد، تضيف الباحثة سناء حسن عامل آخر، وهو التهديد الذى شكلته إرساليات التبشير الغربية (الكاثوليكية والبروستانتية) التى جاءت مصر فى نهاية القرن التاسع عشر. فقد نجحت تلك الإرساليات فى تحويل العديد من الأقباط إلى مذاهب كنائسها. الأمر الذى تصدى له علمانيون أقباط بإدخال الوعظ الدينى ودراسة الكتاب المقدس ضمن الخدمة الكنسية، وهى أمور كان الإكليروس الارثوذكسى غير مؤهل لها. وكان رائد ومؤسس حركة مدارس الأحد هو حبيب جرجس، الذى أصدر مجلة الكرمة، كما أصدر كتب وعظية أخرى. ثم صدرت بعدها، وفى عام 1947 مجلة مدارس الأحد، وكان أول رئيس تحرير لها هو نظير جيد (قداسة البابا شنودة الثالث).
وتسجل الكاتبة بداية نشئة مدارس الأحد فى أحياء شبرا، وجزيرة بدران، والجيزة والفجالة وكان من روادها الدكتو/ ميلاد حنا، والدكتور/ وليم سليمان قلادة، والدكتور/ مراد وهبة، والصيدلي يوسف إسكندر (الأب متى المسكين، فيما بعد) والمهندس/ يسى حنا، وسعد عزيز(الراهب مكارى السريانى، الأنبا صموئيل، أسقف الخدمات فيما بعد). وكان هناك تنوع فى إتجاهات هؤلاء الرواد، فمنهم من أهتم بإحياء التراث القبطي، وخصوصا ما يتعلق بتاريخ الكنيسة وقديسيها، ونهضة الرهبنة، بينما أهتم الآخر بالخدمة الإجتماعية، والعمل العام. كما تسجل الباحثة العمل المضنى والشاق الذى قام به هؤلاء الرواد وخدام القرى وخصوصا فى المناطق القريبة من محافظة الجيزة.
وتؤكد الباحثة على أن التنقيب فى تراث الكنيسة القبطية وإحياءه – فى إطارعصرى - جعل من حركة مدارس الأحد مؤسسة على مستوى مثيلتها فى الكنيسة البرتستانتية من جهة الرعاية المسيحية، كما أنها – وبما إحتوته من مادة غزيرة عن تاريخ وحياة قديسي الكنيسة القبطية – أكدت على الهوية المسيحية الأرثوذكسية فى مواجهة الرموزغير المسيحية السائدة. وفى النهاية، إن مدارس الأحد هي حركة كان الهدف الأساسى منها تغيير الناس، حسبما رأت الباحثة سناء حسن، من أجل الإصلاح الكنسى العام. وتنهى الباحثة هذا الفصل بعقد مقارنة بين نجاح هذه الحركة فى إحداث الإصلاح الكنسى المنشود وبين فشل حركة الضباط الأحرار فى تحديث الدولة بسبب تصور الضباط أن مجرد نقل العلوم الغربية، دون ثقافتها، كان كافيا لإحداث التغيير.
الأباء المؤسسين المتحاربين (الأسقف شنوده، الأسقف صموئيل، الأب/ متى المسكين)
تتناول الكاتبة، فى هذا الفصل، رؤية كل من هذه الشخصيات الرائدة فى الإحياء القبطي. وإن كانت هذه الرؤى متنوعه، إلا أن أصحابها جميعا كان لهم نفس الغيرة الملتهبة، والإصرار الصلب، إلى الحد الذى كثيرا ما أدى إلى العراك والضغينة فيما بينهم. كما تذكر وقوف "الحرس القديم" فى المجتمع القبطى فى طريق ترشيح أى من هذه الشخصيات الشابة لمنصب البطريرك بعد نياحة البابا يوساب الثانى، فى نهاية الخمسينات. وهكذا وقع الإختيار على الراهب الناسك مينا المتوحد، الذى كان معروفا لدى هؤلاء الشبان حتى قبل رهبنتهم. وعلى أساس هذه المعرفة والعلاقة القوية أوكل البابا الجديد، كيرلس السادس، لكل من هؤلاء الرهبان الغيورين منصبا كنسيا كان له أهميته فى حركة الإحياء القبطي المعاصرة.
وتخصص الكاتبة جزء هام من هذا الفصل حول العلاقة بين البابا كيرلس وأسقف التعليم الدينى، الأنبا شنودة ، "الواعظ النارى"، وكيف أن البابا أضطر لوقف إجتماعاته الوعظية الأسبوعية تحت ضغط من نظام عبد الناصر السلطوي. كما تتناول علاقة البابا بالأب متى المسكين، وإعفاء الأخير من منصب وكالة البطريركية بالأسكندرية. ويبدو أن توتر العلاقات بين البابا وبعض مساعديه كان بسبب إختلاف الرؤية والفجوة العمرية والثقافية بين الطرفين. إذ تسجل الباحثة إستمرار نشاط الأساقفة الجدد والأب متى المسكين، فى المجال الفكرى المسيحي والرعوى الذى قام به هؤلاء وغيرهم من الشباب الذى وهب حياته لخدمة الكنيسة ومجتمعه القبطي، وفى نفس الوقت تكريس النفس للعبادة والتأمل الروحي.
وتذكر الكاتبة ضمن هذه المجموعة آباء لهم بصمتهم الروحية والفكرية – التى ينبغى إلقاء الضوء عليها اليوم – حتى تستفيد منها أجيال اليوم والغد. ومن هؤلاء الأنبا بيمين، أسقف البلينا "المستنير" (كمال حبيب، قبل الرهبنة)، والأنبا صموئيل، أسقف الخدمات الإجتماعية، الذى كان له الريادة فى إنشاء وتنظيم الخدمة الإجتماعية فى الكنيسة القبطية فى مصر وفتح نوافذ الكنيسة القبطية على العالم الغربي وكنائسه من خلال مشاركته فى الحركة المسكونية، وتعريف العالم بالكنيسة القبطية. كما تذكر الكاتبة الأنبا أثناسيوس، مطران بنى سويف، ودوره الرعوى البارز فى المجالين الروحى والتنموى.
وتفرد الباحثة بعض الصفحات لما تعتبره صراع رؤى بين هذه الشخصيات، صراع بين التحديث والتركيز على العمل الإجتماعى (ويمثله الأنبا صموئيل)، من جانب ، وإحياء التراث القبطى مع دخول الكنيسة فى قضايا المجتمع والعالم (ويمثله الأنبا شنوده) وبينهما رؤية الأب متى المسكين الخاصة بالتكريس والعمل الروحي القبطي على مستوى البحث الأكاديمى الغربي.
وإن كان البعض يتفق مع الباحثة على وجود صراع رؤى بين هؤلاء الرواد، إلا اننى أرى أنه أمر طبيعى نابع من إختلاف شخصية الواحد منهم عن الآخر. وهو تنوع أفاد الكنيسة والمجتمع القبطى أكثر مما أضر بهما. أنه تنافس بين أقطاب، إن دل على شئ إنما على حيوية الروح التى دبت فى خلايا جسد الكنيسة التى إستعادت حياتها فى واقع الناس، ولتلبي إحتياجتهم المتنوعة.
الكنيسة كمتحدث سياسي: التعامل مع الدولة المسلمة
فى الفصل السابع من هذا الكتاب موضوع هذه السلسلة، تقول الكاتبة: "من الغريب أن يقوم نظام الرئيس عبد الناصر السلطوي، دون أن يدرى، بتدريب الكنيسة على القيام بدور سياسي، وذلك بعد أن أضعف الأرستوقراطية العلمانية القبطية، مثلما أضعف المؤسسات الليبرالية كالبرلمان المصري والمجلس الملي للأقباط، حيث لعبت هذه الطبقة دورا هاما. والملاحظ أنه حتى قبل أن يقضى على النظام الحزبي، كان عبد الناصر قد قوض قوة الأقباط السياسية، وذلك بتدمير قاعدتها الأقتصادية من خلال قانون الإصلاح الزراعي، الذى إستولت الدولة بموجبه على آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية التى إمتلكها الأقباط." (104)
وكما إستولت الدولة على كل ما زاد عن المئتين فدان من الأراضى المملوكة للأقباط، كذلك إستولت على الأراضي المملوكة للكنيسة، الأمر الذى قلص موارد المجلس الملى، بعد أن كانت سلطته ذاتها قد تقلصت بالغاء المحاكم الملية التابعة له.
قلت فى المقالة الأولى من هذه السلسلة، ان ما بدا للبعض انه عمل سياسي صدر عن الكنيسة، من حين لآخر، لم يكن كذلك؛ ولكنه - فى الواقع ومن منظور سياسي موضوعي، لم يكن أكثر من ردة فعل – صدرت من منطلق أدبى وإلتزام مسيحي - على أنتهاكات حقوقية تعرض لها الأقباط على مدى عقود، وخاصة منذ قيام ثورة 1952. ولا زلت أرى أن تقويض سلطة المجلس الملى فد أضعفت من لمشاركة الأقباط فى الحياة العامة ومنعهم من الإهتمام بشئون مجتمعهم القبطي.
و لقد ظهرت نتائج سياسة إضعاف الأقباط التى بدأها عبد الناصر، بعد ظهور الجماعات الإسلامية تحت حكم أنور السادات، الأمر الذى لم يتمكن المجلس الملى من مواجهته كما كان الحال قبل الثورة. كما أن الكنيسة لم تكن مؤهلة لمواجهة التحديات السياسية الكبرى التى واجهها الأقباط، وكان أن حاول قداسة البابا شنوده القيام بتلك المهمة الصعبة بمفرده. حقيقة، لقد أعلن المجمع المقدس الإحتجاج على أحداث طالت الأقباط بدءا من السبعينات وإستمرت بشكل حاد إلى أواخر الثمانينات، إلا أن الدولة لم تعر الأمر أي إهتمام، ولم تضع توصيات لجنة الدكتور/ العطيفى موضع التنفيذ لنزع فتيل العدوان المتواتر على الأقباط، فى غالبية محافظات مصر، وخاصة كلما شرعوا فى بناء أو إصلاح كنيسة.
ومن المواقف الهامة التى تسجلها سناء حسن لقداسة البابا ودفاعة عن حقوق الأقباط، دعوته لكل الأقباط للصيام لمدة خمسة أيام إحتجاجا على محاولة تقنين حد الردة فى أواخر السبعينات، وهو مشروع قانون ينص على إعدام المسيحي - الذي كان إضطر إلى دخول الإسلام - وأراد العودة إلى ديانته الأصلية لاحقاً.
إن الملابسات والظروف التى وضُع فيها الأقباط، وسياسة الدولة التمييزية ضدهم، بعد إستخدام كل وسائل التهميش السياسي والضغط الإقتصادى من قبل الدولة ضدهم، وخلو الساحة من أية زعامة قبطية علمانية مهمومة بأحوال الأقباط، كانت قد فرضت على البابا شنودة القيام بدوره "السياسي"، حاملاً هموم ومطالب الأقباط عنهم إلى الدولة.(ص111) ومما لاشك فيه أن شخصية البابا الكاريزمية وخبرته في الحياة قبل رهبنته، وثقافته الموسوعية وإيمانه بالعدالة وحقوق الإنسان، وقوة وصلابة إرادته وشجاعته، كانت كلها عوامل أهلته كشخص للقيام بهذا الدور، الذى أعتقد أن قداسته، لم يسع إليه إصلاً.
ويظهر من الأحاديث التى سجلتها الباحثة سناء حسن لبعض كبار الأقباط من الحرس القديم أن أحوال الأقباط لم تكن تعنيهم كثيرا، بل أن بعضهم إعتبر أن شكاوى الأقباط فيها كثير من المبالغة. وهذا ما جاء على لسان الدكتور/ بطرس غالى، على سبيل المثال، رداً على سؤال للباحثة، ومضيفا، قوله: "بدلا من صراخهم ونحيبهم، الأفضل أن يفعلوا شيئا لحل مشاكلهم. دعينى أقول لك: أن الأقباط ليس لديهم الدافع لذلك." هذا بالإضافة إلى من كال اللوم للأنبا شنودة على مواقفة، ومنهم فخرى عبد النور، وهو سليل أحد العائلات القبطية ذات التاريخ السياسي والإقتصادي. (ص 112)
وتسرد الباحثة تصاعد الأحداث على المستوى الوطنى، وتزايد السخط الشعبى والمعارضة السياسية ضد الرئيس السادات، وتزداد الحالة الإجتماعية إضطرابا إثر مذبحة الزاوية الحمراء التى راح ضحيتها أكثر من ثمانين قبطيا، تحت نظر رجال الشرطة، ورغم تحذير القيادات السياسية والإدارية المحلية، لينتهى حكم السادات بإغتياله فى السادس من أكتوبر عام 1981 بعد مرور شهر تقريبا على نفيه لقداسة البابا شنودة الثالث، وسجن أكثر من 1500 شخص من المعارضة بكل فصائلها والجماعات الإسلامية ورجال الكنيسة.
لقد كانت تلك الفترة من ذلك التاريخ وحتى عودة البابا شنودة الثالث من منفاه بوادى النطرون بعد حوالى أربعة سنوات من أحلك الفترات التى مرت على الكنيسة فى عصرها الحديث.
وتحت عنوان الكنيسة والدولة: التحالف الصعب فى عصر الرئيس مبارك، تقول سناء حسن أن تقييم العلاقة بين الكنيسة والدولة تحت حكم مبارك لا يبدأ بإستلامه السلطة عام 1981، إنما بإعادة البابا شنوده إلى كرسيه البطريركي عام 1985. وترى الباحثة أن العلاقة بين الكنيسة والدولة قد تحولت من المواجهة إلى الدبلوماسية. وتذكر الكاتبة إن عودة العلاقات بين الطرفين لم تأت من خلال وساطة أي من أقباط الحرس القديم الذى كان النظام قد قضى عليه منذ قيام ثورة 1952 إنما عادت عبر الإتصالات المباشرة بين البابا ومجموعة من الأساقفة المقربين والرئيس نفسه. وقد بدأت هذه العلاقات من خلال حفلات إفطار رمضان حيث دعي كبار رجال الدولة ورجال الدين الإسلامي العام تلو العام، وكذلك بإستقبال كبار رجال الدولة فى إحتفالات عيد المبلاد وعيد القيامة. وهكذا أصبحت الشكاوى االناتجة عن بعض الأمور تقدم بواسطة البابا إلى المختصين مباشرة، ونفس الأمر يتم فى المحافظات بين أسقف الإيبارشية والمسئولين بالمحافظة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد قام البابا بتكوين لجنة الوحدة الوطنية ضمت ثلاثة من أقرب الأساقفة اليه، وهم الأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا بولا، أسقف الغربية، والأنبا بيسنتى أسقف المعصرة، بغرض دعوة كبار المثقفين والمفكرين المسلمين لإجراء الحوار حول المشاكل القبطية أو المصاعب التى يواجهها الأقباط عند طلب بناء أو ترميم الكنائس، أو علاج حالات التمييز فى العمل.
بنيما يعزي البعض هذا التحول، من أسلوب المواجهة إلى الدبلوماسية في تعامل البابا شنوده مع الدولة، إلى الثمن الذى دفعه (أو الألم النفسى الذى تحمله) خلال فترة نفيه من كرسيه البابوى، يرى البعض الآخر أن هذا التحول يرجع إلى التغيير الجذري فى الظروف العامة التى واجهت فيها الدولة والكنيسة عدو مشترك. ويبدو أن الرأي الأخير أكثر منطقية، إذ لم يعد من الممكن تجاهل رئيس الدولة لمدى الخطر الذي أصبح نمو الجماعات الإسلامية يمثله على الإستقرار ونظام الدولة ذاته فى التسعينات من القرن العشرين.
تقول الكاتبة ان السادات دأب على إيجاد كبش فداء، عند كل حدث يلم بالأقباط على أيدى الجماعات الإسلامية، تهربا من الدخول فى مواجهة من تلك الجماعات. وهي سياسة لم تعد صالحة فى عهد مبارك، بعدما أدرك الرئيس خطورة تلك الجماعات على الحكم. ومع ذلك، و بالرغم من كل الجهود التى بذلها البابا شنوده مع الرئيس ووزير الداخلية ووزير التعليم، وما بذله الأساقفة مع محافظين ومدراء الأمن، لم تقدم الدولة إلا معسول الكلام حتى عام 1990 ، كما لم يهتم المسلمون بالوضع التعيس الذي يعيش فيه الأقباط، بل غالبا ما نظروا إليهم بإزدراء. (ص117)
على أن هذا الوضع سرعان ما بدأ يتغير، مع بداية عام 1991، عندما طال عدوان الجماعات الإسلامية بعض المواطنين المسلمين
فى المناطق المزدحمة من القاهرة فى أحياء إمبابة وبولاق الدكرور. تلى ذلك العدوان على رجال الشرطة، وأستمر بشكل متواتر حتى عام 1993، وهى الفترة التى تصاعد فيها الإعتداء على السياح. الأمر الذى خلق ما يشبه الرباط المتين بين الكنيسة والدولة.
من جانب آخر، ترى الباحثة سناء حسن، أن قوة البابا شنودة تتمثل فى صموده أمام عدو الكنيسة، الذى أسال دماء الأقباط فى أحداث وقعت ضد الأقباط فى المنيا، وديروط، وطما، والقوصية، ودير مواس، وأسيوط، ومناطق أخرى من مصر. فبإحتماله وتصرفه بحكمة وسط تلك الأزمات، رفع قيمة الشخصية القبطية، وأعاد لرعيته صور القداسة والإستشهاد التى كانوا قد سبق وقرأوا عنها فى قصص القديسين وسيّر آباء الكنيسة. (ص119)
أن قيادة البابا شنودة فى تلك الفترة، بوجه خاص، كانت لها آثار فى غاية الأهمية، ليست فقط بسبب مواقفه فى مواجهة السادات، التي ساعدت على ضمد جروح الذات القبطية بعد قهر قرون تحت الحكم الإسلامي، ولكن الأهم من ذلك، إن تدبيره شئون رعيته قد مكن شعبه من إستعادة حيويته، بعد أن كانوا أقلية مهدده.
الكاتب رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان
انقر على ما يهمك:
عالم الأدب
الفن السابع
المسرح
شعر
قص
ملف قصيدة النثر
مكتبة إيلاف




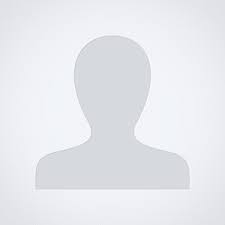
التعليقات