حازم كمال الدين عن عن تجربته في العراق (1-2)
بعد أكثر من 25 سنة قضيتها في جحيم المنفى حصلت على هبة العودة إلى وطني لأشارك زملائي هموم اعادة بناء ما خلفه الديكتاتور من خراب. الفنانون المسرحيون يتمتعون بدفء لا يوصف. تراهم أو بالاحرى هم يروك فيقبلون عليك وأنت تنظر أو تستغرق بالخجل لأنك لا تكاد تتعرف على وجوه الذين يهتفون لك، أولئك الذين تركتهم شبابا وعدت فوجدتهم..... لقد تعرفت على محمود شنيشل بعد أن كاد (يبلّع لي مثل أيام زمان). فجأة انبثق ذلك الضوء اللامع من عينينه القديمتين فتذكرت صديق العمر الذي لم يبق منه سوى غابة شيب يحملها فوق رأسه، وخنادق محفورة في وجهه. وكأن وجهه هو ساحة الحرب التي عاث بها المحاربون! ومن خلل تلك الخنادق تنفتح أبواب الضحكة القديمة والمزاح الحميم.... وكأننا لم نفترق.
الكل يريد أن يأخذك بالاحضان، بيد أن البعض لا يعرف كيف سيكون استقبالك له!! هل ستصده مثلا؟ ثمة تصور عنا نحن الذين عشنا الجحيم البارد (جحيم المنفى) بأننا ننظر باتهام وتعالي إلى زملائنا الذين قضوا حياتهم في الجحيم اللاهب (جحيم صدام حسين). ولكن سرعان ما تتبدد الوساوس من الطرفين. ها نحن نقف مع بعض من جديد. تحيات من شفيق المهدي دفء من هيثم عبد الرزاق، صفعات حبيبة من نزار الناصري، ونظرات احترام من زملاء لم يسمح لنا صدام حسين بالتعرف عليهم قبل ذلك اليوم. زملاء ترعرعوا في غيابنا وقد أشادوا ما أشادوا.
 صحيح أنني لاحظت بأن الكثير من الفنانين يبدون كجماعات تنتمي للنخبة المقدسة وذكروني بنفسي قبل الـ 18 عام التي قضيتها في بلجيكا وأثارت في العديد من الذكريات عن النخبوية والنجومية وداء العظمة... وما إلى ذلك! صحيح أنني لاحظت بأن طريق المعالجة الفنية للانتاج المسرحي ما زال كما كان وما زال المشاهد مستقبلا لرسالة هامة سواء كانت ذات قيمة جادة أو تجارية. وما زالت الرسالة محمولة من تلك النخبة المصطفاة لتصل إلى المشاهد الذي يجلس مطيعا في الفجوة المظلمة!
صحيح أنني لاحظت بأن الكثير من الفنانين يبدون كجماعات تنتمي للنخبة المقدسة وذكروني بنفسي قبل الـ 18 عام التي قضيتها في بلجيكا وأثارت في العديد من الذكريات عن النخبوية والنجومية وداء العظمة... وما إلى ذلك! صحيح أنني لاحظت بأن طريق المعالجة الفنية للانتاج المسرحي ما زال كما كان وما زال المشاهد مستقبلا لرسالة هامة سواء كانت ذات قيمة جادة أو تجارية. وما زالت الرسالة محمولة من تلك النخبة المصطفاة لتصل إلى المشاهد الذي يجلس مطيعا في الفجوة المظلمة!
إن العروض المسرحية التي شاهدتها تطرح تصورا واضحا للواقع وتقدم أجوبة واضحة كذلك! الممثل في المسرح هو (الربّ)، رغم أنه خلف الكواليس عبد لـ (خالق) العرض المسرحي المخرج. الدراماتورغ، وهو ظاهرة جديدة نسبيا على المسرح العراقي يتعامل بناء على ما يمليه المخرج وليس بناء على مبادرته وتأويله الشخصي ورقابته الصارمة لتطور العملية الابداعية في مراحل نشوء العملية المسرحية المختلفة. وهكذا ينطبق الامر على المؤلف الموسيقي، السينوغراف والبقية. الممثل هو إله العمل المسرحي العراقي والمخرج هو ربه الخفي!! لاحظت أيضا أن المخرج كثيرا ما يلعب دور الممثل على المسرح أو بالعكس، الممثل يلعب دور المخرج خلف الكواليس!! الاستبداد ليس بعيدا عن هذا السلوك الفني! فالديكتاتور لا يطرح أسئلة! أللهم الا اذا كانت اسئلة استخباراتية أو لغرض المحاسبة أو أسئلة هامشية! الديكتاتور يطرح أجوبة! أوامر وأجوبة في صيغة أسئلة ليس عليك سوى أن تقبلها، أو تصدقها، أو تلوكها.. الخ.. الخ. والديكتاتور كما هو معروف ليس عراقيا فحسب! إنه موجود في أماكن كثيرة من العالم حتى في بلجيكا، حيث قارعته لاكثر من عقد ونصف!
صحيح أنني لا حظت بأن العملية الابداعية في بغداد ما زالت بعيدة عن أن تكون مشروعا للالتباس، لسوء الفهم، للتساؤل، للحوار، لكي تكون طريقا إلى غابة الأسئلة.. أن تكون مساءلة لما جرى أو يجري. لكنني لاحظت أيضا أن الكثير من الفنانين لا يفعلون ذلك بدافع الأنا المتورمة أو عقدة النقص أو غير ذلك، بل بسبب أن التغيرات التي طرأت على الأخلاقيات الفنية خارج العراق ما زالت مجهولة لديهم. أكثر من ذلك، لقد لاحظت أن لديهم الاستعداد والرغبة الجامحة في رأب الصدع بين العراق المسرحي وبين آليات المسرح المعاصر.
بعد أسبوع من تواجدي في مبنى المسرح الوطني بدأت ملامح الرؤية الفنية تتضح لي. لن تحدد الملاحظات والبحوث والتحضيرات التي أجريتها قبل قدومي إلى بغداد رؤيتي للعمل، بل ستحددها الملاحظة السابقة (وملاحظات لاحقة). في المرحلة التي اصطلحنا عليها تسمية (مرحلة التعارف) في التمارين قررت أن أعود إلى موضوع نفي الديكتاتور من المسرح! أن أبحث عن طرق لا تلتقي مع الاساليب الاستبدادية للعملية المسرحية. وقد كان هذا تحديا يعني أنني بعد أن ألغي سلطتي العرفية يجب أن أتعامل بطريقة جذرية مع الممثل، الفضاء، الدراماتورغ، المؤلف الموسيقي وبالطبع مع ادارة دائرة السينما والمسرح، الطرف الثاني في الانتاج المشترك. وقد كان منطلقنا الأساسي لذلك هو أن لا ننتج ابداعيا بطريقة أنانية، تري الآخر أنني الممثل الأوحد، أنني الفنان الذي ولدتني أمي (ننسون) ورفع إنليل رأسي عاليا على الآخرين.
لا!
لقد ركزنا على أن نقترب من بعض في مراحل الاعداد للعرض المسرحي حتى يصبح بالامكان أن يلعب الزميل على المسرح لأجل زميله، لا لأجل نفسه فقط! أن يقترب من الفضاء المحيط لكي يتّحدا ببعض لا لأجل اعتبار الفضاء ديكورا سيستخدمه. أن نلعب على المسرح لأجل المتعة الجماعية (التي تصبح فيها المتعة الفردية جزء أساسي لتقوية الاحساس الجماعي). لأننا إذا ما ظهرنا بهذه الطريقة على المسرح كجماعة واحدة (وليس مجموعة من الممثلين!) سنقوي أنفسنا وتمثيلنا والمشاهد المسرحية وبالنهاية ايقاع ومزاج العرض العام. بهذه الطريقة لا يعود المخرج (خالقا) أو (مؤلفا) للعرض المسرحي يمسك بكل خيوط لعبة العرض. المخرج ليس سوى وسيط بين الممثل وأدواته المعلنة والخفية (النص، الفضاء، الموسيقى، الجسد، الصوت، الروح، الطاقة، الحدس...). الموسيقي هو شخصية حية على المسرح وليس صانع أجواء أو موزع بخور في طقس يثير شجون البشر، كما إنه ليس موسيقارا ذا اوركسترا عظيمة! السينوغراف لا يتوجب عليه أن يخفي الفضاءات المكانية عن طريق صناعة الكواليس وغيرها. بالعكس! على السينوغراف أن يؤكد على عناصر الفضاء الظاهرة والخفية لكي يكتشف أسراره ومن ثم يكشف عنها.
 لقد لاحظت أيضا أن بعض الفنانين العراقيين يعانون من احساس بالنقص باتجاه الثقافة المسرحية الغربية على صعيد: التمثيل، الاخراج، النص الأدبي، الدراماتورغي، الموسيقى، السينوغرافيا.. الخ. وقد كان هذا البعض ينتظر مني أن أقدم وجبة مسرحية غربية، أو قل أسلوبا مسرحيا غربيا. وهم بذلك لم يكونوا يرمون الى التواصل مع الثقافة الغربية باعتبارها مشرطا (وسيلة لتحليل الواقع وليس تغريبه فقط. وسيلة لوعي الواقع) نرى من خلاله ثقافتنا من جديد ولا هي امكانية للتفاعل بين الثقافات أو هي بحث عن جانب آخر خفي من ذاتنا المحاطة بالضباب! لا!! لقد أرادوا أن يتعاملوا مع الثقافة الغربية باعتبارها المثال الأعلى ومركز التطور في العالم! ولكي نعرض لرؤية تعيد التوازن الموضوعي للعلاقة بين الثقافات ركزنا على قاعدة أن أدواتنا الشرقية وطقوسنا وممارساتنا (العرضية) تشكل نقاط قوة لثقافتنا وبالتالي للعملية المسرحية واكدنا ان محاكاة الغرب او اعادة انتاج الغرب من خلال ثقافاتنا (باعتبار ثقافتنا وسيلة!!) هي نقطة اضعاف وافقار لنا ومن ثم لسيرورة التطور المسرحي. التطور المسرحي لا يحتاج منا أن نقلده او نعيد انتاجه. ما تحتاجه الثقافة الغربية هو انقاذ نفسها من مأزق الاحتضار الذي تعيشه منذ اكثر من 5 عقود. نحن لا نريد اعادة انتاج او محاكاة او تقليد ثقافة تحتضر، لأننا سنكون وكأننا نتتبع قصة موت معلن في صيرورة ثقافة ما. نحن لا نريد في ذات الوقت ان نكون وسيلة علاج (دواء) لانبعاث الثقافة الغربية (رغم اننا لا نرفض ذلك اذا كان هذا ضمن واجبنا الانساني). لقد اكدنا في ذات الوقت على الحاجة للنظرة النقدية الى ثقافاتنا الشرقية وليس اعادة انتاجها باعتبارها كتبا مقدسة!! لكي لا تعود مجرد ثقافة متحفية تستحق التبجيل باعتبارها ثقافة لا تجارى!!
لقد لاحظت أيضا أن بعض الفنانين العراقيين يعانون من احساس بالنقص باتجاه الثقافة المسرحية الغربية على صعيد: التمثيل، الاخراج، النص الأدبي، الدراماتورغي، الموسيقى، السينوغرافيا.. الخ. وقد كان هذا البعض ينتظر مني أن أقدم وجبة مسرحية غربية، أو قل أسلوبا مسرحيا غربيا. وهم بذلك لم يكونوا يرمون الى التواصل مع الثقافة الغربية باعتبارها مشرطا (وسيلة لتحليل الواقع وليس تغريبه فقط. وسيلة لوعي الواقع) نرى من خلاله ثقافتنا من جديد ولا هي امكانية للتفاعل بين الثقافات أو هي بحث عن جانب آخر خفي من ذاتنا المحاطة بالضباب! لا!! لقد أرادوا أن يتعاملوا مع الثقافة الغربية باعتبارها المثال الأعلى ومركز التطور في العالم! ولكي نعرض لرؤية تعيد التوازن الموضوعي للعلاقة بين الثقافات ركزنا على قاعدة أن أدواتنا الشرقية وطقوسنا وممارساتنا (العرضية) تشكل نقاط قوة لثقافتنا وبالتالي للعملية المسرحية واكدنا ان محاكاة الغرب او اعادة انتاج الغرب من خلال ثقافاتنا (باعتبار ثقافتنا وسيلة!!) هي نقطة اضعاف وافقار لنا ومن ثم لسيرورة التطور المسرحي. التطور المسرحي لا يحتاج منا أن نقلده او نعيد انتاجه. ما تحتاجه الثقافة الغربية هو انقاذ نفسها من مأزق الاحتضار الذي تعيشه منذ اكثر من 5 عقود. نحن لا نريد اعادة انتاج او محاكاة او تقليد ثقافة تحتضر، لأننا سنكون وكأننا نتتبع قصة موت معلن في صيرورة ثقافة ما. نحن لا نريد في ذات الوقت ان نكون وسيلة علاج (دواء) لانبعاث الثقافة الغربية (رغم اننا لا نرفض ذلك اذا كان هذا ضمن واجبنا الانساني). لقد اكدنا في ذات الوقت على الحاجة للنظرة النقدية الى ثقافاتنا الشرقية وليس اعادة انتاجها باعتبارها كتبا مقدسة!! لكي لا تعود مجرد ثقافة متحفية تستحق التبجيل باعتبارها ثقافة لا تجارى!!
لقد ركزنا في عملنا على المسرح الجسدي. وهو أمر لم يدرسه الممثل العراقي في السابق الا على يد الفنان الكبير قاسم محمد (انطلاقا من مباديء ستانسلافسكي) وعلى يد بعض المدرسين الذين قدموا بعض تمارين المرونة الجسمانية. وفي اواخر التسعينات قدم الفنان طلعت السماوي من السويد لكي يقدم في العراق اسلوبا من اساليب العرض الحركي أطلق عليه اسم المسرح الدرامي. وللسماوي سبق الريادة (كما كان ذلك من قبله لقاسم محمد) في نقل هذا الفن العرضي المابعد حداثي الرائع الى العراق في وقت غيبت فيه ثقافة صدام حسين حتى اساسيات فن الممثل.
بيد أنني لم أعتمد تقنيات العرض الحركي، لا من كوننكهام التجريدي ولا بينا باوش الدرامية، ولا هارولد كرايسبرغ وماري ويكمان التعبيريان. بل اعتمدت أسسا مستمدة من تطورات التقنيات المسرحية الحركية والروحية واللا تقنيات: الاعراب الحركي (أتيان دوكرو) الفرنسي، الحيوية الحركية (يوجينو باربا) الايطالي، البوتو (تاتسومي هيجيكاتا) الياباني، القناع المحايد ( جاك لوكوك) الفرنسي. وقد جاء اعتمادي في الاقتراب من الممثل جسديا سياقات من تلك الاساليب الغربية باعتبارها (وسائل) ساعدتني في الوصول الى مجاهيل الممثل الحسية ومن ثم الروحية وصولا إلى التابو الذي لا يريد أن يريه لنا كمشاركين له في العملية المسرحية.
لحظة!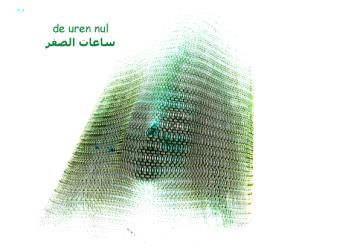 قد يعتقد كثيرين أن المسرح الجسدي هو ظاهرة غربية. لهذا يجب أن أسارع وأخيب ظن القاريء. فالمسرح الجسدي لم يكن حتى وقت قريب جدا ظاهرة غربية. لقد اعتمد الغرب فيما اعتمد في بناء ثقافته على الاحساس المسيحي بالخطيئة الأولى وبالذنب والعورة وبالتالي فالجسد هو عورة بالنسبة للثقافة الغربية. وثمة ثقافة غربية مغرقة في الرجعية للعورة الجسدية ليس نموذج حزام العفّة (Clean girdle or kuisgordel) الا واحدا منها. وحين دخلت إلى الغرب الثقافات الجسدية قادمة من الشرق الأقصى كان هذا دخولا متأخرا جدا، وبقي الغرب أسيرا للشكلانية الجسدية في مقارباته للجسد حتى وقت قريب. ثانيا إن الثقافة الغربية مبينة فلسفيا على أساس الكلمة اولا (في البدء كانت الكلمة) والتفكير (أنا أفكر إذن أنا موجود) وهو أسلوب عقلاني وليس جسدياً. ولا يخفى على القاريء أن الجسد له ميكانيزمات خارجة عن ارادة العقل المنطقي والعقل الرياضي. وقد مارس العقل طوال قرون قمعا وحشيا ضد الجسد لانه لم يكن قادرا على فهم الجسد ولا على تدجين حياة الجسد الخاصة واخضاعها لآليات العقل المنهجية (efficient)، البنيوية، التفكيكية والـ constructive. مثال واضح على هذا هو ان مهنة الدعارة كانت مهنة غير مقبولة عقلانيا طوال قرون بيد أن العقل لم يستطع أن يلغيها كظاهرة اجتماعية. وحين اعترف بعجزه عن ذلك بدأ أسلوبا آخر هو تدجين هذه المهنة وتحويلها الى مفهوم اجتماعي قابل ان يدخل ضمن ميكانيزمات الفلسفة والمنطق الرياضي الخ.
قد يعتقد كثيرين أن المسرح الجسدي هو ظاهرة غربية. لهذا يجب أن أسارع وأخيب ظن القاريء. فالمسرح الجسدي لم يكن حتى وقت قريب جدا ظاهرة غربية. لقد اعتمد الغرب فيما اعتمد في بناء ثقافته على الاحساس المسيحي بالخطيئة الأولى وبالذنب والعورة وبالتالي فالجسد هو عورة بالنسبة للثقافة الغربية. وثمة ثقافة غربية مغرقة في الرجعية للعورة الجسدية ليس نموذج حزام العفّة (Clean girdle or kuisgordel) الا واحدا منها. وحين دخلت إلى الغرب الثقافات الجسدية قادمة من الشرق الأقصى كان هذا دخولا متأخرا جدا، وبقي الغرب أسيرا للشكلانية الجسدية في مقارباته للجسد حتى وقت قريب. ثانيا إن الثقافة الغربية مبينة فلسفيا على أساس الكلمة اولا (في البدء كانت الكلمة) والتفكير (أنا أفكر إذن أنا موجود) وهو أسلوب عقلاني وليس جسدياً. ولا يخفى على القاريء أن الجسد له ميكانيزمات خارجة عن ارادة العقل المنطقي والعقل الرياضي. وقد مارس العقل طوال قرون قمعا وحشيا ضد الجسد لانه لم يكن قادرا على فهم الجسد ولا على تدجين حياة الجسد الخاصة واخضاعها لآليات العقل المنهجية (efficient)، البنيوية، التفكيكية والـ constructive. مثال واضح على هذا هو ان مهنة الدعارة كانت مهنة غير مقبولة عقلانيا طوال قرون بيد أن العقل لم يستطع أن يلغيها كظاهرة اجتماعية. وحين اعترف بعجزه عن ذلك بدأ أسلوبا آخر هو تدجين هذه المهنة وتحويلها الى مفهوم اجتماعي قابل ان يدخل ضمن ميكانيزمات الفلسفة والمنطق الرياضي الخ.
الحركة ما تزال لدى الممثل العراقي الذي التقيته تشخيصا أو تصويرا لحالة ما أو تعبيرا عن فكرة ما أو تجسيدا لكلمة ما، لصورة ما، لانفعال ما. إنها خاضعة لقوانين المعنى وتصوير المعنى أو الموضوع او الحالة. بمعنى آخر، ما تزال الحركة خاضعة لسلطة الكلمة. فمنها أو اليها تنطلق الحركة. ولذلك كانت بداية عملنا هي أننا رحنا نعمل جسديا في الفضاء ليس على أساس سردي أو حكائي. وكان يتوجب علينا أن نعي حقيقة هامة، وبديهية في ذات الوقت وهي أننا يجب أن نري المشاهد أقصى درجات الاحترام ولا يجوز لنا أن نعامله باعتباره ضحية (مستقبلاً سلبياً) لافكار ولرسالة الفنان! ووفق هذا المعيار نحن نعتبر تباين وتضارب آراء المشاهدين وردود أفعالهم السلبية أو الايجابية انما هي معيار للنجاح وليس للفشل تدفعنا إلى ذلك القناعة التالية: إن حقيقة الجودة الفنية هي حقيقة نسبية! ولهذا لا يوجد عرض مسرحي يحظى بالاجماع! كما لا توجد انتخابات يفوز فيها شخص ما بالاجماع! الاجماع هو دليل على وجود خلل في العمل أو الجماعة!!
ولذلك كان أساس منطلقاتنا في المراحل الاولى التركيز على اللا تصويرية واللا تشخيصية في العمل (اللتين تسمحان بالتأويل والالتباس أكثر من تركيزهما على التبسيط) والبحث عن أصل الفعل في العضلات والأوعية الدموية والأعصاب وأجهزة التنفس والهضم وفي الأفعال الارادية واللا ارادية. كل هذا بمساعدة الخيال من جهة وبمساعدة الذاكرة الانفعالية منطلقين من مبدأ هام جدا: هو أن الكلمة أقوى من الحركة في ايصال المعنى من حيث السرعة والدقة. واذا كان لابد من التعبير عن المعنى بطريقة عقلانية فاللغة هي آخر وأنضج وأخطر انتاجات العقل البشري وهي قادرة على اختصار أحقاب في جملة أو فقرة وهو ما لا تستطيع أي اداة أخرى تحقيقه بما فيها الحركة. وانطلاقا من مبدأ أن الحركة ليست بديلا عن الكلمة ولا مكملا أو ترجمة لها انطلقنا إلى مفهوم: الحركة هي ما يستعصي على التحول الى كلمات!
المسرح الوطني
في مبنى المسرح الوطني العراقي القائم في ساحة الفتح ثمة ما يقارب ال 600 موظف (فنان واداري وتقني وعامل وخدمي) ومن هؤلاء ما لا يقل عن 500 من العاطلين عن العمل بمعنى البطالة المقنعة. الكثير من هؤلاء تم تعيينهم من قبل لؤي حقي، المدير السابق لدائرة السينما والمسرح في أواخر عهد صدام حسين وهو من مناصري صدام الاحقاق. وحتى بعد سقوط نظام صدام، بقي الرجل في موقعه الوظيفي في المؤسسة لأشهر عديدة. وفي تلك الأشهر، وقبل اختفائه السحري، قام لؤي حقي بتعيين مجموعة كبيرة في المؤسسة. وزير الثقافة العراقي الذي عينته سلطات بريمر ومجلس الحكم لم يتخذ حتى كتابة هذه السطور اجراءات فعلية لحل هذه المشكلة الكبيرة ذات المضاعفات الانسانية والادارية. فعلى الصعيد المالي تكلف هذه القضية المتروكة ما لا يقل عن 30 مليون عراقي دينار في الشهر (باعتبار أن معدل أجور العقود الشهرية يتراوح بين المائة والمائتين وخمسين ألف دينار للعقد الواحد). ولم أعرف حتى تاريخ كتابة هذا النص لماذا لا يتم تأمل لمصير المؤسسة التي تتشكى دائما من قلة الأموال المخصصة للانتاجات الابداعية، ولا تأمل لمصائر هؤلاء العاطلين ومايترتب على العطالة من تورم وعضال مؤسساتي وانخفاض في المستوى الابداعي وغير ذلك.
لا.
لقد لاحظت ان ثمة نوع من اللا أبالية اتجاه مصائر هذه المجاميع من جهة، وباتجاه هموم ادارة دائرة السينما والمسرح من جهة أخرى. وهذ الدائرة هي مؤسسة غارقة حرفيا في بحر من المعضلات ومشغولة على الدوام بحل اشكاليات داخلية لا تسمح لها أن تتقدم خطوة نوعية الى الامام نحو عملها الاختصاصي: الابداع المسرحي والسينمائي وما يحيط بهما. لم أسمع واحدا طوال فترة وجودي هناك يتحدث عن طرق تفعيل الكادر، تنسيبه الى العمل في المحافظات أو في مؤسسات اخرى. إن هذه الظاهرة بالاضافة الى ما لا نهاية له من المشاكل والعراقيل تشكل لدى الموظفين الكبار في المؤسسة ضغطا نفسيا دفع البعض منهم للحديث أمامي برغبتهم في الاستقالة او البحث عن أفضل الطرق للعودة إلى العمل الابداعي بعيدا عن شجون المناصب العليا. إنها ضريبة نفسية عالية يدفعها المسئولون في مؤسسة تضطر إلى تحويل اختصاصها من اختصاص ابداعي إلى مؤسسة ادارية. وكذا الأمر على الصعيد المكتبي حيث تتجمع ما لانهاية من التراكمات الادارية والتواقيع اليومية والازدحامات الخانقة يوم توزيع الرواتب التي لا توزع بشكل منتظم. النميمة منتشرة انتشار النار في الهشيم. المؤامرت الصغيرة. الشلليّة الوظيفية. كل هذه ظواهر منتشرة إلى حد لا يمكن ان تصفه الا بانها..... مصيبة!
جماعة زهرة الصبار للمسرح
0032 (0) 297 79 66





التعليقات