حوار مع الدكتور منذر عياشي
حاوره د. إسماعيل نوري الربيعي: غارق في ابتداع الأفكار، متطلع نحو التفسير والتأويل والتحقيق، يتوقف مليا عند هذا الحشد من التمركز الذي يتبدى عليه الآخر، من دون أن يروعه المشهد، فالناقد فيه يتجلى ويحضر كاشفا لوثة الضلال، ليجعل منه متفيئا في ظلال المعنى، منذر عياشي باحث يترصد الإنتاج المعرفي من دون الخضوع للبديهيات والجاهزية التي تفرض نفسها على بعض النتاجات، تلك التي تحاول جاهدة الانتساب إليها حتى ولو كان هذا الانتساب مجزوءا أو مشروطا. لا يتوانى عن رجم تابوهات السيطرة الثقافية، فالنسبي لديه هو الحاضر الدائم في ساحة المعرفة، وما يراه مساحة لا بد له أن يعيش الانفتاح والتبادل، من دون السقوط في دوامة التماثل والخضوع والإذعان. في جهده المعرفي المتواصل تراه متطلعا نحو المزاوجة بين العلم والحقيقة، محددا خطوه في طبيعة النظر وتشخيص الموقف عبر الكشف عن المغالطات التي تفرضها سطوة الأوج التي يتحصن بها الغالب. 
من واقع الدرس اللساني الذي وهب نفسه للغور والبحث فيه، يعمد عياشي نحو تشخيص الأسس والقواعد النظرية، وجعلها الأداة التي يتم من خلالها الوقوف على الفواصل التي تتبدى على قواعد التعبير. من دون الوقوع في التياثات التحصن ومواقعات التنازع والتخاصم، فاللغة تبقى وعاء يحمل وسائل التعبير، ضمن الإطار الثقافي الذي تظهر فيه، بحثا عن التواصل والتفاهم والتقارب وتعزيز مجال التفاعل. ويبقى أخيرا، أن نقول ما قاله د. منذر عياشي عن نفسه: quot;إن الغربة التي صاغت ثلثي عمري، أنا الذي أطرق أبواب الستين، قد وهبتني حكمة الورد الجوري، وحيوية الزعتر، وثورة الياسمين، كما وهبتني حرية كل الطيور المهاجرة ليس إلا إلى أعشاشها الدافئة وربيعها الآتيquot;، منذر عياشي من أصل سوري، ويعمل حاليا مدرسا للسانيات بجامعة البحرين.
* كيف يمكن للغةٍ ما أن تتلبس ناصية الحقيقة، سؤال يندرج في واقع التمركز الذي تخوض فيه بعض الثقافات، فهل ثمة سبيل لكسر طوق هذه النظرة؟ وكيف؟ وهل يمكن صوغ الحقيقة ثقافيا في مساحات من الرؤى لا تمثل هي فيها المطلق؟
- قد يهزأ المرء من نفسه ويسخر، فيزعم أنه يمتلك ناصية الحقيقة. وفي الواقع فإن مثل هذا الزعم، شيطان، يتلبس قائله فيظن أنه يمتلك الحقيقة. ولواحد من كتاب السلف المشهورين إدراك دقيق بهذا الأمر، جعله يضع كتابا يفضح فيه هذا الزعم ومن يدعيه، وقد كان كتابه بعنوان quot;تلبيس إبليسquot;. إن الحقيقة، مع ذلك، معطى يستطيع المرء بسهولة أن يدعيه. وإذا كان هذا من ممكن المرء فلأنه يعلم أن كينونته ليست جوهرانية ثابتة، وإنما هي متغير متبدل تحمله النسبية إلى آفاقها الرحبة. وبقول آخرَ منْ علِمَ أنه نسبي، فإنه يستطيع أن يغامر بزعم امتلاك الحقيقة. حينئذ لن تكون هذه الحقيقة كلية تصلح لكل العصور ولكل الناس، وإنما تكون من منظور هذا الكائن النسبي، نسبية على مثاله تماما. وزعم كهذا حينئذ يليق بقائله مادام يدرك أنه نسبي، وأنه متغير، وأنه لا يقوى على ثبات، ولا يثبت في استمرار.
غير أني إذ أتأمل في التباس ناصية الحقيقة، أرى أن الثقافات من خلال نخبها المتسلطة هنا وهناك، عند العرب وعند غيرهم، في أمريكا وفي العالم الغربي، تميل إلى أن تكون صاحبة الحق في رؤية نفسها وحيدة في كشف ما لا يراه الآخر. ولقد نعلم أن المركزيات التي تؤسس على هذا وجودها مبنى ومعنى، هي مركزيات قاتلة تجعل أبناء هذه الثقافات لا يرون إلا ذاتهم، أو على نحو أدق تجعلهم يلغون الآخر تماما لكي لا يروا إلا ذاتهم. وما قتل الإنسان شيء مثل تمركز هذا الإنسان على ذاته، واكتفائه بهذه الذات. ولذا يصح أن نقول ونحن نرى ما يجري في العالم، إن كل الجرائم الكبرى التي تفتت الإنسان وتكاد تودي بكوكبنا الجميل إنما تأتي من هذه المركزية العمياء التي لا تقوى أن تطير إلا بجناح واحد، أو هي لا تريد أن تمشي إلا بقدم واحدة وتنسى أن للطير جناحين وللإنسان قدمين، كما تنسى أن لكل شيء وجهين وربما أكثر من وجهين.
* أنت مثقف تؤمن بالنسبية، وتروم الطيران بجناحين، كناية عن التعدد والتعددية، فما هو شكك، وماهي أسئلتك التي تعمل بها على امتحان ذاتك من جهة، وتقديم هذه الذات بوصفها جزءا من الثقافة، أو صورة لها من جهة أخرى؟ثم... ثم أنت بوصفك مثقفا، ماهي مهمتك، وأين تقف من العالم؟
- ليس المثقف نبيا، ولا هو مشروع نبي. ولكنّ المثقف فرادة. وهذه الفرادة صفة لكينونة تخترق المعتاد والمألوف. فبأي شيء يكون المثقف فرادة؟وماهي المهمات التي إذا اضطلع بها يكون فرادة؟ثم هل فعل المثقف تفسيري، وتأويلي، وتنظيري، أم هو انقلابي تغييري، أم هو تأسيسي بنيوي؟هذه أسئلتي الآن، أما عن مهماتي، فلقد يراد أحيانا أن نحمل المثقف مهمات من شأنها تفعيل الواقع، وماركس يقول تغيير الواقع، وآخرون لهم أيضا عبارات أخرى تتصل بالواقع. بتواضع كبير اعتقد أن المهمة الأولى والرئيسة للمثقف تكمن في عشق الأفكار والغزل معها والسعي وراءها. المثقف هو من يطوي العصور والأزمنة ليعيش الأفكار ولا شيء غير الأفكار. وتحميل المثقف بمهمات غير التفكير هو تحويله أو إخراجه مما جُعل له ويُسّر لكي يكون شغّيلا في ورشات الواقع. هناك مقولة إرهابية سيطرت على الثقافة في الخمسينات والستينات والسبعينات، تشجب المثقف الذي يعيش (كما ترى هذه المقولة) في برج عاجي. أنا أعتقد أن المثقف الذي يسعى خلف الأفكار ويفكر بالأفكار وفي الأفكار، هو مثقف لا يبتعد عن الواقع، ولكن يجب أن نعلم ما هو الواقع، هل هو ذلك الحيز الذي تحدده أنت فقط ولا أحد سواك، وإذا خرج عنه آخر فقد خرج عن الواقع؟ وهل المهمة الثقافية هي فقط تلك المهمة التي حددها ماركس أو سواه؟ ومن قال إن ماركس (وهنا نعود إلى سؤالنا السابق) يمتلك الحقيقة؟ أليست حقيقة ماركس هي ذلك الضرب من تلبيس إبليس، وكل حقيقة يزعم من يزعم أنه يمتلكها في المطلق، أليست هي ذلك الضرب من تلبيس إبليس؟الإنسان متعدد، والواقع يتعدد بتعدد الإنسان خلقا.
ولكي لا أبدو معلقا لا إلى سماء أنتمي ولا إلى أرض أنتسب، أقول: ما أحوج هذا الكائن الجميل الذي هو الإنسان إلى الأفكار ثم إلى الأفكار، سواء اتصلت هذه الأفكار بحياته مباشرة أم لم تتصل، وسواء كان لها وجود في الاعيان أم كان لها وجود في الأذهان.
إن المطلوب من الكائن الجميل، الذي هو الإنسان، أن يفكر وهذا هو عمله. وإن قصد التفكير ليعلو على كل قصد. فالإنسانية لن تؤخذ غدرا بالمتسلطين إذا وجد المفكر فيها، ولذا لا يصح في الوجود أن نضع على المفكر شروطا أو اشتراطات، فالمفكر لا يسأل عما يفعل وهم quot;سدنة الوهم والسلطةquot; هم يُسألون، والمفكر لا يحتجز خلف أسوار وهم يحتجزون، والمفكر لا تغلق عليه أبواب السماء، فالله مذ بدأ الخلق جعل للمثقف عقلا كي ينفذ به من أبواب السماء. أعود فأقول على المفكر أن يفكر وهذه هي مهمته. وإذا وجد هذا المفكر، حينئذ نستطيع القول إن الواقع بخير وإن تفعيل الواقع أو تغيير الواقع، لكي ألتقي مع ماركس الظريف، أمر ممكن.
وأما عن شكي، فيأتي من كوني، بوصفي مثقفاً، كائناً إشكالياً، أي لا يؤمن بالبدهيات، ويعمل باستمرار لكي يكون تواصله قطيعة. أنا لا أطمئن، في إطار حياتي الإنسانية، إلى الإنسانية وإنتاجها:علماً، وفناً، وإيديولوجيا. شكي يدفعني نحو الممكن، وهذا يذهب بي على الدوام نحو التجاوز. ألف وجه خير من وجه. ألا ترى أن هذا يجعل واحدنا كثيراً، وكثيرنا مطلق، الشك ليس عبثاً نمارسه، إنه اختراق واقتناص للمستحيل. وبهذا فإنني لا أهوم خارج العالم وإنما أعوم فيه، وأعمل لكي تكون علاقتي به تأسيساً بنيوياً، أي أن الثابت لا ينفي المتغير، ولكن ينتجه ويستمر فيه. ومن جهة أخرى، فأنا إذ أكون كذلك، فإني لا أسأل لماذا تقدم غيرنا وتأخرنا، وإنما أسأل ما الإبداع الذي أنتجته في شكي وتجاوزي؟ أنا بهذا أقدم مسؤوليتي بدل التهرب منها، وأضع الحصان أمام العربة وليس خلفها أو فوقها، وأنا بهذا السؤال أومن بفرديتي وليس بجماعتي. فالإبداع والمسؤولية عن الإبداع أمر فردي وليس أمراً جماعياً أو قطيعياً. إنه فردي ولكنه يحتاج إلى مناخات جماعية توفر له كثيراً من زاد الحرية وعطائها.
*تعاني آليات الاستدلال في المجال العربي، من التداخل وسوء الفهم في الكثير من الأحيان، بل إن الخلط بات يلقي بظلاله على طريقة الاستفادة من المفاهيم المتداولة، خذ مثلا نظام التسمية:إنه يشهد حربا ضروسا في الأفق العربي، فالمصطلحات في حرب، والمفاهيم تحترق، والعلامة اللغوية المتداولة تنهار، والأمة كلها بسبب هذا تكاد تصبح خبرا بعد وجود، فكيف ترى ذلك؟
- عديد من الباحثين تكلم عن حرب اللغات. وإنها في الواقع لحرب ضروس لا ينجو منها إلا ذو حظ عظيم، فكم من كلمة قتلت صاحبها! وفي تاريخنا هذا أمر معروف، فقتلى الكلمة كثر، سواء كانت هذه الكلمة تحمل على اختراع الخصم الموهوم أم تحمل على تمجيد الذات، أم تحمل على صاحب السلطان. وإذا تركنا هذا الجانب لكي ننظر كيف تقوم حرب اللغة في واقعنا من خلال نظام التسمية للمفاهيم والمتصورات، فسنجد أن الاسم، في مكان ما، يبني لنفسه أفكارا تعيش في الصيرورة وتنمو، في حين أنه في مكان آخر يفتح في الأرض مقابر جماعية لمن يلهجون به. وأضرب على ذلك مثلا بالديمقراطية اسما.
الديمقراطية، في وطننا العربي تحديدا، تقتل الديمقراطية، والديمقراطيون يمشون في جنازات الديمقراطيين، بعد أن يفخخوا بيوتهم ويلغموا أقدامهم ويزرعوا بالمتفجرات أماكن نومهم. ما من قتيل عربي quot;أو لنقل شهيدquot; إلا ووراءه يقف ديمقراطي مزعوم. فالكل يقتل الكل باسم الديمقراطية، ودفاعا عن الديمقراطية. وهناك مسميات أخرى، نظام التسمية فيها نظاما للإرهاب ولسحق الآخر ونفيه من الوجود وطرده.
لنأخذ مثلا مسمى quot;الاشتراكيةquot; فباسمها ومن أجلها وحفاظاً عليها تم في بلدان معينة من الوطن العربي، قتل الناس بالآلاف بدعوى انهم مناهضون للاشتراكية، وانهم رجعيون، إلى آخر ذلك من تصنيفات الإرهاب والقتل والتعذيب. وكذلك القومية، فباسمها ومن أجلها غزا قطر عربي قطرا آخر وعمل على تدميره وإبادة أهله، والخطاب العربي المعاصر عموما، يعيش أزمة لأنه لا يستند في إنتاجه لنفسه على جنون المبدعين، ولكن يستند في إنتاجه لنفسه إلى إيديولوجيا المستبدين، وباختصار يمكنني أن أجازف فأقول إن العربي يصوغ في المنافي نثارة خطاب حر وعقلاني، ولكنه بسبب وجوده في المنافي لا يصوغ نظاما للخطاب تؤسسه الحرية والعقلانية. فنحن نتوق لهذه الجميلة لأننا في منفانا نراها حيث يتمتع بها الآخر، نتوق إليها ونخطبها ونسعى وراءها وهذا كل ما في الأمر، ليس أكثر من ذلك. إننا مخصيون لا نستطيع الزواج بسيدتنا الحرية، فالاستبداد قد حول الكائن فينا من كينونته الإنسانية ليكون شيئا من الأشياء، وأخرجنا من حريم الإنسانية التي تليق بنا، الى حريم البهيمية التي أراد هذا الاستبداد أن يكرسها فينا. ومن عجب أن المثقف في أي ساحة من ساحات العواصم العربية، يستطيع أن يستبدل، نظرياً، الكائنات التي يراها أمامه بكائنات أخرى، دونها في الخلق، من غير أن يتبدى له أي فرق في التغيير. وتلك لعمري مأساة لم تعرف لها الإنسانية ما يساويها مثيلا. و أقول إذا كان هذا الذي أتلفظ به مليء بالسوداوية والتشاؤم، فالحبر الذي تكتب به أعظم الأفكار يحمل أيضا اللون الأسود، ولا بد من سواد كثيف لكي نكتب على ظهر الواقع الذي نسير فيه ما نستحق من الحرية، ومن الوجود ومن البياض، والبياض ليس الموت هنا، ولكنه الأمل.
*في خضم الصراع على القيادة الرمزية للمجتمع، يعيش الخطاب الذي يستخدمه الفاعل الاجتماعي حالة من الاختلاط المربك في الرؤى والتصورات والرهانات، فكيف يمكن تجديد الخطاب، وتحويل الفاعل الاجتماعي إلى فاعل بنائي، أو كيف يمكن رده إلى كائنه الحضاري؟
- لنا أن نتساءل عن الفاعل الاجتماعي، من هو؟ما هويته؟من يكون؟ما كفاءته؟ما قدرته؟هل له سلطة؟إلى آخر ذلك من الأسئلة. ويجب حتما أن تكون الأجوبة مختلفة، وإلا يكن ذلك، فإن التطابق يقضي بموت من يعطي جواباً عن السؤال. ولكي لا أغادر ساحة الاختلاف أقول إن الله تعدد في أسمائه لكي لا يكون سيفا مسلطاً، إن في المعرفة وإن في الخلق، وكذلك كان الله مختلفاً. ولذا كان كما أخبر عن نفسه quot;هو كل يوم في شأنquot;. إذاً من ساحة الاختلاف أنظر إلى الفاعل الاجتماعي، وأسعى إلى تحديده فأقول إن الفاعل الاجتماعي في المجتمع الذي أنتمي إليه، هو عين حضارة النص التي تميز بها من فاعل اجتماعي آخر، يتمثل في حضارة الشخص كما في العالم الغربي، وحضارة الحركة كما في العالم الياباني والصيني، وحضارة الإيقاع كما في العالم الأفريقي الخ.... فاعلنا الاجتماعي هو النص وحضارة النص، ولا يمكننا إذا أردنا أن نبني معماراً لوجودنا نستقبل فيه كل اختلافاتنا، إلا أن نؤسس هذا المعمار على حضارة النص. ومن يسعى لتقويض أسه الحضاري لن يصل إلى شيء، وكذلك من يسعى إلى استبدال مكونه الحضاري لن يصل إلى شيء. ففاعلنا الاجتماعي، إذن، هو نص ونحن على مثال فاعلنا الاجتماعي يجب أن نكون.
إذا أردنا أن ننطلق كيانا ووجودا، وبوصفنا فاعلين اجتماعيين، فيجب أن نرتدي، جسدا وروحا، لباس السمة الحضارية لفاعلنا الاجتماعي، أقصد حضارة النص، وحينئذ سنعرف كيف نقرأ أنفسنا وكيف نقرأ الآخر وكيف نتجدد خطابا، وسنعرف الموقع الذي يجب أن يكون لنا في العالم، كما سنعرف كيف نستقبل من الآخر هداياه، وغيريته، وعشقه، وتسامحه، وأسماءه الحسنى: ( الاشتراكية، الديموقراطية، الليبرالية، العلمانية، العولمة، إلى آخره) وكذلك سنعرف، في المقابل، كيف نهديه غيريتنا، وعشقنا، وتسامحنا، وأسماءنا الحسنى: quot;قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحدquot;.
إن العقبة التي عطلت فينا اشتغال التعبير، وحالت دون تكوين الخطاب هي أننا نسينا انتماءنا إلى حضارة النص. فصار مثلنا بين الحضارات كمثل الغراب والحجل، وهي حكاية سجلها كتاب كليلة ودمنة ببيان رائع. نحن اليوم هذا الغراب، وقد آن الأوان بعد أن تكرمت الإنسانية علينا باختراعات لا مثيل لها، ومعارف غامرة بعطاياها أن نكتشف، أننا ننتمي إلى حضارة النص. فإن اكتشافنا هذا يعيد توازننا ويجعل من كلنا فاعلين اجتماعيين، كما يجعل من كل واحد منا أيضا وعلى حدة فاعلاً متفرداً في فعله الاجتماعي ومتميزا.
وبقول أدق يجب أن يشتغل إدراكنا على الإدراك، حينئذ نحدد من نحن من غير مركزية. والاشتغال بالإدراك على الإدراك هو نقد للإدراك. فإذا اشتغلنا نقديا على إدراكنا، فسنتخلص من عقدة ووهم : عقدة الدونية، ووهم سيادة العالم كما في بعض الخطابات. إننا سندرك أننا وسط فاعلين آخرين حضاريين يحيطون بنا من كل جانب، ويشكلون معنا العالم الذي نعيش فيه. ثم إن هذا الإدراك الذي نؤسس به أنفسنا بوصفنا كائنات تنتمي إلى حضارة النص، يهبنا الممكن في إبداع علومنا وثقافتنا، ومعاشنا، ونظامنا:سياسة، واقتصادا، واجتماعا. كما يهبنا طرق بناء الأفكار، وبناء الوجود الخاص بنا، وطرق بناء علاقاتنا سلاما وأمنا مع الآخر. وإذا كان الحكيم من يستأنس بماضيه، فإننا إذا رأينا في أنفسنا كائنات حكيمة، فيجب أن نستأنس بالسلف الصالح الذي انطلق من حضارة النص ليعانق العلم والعالم معاً. فهل إلى هذا الطريق نحن ذاهبون؟هذا شبه سؤال وليس سؤالاً بمعنى الكلمة، لأن الإنسان الذي يسكننا quot;الآن quot; وفي الموجود حاضرا لا يقوى على طرح الأسئلة، فالأسئلة فيه وجود مؤجل ومرجأ إلى أن يجد سبيله نحو حضارته، أقصد حضارة النص.
*عن أي نص تتحدث؟
- سئلت أم المؤمنين عائشة عن خُلق الرسول quot;وأنا أقول لعلها سئلت عن خلْقِه أيضاًquot; فقالت كان خلقه القرآن quot;ولعلي أقول كان خًلْقهُ-أي كينونته- القرآنquot; النص الذي تسألني عنه هو هذا، ليس الكتاب وليس السطور ولكنه الجسد الذي ترتسم بأفكاره الكتابة، وهو الجسد الذي تظهر السور في ثنياته وثناياه. إن الجسد العربي نص، لا أقول إنه لحم وعظم ودم، ولكن أقول نص، أي كائن نصي إذا مشى مشت المعرفة معه، وأودعت منه أجزاء لا تحصى في المكتبات، وإذا نظر ملأ الوجود تسامحا ومحبة، وإذا أنتج اقتسم مع الآخر رغيف بقائه ومعارفه.
ألم تقم حول هذا الكتاب (القرآن الإنسان- الإنسان القرآن)، حضارة عظمى؟ ألم تصبح هذه الحضارة علامة سيميائية دالة بين الحضارات؟ألم تقرأ هذه الحضارة العربية مذ تلك اللحظة التي تحوّل بها الجسد العربي بوساطة القرآن إلى نص، بوصفها فرادة وتميزاًَ بين الحضارات؟ ألم يخرج الكائن العربي من ظلامة عدمه إلى أنوار وجوده بهذا النص؟ وإذا أراد المستدل أن يستدل عليه ألا يشير به على كينونته؟نحن حضارة نص، وبهذا يجب أن نشير إلى أنفسنا وهذا ما أعنيه بالنص. وهكذا تراني أملأ السؤال بكل إجابات النص المحتملة، بل بهذا النص أبدع كل الأسئلة الضرورية لبناء المعارف وابتداء التعامل مع الآخر دون إلغائه أو إقصائه أو نفيه. بالنص أنا والآخر، الشخص والحركة والإيقاع، نعيش العالم.




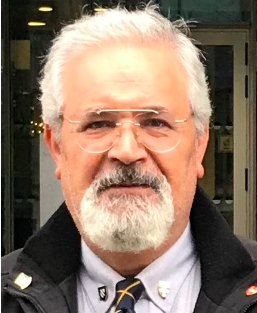
التعليقات