الأربعاء: 03 . 08 . 2005
لم يحصل “قانون العفو”، الذي أقره مجلس النواب اللبناني، على إجماع سياسي وإن تأتى له شبه إجماع نيابي (أو أغلبية كاسحة للدقة). فقد جودِل في شرعيته القانونية والأخلاقية كقانون يجُبّ سياسياً تحت عنوان استكمال المصالحة الوطنية أحكام القضاء اللبناني ومؤسسته الرفيعة (المجلس العدلي)، ويتجاهل الحقوق المدنية لِمَنْ لم يتنازلوا عن حقهم في النازلة. ولقد كان يمكن النظر إلى استفادة سمير جعجع قائد “القوات اللبنانية”، من القانون هذا مكسباً سياسياً للوحدة الوطنية ذا مضاعفات “جانبية” على ذوي الشهيد رشيد كرامي وجمهوره، على أمل صفح المفجوعين والمصابين، وتفهم المراجع القضائية لمقتضيات تلك المصالحة، لولا أن القانون إياه تحوّل إلى سابقة لدى بعضٍ تراءت له الفرصة سانحة للبناء عليها وإشهار مطالب صفْح جديدة يعسُرُ تبريرها باسم المصالحة الوطنية، على فرض أن ذلك ممكن في حالة قائد “القوات اللبنانية”!
المطالبة بالصفح عن عملاء الاحتلال، ومقاربة حالتهم مقاربة إنسانية، وحسبانهم مجرّد لاجئين إلى “إسرائيل” اضطرتهم “تهديدات” السيد حسن نصر الله إلى ذلك، هي الوليد غير الشرعي ل “قانون العفو”، وهي كذلك وليد غير شرعي لأن العفو لا يكون عن الخيانة الوطنية.
بعد تحرير فرنسا من القوات النازية وسقوط حكومة فيشي العميلة، نظّمت المقاومة الفرنسية “محاكمات” لعملاء النازية وأعدمت الآلاف منهم في الساحات العامة حتى من دون أن يقول القضاء الشرعي كلمته في نزاهة الأحكام الصادرة في حقهم. ومن أفلت منهم من القصاص الشعبي، حوكم في محاكم رسمية وجُرّم بأفعال العمالة والخيانة. وحدث الشيء نفسه في المغرب بعد الاستقلال، حيث أعدمت قوى المقاومة وجيش التحرير عملاء فرنسا وإدارتها الاستعمارية، بينما التمست الدولة براءة لبعضهم ممن سيُلحقُون بأجهزة الأمن والجيش. أما في الجزائر، فقد اضطر عشرات الآلاف من “الحركيّين” من الهروب من جيش الاحتلال الفرنسي على مثال هروب العملاء اللحديين من الجيش الصهيوني خشية الاقتصاص الوطني منهم. وما زالوا حتى اليوم، وبعد ثلاثة وأربعين عاماً، خونة وعملاء في نظر الدولة لا يجرؤون على دخول الجزائر.
تلك خبرة التاريخ من بعض حالاته القريبة لمن لا يعرف. وإذا كان للبنان أن يبرئ ذمّته في الموضوع، فيكفيه أنه أنتج أرقى أشكال المقاربة الإنسانية والقانونية العادلة لملف العملاء في تاريخ الإنسانية المعاصر. هل يجادل أحد في أن أحداً من المتعاونين اللحديين، الذين سقطوا في قبضة المقاومة غِب التحرير، لم يصب برصاصة واحدة ولا تعرّض لصفعة، ولا تلقّى شتيمة، وإنما سُلِم إلى السلطات اللبنانية لبتّ أمره قضائياً؟ وهل يجادل أحد في أن الدولة عاملت المتعاونين، الذين سلّموا أنفسهم أو سلّمتهم المقاومة إليها، بالحسنى أو قل كمواطنين متهمين أو أظنّاء يحق لهم الدفاع عن أنفسهم في محاكمات عادلة محاطة بكل الضمانات القانونية؟ ثم هل يجادل أحدهم في أن السلطة التمست لهم ظروف التخفيف فأنزلت بهم أحكاماً رمزية لأسباب سياسية قد تكون مخالفة للاعتبارات القضائية نفسها؟
تلك سجِية لم تُسجّل لغير لبنان في هذا المضمار، حتى أن قسماً من شعب هذا البلد أصيب بالحبوط وهو يعاين كيف تتعامل السلطة برأفة مع المتعاونين وكأنهم عصابات سرقة سيارات أو محلات مناقيش! حتى اعتراض المقاومة وبعض المجتمع السياسي اللبناني على الأحكام “القضائية” الرؤوفة بالمتعاونين، مخافة أن تقدّم إيحاء خاطئاً بأن العمالة والخيانة ليست جريمة عظمى يعاقب عليها القانون بأغلظ الأحكام التي تناسبها، (حتى الاعتراض ذاك) ظل في نطاق القول ولم يرافقه فعل سياسي يصطدم بالسلطة أو يفتح معركة عليها بدعوى تدخلها غير المشروع في تكييف أحكام القضاء مع اعتبارات سياسية لديها، فلم، إذن، مؤاخذة المقاومة والدولة على موقفهما من ملف المتعاونين؟
سيقال وقد قيل إن كثيراً منهم أجبرهم إهمال الدولة لأهالي “الشريط الحدودي” المحتل طيلة اثنين وعشرين عاماً على الانخراط في جيش سعد حداد وأنطوان لحد والتعامل مع الاحتلال، وأن على الدولة بالتالي أن تحاسب نفسها على ذلك الاهمال قبل ان تحاسب من كانوا في عداد “ضحاياه”، أو أن تعترف به فترفع عنهم سيف المتابعة السياسية والقضائية. ولعمري انها حجة واهية من أكثر من وجه.
ألم يطل إهمال الدولة على فرض أنه كان في مُكنِها أن تفعل شيئاً مئات الآلاف من الجنوبيين الرازحين تحت سلطان الاحتلال. فلماذا لم يكن هؤلاء جميعاً عملاء، وإنما فئة قليلة فقط. ولماذا ارتضى آخرون العمل ضمن المقاومة وآثر قسم ثالث النزوح إلى بيروت أو غيرها من المناطق على العمل في مؤسسات الاحتلال وتقديم السخْرة له؟ الجواب هنا أن التعاون مع العدو كان طوعياً وإرادياً بحيث يمتنع رده إلى فرضية الإهمال. هذه واحدة..
الثانية على علاقة بمراتب المتعاونين: إذا كان يمكن ان يُفْهَم التجنيد في جيش عميل للاحتلال وهو لا يُفْهم بأي معيار كضرب من المساهمة في إدارة الشؤون الأمنية في منطقة لبنانية لا تبْسُط عليها الدولة سلطتها، فكيف يُفهم إقدام جنود لحد على قتل مدنيين أو التنكيل بهم لمجرّد الاشتباه في وطنيتهم، أو في دعمهم لرجال المقاومة، أو حتى لمجرّد إبدائهم التعاطف معها؛ وكيف يمكن فهم جرائمهم الوحشية في حق سجناء معتقل الخيام الذي أداروه بحنكة بربرية تواضعت أمامها السجون “الإسرائيلية” نفسها في قلب فلسطين المحتلة؟!
ثم كيف نفسّر في حالة ثالثة أن قسماً كبيراً من هؤلاء المتعاونين آثر عدم الهروب مع قوات الاحتلال وقدّم نفسه للدولة أو للمقاومة: ألم يكن قد سمع، مثل القسم الفارّ، “تهديد” السيد حسن نصر الله من دون أن يخشى عاقبة ذلك التهديد لعلمه ربّما بأنه حرب نفسية، أو لشعوره بأنه بريء من دم المدنيين والمقاومة؟ وعليه، ماذا يعني هروب من هرب سوى أنه يتهم نفسه قبل ان تتهمه الدولة والمقاومة بالعمالة والخيانة، ويقتصّ منها اقتصاصاً ربما فاق في حدته القصاص القضائي أو السياسي اللبناني؟
وبعد كل هذا، يهون على البعض استسهال أهوال تلك الصفحة النكراء من تاريخ لبنان المعاصر. فماذا تعني مفردات “العفو” و”الصفح” و”المعالجة الإنسانية” لملف “اللاجئين” اللبنانيين إلى فلسطين المحتلة غير استنقاذ حفنة من المرتزقة على حساب وطني هو بلغة الأرقام ملايين اللبنانيين الذين سقط لهم في مواجهة العدوان “الإسرائيلي” منذ ثلاثين عاماً عشرات الآلاف من الشهداء؟ وإلى أي حتف يقود لبنان سوى التأسيس للعمالة والخيانة وتسويغها وإباحتها بوصفها وجهة نظر؟
ليس صحيحاً أن العفو عن المتعاونين مع الاحتلال شرط لاستكمال المصالحة الوطنية، إنه نداء جديد للانقسام ولدقّ الإسفين بين اللبنانيين.






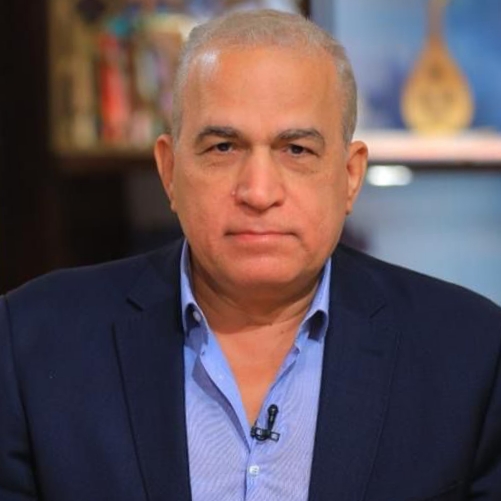









التعليقات