هل تدعم طهران ما يراه العرب صالحاً لهم لا ما تتصوره هي واجباً عليهم؟
صلاح سالم - الحياة
تحدث خبراء عرب كثر، قبل عاصفة العدوان الاسرائيلي على لبنان وبعدها، عن صراع بين مشروع أميركي وآخر إيراني على مقادير المنطقة مع غياب أي تصور عربي لمستقبلها. وأظن ذلك صحيحاً في المجمل وغير دقيق تفصيلاً، فالولايات المتحدة بحكم هيكليتها وحجمها ليست في موقع تناقض جذري أو جوهري مع العالم العربي بحسب المنطق الإستيراتيجي الصحيح الذي تصوغه ثوابت تكوينية كالجغرافيا والتاريخ والثقافة، ما يعني أن التوافق بين الجانبين أمر ممكن بل طبيعي، وأن التناقض الظاهر بينهما صنيعة وعي مزيف مثقل بأوهام السيطرة الإمبراطورية فرضه اليمين المحافظ، الذي تمكن من إخضاع العقل الأميركي الجمعي لأسوأ المؤثرات الإسرائيلية.
والصراع الجوهري إذن يدور بين إسرائيل من جهة التي تخاطب العقل الأميركي من داخله لإقناعه بالتعامل مع المنطقة عبر منهجها العدواني سواء لدافع نفسي يتعلق بعقدتها الوجودية المستحكمة، أو لدافع استيراتيجي يعنى بتحقيق أكبر عائد ممكن لتحالفها مع الولايات المتحدة، أو كليهما. وبين إيران، من جهة أخرى، التي تخاطب العقل الأميركي أيضاً ولكن من خارجه، لإقناعه/إرغامه بالسماح/ التسليم لها بالعمل كقطب استيراتيجي فعال في إدارة المنطقة بما يعظم من مصالحها ومكانتها.
ويستند الجانبان، الإسرائيلي والإيراني، الى حال الركود التي تعيشها المنطقة حيث تخلت مصر عن قيادتها حضارياً نهاية السبعينات من القرن الماضي، قبل أن تفقد حس الإتجاه الاستراتيجي بفعل العدوان العراقي على الكويت بداية التسعينات، والى أن تحولت الى فراغ استراتيجي كامل بعد احتلال بغداد قبل ثلاث سنوات. ووهما يفترضان أن الوضع العربي سيظل كذلك في المدى الذي يسمح لكليهما بإنجاز مشروعه الخاص، وهذا الافتراض بالضبط هو ما ندعو الى تحديه وإفشاله. ولا شك عندي في قدرة العالم العربي على الإفشال لأنه يجيد الممانعة وممارسة تكتيكات الإبطاء والدفاع السلبي عن النفس، لكن الاستجابة العميقة للتحدي تقتضي إجادة تكتيكات أخرى تبدأ بالدفاع الإيجابي، مروراً بالهجوم البناء، وصولاً الى المبادرة الخلاقة لإعادة تأسيس الواقع التاريخي.
ولعل نقطة البداية الصحيحة لهذا الدفاع الإيجابي والتي يمكن تطويرها تلقائياً الى هجوم بناء، هي التصالح مع المشروع الإيراني، والضرب على المشروع الإسرائيلي بشدة تكفي لإفشاله نهائياً، كمقدمة للخروج من المأزق الشامل وإعادة امتلاك المصير.
وتنبع مشروعية هذا الفهم من دواعي شتى يأتي على رأسها الأعراض الجانبية للصدام مع المشروع الإيراني، لأنه ينبع من المنطقة نفسها ويحوز وسائلها ويتحدث لغتها، ولذا فسوف يثير لسنوات عدة استقطاباً في الساحة العربية بين تيار عام عقلاني وإن بقي laquo;محافظاًraquo;، وتيار ممانعة laquo;راديكاليraquo; وإن ظل هامشياً، والأغلب أنه سوف يتآكل في النهاية كما تآكلت laquo;جبهة الصمود والتصديraquo;، غير أنه سيشغل حيزاً من الزمن العربي المتمدد حينئذ في شبه حرب باردة إقليمية، لها استقطاباتها المتعددة على نحو يؤجل كل صياغة حضارية للمستقبل، وكل صياغة استراتيجية للفراغ العربي المتزايد الاتساع.
وربما يتيح المشروع الإيراني إطلاق أدوار عربية خلاقة للجدل معه, إذ ينطلق من شراكة حضارية مع العالم العربي تبتغي إيران نصيباً أكبر في قيادتها، بعكس المشروع الإسرائيلي الذي يطمح الى قمع كل دور عربي ممكن في إعادة صياغة المنطقة لأنه ينطلق من تناقض جذري معها، ويسعى الى طمس laquo;الشخصية الحضارية المستقلةraquo; للـ laquo;كتلة التاريخية العربيةraquo; بإحالتها الى مجرد كيانات في laquo;الشرق الأوسطraquo;:
فبينما ترتكز إسرائيل على الغرب كرصيد حضاري مفتعل وسياسي مؤكد, وتندرج في استراتيجيات عابرة للإقليم ترتبط بنزعات الهيمنة الأميركية، وتثبت فشلها في كل اختبار للتعايش مع المنطقة، فإن إيران لا ترتبط بمشاريع هيمنة عالمية، ولا تعدو باحثة عن مجال أرحب للقيادة الإقليمية تستحقه إذا ما تخلت عن مفهوم تصدير الثورة وهو ما نظن أن إيران تجاوزته عملياً أو على الأقل لم يثبت فشلها المؤكد في تجاوزه، لأن العالم العربي الذي دخل مع إسرائيل في حوار طويل لم يسفر إلا عن laquo;قانا 1raquo;, و laquo;قانا2raquo; لم يكلف نفسه أبداً فتح حوار جاد و laquo;علنيraquo; مع إيران, مكتفياً باتهامها عن بعد بالمسئولية عن عدم استقرار المنطقة لأنها أحيانا ذات مشروع إسلامي ثوري, وأحياناً أخرى ذات مشروع قومي فارسي من دون ضبط للمصطلح أو تدقيق للتاريخ.
وبينما سعت إيران ولا تزال إلى كسب ود الدول العربية الكبرى وفي مقدمها مصر والسعودية، وتدخل فى تحالف ملموس مع سورية، فإن إسرائيل لم تعد تكترث بدول المنطقة الكبرى, ولا تزال ترى فى مصر، بحسب ما قال فرويد يوماً، عقدة وجودها في الواقع ودليل هامشيتها في التاريخ، ما يجعل الخلاف بينهما على قيادة المنطقة خلافاً وجودياً في الحقيقة لا يخفيه موقتاً سوى تجميد مصر دورها وحصره في العقد قبل الأخير في مجرد الوساطة بين العرب وإسرائيل، وهو ما تقلص في النصف الأول من العقد الحالي الى الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل، ثم فى السنوات الثلاث الأخيرة الى مجرد الوساطة بين الفصائل الفلسطينية نفسها، وهو دور صغير وثانوي لم يكن أبداً هو دورها أو قدرها، ولا شك عندي في سفور هذا الخلاف وبأكثر درجات الحدة بمجرد أن تعود مصر الى ممارسة دورها في إعادة صياغة المجال العربي من حولها.
وبينما تمتلك إسرائيل سلاحاً نووياً متقدماً يدفعها الى العربدة الإقليمية ويمنحها صك أمان نهائي ضد ردود فعل ضحاياها، لم يبذل العرب جهداً يذكر لنزعه منها بغض النظر عن استحالة ذلك واقعياً، وهم يبدون معارضة خفية وظاهرة لبرنامج إيران النووي الذي يبدو حتى الآن سلمياً, وحتى إذا ما صار عسكرياً فمن المستحيل استخدامه ضد جوارها العربي الذي يزخر بالعنصر الشيعي المفترض ولاؤه لها بحسب ما يدعي مناقضوها, والمؤكد قرابته الدينية والحضارية لها حسبما تشي معطياتها.
هذه الدواعي جميعاً تفضح عجز العالم العربي عن المناورة الخلاقة بين الطموح الإيراني الأكثر مشروعية، والإسرائيلي الأكثر عدائية، إذ يميل الى التعامل بشدة غير مبررة مع إيران لدرجة التجاهل، وبمرونة زائدة مع إسرائيل. وهذا الميل لا ينبع من مساحة أو عمق التناقض الحقيقي مع كلتيهما, وإنما من الحاجة الى الحفاظ على الأمر الواقع, والإحجام عن بذل أي جهد سياسي لاستثمار الفرص ودرء المخاطر.
وفي هذا السياق تكمن ميزة إسرائيل الحاسمة في وجود إطار يُسمى بعملية التسوية وهو إطار معقد صار مُستهلكاً وبالياً وربما مذلاً, إلا أنه يبقى قابلاً لأن تحال عليه سلوكيات تبدو في الظاهر سياسية تنزع الى تحقيق laquo;السلامraquo; وهي في الحقيقة لا تعبر إلا عن laquo;غياب السياسةraquo;. ويضيف إلى هذه الميزة الإسرائيلية كون إطارها المحيط مشمولاً بالرعاية الأميركية حتى صار أقرب إلى محطة تتم خلالها عملية laquo;غسيل للسياسات الداخليةraquo; لدى دول المنطقة، فكل ما تختلف عليه مع الولايات المتحدة يمكن مبادلته بقبول أوسع للتصور الإسرائيلي, وكلما زادت التهديدات الإسرائيلية كلما زادت المناشدات والتنازلات الى الولايات المتحدة، وتكون النتيجة النهائية نقصاً مزدوجاً من الأرصدة السياسية، ونزيفاً مستمراً للكتلة الحضارية العربية بما يؤدي الى ذبولها ثم تشققها أمام تيارات الإرهاب العدمي التي تجد في هذا الفراغ أفضل بيئة للنمو وأكبر مجال للتمدد.
وفي المقابل لا تمتلك إيران مثل هذا الإطار، فقد خرجت الثورة الإسلامية مباشرة الى حرب السنوات الثماني التي شنها صدام حسين بإغواء من الغرب أو من شيطان الاستبداد، ثم خرجت المنطقة كلها الى حرب عاصفة الصحراء في ظل تحالف أميركي - عربي laquo;استثنائيraquo;، وذلك في مقابل إطار laquo;استثنائيraquo; للتسوية السلمية بين العرب وإسرائيل بدأ بمدريد وانتهى بـ laquo;قانا2raquo; وظلت إيران على مسافة منه. وفي هذه المراحل جميعها لم يُتح للطرفين العربي والإيراني شق قناة جادة للحوار المباشر, فدار الحوار عبر الإعلام ومن خلال الصور النمطية الغربية التي غذت الهواجس والشكوك العربية إزاء إيران.
وعلى العكس من إسرائيل، لا يحظى التفاعل مع ايران بضمانة أميركية، بل إنه محاط بصاعق سياسي لا يكاد أحد يقربه إلا وأصابه من الكوارث بقدر جرأته أو غفلته وإلى الدرجة التي لم يطرح معها زعيم عربي على نفسه هذا السؤال الجاد: إذا كانت إيران حاضرة واقعياً في القضايا العربية الملتهبة على النحو الذي يدعيه الجميع، فلماذا لا يتم الحوار معها وصولاً الى توافق عقلاني حول تلك القضايا ووضع سقوف ممكنة يمكن الدفاع المشترك عنها، حتى لا تبقى إيران مثل laquo;الفاعل الشبحraquo; تطرح تأثيراتها من داخل فضاء مظلم، ما يمنحها فرصة التأثير، ويعفيها من عبء الحساب؟
هذا التوافق العقلاني إذ يتطلب قدراً كبيراً من المرونة الاستيراتيجية، إنما يقتضي إرساء الحوار العربي - الإيراني على قاعدة ديموقراطية جوهرها دعم إيران للخيارات الإقليمية التي يتوافق العرب حولها ويرونها صالحة لهم وليس ما تتصوره هي واجباً عليهم، وفي المقابل على العرب ان يكونوا بمثابة الجسر بينها وبين الغرب تكريساً لخيارات عقلانية تقوم على الحوار والحلول السلمية وعلى حفظ حقوقها العادلة في امتلاك التكنولوجية النووية، أو على الحياد الإيجابي إذا اختارت هي المواجهة مع الولايات المتحدة فلا يسمحون لأحد بالهجوم عليها من الأرض العربية أو الزج بهم دعائياً وسياسياً في مخطط لحصارها والضغط عليها.
وفي المقابل على إيران أن تتحدث بلغة واضحة مستقيمة، وأن تقدم ما يثبت للعرب من غير حلفائها (سورية وحزب الله وحماس) أنها تقف معهم في الخندق نفسه، وأنها لا تأخذ هؤلاء الحلفاء كرهينة لديها أو تسعى لتوظيفهم ضد المصالح العربية، وأن تقدم لمحيطها الخليجي بالذات من الضمانات ما يكفي لطمأنته، ولدولة الإمارات العربية تحديداً من التعهدات ما يضمن لها إخضاع قضية الجزر الثلاث للتحكيم الدولى، ناهيك عن إحترام الرؤية العربية لمستقبل العراق الموحد وللدور السنّي فيه.
وفي هذا السياق يتوجب على سورية أن لا تجعل من نفسها مخلب قط إيراني في الساحة العربية وخصوصاً في لبنان، بل جسراً بين الطرفين تحقيقاً للتوافق العقلاني المنشود، وحماية للمنطقة من الفوضى. ذلك أن الفوران السياسي الناجم عن العاصفة اللبنانية يبقى الأفق مفتوحاً على كل الاحتمالات، وحيث السجال يزداد اشتعالاً داخل إسرائيل بين قراءتين متناقضتين للواقع والمستقبل معاً، إحداهما ترى الحل في تسريع خطى التسوية السلمية باستنتاج أن العاصفة اللبنانية جاءت نتيجة للإبطاء فيها، وهذه القراءة تقود الى الحوار مع سورية، وإن بقي الأمر رهناً بالفصول المقبلة من المنازلة النووية بين أميركا وإيران، فقد تلجأ الولايات المتحدة لهذا الحوار لعزل سورية والاستفراد بإيران قبل مواجهتها، وقد تنتهي المنازلة بصفقة مع إيران تقود الى التشدد الإسرائيلي مع سورية، وأتصور أن التصالح العربي - الإيراني عبر الجسر السوري هو الضمانة الأكيدة لعدم عزل أي من البلدين وتجميد سيناريو الفوضى الإسرائيلي / الأميركي. وثانيتهما ترى الحل في مزيد من إعمال القوة باستنتاج أن ما جرى في لبنان يرجع الى تهاون إسرائيل في استخدام القوة مع حزب الله! وهو خيار قد تلجأ اليه الحكومة الحالية هروباً الى الأمام بمزيد من التورط العسكري لإقناع الرأي العام الإسرائيلي بجدارتها، أو الحكومة المقبلة، وهي غالباً أكثر يمينية وتشدداً، إثباتاً لحزمها وقدراتها.
وفي الحالين، لا سبيل أمام سورية إلا العودة للإلتحام بالكتلة العربية، خصوصاً المحور الثلاثي الذي صنع حس الإتجاه العربي طيلة العقدين الأخيرين، والذي جمعها مع مصر والسعودية، رفاق الأمس واليوم والغد، وعدم التعويل فقط على تجربة laquo;المقاومة الوطنية الباسلة والمشروعةraquo; التي استطاعت فعلاً جرح كبرياء إسرائيل وكشف قصوراتها وتعطيل مشروعها، لكنها بالقطع لا يكفي للتحرك الى الأمام، فإذا كان من العبث التقليل من التجربة الفذة لحزب الله، فمن الخطر التعويل عليها وحدها في صنع المستقبل، الذي لا تملكه سوى القدرات الكبيرة والإرادات النافذة، حتى لا تبقى الجغرافيا العربية رهينة فراغ، والمصير العربي أسير فرقاء.






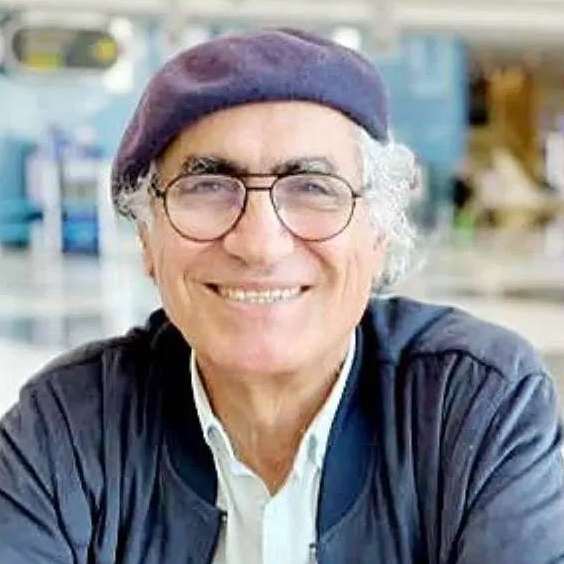










التعليقات