محمد نور الدين
في ال 17 من أيلول / سبتمبر 2018 اتفقت روسيا مع تركيا بموجب اتفاقية خفض التصعيد في منطقة إدلب على ترتيبات عسكرية من نقاط عدة، تقضي بإقامة منطقة نزع السلاح الثقيل بين قوات المعارضة المسلحة وقوات الجيش السوري، وانسحاب عناصر التنظيمات المسلحة من بعض المناطق (إلى أين؟)، وفتح بعض الطرقات الرئيسية التي تصل حلب باللاذقية وحماة وغيرها، وفي الوقت نفسه تسيير دوريات تركية - روسية في مناطق نزع السلاح.
هذه الاتفاقية أضيفت إلى اتفاقية خفض التصعيد التي تلحظ إقامة نقاط مراقبة خاصة بالجيش التركي بلغ عددها 12 نقطة على الأقل.
خرج الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في نهاية الصيف الماضي في سوتشي يتحدثان عن الإنجاز الذي كان يفترض أن ينتهي تطبيقه مع نهاية عام 2018.
لكن الذي ظهر أن ما اتُفق عليه كان كتابة على الرمل ولم ينفّذ منه شيء. وكانت موسكو تخترع التبريرات لتعطي تركيا مهلاً جديدة وشهراً بعد شهر لتنفيذ الاتفاق. وها قد وصلنا إلى نهاية الشهر التاسع، ونقترب من الذكرى السنوية الأولى، ولم ينفذ منه شيء مهم وعملي.
قبل أيام خرج وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف منتقداً تركيا بشدة، ومحمّلاً إياها مسؤولية هجمات المسلحين على الجيش السوري، بل على قاعدة حميميم الروسية قرب اللاذقية بطائرات من دون طيار.
معزوفة الوزير الروسي تتكرر كل مدة، والنتيجة واحدة، وهي استمرار المراوحة في ملف إدلب وغير إدلب.
توقف الدعم الروسي الميداني للجيش السوري عند بوابة إدلب، وشرّع الأبواب واسعة أمام غزوات الجيش التركي لمنطقتي جرابلس وعفرين.
لا شك أن ملف الدعم الروسي لتركيا هو ملف خلافي بين دمشق وموسكو. ولكن دمشق ليست في ظروف تتيح لها التحرك منفردة، لأنها بكل بساطة غير قادرة. انتصارات الجيش السوري على المعارضة كانت بالتعاون والشراكة مع روسيا وإيران وآخرين، وكانت لمصلحة كل هذه الأطراف. لذلك فإن دمشق محكومة بالتفاهم والتعاون والتنسيق مع روسيا أولاً وإيران ثانياً.
اتفاقية خفض التصعيد في إدلب واتفاقية منطقة منزوعة من السلاح الثقيل وتسيير دوريات مشتركة روسية تركية تمنح أنقرة مشروعية عملية، لا قانونية، لاحتلالها منطقة إدلب وسائر المناطق الأخرى، وتثبّت «أمرَ واقع» جديداً بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة، كما لو أنها منطقة حدودية بين دولتين، وهذه سابقة في الحرب السورية.
في هذا الوقت، وفي تطورات مرتبطة عضوياً بالوضع في إدلب ارتفعت مؤخراً النقاشات حول مسألة صواريخ «إس 400» الروسية، وما إذا كانت تركيا سترضخ للضغوط الأمريكية، وتلغي الصفقة. لكن أردوغان خرج مؤكداً أنه لا إلغاء للصفقة مع تحديد روسيا لتسليم الصواريخ خلال شهرين.
التأكيد التركي لاستمرار اتفاقية الصواريخ يؤكد أن اتفاقية التاسع من أغسطس / آب 2016 بين بوتين وأردوغان في سانت بطرسبرغ وضعت حجر أساس لصفقة مصالح متبادلة تقضي بما يلي:
1- موافقة أنقرة على مدّ خط أنابيب «السيل التركي» من روسيا تحت البحر الأسود، ومنها عبر تركيا إلى أوروبا، وبذلك تتحرر روسيا من ارتهانها لخط أنابيب الغاز الوحيد لها، والذي يمر بأوكرانيا.
2- موافقة أنقرة على تلزيم روسيا إنشاء مفاعل نووي في مرسين، وهو إنجاز روسي في الاستثمار الخارجي.
3- موافقة أنقرة على شراء منظومة الصواريخ الروسية «إس 400» بما يشكل خرقاً لمنظومة عسكرية لدولة في حلف شمال الأطلسي.&
في مقابل هذه المكاسب الروسية، فقد حصلت أنقرة على مكاسب لا تقل أهمية بالنسبة للأمن القومي التركي والمطامع التركية في الأراضي السورية (والعراقية تالياً):
1- دخل الجيش التركي مباشرة بعد اتفاقية التاسع من أغسطس 2016 إلى سوريا تحت اسم «درع الفرات»، محتلاً المنطقة الممتدة من جرابلس إلى أعزاز نزولاً إلى الباب.
2- احتلال تركيا منطقة عفرين في مطلع عام 2018 تحت مسمى «غصن الزيتون».
3- تثبيت تركيا سيطرتها وتحكمها بمنطقة إدلب عبر اتفاقية خفض التصعيد واتفاقية 17 سبتمبر / أيلول 2018.
4- وهذا فتح أمام تركيا الباب واسعاً لتكون لاعباً شريكاً في الأزمة السورية، عبر مسار أستانا، مستعيدة دوراً كاد يتلاشى لولا اتفاقيتي التاسع من أغسطس وال 17 من سبتمبر. وبموجبهما سيطرت تركيا على شريط حدودي واسع داخل سوريا، وثبّتت دورها كلاعب في تقرير مستقبل سوريا والحل النهائي المفترض.
لذلك فإن تركيا لا يمكن لها إلغاء اتفاقية الصواريخ مع روسيا، كما أن روسيا لا تستطيع ولا ترغب في الضغط على تركيا عبر عملية عسكرية واسعة يشنها الجيش السوري. فأي إلغاء متبادل يعني انهيار مكاسب الطرفين. لذا فإن تحريك جبهة إدلب الآن ليس أكثر من ذرّ الرماد في العيون، وليس سوى جزئيات ميدانية تافهة لاعتبارات روسية أولاً وأخيراً (مع امتعاض واضح لدمشق)، ليبقى تفاهم المصالح بين روسيا وتركيا، وبالتالي الواقع الميداني الحالي قائمين إلى حين التوصل إلى تسوية للأزمة السورية.
&








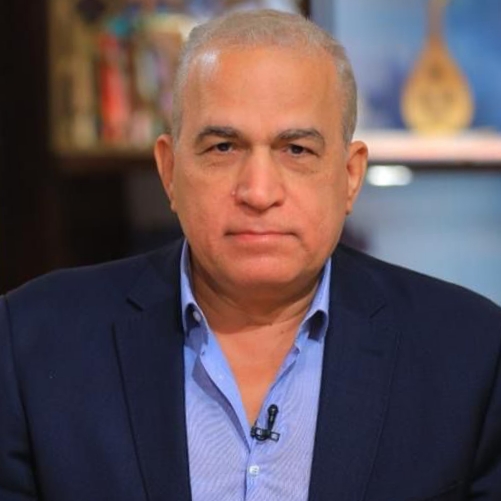







التعليقات