عبد الله المدني&
كان الاعتقاد السائد في إندونيسيا أن مشكلات البلاد تكمن في الديكتاتورية السوهارتية، بمعنى أن التخلص منها سيفتح الأبواب أمام الارتقاء والنهوض. نسي أصحاب هذا الرأي أن دول الشرق الأقصى -باستثناء اليابان- حققت نهضتها المشهودة في ظل أنظمة حكم ديكتاتورية راوحت بين عسكرية قمعية (كوريا الجنوبية) ومدنية رحيمة (سنغافورة). كما غاب عنهم أن السوهارتية نجحت خلال 30 عاما من القبضة الحديدية في إحداث ما يسمى بالدولة العميقة التي لا يمكن التخلص من رموزها وآثارها بين ليلة وضحاها، بدليل أن مشكلات البلاد ما زالت باقية على حالها بل في حالة تفاقم رغم تبدل الحكومات والوجوه السياسية عدة مرات خلال العقدين الماضيين.
اليوم، وبعد مرور نحو عقدين من سقوط نظام الجنرال سوهارتو، تواصل إندونيسيا تجربتها الديمقراطية التي كان آخر شواهدها الانتخابات الرئاسية الأخيرة في نيسان (أبريل) من العام الجاري التي منح فيها الشعب صوته مجددا للرئيس جوكو ويدودو كي يحكم لفترة رئاسية ثانية تنتهي عام 2024.
ومن نافلة القول: إن ويدودو يواجه تحديات جمة في سبيل بلوغ الأهداف التي وضعها لبلاده وعلى رأسها تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 7 في المائة، وضرب أوجه الفساد والمحسوبية المتوارثة من عقود سابقة، وإحداث إصلاحات جذرية في الجهاز البيروقراطي المنيع، ومعه الجهاز القضائي المخترق من ذوي النفوذ، وهما جهازان ما برحا يقفان عائقا أمام تحقيق قفزات اقتصادية مشابهة لتلك التي حققتها الدول الآسيوية المجاورة لإندونيسيا.
وإذا كانت هذه الأهداف معلنة ويجري الحديث عنها على رؤوس الأشهاد من غير مواربة، بل يسعى الرئيس إلى تنفيذها من خلال إحاطة نفسه بمجموعة من الشباب من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات العملية في مجالي الابتكار والتطوير والثورة الرقمية "على نحو ما حدث أخيرا حينما سمى 12 من الشباب الموهوبين ممن تراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما ليكونوا ضمن فريقه الاستشاري، وأردف قراره بإطلاق تغريدة قال فيها إنه سيجتمع بهم كل يوم إن دعت الحاجة وليس كل شهر، إضافة إلى منحه 18 حقيبة وزارية في حكومته الجديدة المؤلفة من 34 وزيرا لشخصيات جديدة غير تقليدية، فإن الحديث عن ضرب قوى التشدد والتطرف، يجري بحذر شديد نظرا لحساسية الموضوع في مجتمع يمكن وصفه بالمؤدلج كنتيجة لتغول بعض القوى الدينية في مفاصله الحيوية منذ تدشين عملية التحول الديمقراطي والسماح بالحريات السياسية بعد سقوط نظام الديكتاتور سوهارتو عام 1998.
الأمر الآخر المحبط لخطط الرئيس ويدودو هو أنه في الوقت الذي قرر فيه الرجل الاعتماد في خططه الإصلاحية على القوى الشبابية المؤهلة الصاعدة، قرر فيه نائبه معروف أمين المحسوب على التيار الإسلامي "يشغل إلى جانب منصب نائب رئيس الجمهورية رئاسة أعلى هيئة دينية في البلاد ممثلة في جمعية العلماء الإندونيسيين" إحاطة نفسه بفريق عمل مضاد مكون من الساسة القدامى التقليديين من بقايا الحقب السياسية السابقة لضمان ديمومة مصالح فئوية وجهوية. وغني عن القول: إن هذا المنحى لا يترك لويدودو فرصة للتقدم خطوة في مشروعه التحديثي الهادف إلى الارتقاء بإندونيسيا ولو بصورة نسبية.
يعرف ويدودو يقينا أن نجاحه في فترته الرئاسية الثانية يعتمد كثيرا على التخلص من آفتي التشدد والتطرف اللتين ابتليت بهما إندونيسيا منذ انتهاء حرب الجهاد في أفغانستان وعودة من ذهب من مواطنيه إلى تلك الديار ثم عاد ليروج لأفكار ومفاهيم لم تكن شائعة على نطاق واسع في الأرخبيل الإندونيسي. ويعرف أيضا أن تلك المفاهيم تشكل معضلة وعائقا أمام استتباب الأمن والاستقرار في بلاده وبالتالي يضر بصورة إندونيسيا كملاذ آمن للاستثمارات الأجنبية ومصدر جذب سياحي، خصوصا في ظل التقارير القائلة إن مخلفات تنظيم داعش وأخواته تنظر إلى منطقة جنوب شرق آسيا -تحديدا إندونيسيا بسبب طبيعتها الجغرافية- كمكان جديد لنقل أنشطته التخريبية.
ومن هنا يمكن معرفة دوافع قرار ويدودو أخيرا بتعيين عدد من الرموز العسكرية والأمنية القديمة في حكومته من أمثال الجنرال المتقاعد بروباو سوبيانتو صهر سوهارتو السابق وقائد قواته الأمنية الخاصة كوزير للدفاع منافسه في آخر انتخابين رئاسيين، ناهيك عن استدعاء كل من الجنرال المتقاعد فخرالله راضي وتيتو كارانافيان الرئيس السابق لجهاز الشرطة وتعيينهما وزيرا لشؤون الأديان ووزيرا للداخلية على التوالي.
والحال أنه يمكن اعتبار الحالة الإندونيسية هذه حالة نموذجية للصراع بين قوى التحديث والبناء التي يقودها ويدودو، والقوى المتشددة المتمسكة بأيديولوجيات عفا عليها الزمن. ولعل الأيام المقبلة ستثبت إن كانت الفئات الشبابية المتعلمة والمدعومة من الرئيس قادرة على تنفيذ طموحاته وبرامجه والوقوف في وجه رموز التيار الديناصوري العتيق ومعهم وزراء الحكومة العواجيز، أم لا؟






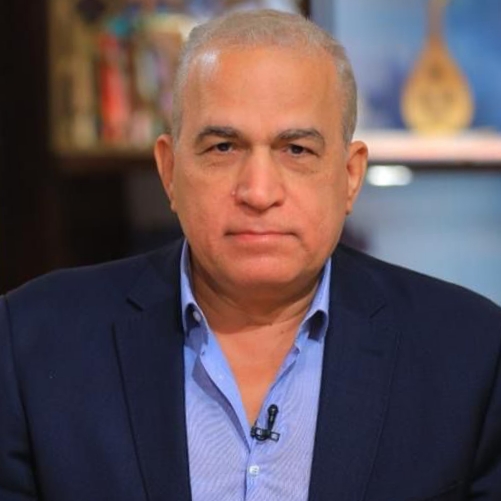









التعليقات