لتونس إيقاع خاص، ثقافياً، وفنياً، وسياسياً، يميزها عن بلدان المشرق العربي وشمال أفريقيا، منذ منتصف القرن الماضي، ويظهر ذلك في طرق مقاربتها للقضية الفلسطينية والوحدة العربية والناصرية واللغة والعلاقة مع الآخر الأوروبي والمرأة والحرية الفردية.
تونس بلد ظل عبر القرون محصناً من ناحية الأيديولوجية الدينية بجامع الزيتونة، الذي منحها إسلاماً تونسياً، بخصوصية محلية، أي مرتبطاً ومشتبكاً بالتقاليد الاجتماعية والحضارية والتاريخية والجمالية لهذا البلد الشمال أفريقي.
إن فكرة "التونسة"، التي دافع عنها الرئيس الحبيب بورقيبة دفاعاً مستميتاً، ومنحها بعداً سياسياً عميقاً، لم تتأسس على قاعدة الإسلام السياسي، أو العروبة، كما هي فكرة "الجزأرة" في الجزائر التي أطلقها جناح في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الفيس) في مطلع تسعينيات القرن الماضي، والتي نحتت من رؤية الإسلام السياسي في ذلك البلد.
ويبدو أن تونس من الناحية الأيديولوجية، عاشت القرن العشرين مستقلةً دينياً إلى حد كبير عن الأزهر، أو تكاد، بالتالي حمت نفسها مبكراً من أيديولوجيا الإخوان المسلمين، ولو إلى حين، وذلك لأنها منذ الاستقلال، وتحت قيادة الحبيب بورقيبة، تبنت العلمانية والدفاع عن فكرة إقامة الدولة المدنية بوضوح، ومن دون نفاق سياسي، فتوجهت نحو أوروبا في البحث عن نموذج للدولة المنشودة، وحتى إن لم تكن "الزيتونة"، كمؤسسة أساسية المرجع للإسلام التونسي، على وفاق دائم مع النخب المعاصرة والمتحررة، إلا أنها ساعدت على بناء فكرة "الاكتفاء" الديني، فهي، أي "الزيتونة"، لم تكن رحيمة بالمثقفين والمفكرين والاجتهاديين من الفقهاء والمفكرين الإصلاحيين المتنورين، وما عاشه وعاناه المفكر والمثقف التنويري، الطاهر الحداد، صاحب كتاب "امرأتنا في الشريعة والمجتمع"، يشكل أحد فصول هذا الصدام بين الفكر التقليدي للزيتونة والفكر التنويري الذي ستتبناه لاحقاً "البورقيبية" في بناء الدولة المستقلة وتجعله قاعدةً لانطلاقها في معالجة مواضيع تحرير المرأة والدفاع عن الحرية الفردية التي كانت، ولا تزال، مكبوتة في دول عربية ومغاربية عدة، وبخاصة تلك التي تبنت النهج الاشتراكي كمصر، والجزائر، وليبيا، بعد انقلاب الفاتح من سبتمبر (أيلول) 1969.
إن وضوح التوجه في اختيار نموذج "الدولة المدنية" منذ وصول الحبيب بورقيبة إلى سدة الحكم في25 يوليو (تموز) 1957، جعل تونس تبدو، تحت "البورقيبية"، كجزيرة غريبة في عالم عربي ومغاربي يتراوح بين الملكية والاشتراكية والقومية.
وستعمل البورقيبة على المستوى الأيديولوجي على تنمية "التونسة" على المستوى السياسي والثقافي والديني والمؤسساتي، مستثمرةً في أفكار علماء تونس التنويريين أساساً، وعلى رأسهم ابن عاشور، والطاهر الحداد، وخير الدين التونسي (مؤسس المدرسة الصادقية)، وغيرهم.
ولأن "التونسة" فكرة ثقافية وحضارية، فقد زرعت لدى المثقف التونسي نوعاً من الافتخار والحس بنوع من الاختلاف عن غيره من المثقفين العرب والشمال أفريقيين، وقد قامت "التونسة" على اختيار الازدواجية اللغوية في التعليم، وفي إدارة مؤسسات البلاد، بينما اختارت الجزائر تجربة أيديولوجية لغوية مختلفة هي التعريب، على الرغم من أنها البلد الفرنكفوني الأول بعد فرنسا من حيث استعمال اللغة الفرنسية. وإذا كانت تونس البورقيبية قد نظرت إلى الفرنسية على أساس أنها لغة الانفتاح على الغرب، فإن النظام في الجزائر رأى في هذه اللغة بقيةً من بقايا الاستعمار التي تجب محاربتها.
وسمح الفضاء التونسي المفتوح والمختلف بالظهور المبكر للوجودية كتيار فلسفي وسلوكي أيضاً في الوسط الثقافي، قبل أي بلد مشرقي أو شمال أفريقي، ويمكن قراءة التجربة الروائية لمحمود المسعدي صاحب "السد"، و"مولد النسيان"، و"حدث أبو هريرة قال"، من هذه الزاوية. ويؤكد تفرد هذه التجربة الأدبية السردية، في البناء وفي اللغة وفي البعد الفكري والفلسفي، وانفتاح الثقافة والكتابة والفنون في تونس على تجارب الكتابة الغربية المعقدة مبكراً. ومن الناحية الاجتماعية - الثقافية فإن ظاهرة "جماعة تحت السور" تمثل انقلاباً حقيقياً في مفهوم المثقف، في الصورة وفي الممارسة وفي الإبداع، إذ استطاعت هذه المجموعة أن تجعل "مثقف الهامش" يحتل المركز الفاعل في المجتمع. وانتمى إلى هذه المجموعة أهم مثقفي تونس، نذكر من بينهم الشاعر أبو القاسم الشابي، والقاص الروائي علي الدوعاجي، والقاص محمود العريبي، والطاهر الحداد، والشاعر بيرم التونسي، وعبد العزيز العروي، الذين كانوا جماعةً متحررة من قيود التقليد في مواضيع الكتابة وحتى في السلوك اليومي. وتظل ظاهرة "جماعة تحت السور" فريدة من نوعها في شمال أفريقيا.
ويتميز المثقف التونسي عن غيره من المثقفين في المشرق العربي وشمال أفريقيا، في استراتيجية الكتابة، وفي طبيعة علاقته بالسلطة السياسية، فالهاجس المركزي لديه هو البحث عن إصلاح المجتمع أكثر من نقد النظام سياسياً، وكأن المثقف يعتقد أن بناء الدولة المدنية المعاصرة لا يكون إلا بمجتمع معاصر يتحقق فيه الوعي الذي يتقبل فكرة المساواة بين الرجل والمرأة، وتتحقق فيه الحرية الفردية أولاً، ويحتفى فيه بالمبادرة الاقتصادية الحرة، وهي مقاربة تختلف عن المقاربة التي تتبناها النخب الجزائرية عامةً، التي تبحث عن تغيير السلطة قبل تغيير المجتمع، أو بمعزل عن التفكير في تغيير المجتمع.
لذلك نجد مثقفين تونسيين تنويريين كثراً انخرطوا في مفاصل الدولة التونسية مبكراً، كمحمد مزالي، ومحمود المسعدي، والعروسي المطوي، ومحمد الشرفي، وغيرهم، وأسسوا لخطاب ثقافي معاصر متجدد من داخل المؤسسات.
وعلى الرغم من أن النظام التونسي في عهد الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011) تحول إلى نظام بوليسي بامتياز، فإن المثقف التونسي المنشغل أساساً بنقاش بناء مجتمع معاصر لم يغب عن الساحة، فظلت كتابات فكرية عالية ومتميزة حاضرة، من أمثال كتابات توفيق بكار، وهشام جعيط، ومحمد الطالبي، وعبد الوهاب بوحديبة، وفتحي التريكي، ومحمد محجوب، وشكري المبخوت، وغيرهم.
كما أن المجتمع التونسي، وعلى الرغم من التغيرات الأخيرة، عرف ويعرف أقلاماً فكرية نسوية عالية وشجاعة ومثيرة للجدل، من بينهن جيزيل حليمي، ورجاء بن سلامة، وهالة الوردي، ورشيدة تريكي، وغيرهن.
كما أن الـ"دياسبورا" التونسية (تونسيي المهجر) بخلاف مثيلتها الجزائرية، حافظت بشكل كبير على علاقتها بالبلد كتابةً وحياةً، وحققت منجزاً أدبياً وفكرياً مهماً يرتبط بأسئلة تونس، وأيضاً بأسئلة العالم الذي يحيط بتونس من أمثال عبد الوهاب مؤدب، وفتحي بن سلامة، والطاهر البكري، وفوزية الزواري، والحبيب السالمي، وأبو بكر العيادي، وغيرهم.
وظل المثقف التونسي محافظاً على قاموسه الثقافي والإبداعي في حواره ونقده للسياسي أو الديني، بالتالي تمكن من مواصلة ممارسة الثقافي من داخل الثقافة والفن والكتابة من دون أن ينفصل عن السياسي. وتشكل تجربة "بيت الرواية" في تونس الذي يديره الروائي كمال الرياحي نموذجاً لهذا السلوك الثقافي الوازن والذكي.
حين نتأمل المثقف التونسي منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن، سنجده يتميز بسيكولوجية جماعية واضحة المعالم مهما كان انتماء هذا المثقف، يسارياً أو يمينياً أو ليبرالياً أو إسلامياً، وهي سيكولوجية الهدوء والتعقل في مقاربات الأمور حتى ولو كانت ساخنة، فهو يناقش قضايا نارية بكثير من برودة الأعصاب لغةً وخطاباً وسلوكاً، بعكس ما تتميز به النخب الجزائرية من سيكولوجية جماعية حادة إن كان كثيراً أو قليلاً.








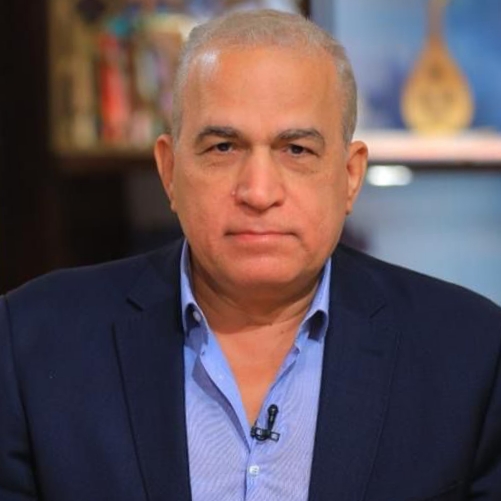







التعليقات