يخرج الرئيس ميشال عون من القصر الجمهوري أضعف بكثير من لحظة دخوله إلى هذا القصر، ولا يقتصر هذا الضعف على نتيجة الانتخابات النيابية والطالبية، إنما يتعدّاه إلى صورته الوطنية والسياسية والشعبية. الفرصة التي مُنحت للعماد ميشال عون بانتخابه رئيسا للجمهورية في 31 تشرين الأول 2016 استثنائية في ظروفها وطبيعتها لشخصية خرجت من القصر الجمهوري باجتياح عسكري سوري ونُفيت من البلد، وعودتها وضعتها في محور انقسامي خارج عن الثوابت التي انطلقت منها وحالت دون انتخابها لولا فراغ طويل وتعقيدات داخلية وتقلبات سياسية، إذ مَن كان يتوقّع انه بعد 26 عاما على هزيمة عسكرية وخروج قسري سيعود إلى القصر نفسه منتصراً وواعداً بأنه سيسلِّم الرئاسة والبلد بوضع أفضل بكثير ممّا استلمه؟
ما وعد به عون لم يتحقّق لا في وضع البلد الذي انحدر إلى الأسوأ ماليا وسياسيا واجتماعيا، ولم يكن هناك من يتصوّر ان أوضاع اللبنانيين ستسوء إلى هذا الحدّ، ولا في تسليم الرئاسة التي آلت إلى الشغور المفتوح، وفوّت على نفسه فرصة تاريخية وهي ان يُثبت بأنّ سعيه لرئاسة الجمهورية كان في محلّه متوّجاً هذا السعي بنجاحات في معظم المجالات والقطاعات.
ويستطيع فريق الرئيس عون ان يُكابر ويتحدّث عن انتصارات وهمية والدخول باكرا في مواجهات سياسية لإثارة الغبار على ما اعترى ولايته الرئاسية من نكسات وخيبات، ولكن الوقائع لا تُدحض بالمواقف، وأي مقاربة موضوعية لا يُمكن ان تخلص سوى إلى خلاصة واحدة وهي الفشل في إدارة سياسة البلاد الداخلية والخارجية، ومهما حاول هذا الفريق تغطية السماوات بالقباوات فإن انطباع الرأي العام اللبناني عن هذه الولاية يستحيل تغييره قبل مرور سنوات بل عقود، وهذه المرة لم تعد المسألة محصورة بالمسيحيين في سياق منطقة شرقية، إنما أصبحت على امتداد لبنان والشعب اللبناني الذي انتفض في 17 تشرين 2019 ضد منظومة حاكمة وفي طليعتها الرئيس عون.
وأثبتت ممارسة الرئيس عون للسلطة بأنه حليف حقيقي لـ»حزب الله» وتحديدا للشيعية الإيرانية التي أينما حلّت حلّ معها الخراب، وبعيدة كل البعد عن مفاهيم إدارة الدول، والدليل الساطع ما آل إليه وضع العراق مع استلامها لسلطته على رغم الثروات التي ينعم بها هذا البلد، ونقطة قوتها هي السلاح وعدم الاستقرار، فيما نقطة قوة عون هي المعارضة للمعارضة، وعندما سمحت له الفرصة بالحكم في مرتين متتاليتين كانت النتيجة كارثية، لأنه يمارس خلافا لما يُعلن، ويتكئ على البروباغندا وليس على الأفعال.
وقد أتيحت للرئيس عون فرصة نادرة كونه انتخب رئيسا للجمهورية بعد فراغ طويل وتفكُّك 8 و14 آذار وبدعم من القوى الأساسية على خلفية انه على مسافة واحدة من فريقي الانقسام وسيكون الجسر بين المتخاصمين، ولكنه أطاح سريعا بكل التفاهمات التي أبرمها قبل انتخابه باستثناء تحالفه مع «حزب الله» الذي استمر على ثباته منذ لحظة توقيعه في 6 شباط 2006، فيما كان الأولى به ان يحصِّن هذه التفاهمات إنجاحاً لعهده، إلا ان حسابات خلافته طغت على كل ما عداها، والنائب جبران باسيل كان بحاجة إلى صدامات ومواجهات انتزاعاً لمشروعية داخل تياره وعلى المستوى المسيحي بأنه قادر على مواجهة «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وحركة «أمل» بهدف ترسيخ الانطباع بأنه الأقدر على تولّي هذه الخلافة.
فالنائب باسيل يفتقد إلى المشروعية السياسية ولا يكفي ان يكلِّفه الرئيس عون برئاسة «التيار الوطني الحر» والتكتل النيابي ليكسب هذه المشروعية، فدخل في مواجهات بالمفرّق والجملة وفي سباق مع الوقت إلى أن فَرملت ثورة 17 تشرين توجّهه الصدامي، فيما لو وضع رئيس الجمهورية أولوية الحكم على الخلافة لكان اختلف الوضع كثيرا، لأن شرط الخلافة نجاح العهد لا فشله، إذ كيف يمكن القبول باستمرارية لعهد فاشل، فضلا عن ان دعم «حزب الله» لعون لم يُفض إلى انتخابه سوى بعد تأمينه توافقات مسيحية وسنية ودرزية، هذه المرتكزات بالذات التي أطاح بها باسيل في سياق سعيه إلى المشروعية.
ولم تقتصر التناقضات والخلافات وتصفية الحسابات فقط مع القوى السياسية، إنما دخل في خصومات مع أقرب المقربين إليه بدءا من دائرة عائلته وتياره، وصولا إلى الدائرة التي ساهمت في تلميع صورته، وقد يكون الفريق السياسي الأوحد الذي شهد هذا الكمّ من الاستقالات من تياره على مدى السنوات وإبّان فترة رئاسته للجمهورية، وهذا الجانب دليل فشل كبير ومَكمن ضعف بنيوي، لأن قوة اي فريق تكمن في تحصين دوائره اللصيقة وتوسيعها وليس تفجيرها وتفكيكها.
والنجاح او الفشل يُقاس بالقدرة على تحقيق خطوات معينة وملموسة للناس، الأمر الذي تحقّق عكسه، كما يُقاس بقوة العلاقات التي نسجها مع أفرقاء الداخل، ومنطق المؤامرة ساقط وغير قابل للتسويق، لأن القوى التي انتخبته لم تنتخبه بقوة السلاح ورغماً عنها، إنما سلوكه السياسي أدى إلى تنفيرها، خصوصا ان هذه القوى ليست قوة واحدة وهي متخاصمة والتقت على انتخابه ظنّاً منها انّ هناك فرصة بعد فراغ طويل، وان هذا الرجل الذي سعى في كل حياته إلى رئاسة الجمهورية يريد ان يتوِّج مسيرته ببصمات بيضاء، ويُقاس أيضا بعلاقاته الخارجية التي شهدت أكبر انتكاسة عرفها لبنان في تاريخه مع تراجع العلاقات مع دول الخليج بشكل غير مسبوق.
وليس من السهل تبرير الفشل المثلّث: الفشل في إدارة السياسة الداخلية المتعلقة بسياسة الدولة المالية والإدارية والإصلاحية، والفشل في إدارة العلاقات السياسية مع القوى والكتل البرلمانية، والفشل في إدارة السياسة الخارجية، وإذا كان مرفوض ان يُحكم لبنان من الخارج، إلا انه لا يحكم ضد الخارج، حيث تحوّل إلى منصة ضد استهداف الدول الخليجية، ويستطيع هذا الفريق ان يقول ما يشاء، ولكن هناك حقيقة ساطعة انه حتى حليفه «حزب الله» لم يجرؤ على تبني ترشيح باسيل على رغم تحالفه الوثيق معه وتأمين كل الدعم اللازم له في الانتخابات النيابية، فيما القوى السياسية على اختلافها قد تختلف حول كل شيء وتتّفق على شيء واحد وهو استبعاد هذا الفريق عن رئاسة الجمهورية.
وإذا كانت القوى السياسية متآمرة عليه بسبب رفضها الإصلاح كما يدّعي، وهذا ليس صحيحا، فالرأي العام العريض الذي هو عابر للأحزاب والطوائف انتفض ضده ويعتبر تجربته من أسوأ التجارب التي عرفها البلد، والحاضنة الشعبية التي شكلت أحد عواميد قوته غادَرته وابتعدت عنه وانكفأ إلى داخل تياره، ولن يكون من السهل عليه استرداد شعبيته بعد خروجه من القصر الجمهوري، لأنّ المعارضة قبل رئاسة الجمهورية شيء، وبعدها شيء مختلف تماماً، خصوصا في ظل الانطباع الراسخ لدى شريحة واسعة من الرأي العام بأنّ هذا الفريق جرِّب وتجربته كانت سيئة للغاية، والناس لن تترحّم على هذا العهد، إنما سيكون لسان حالها: ينذكَر ولا ينعاد.
وفي موازاة كل ذلك هناك شريحة من الناس تتموضع إلى جانب الفريق الذي يملك أدوات الحكم والسلطة بعيدا عن المبادئ والمسلمات، وبعد خروجه من السلطة وخسارته لهذه الأدوات سيفقد جزءا واسعا من هذه الشريحة مهما احتفظ بوزارات وإدارت، ومن المفيد المقارنة بين انتخابات 2018 التي شكّل فيها عامل جذب للشخصيات التي تريد الترشُّح على لوائحه، والانتخابات الأخيرة التي ابتعد فيها الجميع عنه على رغم انه كان ما زال في موقع الرئاسة الأولى، فكيف بالحري بعد خروجه النهائي من القصر الجمهوري.
والسؤال الأساس الذي يطرح نفسه: ألم يكن من الأفضل للعماد ميشال عون لو لم يُنتخب رئيساً للجمهورية، فكان بقي في نظر شريحة واسعة فرصة للبنان حالت دونها بعض القوى السياسية، وذلك بدلاً من رئاسة بدّدت معظم الرصيد الذي راكَمه في تاريخه الطويل سعيا إلى هذا الموقع؟ فلو لم يحكم الرئيس عون لكان حافظ على صورته، هذه الصورة التي كانت أفضل بكثير قبل دخوله إلى القصر الجمهوري، وبدلاً من ان تعزِّز الرئاسة الأولى موقعه ودوره وشعبيته، إذا بها تكشفه على حقيقته بأنه باحث عن سلطة وعاجز عن إدارة دولة وبلد، والفشل الذي نسبه إلى الحرب إبّان رئاسته لحكومة انتقالية، تثبّت إبّان رئاسته للجمهورية في زمن السلم بأن لا علاقة للحرب ولا للسلم في ما آلت إليه البلاد عندما قبض على السلطة، إنما كل المسؤولية تقع على طريقة إدارته السياسية.
ولأن الأمور تقاس بنتائجها، فإن الخلاصة الأساسية لتجربة الرئيس عون السياسية انه في كل مرة استلم فيها السلطة أوصَل لبنان إلى الكارثة، وهذا ليس وليد الصدفة ولا المؤامرات، إنما نتيجة عدم اتقانه فنّ ومعنى إدارة الدولة، فوظيفة الحاكم تلافي الحروب والحدّ من الخسائر وتحقيق الاستقرار والازدهار، وهذا ما يتناقض مع مفاهيم عون في الحكم، فلو لم يعلن مثلاً حرب التحرير في آذار 1989 لما سلكت الأمور المنحى الذي سلكته، ولم يعلن الحرب سوى لأنّ همّه تثبيت استمراره في القصر الجمهوري كرئيس للجمهورية وليس كرئيس حكومة انتقالية، فيما لو كانت أولويته إنهاء الشغور الرئاسي لكان ربح في انتخابه او عدمه من خلال الظهور بمظهر الحاكم الذي يولي الأهمية لبلده وشعبه لا لشخصه، ولو لم يضع أولوية خلافته لباسيل لكانت الأمور سلكت أيضا باتجاهات مختلفة.
وعلى رغم إضاعة الرئيس عون للفرصة الأولى بين عامي 1988 و 1990 إلا انه استفاد من فرصة ثانية نادرة، ولن يكون له بعد اليوم فرصة ثالثة لخليفته، لأنّ ما تركه خلفه من خصومات وتناقضات وانهيار ونقمة شعبية وسياسات داخلية وخارجية أدت إلى ما أدت إليه لن يكون من السهل نسيان ما حفل به عهده سوى بعد مرور زمن طويل، ولن يكون من السهل عليه تعويض خساراته، والمعارضة هذه المرة لن تكون مربحة مع فريق استنزَفته السلطة وكَشفته، إنما خروجه من السلطة سيُفاقم خسائره، وعون بعد الرئاسة غير ما قبلها.






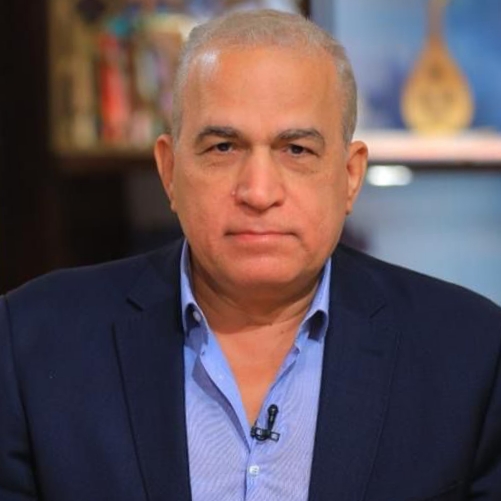








التعليقات