في مهب العواصف ومع امتداد شبح الحرب فوق «بلاد الأرز»، سُئل الوزير اللبناني الذي عمل سابقاً في مؤسسات إعلامية فرنسية عن رأيه في معالجة المسألة اللبنانية، فلم يتردد في الإجابة فوراً: «إلغاء الطائفية السياسية». فكرة جد شائعة لبنانياً في الكثير من الأوساط المذهبية، كما في العديد من الأوساط التغييرية العلمانية، على حدّ سواء. ومع أن المجمعين على «إلغاء الطائفية السياسية» لا يدركون بالضرورة الفكرة بالطريقة نفسها، فهم على ثقة بأنها هي الحل المنشود، وليس من حل سواها. وهم يستغربون كيف يمكن لأحد عدم تبنيها.
لكن في الحقيقة، ليس من عبارة تختصر المتاهة اللبنانية، وتكتنز كل ما تتضمنه من ضياع وجهل وتناقض أكثر من هذه العبارة الواحدة. وهذه بعض مدلولاتها:
يعني «إلغاء الطائفية السياسية» إلغاء الصيغة اللبنانية برمتها. ومن دعاة الإلغاء من يدرك ذلك، ومنهم من لا يدركه. والمطالبة بـ«إلغاء الطائفية السياسية» تعبير مموّه، قابل للرواج أكثر من المطالبة بإلغاء الصيغة اللبنانية، مع أن الفكرة هي نفسها بالتمام. رغم ذلك، لا تتعجب إذا سألت مطالباً بإلغاء الطائفية السياسية إذا كان يريد إلغاء الصيغة اللبنانية، فأجابك: «كلا قطعاً، أنا مع الصيغة». فهو يقول، من دون أن يدري، الشيء ونقيضه.
ويرجع ذلك، على الرغم من التجارب الراهنة القاسية، إلى عدم إدراك المسألة اللبنانية في جوهرها وفي تاريخها. فمعظم المحللين يربط الصيغة اللبنانية بميثاق 1943، أو في أحسن الأحوال بقيام «لبنان الكبير» عام 1920. لكن في الحقيقة، لا يمكن فهم الصيغة اللبنانية إلا بالعودة إلى نشأتها عام 1861. فهذه الصيغة هي أقدم نظام سياسي في الشرق الأوسط، وهي قائمة منذ 163 عاماً (باستثناء سنوات 1915 - 1918 الثلاث)، إذ استمرّت على التوالي في «متصرفية جبل لبنان»، ثم في «لبنان الكبير» تحت الانتداب الفرنسي، ثم في لبنان المستقل.
فلتجنّب حل التقسيم الذي فشل آنذاك وقاد إلى مآسي 1860، كان لا بد من إيجاد صيغة لتعايش الجماعات الست الموجودة في جبل لبنان، الموارنة والدروز والسنة والشيعة والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك، فكانت «الصيغة اللبنانية»، التي هي فيدرالية مجتمعية، تم اعتمادها لتجنب التقسيم أو الفدرلة الأرضية. وقد حظيت الجماعات المختلفة بموجبها بتمثيل متساوٍ في السلطات المركزيّة والمحليّة، بصرف النظر عن أعدادها، في أرض وطنيّة موحّدة. وعلى سبيل المثال، بينما كان الشيعة يشكلون نحو 1 بالمائة فقط من السكان، والموارنة 76 بالمائة، كان للجماعتين تمثيلهما المتساوي في «المجلس الإداري» (حكومة 1861)، وفي مجمل الهيئات المحلية. واستمرت الصيغة اللبنانية، مع تعديلات محدودة عليها، حتى اليوم.
غالباً ما يعدُّ مهاجمو الصيغة أنها مسؤولة عن عدم الاندماج الوطني في لبنان، أي عدم تفكيك الجماعات وتحويلها إلى أفراد مواطنين. وهو اتهام باطل. فكل الدول والأنظمة السياسية التي توالت على المنطقة منذ سقوط السلطنة العثمانية قبل مائة عام حتى اليوم لم تحقق الاندماج الوطني، ولم تستطع تحويل الجماعات إلى أفراد مواطنين. لكن «الصيغة اللبنانية» على الأقل أحسنت إدارة الجماعات أفضل بكثير من سائر الأنظمة، عبر مفهوم التوازن، فلم تؤدِّ إلى ديكتاتوريات تقمع فيها جماعة الجماعات الأخرى وفقاً لدوامة الساحق والمسحوق.
كما كان لهذه الصيغة الإسهام الكبير في تحقيق مجمل الإنجازات الحضارية التي عرفها المشرق، من 1861 إلى 1975، في النهضة الفكرية والمعرفية، والتعليم الجامعي والتعليم العام، وفي العدالة وحقوق الإنسان، وفي الفن واللغة والأدب والصحافة والطباعة، وفي العلم والطب والاستشفاء والاقتصاد والسياحة، وفي التفاعل مع الحداثة والعالم، خصوصاً في تجسيد نمط حياة، لا مثيل له، قوامه الحرية ونوعية الحياة البشرية.
تهاوت التجربة في نهاية المطاف؟ أجل، لكنها عاشت وازدهرت طويلاً، وما زالت قادرة على النهوض. وهي تهاوت، ليس بفعل الصيغة، بل للصعوبات البالغة التي يواجهها نظام قوامه الحريات والحداثة وسط محيط أمني وقمعي مطبق يسعى بلا كلل لاختراقه وتخريبه. محيط سادت فيه الديكتاتوريات، وشهد احتلال الكيان الصهيوني أرض فلسطين.
وحين تلتقي هيئات وأحزاب مذهبية صافية مع جماعات علمانية تغييرية على المطالبة بـ«إلغاء الطائفية السياسية»، أي الصيغة اللبنانية، وإقامة الديمقراطية العددية، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الطرف الأول يعرف تماماً ماذا يريد لتكريس ديكتاتورية مذهبية نهائية في لبنان، بينما يتوهم الطرف الثاني أن البديل سيكون ديمقراطية حديثة شبيهة بالنموذج الفرنسي... ومن صبر إلى المنتهى يخلص.








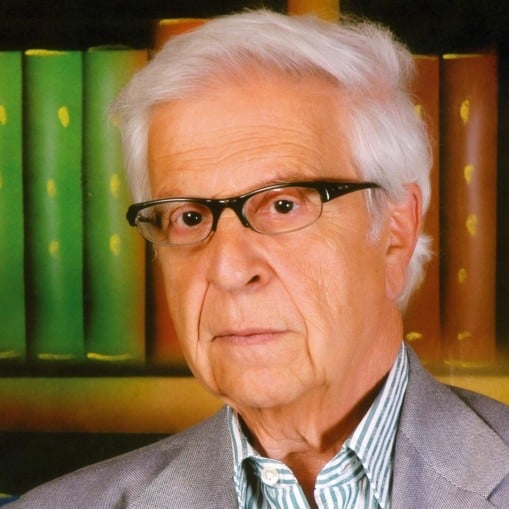








التعليقات