لا شك أن ظاهرة الإرهاب فى العالمين العربى والإسلامي قد أصبحت اليوم أكثر تعقيدا عما كانت عليه بداياتها الحديثة فى العشرينات من القرن الماضي. فقد أصبحت لها الآن أسباب مختلفة وجوانب متعددة، وبالتالى فهي تتطلب حلولا متشابكة وجذرية.. حلولا تتناسب والأوضاع المعاصرة.
على أننا، وقبل أن نغور فى البحث والحديث عن الأسباب القديمة والحديثة لهذه الظاهرة، لا بد أن نؤكد أن الخيط الديني والخلط السياسي هما العاملان الأساسيين فى نشأتها وإستمرارها إلى اليوم. فالخلاف "الدائر بين المسلمين اليوم (أولاً) بل ومنذ عصر الخلافة الراشدة، ممتركز ومتمحور فى سياسة المجتمع ونظم الحكم... (1)
وما نراه اليوم فى العديد من المجتمعات الإسلامية هو – فى واقع الأمر – صراع بين مجموعتين دأبت كل منهما على توظيف الإسلام سياسيا من أجل الوثوب إلى سدة الحكم أو التشبث بها. كما دأبت كل فرقة – إن تواضعت حينا – على إعتبار نفسها أصح إسلاما من الأخرى. أما فى حالة التشدد، وهي فى الإعم من جماعات "الإسلام السياسي"، فترى هذه انها هي الجماعة المسلمة وإن الأخرى، الموجودة فى السلطة، جماعة كافرة ينبغى "الجهاد" ضدها والقضاء عليها.
ويُرجع البعض البداية التاريخية لجماعات "الإرهاب" الملتحفة بالإسلام إلى الخوارج، أما بعث "الإسلام السياسي" فى العصر الحديث، فيعتقد بعض الباحثين انه حدث على أيدى جماعة الإخوان المسلمين فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرين، وإن منهم خرجت معظم الجماعات المسلحة التى تطلق عليها السلطات الحاكمة إسم "الجماعات الإرهابية".
وسواء أُطلق على هذه الجماعات ألقاب "إرهابية" أو "إسلامية سياسية" أو "أصولية إسلامية"، أو غير ذلك من مسميات، فهدفها الأساسي فى النهابة – كما تُعلنه فكراً وعملاً – هو إقامة "الدولة الإسلامية"، ووسيلتها فى ذلك، فى معظم الحالات وإلى الآن، حد السيف، وهو ما تراه السلطات "إرهاباً".
ومن المؤسف، وهو ما أشرنا إليه فى البداية، أن هذه الجماعات، بل وغيرها من قطاعات إسلامية لا تنتمي إليها تنظيميا، قد إستندت فى خطها الفكرى والحركي إلى سوابق تاريخية ترجع إلى فترات الحكم الإسلامي، كما إعتمدت على آراء مُفسرين قدامى بقولها بنسخ مائة وأربعة وعشرين آية قرآنية تناولت "الصفح" و "العفو" و"الإعراض" و "الصبر"، بآية "السيف": "فاذا إنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم وأقعدوا لهم كل مرصد". (التوبة 5). بل وإستشهدت هذه الجماعات والمتعاطفون معها بأحاديث نبوية، مثل: "بُعثت بالسيف، بين يدي الساعة، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقى تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى، ومن تشبه بقوم فهو منهم". (رواه أحمد بن حنبل عن ابن عمر) (2) وهذا ما تأسس عليه فكر جماعة "الجهاد" فى مصر.
وهذا ما قد إنعكس قبلاً على فكر جماعة الإخوان المسلمين، على لسان مؤسسها ومرشدها الأول، حسن البنا، حين قال: "... ونريد الحكومة المسلمة التى تقود هذا الشعب إلى المسجد وتحمل به الناس على هدى الإسلام، ونريد بعد ذلك أن نعلن دعوتنا على العالم وأن نبلغ الناس جميعا، وأن يعم بها آفاق الأرض وأن نُخضع لها كل جبار. لقد نفر المسلمون بعد وفاة الرسول فى أقطار الأرض، قرآنه فى صدورهم ومساكنهم على سروجهم وسيوفهم بأيديهم، حجتهم واضحة على أطراف السنتهم، يدعون الناس إلى أحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال. فمن أسلم فهو أخوهم ومن أدى الجزية فهو فى ذمتهم وعهدهم ومن أبى جالدوه حتى يظهرهم الله عليه.." (3)
وهنا يظهر بوضوح خلط السياسة بالدين، وإمتزاج وظائف الدولة بمسئوليات المؤسسة الدينية. بل والأخطر من ذلك، نجد بذور وأسس العنف الديني الحاض على فرض الرأي والعقيدة على المخالفين. الأمر الذى يشكل أحدى بؤر التوتر بين الدين والدولة، وبين الجماعات المختلفة فكرا وسياسة ودينا، داخل حدود الدولة ذاتها، وبين مثل هذه الدولة والدول الأخرى التى لايؤمن مواطنوها بالإسلام!
وهذا ما يُعرف بالفكر الجهادي الذى يحض على قتال حكام البلاد الإسلامية الذين لا يطبقون الشريعة، وقتال حكام البلاد غير الإسلامية الذين حجبوا الإسلام عن شعوبهم. (4)
على أن هناك من المسلمين من يعترض على هذا المنحى، فيرى أن "الجهاد" هو "جهاد النفس" و "جهاد الشيطان" و"الجهاد بالعلم"، ومع ذلك يرى آخرون، ممن يعتبرون أنفسهم فى مرحلة "الإستضعاف" أن "الجهاد" مؤجل لحين تحصيل القوة خلال فترة إعتزالهم المجتمع والهجرة منه، ثم العودة إليه غازين ومقيمين لدولة الإسلام. (5)
وبالرغم من كل هذا الجدل الذى لايزال يحتدم بين الفرقاء، وتسيل بسببه الدماء، وبالرغم مما لهذه الحال من آثار خطيرة على التنمية والتطورفى البلاد العربية والإسلامية، يقول آخرون ان قضايا الدولة والسياسة وعلاقتها بالاسلام من وجهة نظر أهل السنة تعتبر من "الفروع" وليست من "أركان الدين وأصوله". ولذلك فالخلاف والجدل حول هذه القضايا يجب أن يقف عند "الصواب" و "الخطأ".. و "النفع" و"الضرر".. و "العدل" و "الظلم"، ومن ثم تبرأ من "غلوّ"" إستخدام مصطلحات "الكفر" فى وصف الفرقاء المتصارعين فيها...، على حد تعبير المفكر الإسلامي محمد عمارة.(6)
وهكذا يعيش العالم الإسلامى، ومعه بقيه العالم، فى تناقضات فكرية خطيرة، لم تنهك العقل فقط، إنما تعمل عملها التدميرى فى مجتمعات بأكملها!
من هنا نتساءل: إذا كانت جذور الجدل العنيف يظهر فيه خلط السياسة بالدين، فلماذا نُبقى على هذا "الزواج" التعيس؟!
يقول الأخوة المتأسلمين أن الإسلام نشأ هكذا مع دولته، وبهذا كانت عزته. ولكن يردُ التاريخ الإنساني – والواقع المعاش - على هؤلاء بشواهد دامغة على أن ذلك التزاوج قد حدث أيضا فى حضارات سابقة على الإسلام، ولاحقة عليه أيضا، ولم يكن ذلك التزاوج فى مصلحة الدولة ولا الدين فى أغلب الحالات.
وبعيداً عن كل هذا الجدل العجيب والعقيم، نقول ان تزامن ظهور الإسلام وقيام نواة "دولته" فى المدينة كان حدثاً تاريخيا أملته ظروف الجماعة الإسلامية آنذاك، ولم تمله العناية الإلهية، إذ لم يأت عنه نص قدسي بأى حال. أضف إلى ذلك، أن تاريخ الشعوب والأمم قاطبة يوضح بجلاء تطور العلاقة بين السياسة والدين، من مرحلة الإرتباط الكامل والتداخل، إلى مرحلة الإنفصال المؤسسي. وهو تطور دفعت فيه تلك الشعوب ثمنا غالياً من العرق والدم، من أجل الحرية والتقدم والتعايش بين الدول والأمم. وهو إستقلال فرضته المستجدات والتحديات التى واجهت عقل الإنسان وواقعه، ولم تكن لها حلول دينية. ومع ذلك فقد ظل للدين دوره فى حياة الأفراد والشعوب على مر العصور، حتى فى العهود التى عانى فيها المؤمنون أشد أنواع الإضطهاد على أيدى حكام طغاة. وكان الدين فى مثل تلك الظروف زاداً للصمود ونورا للضمير، كما ساهم دائما – فى أجواء الحرية والتعددية السياسية والثقافية – فى صياغة فكر الإنسان وأخلاقياته، وإنعكس ذلك على حياة المجتمع ككل، بشكل أو بآخر، فى تقاليده وأحكامه، دونما قهر أو تشدد.
فهل لنا أن نعتبر بخبرة من سبقونا فى فصل السلطتين – الدينية والسياسية – عن بعضهما، وبالتالى فصل الإشتباك الدموي بين الدين والدنيا، من أجل بناء الحاضر والمستقبل الأفضل؟ وبمعنى آخر، هل لنا من العزم والبصيرة ما يؤهلنا لتوفير الطاقة المهدرة، والأرواح المُدمرة، من أجل نصرة الديموقراطية ودحر الإستبداد من أي طرف كان؟
قد يبدو الطلاق بين الدين والدولة صعباً، ولكن ليس للعالمين العربى والإسلامي من خيار آخر، إلا المزيد من الصراع مع الذات والآخر.
______________
(*) رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان
(1)محمد عمارة، الفريضة الغائبة: عرض وحوار وتقييم، دار الوحدة للطباعة والنشر، بيروت، 1983، ص 93
(2)محمد عمارة، نفس المصدر، ص 23 – 31
(3)من مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا والمنشورة فى كتاب أصدرته دار الشباب للنشر، أنظر: علي الدالي، جذور الإرهاب، القصة الحقيقية للإخوان المسلمين، القاهرة، 1993، ص 7
(4)محمد عمارة، سبق ذكره، ص 30
(5)محمد عمارة، نفس المرجع، ص 35
(6)محمد عمارة، نفس المرجع، ص 93
- آخر تحديث :




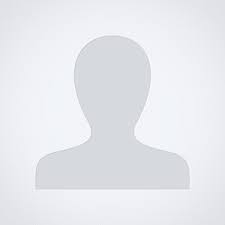
التعليقات