الأطفال مولعون بالتقليد. والتقليد لما يشاهدونه في المجتمع من سلوك. ومن ثم يكشف لعب الأطفال عن مجموعة من السلوكيات الاجتماعية التي تعبر بدورها عن الأوضاع السياسية في البلاد. والأطفال معروفون بالبراءة. هم المرآة العاكسة لما يحدث في واقعهم، ولما يشاهدونه من أحداث، وما يعايشونه من مواقف. لذلك هم من أهل الجنة. هم موضوع بحث علم نفس الطفل. وعادة ما يكون اللعب في أوقات الفراغ آخر النهار بعد المدرسة أو في عطلة نهاية الأسبوع أو في عطلة الأعياد الدينية والوطنية أو في عطلة الصيف. ولما كان الصيف على وشك الانقضاء فقد لاحظت بعض لعب الأطفال ذات الدلالة الاجتماعية والسياسية والثقافية خلال هذا الصيف.
يلعب الأطفال لعبة "شرطي المرور". إذ يقف أحدهم على الممر ويقطع الطريق على المارة ويسألهم: أين الرخصة؟ أين بطاقة الهوية؟ وينزعج المار من هذا الطلب الكبير، من هذا الطفل الصغير. والأطفال عن بُعد، جالسين أو واقفين يضحكون. وهم يرون علامة الجد على صديقهم الشرطي المزيف وهو يحسن التمثيل مادّاً يده، ومحركاً أصابعه من المار إليه وعلى وجهه علامة الجد، وفي طلبه الرقابة على المواطنين المحتالين الذين يسيرون بالعربات من غير رخصة أو الذين لا تعرف لهم هوية. مواطن مثل كل المواطنين، يسعى في أرض الله، ويأكل من خشاش الأرض. فشوق الطفل أن يصبح شرطياً. وهو رمز السلطة والجاه. والرقابة على الناس، وقطع طريق المارة، وهو المفتش في القلوب والضمائر. في قلب كل طفل، من المهد إلى اللحد، هناك شرطي. فالأب شرطي في الأسرة، والمدرس شرطي في العقل، والشيخ شرطي في السلوك. والتعاليم واحدة، الواجب والعيب، الصواب والخطأ، الحلال والحرام. وفي جيل أقدم كان الأمل أن يكون ضابطاً، بل وضابطاً طياراً حتى يقوم بألاعيب الهواء. وكان هو نموذج الحبيب الذي تقع الفتيات في غرامه، بلباسه المزركش، وقبعته المذهبة، ووسامته وقامته، وبقدرته على الارتفاع. وكل فتاة تريد الارتفاع والانتقال من حضيض الأرض إلى أعالي السماء. وكان ضابط الجيش أعلى قيمة في نظر جيلنا من ضابط الشرطة، والآن أصبح أمل الطفل أن يكون مجرد شرطي المرور أو "أمين شرطة". وفي الثقافة الشعبية هناك صراع خفي بين ضباط الشرطة وضباط الجيش، أي الفريقين أولى بالتبجيل والتعظيم والوجاهة الاجتماعية. ضابط الشرطة يدافع عن الأمن في الداخل وضابط الجيش يدافع عن الأمن في الخارج. ومعظم الرؤساء ضباط جيش وقليل منهم ضباط شرطة.
ولعبة أخرى مقابلة وهي لعبة "عسكر وحرامية". إذ ينقسم الأطفال قسمين. الأول العسكر أو الشرطة أو "البوليس" والثاني الحرامية واللصوص. وفي هذه الحالة الحرامية هم الأشجع والأذكى والأقوى والألطف والأظرف والأخف ظلا. وأولاد البلد من العسكر الأجبن والأغبى والأضعف والأغلظ، والأكثر تجهماً، والأثقل ظلا، والغرباء عن البلد مثل التركي وشنبه الغليظ القاسي القلب الذي لا يعرف الرحمة، وعادة ما تكون الغلبة للحرامية، والهزيمة للعسكر. فالنصر في النهاية للشعب ضد النظام، والحق ضد الباطل، وللمواطن ضد الدولة، ولسرقة المحفظة ضد سرقة الدولة ونهب أموال الشعب. فمازال اللص هو اللص الشريف صاحب القيم الذي لا تستطيع الشرطة النيل منه. وقد خلّدت هذه اللعبة رواية "اللص والكلاب".
وفي جيلنا كانت هناك لعب أخرى تعبر عن نضال مصر الوطني مثل "مصريين وإنجليز" كان الأطفال ينقسمون قسمين. الأول يمثل المصريين الوطنيين المناضلين، والثاني يمثل الإنجليز المعتدين المحتلين المغتالين للوطنيين. كان الفريق الأول أذكى وأشطر وأشجع وعلى حق. صاحب هدف ويعمل لقضية. بينما الثاني أغبى وأجبن وعلى باطل. استعماري أجنبي يرمز إليه الخواجه "جون". والنصر باستمرار حليف القسم الأول الذي يستطيع بحركات الجسد وأساليب الفتوة قهر الجندي المدجج بالسلاح والذي يقف عاجزاً عن حرفية ابن البلد في شل حركة الخصم دون أن يشعر وبسرعة غير متوقعة.
وكان جيلنا أيضاً يلعب "أبويا ملك". وهي منافسة بين الأطفال على رفع الأثقال أو قذف أشياء في الهواء ثم تلقفها باليد ولا تقع على الأرض أو كسر عود قصب بضربة يد واحدة. ومن يكسب يكون أبوه ملكاً. فقد كانت صورة الملك معلقة فوق الجدران دون أن نعلم أنه يملك البلاد طولا وعرضاً. يقيل الحكومات، ويهب الدستور، ويتعاون مع الاحتلال، ويكوّن أحزاباً لحسابه هي أحزاب السرايا أحزاب الأقلية. ومع ذلك كان الملك ونحن أطفالا هو الرمز. يُذكر في النشيد الوطني "للمليك اهتفوا، يا أسود الحمى". نهرع إليه مع المدرسة إلى قصر عابدين في عيد ميلاده 11 فبراير ونغني:
لبيك مليكــــــــي لبيـــــــــك \ حياك لساني وجناني
الغيث هما من كفيك \ وغدوت جنة وجنــــــــان
تاريخـــك آيـــــة عليــــــــــــا \ كتبت بيمن الرحمــــــــن
وكانت أحلام الأطفال وقتئذ، صبياناً وبنات، تتلخص في لعبة "عريس وعروسة" تعبر عن أشواق المستقبل. إذ يقوم طفل وطفلة بما لديهم من صغار الأشياء بتكوين شكلين على الأرض، غرفتين، كراسي وسرير، وعليه عريس وعروسة. وكلما كان المكان نظيفاً ملوناً جميلا كان عش الزوجية سعيداً. لم يكن هناك عيب أو فصل للبنات عن الصبيان منذ البداية، وتحجيب البنات. كان العريس يحب العروسة، والعروسة تبادله الحب دون أن يعرف الأطفال معنى الحب إلا التواجد معاً والعطف المتبادل والمكوث معاً طيلة النهار، وانتظار الصباح حتى يعاود اللعب من جديد.
وكان جيلنا أيضاً يلعب "الفتوات". إذ ينقسم الأطفال إلى فريقين. وكل فريق تحت زعامة الأقوى باعتباره الفتوة. ولكل فريق اسم حي: العطوف، باب الشعرية، الوايلي، الجمالية. وتدخل الأحياء في نزاع بينها على الزعامة. ويتصارع الفريقان. ووسط كل فريق الزعيم. والمهزوم هو الذي يُطرح أرضاً، ويركب فوقه الزعيم الآخر، ولا يتركه إلا بعد أن يستسلم وسط تهليل الأطفال من الفريقين، ثم تنصيب المنتصر على الحيين معاً. فلا يوجد إلا فتوة واحد على كل الأحياء، وزعيم واحد على كل الزعماء. ولا فرق بين الدولة المعاصرة والحي الشعبي أو بين الحاكم والفتوة. زعيم واحد، وحزب واحد، وفكر واحد، ورب واحد. وقد خلّد نجيب محفوظ ذلك في "الحرافيش". لم يعد ابن البلد الآن قائماً. واختفت الفتوة. ولم يعد الأطفال راغبين فيها. فإذا ما كبروا هاجروا الأحياء بحثاً عن الرزق. فالمال هو القوة. راح الفتوة وبقي الحرافيش. وأصبح الفتوة خارج الأوطان تقوم بدوره الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة أو الدول الصغرى مثل إسرائيل التي تلعب دور الدول الكبرى والأنظمة العربية أصبحت الحرافيش.
لا يلعب أطفال اليوم فلسطينيين وإسرائيليين أو أميركيين وعراقيين كما كنا نلعب مصريين وإنجليز بالرغم من انتشار القنوات الفضائية وذيوع الأخبار في كل مكان داخل الأسر. لم يعد الأطفال يتحمسون للقضايا الوطنية. ولا قامت حركة مناصرة من أطفال مصر أو العرب إلى أطفال فلسطين والعراق. لم يعد الأطفال في حاجة إلى نصر أو الدخول في معركة. يسأل البعض منهم عن عبدالناصر من هو؟ هل كان وزيراً في مصر؟ إلى هذا الحد بلغ النسيان لذاكرة التاريخ. معارك الأطفال شجار شخصي بلا سبب واضح. وعلى أقصى حد على تسجيل الأهداف في كرة القدم. كان طفل يسير مشية عسكرية رافعاً عصا مقشة على كتفه وكأنه جندي مغوار. فسألته: ماذا تفعل؟ قال أحارب! قلت: تحارب من؟ قال أحارب العراق! قلت: وماذا فعل العراق؟ قال إذن أحارب إيران! قلت: ولماذا تحارب إيران؟ قال أمّال أحارب مين؟ قلت: تحارب إسرائيل. قال: قالوا في المدرسة أننا عملنا معاها سلام! إلى هذا الحد بلغ تزييف الوعي القومي. الطفل يريد معركة. فالحياة بلا معارك تنتهي. والطفل لا يدري أين هي الجبهة؟ يسمع عن الحرب بين العراق وإيران، ويريد أن يكون طرفاً فيها كما فعل العرب لحساب هذا الفريق أو ذاك أو لحساب الاثنين معاً. وغابت عنه المعركة الحقيقية للعرب في فلسطين كما غابت عن الزعماء. وحلت محلها المعارك القطرية والطائفية والعرقية والعشائرية تشتت الجهود. واختفى التناقض الرئيسي لصالح التناقضات الثانوية. والثقافة تقوم على التوحيد، توحيد القوى والجهود، والقبائل والشعوب، والأقطار والأمصار نحو غاية واحدة، عزة الأمة وكرامتها واستقلالها.
ويلعب الأطفال أحياناً الثابت في الحياة الشعبية لعبة الجن والعفاريت، وشخصيات الغول وأبو رجل مسلوخة، وأبو طبق، والساحر، والشيطان. فالخرافة مستمرة، تفرز شخصياتها الشعبية. والعفريت أو الجن وغيرهما قادران على فعل المعجزات، والإتيان بالعجائب، وإحضار الغائب، وإشباع الجائع، وتلبية مطالب المحتاج. يثير الخيال، ويبقي على الحلم خارج الواقع والمجتمع. ويقفز نحو المستقبل لحل قضايا الحاضر.
ولم يلعب الأطفال حتى الآن لعبة الفلاح أو العامل أو التاجر وهو بلغة الستينيات، جيلنا، لعبة تحالف قوى الشعب العامل. فقضايا الأرض والفلاح، وقضية والعامل والمصنع، وقضية التاجر الصغير واحتكار سوق الجملة لم يعد يهتم بها أحد. لذلك لا يتحرك الفلاحون مهما سُلبت منهم الأرض، ولا يثور العمال إذا ما بيع المصنع. ولا يتكلم صغار التجار إذ لا يقوى أحد على منازلة الكبار. ولا يلعب الأطفال لعبة الشيخ والمعلم والتلميذ بل إنهم حتى لا يسخرون منهم. فهم خارج دائرة الانتباه. لم تؤثر فيهم المدرسة. ولا يلعب الأطفال لعبة الزعيم الوطني، عرابي وسعد زغلول وعبدالناصر، يهيب بالأطفال الصغار على النهوض بهم وتحقيق الاستقلال بالرغم من تماثيلهم في الميادين وذكرهم في كتب التاريخ ولكنهم ليسوا أحياء في وجدان الناس بل انزووا في دائرة النسيان.
إن لعب الأطفال ليس بلا دلالة بل هو كاشف عن شخصية الطفل وأوضاع المجتمع وحال الأمة. اللعب إثبات وجود مثل الفكر عند الفلاسفة.يلعب الأطفال على طريقة الكبار. ويتغيرون بتغيرهم. والكبار ضحايا المرحلة التاريخية وأحد أسباب ازمتها. الأطفال نور كاشف لما يحدث في قاع المجتمع من خفافيش الظلام.











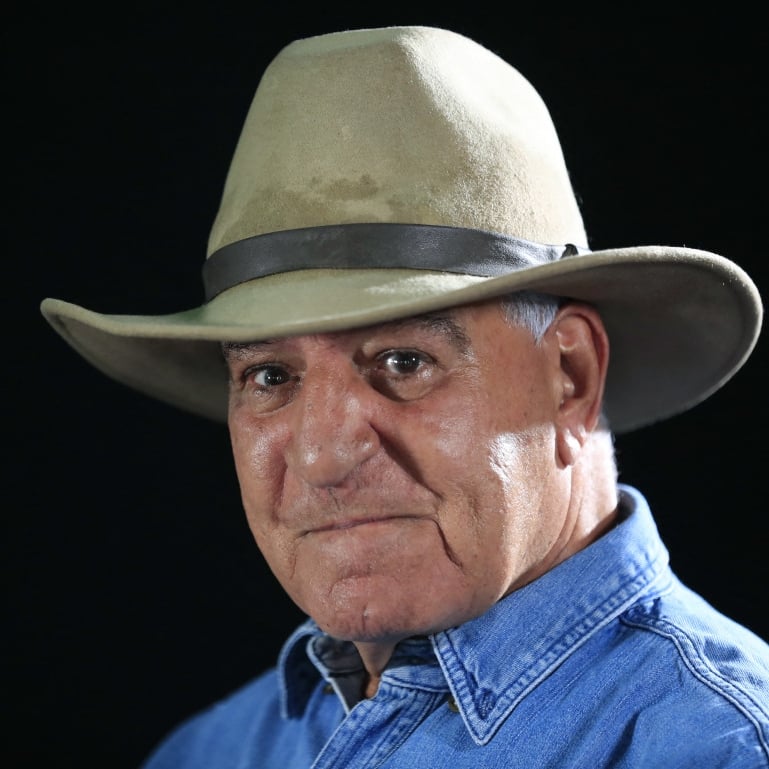
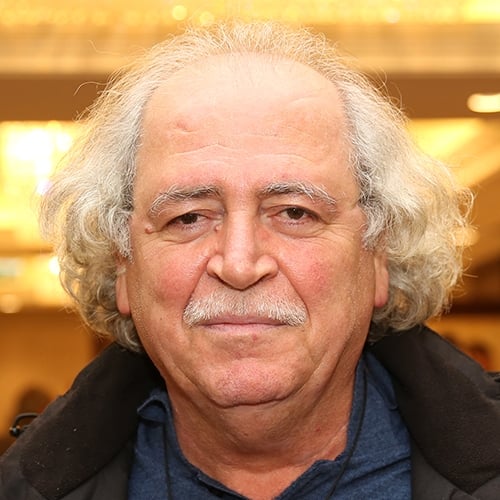

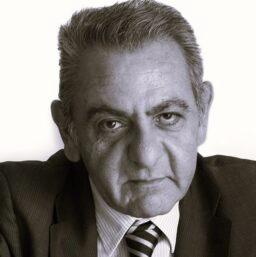


التعليقات