فى اليوم الذى اقيلت فيه وزارة الوفد عام 1937 ، بعد اول صدام بين حزب الوفد، وحزب الاغلبية الشعبية المصرية على امتداد حقبة ما بين الثورتين «1952/ 1919» وبين القصر الملكى فى عهد الملك الشاب «فاروق»، التقى «كمال احمد عبدالجواد» بصديقه القبطى «رياض قلدس».
ولان الاثنين كانا من المتعاطفين مع «الوفد» فقد هزتهما الاقالة، واعتبراها هزيمة للشعب المصرى، فى نضاله التاريخى ضد ديكتاتورية القصر الملكى، وتبددت- كما قالا- الآمال التى علقاها على الملك الجديد، وثبت لهما ان «فاروق» سيسير على خط ابيه، ويقاوم بضراوة كل محاولة لالزامه بالقاعدة الدستورية التى تقول ان الملك يملك ولا يحكم، وكل محاولة لوضع النص الدستورى «الامة مصدر السلطات»، وكان «كمال» حزينا، لان مظاهرات دبرها رجال القصر، استقبلت «مكرم عبيد» السكرتير العام لحزب الوفد- عندما ذهب الى القصر ليحاول التوصل الى حل للأزمة بينه وبين الحزب، بالسباب، وبالتعريض بمسيحيته.. وفى اشارة الى قبطية الاثنين قال له «كمال» مداعبا انت غاضب لـ«مكرم».. فقال «رياض» دون تردد:
ان الاقباط جميعا وفديون.. ذلك ان «الوفد» حزب القومية الخالصة ليس حزبا دينيا تركيا كالحزب الوطنى «مصطفى كامل»، ولكنه حزب القومية التى تجعل من مصر وطنا حرا للمصريين على اختلاف عناصرهم واديانهم، اعداء الشعب يعلمون ذلك، ولذلك كان الاقباط هدفا للاضطهاد السافر طوال عهد الديكتاتور اسماعيل صدقى وسيعانون ذلك منذ اليوم.
وواصل «كمال» مداعبته له قائلا:
ها انت تتحدث عن الاقباط.. انت الذى لا يؤمن الا بالعلم والفن!
بعد لحظة صمت.. قال «رياض قلدس»:
انى حر وقبطى فى آن.. بل انى لا دينى وقبطى معا، اشعر فى احايين كثيرة بأن المسيحية وطنى وليست دينى، وربما اذا عرضت هذا الشعور على عقلى اضطربت.. ولكن مهلا.. اليس من الجبن ان انسى قومى؟.. شئ واحد خليق بأن ينسينى هذا التنازع، ألا وهو الفناء فى القومية المصرية الخالصة كما ارادها «سعد زغلول» ان «مصطفى النحاس» مسلم دين، ولكنه قومى بكل معنى الكلمة ايضا فلا نشعر حياله الا بأننا مصريون، لا مسلم ولا قبطى، بوسعى ان اعيش سعيدا دون ان اكدر صفوى بهذه الافكار، ولكن الحياة الحقة مسؤولية فى الوقت نفسه.
وقال «كمال عبدالجواد» لنفسه« ان موقف رياض له وجاهته التى لا تجحد كيف يتأتى لاقلية، ان تعيش وسط اغلبية تضطهدها.. وجدارة الرسالات السامية، تقاس عادة بما تحققه من سعادة للبشرية، تتمثل اول ما تتمثل فى الاخذ بيد المضطهدين، اما «رياض» فقد اضاف:
يؤسفنى أننا نشأنا فى بيوت لا تخلو من ذكريات محزنة.. لست متعصبا، ولكن من يستهين بحق انسان فى اقصى الارض- لا فى بيته- فقد استهان بحقوق الانسانية جميعا.
وقال «كمال»: جميل هذا القول، لا عجب ان رسالات الانسانية الحقة كثيرا ما تنبعث من اوساط الاقلية، او من رجال مشغولى الضمائر بالاقليات البشرية، ولكن ثمة متعصبون دائما.
واستطرد «رياض»: دائما وفى كل مكان.. وهم عندكم يعتبروننا كفارا ملاعيين، وهم عندنا يعتبرونكم كفارا مغتصبين، ويقولون عن انفسهم انهم سلالة ملوك مصر الذين استطاعوا ان يحافظوا على دينهم بدفع الجزية.
فضحك «كمال» ضحكة عالية، وقال:
هذا قولنا وذاك قولكم.. ترى ما الاصل فى هذا الخلاف؟ اهو الدين ام الطبيعة البشرية المتطلعة ابدا الى الخصام، لا المسلمون على وفاق، ولا المسيحيون على وفاق، وستجد نزاعا مستمرا بين الشيعى والسنى، وبين الحجازى والعراقى، كالذى بين الوفدى والدستورى وطالب الاداب وطالب العلوم، والنادى الاهلى ونادى الترسانة، لكن رغم ذلك كله، فشد ما نحزن اذا طالعنا فى الصحف خبر زلزال باليابان.. والسؤال هو : كيف نستأصل هذه المشكلة من جذورها؟
واجاب «رياض»: مشكلة الاقباط اليوم هى مشكلة الشعب، اذا اضطهد اضطهدنا.. واذا تحرر.. تحررنا.
مشكلة الاقباط امس، هى مشكلتهم اليوم، وهى مشكلة الشعب امس واليوم، وجوهرها- بالمختصر المفيد- ان الثورة المصرية عجزت على مدى حقبتين متتاليتين- بين ثورتي 1919 و1952- عن ارساء قواعد دولة وطنية ديمقراطية تساوى بين المصريين فى حقوق المواطنة.. بصرف النظر عن نوعهم او دينهم ومذاهبهم، او معتقداتهم السياسية فكان طبيعيا ان يشعر «رياض قلدس» بأن المسيحية وطنه وليست دينه، ولابد ان حفيده كان احد الشبان الذين قادتهم شائعة كاذبة، للمشاركة فى المظاهرات التى شهدتها الكاتدرائية المرقسية، خلال الازمة الاخيرة.
اما لماذا فشلت الثورة القومية المصرية فى ارساء قواعد دولة وطنية ديمقراطية فلذلك اسباب تاريخية معقدة، اما المهم فهو ان المشكلة التى بدأت جذورها خلال الصراع بين التيارين الاوتوقراطى والديمقراطيى خلال العهد الليبرالى، على النحو الذى شرحه «رياض قلدس» قد تفاقمت وتعقدت خلال الحقبة الناصرية.
صحيح ان «عبدالناصر»- كسلفيه- «سعد زغلول» و«مصطفى النحاس» كان زعيما قوميا، يخلو من اى مظهر من مظاهر التعصب الدينى، ولم يكن يفرق بين المواطنين حسب اديانهم، الا انه، بحكم تفتحه السياسى فى ظل صعود الاتاتوركية والنازية والفاشية، كان يعتقد اعتقادا جازما بأن الديمقراطية مضيعة للشعوب، وبان التعددية الحزبية والفكرية تعطل المسيرة الوطنية نحو تحرير الشعب من الاحتلال الاجنبى والتخلف الاقتصادى والاجتماعى، وان بناء دولة مستقلة قوية سياسيا واقتصاديا يتطلب سلطة قوية ومهيمنة تخضع لارادة زعيم ينتمى للشعب، ويوحده فى شخصه ويصفه كله صفا واحدا وراءه، ويزحف به نحو تحقيق اهدافه.. فذلك ما حدث فى تركيا والمانيا وايطاليا التى خرجت جمعيها من الحرب العالمية الاولى مهزومة ومدمرة، ثم استطاعت خلال سنوات، وفى ظل حكم الزعيم الفرد، ان تحرر ارضها وارادتها وتعيد بناء نفسه.
وذلك ما كان..
انهى عبدالناصر العهد الليبرالى الوطنى الذى لم ينجز سوى نصف استقلال ونصف ديمقراطية، وقضى على كل رموزه ومؤسساته بل وذكرياته.. حل الاحزاب وأمم الصحف وسيطر على النقابات والجمعيات وحطم استقلال الجامعات وحرم كل اشكال الجدل السياسى والفكرى، وتصدى بكل قوة وحسم لكل شكل من اشكال التنظيم المستقل او الحركة الشعبية خارج نطاق المؤسسات التى خصصها لهذا الغرض، وفرض على الجميع وحدة قسرية صهرهم فيها، مكرهين احيانا ومستسلمين فى احيان اخرى، وراضين فى معظم الاحيان، بسبب ما حققته زعامته الملهمة من انجازات حقيقية، فخلال خمسة عشر عاما، كان قد حول مصر الى دولة مستقلة ومستقرة، ونامية اقتصاديا، تتزعم معسكراً عالمياً ثالثاً، وتلعب دوراً اقليمياً ودولياً مؤثراً.
لكن ذلك كله لم يحدث من دون اعراض جانبية كثيرة، عصفت بعد ذلك بالكثير مما انجزه.. وقادته الى المصير الذى ينتهى اليه عادة هذا النوع من انظمة الحكم، بما فى ذلك النماذج الذى استلهمها، كان من بينها ان المجتمع المصرى فى ظل هذه الوحدة القسرية التى تصادر الحق فى التنوع والتعدد والاختلاف، وعلى العكس مما اراد، ومن الوحدة الظاهرة على السطح، قد تفكك، وبعد ان كان مجتمعا سياسيا يعبر الافراد فيه عن تنوعهم بالانضمام الى الاحزاب السياسية والجمعيات الفكرية والتجمعات الاجتماعية التطوعية، ليدافعوا عن مصالح مشتركة، وهى ارقى الاشكال الاجتماعية تعبيرا عن هذا التنوع، ارتد على اعقابه، وتحول الى مجتمع غير سياسى، ينقسم الناس فيه الى وحدات بدائية، تقوم على الدين او المذهب او الطائفة واحيانا تقوم على الانتماء للبلد او القرية او العائلة.
فى ظل هذه الوحدة القسرية التى تصادر الحق فى تكوين الاحزاب السياسية لم يعد المصريون يعبرون عن تنوعهم بالانضمام الى حزب الوفد، او حزب الاحرار الدستوريين او الحزب السعدى او الحزب الشيوعى، ولكنهم اصبحوا يعبرون عن هذا التنوع الطبيعى الذى لا يستطيع احد مصادرته، بالانضمام الى الحزب القبطى او الحزب الاسلامى او الحزب الصعيدى او حزب بحرى، او حزب الاهلى او حزب الزمالك.
وفى الانتخابات العامة، لم يعد الناخبون يختارون المرشحين على اساس احزابهم او برامجهم السياسية، فكلهم من الناحية السياسية جمال عبد الناصر،وكلهم الاتحاد الاشتراكى، اما الذى يتمايزون فيه، فهى اديانهم ومذاهبهم، ومدى الصلة الشخصية او العائلية او الرياضية التى تربط الناخب بهم.. وهكذا انتهى العهد الذى كان فيه «مكرم عبيد» يفوز فى كل الانتخابات فى دائرة «قنا» التى يتشكل المجمع الانتخابى فيها من المسلمين، على الرغم من انه قبطى، وعلى الرغم من ان منافسه كان مسلما، لسبب واحد، هو انه كان يخوض الانتخابات بصفته وفديا لا قبطيا، ولان المجمع الانتخابى كان مجمعا سياسيا وليس طائفيا.
وجاء اليوم الذى اكتشف فيه عبدالناصر عام 1964 انه لا يوجد قبطى واحد من بين الذين فازوا بعضوية مجلس الامة فى الانتخابات العامة التى اجريت فى هذا العام، فاضاف الى مسودة الدستور المؤقت نصا يعطى رئيس الجمهورية الحق فى تعيين عشرة اعضاء، وهو نص لايزال قائما، ويستخدم فى زيادة عدد النواب الاقباط فى المجلس التشريعى!
مشكلة الاقباط، هى مشكلة المصريين، ومشكلة المصريين هى مشكلة العراقيين، ومشكلة غيرهم من العرب الذين خضعوا لتلك النظم الوطنية الاستبدادية، التى فرضت عليهم وحدة قسرية، قضت على التنوع السياسى، فتحول الى مسارب اخرى، وهى مشكلة لا حل لها، الا أن نعمل بقوة وبجهد مشترك على اعادة تأسيس المجتمع السياسى الذى ينقسم الناس فيه الى احزاب تدافع عن مصالح مشتركة لمن ينتمون اليها، وتتنافس حول ما هو دينوى وليس حول ما هو دينى.. مجتمع سياسى يبنى دولة ديمقراطية علمانية.. وليس صراعا دينيا يقودنا الى الكارثة.





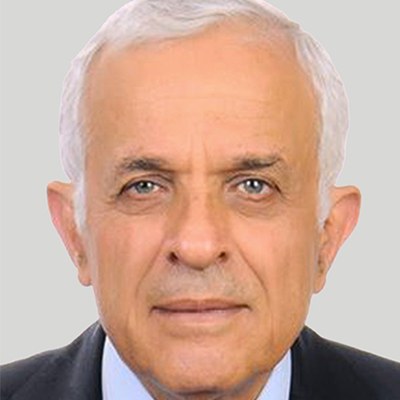















التعليقات