باريس من انعام كجه جي: بتسجيلها، بشكل روائي، حكاية والدتها «كاملة» التي تركتها وهي طفلة لكي تتزوج من حبيب عمرها «محمد»، تكون حنان الشيخ قد صفت جانباً من حساب، لعله كان مؤجلاً، مع ماض مرتبك وقد لا يبعث على السرور. أزاحت الروائية اللبنانية الغطاء عن البئر القديمة وأطلت على المياه الراكدة بعينيها السوداوين النهمتين مثل عيني جنية، ثم دعتنا لمشاركتها في الاحتفال الذي تصورناه حزيناً فاذا به مؤثث بالكثير من التفاصيل الممتعة.
بهذا الكتاب الذي يحمل عنوان «حكايتي شرح يطول» الصادر حديثاً عن دار الآداب في بيروت، لا تستحق حنان الشيخ وسام الشجاعة إلا مناصفة مع تلك الأم التي قررت ان تستجيب لفضول الابنة الكاتبة وان تروي لها كل شيء بعد ان تجاوزت السبعين، اذ لا شيء يستوجب الخجل في حياة امرأة أحبت الحياة بشكل مفرط، ولم تفعل اكثر من انها مدت يدها وأكلت من طيبات ما رزقت.
جاءت كاملة من النبطية، في جنوب لبنان، طفلة فقيرة مكسورة لوالدة مهجورة لا عائل لها، وسكنت بيروت يوم كانت بيروت ست الدنيا، وادركت الحرب، ووصلت في آخر سنوات عمرها إلى اميركا. خلقها الله بهية الطلعة، مرحة وذكية وقريبة من القلب، وزاد من اتساع دنياها انها عشقت السينما والغناء، وأرادت ان تعيش حياتها في الواقع مثلما كانت ترى حياة ليلى مراد في الافلام. أن تهرب من الفقر إلى فضاء الشاشة، وان تتصور الدموع جمرات تفيض بها المآقي، لا قطرات من الغليسرين تقطر على خدود الممثلات.
تسأل كاملة نفسها اذا كانت تفضل السينما على أكل مرطبان الدبس كله فتجد نفسها تفضل السينما.. تفضلها حتى على محادثة البنت البيروتية التي تترفع عليها، حتى على اللعب في حواكير النبطية مع صديقتها تفاحة. لهذا كانت تهرب من البيت وتذهب الى صالة السينما في ساحة البرج لكي تشاهد، مرة بعد مرة، فيلم «الوردة البيضاء» رغم انها لا تفهم اللهجة المصرية. وقد ادى ادمانها افلام الحب الى نضوجها قبل الأوان، فراحت تبحث عن «وردة الحب الصافي» لتجدها لدى محمد.. لا المطرب عبد الوهاب، بل الشاب الجنوبي الذي يتردد على خياطة الجيران ويهوى الشعر والفن ولا يحلم بأكثر من وظيفة في مديرية الأمن العام.
أحبت، بكل جموح ابنة الثالثة عشرة محمداً الفنان، لكنهم زوجوها من محمد آخر في عمر ابيها، شيخ ورع يبيع القماش في سوق سرسق، كان زوجا لشقيقتها التي ماتت وتركت ثلاثة صبية صغار. ورغم انها فعلت كل ما اوحى لها به عقلها الصغير في سبيل ان تتملص من تلك الزيجة، فانهم جاءوا لها بوكيل ناب عنها عند عقد القران، وسيقت كالشاة الى فراش الزوجية.
منذ تلك اللحظة عاشت كاملة حياتين متوازيتين، واحدة في البيت الكبير الذي يسرح فيه الأهل والجيران والأقارب الآتين من الجنوب، وواحدة في غرفة الحبيب محمد الذي كانت تتردد عليه وتتشوق لزيارته، خلسة، لأنه كان يقول لها «تسلم لي طبعة ذقنك» ان تلك الغرفة الصغيرة المتواضعة هي «الهودج» الذي يرفعها الى سماء المباهج الممنوعة ودلال المحبوبات، هي التي لم تحب يوماً أعمال البيت والمطبخ، وكانت تنظف غرفة زوجها «مستخدمة قدماً واحدة على الممسحة، تجرها كيفما اتفق». أليست هي التي كانت تتماهى مع بطلات الأفلام اللواتي يعشن في القصور حيث تضع الواحدة منهن يدها على الدرج الرخامي الابيض وتلتفت لكي تقول للسفرجي: «جهزت العشا يا عبده؟!».
لهذا، لا تتردد كاملة في القول: «السينما هي المكان الأكثر أماناً. عند بابها تتوقف سلطة شقيقي العابس وزوجي، فلا ترقبني عين ولا تتوعدني يد. انا حرة في السينما. ادخلها وكأني غريقة فتنتشلني». وفي مقطع آخر تقول: «السينما هي أهم ما في بيروت، كأنها كانت تطغى على الدنيا التي «هي قايمة وقاعدة» تندلع فيها التظاهرات ضد فرنسا والانتداب».
ولم يكن من الممكن ان تستمر في تلك الحياة المزدوجة أكثر من 14 عاما، فقد أصر محمد الثاني على تطليقها من محمد الأول، ثم عقد عليها بعد أن وضع المسدس فوق رأس أبيها مهدداً، قبل اكتمال أشهر عدتها.
نزلت قصة الحب إلى الأرض وصارت تمشي على ساقين، فإذا بكاملة تتعب من تكرار الحمل والولادة، ومن أعباء البيت، ومن ضيق ذات اليد، ومن الغرفة التي كانت هودجاً ثم عفا عنها الخيال فعادت مترين في ثلاثة، ثم ان زوجها كثير التنقل بحكم عمله، وقد كتب لها في إحدى رسائله: «هل تحدثك نفسك بالذهاب إلى السينما من دوني؟»، إنه يلومها على هوسها بالأفلام وتقليدها للبطلات، ويقول لها إنه لا ينشد المرأة التي تعتبر السينما قاموساً للحياة الاجتماعية.
كيف كانت تقرأ رسائله وترد عليها، هي التي لم يعلّمها أحد القراءة والكتابة؟، تلك قصة أخرى تمر عليها حنان الشيخ بدهشة لا تخلو من حسرة، فلو تعلمت كاملة، لو دخلت المدرسة، لو قرأت الكتب والمجلات، لصارت هي أيضاً كاتبة مثل ابنتها «لو علموك كنت أنت الكاتبة.. لا أنا».
ألهذا قررت الابنة أن تقوم بالمهمة نيابة عن والدة لم يقدر لها أن تفك الحرف؟
إن حكاية كاملة تغري أي روائي يتناولها، فكيف إذا تتالت عليها ضربات التراجيديا وسلبت منها الحبيب الذي حاربت الدنيا لكي تفوز به.. حتى إذا تحقق لها ما أرادت فقدته في حادث سيارة. مع هذا، فإن لا شيء يقف أمام حبها الجامح للحياة، وللغناء، وللسينما، ولا أحزان تقتل رغبتها في أن تكون محبوبة ومرغوبة، بل انها في لحظة إنزال جثمان زوجها إلى القبر، تفكر انها اطمأنت عليه أخيراً، في هذه الحفرة، من احتمال أن يتعلق قلبه بغيرها، ان الفقد أهون من الغيرة!
تكبر حنان وتصبح صحافية وتتزوج زيجة طيبة وتهاجر بسبب الحرب إلى خارج لبنان، لكنها تعود لتزور الأم التي تركتها طفلة، ولتتحدثا كامرأتين صديقتين ناضجتين، في شؤون هذه الدنيا وما تجره من تجارب. ولما تموت كاملة بالمرض الخبيث، فإن صوتها لا يتوقف عن الرواية، مستعيراً صوت الابنة، فتأخذنا معها في تطواف جنازتها من بيت الزوج الأول في بيروت، إلى بيت الزوج الثاني، عودة إلى النبطية، حيث البيت الذي ولدت فيه، وحيث دفنت على رابية بجوار قبر حبيبها محمد.
قصة تبدو خفيفة في فصولها الأولى، هشة بسبب الكثير من العبارات باللهجة المحكية، لكنها تلبس جسداً صلباً في نهاية المطاف، وتتفوق فيها لغة القلب على لغة القاموس، وتخلق أجواءها الخاصة والنابضة بالحرارة، فلا تترك تلابيب قارئها حتى يبلغ الصفحات الأخيرة. انه يقرأ وهو يعود، بين الفصل والآخر، إلى صورة كاملة المنشورة على الغلاف، فيحاول أن يستشف من وراء الخمار الأسود الرقيق الذي غطت به نصف وجهها، بغواية بنات السينما، أية قوة تكمن وراء هاتين العينين الضاحكتين؟!
حتى الغلاف الذي صممته نجاح طاهر، وبدا عند التصفح الأول للكتاب باهتاً ومتواضع الطباعة، ارتدى في النهاية حلّة تحاكي شخصية كاملة في خفتها وبهرجتها وطابعها الشعبي وميلها إلى الطبيعة والطير والتين ومرطبان الدبس المشتهى.
- آخر تحديث :





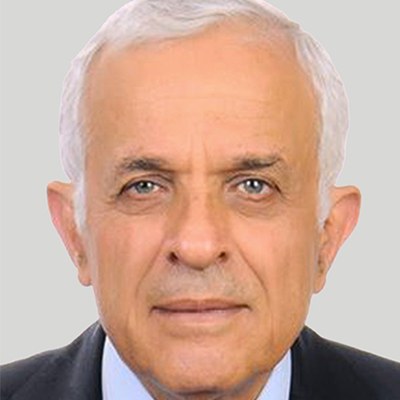















التعليقات