&
لم تقتصر جناية إرهابيي الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) علي إزهاق ارواح الآف الابرياء، وإنما إحياء دعاوي ومزاعم تتسم بأيما شيء ما عدا البراءة والدعوة الي التفاهم والسلام.
فبعدما حسبنا ان العالم المتعلم قد بلغ من الوعي طوراً لم يعد ثمة مكان فيه للغة تتوسّل التمييز الجوهري بين البشر علي اساس الانتماء الديني او الاثني او الجغرافي، او الي ما هنالك من عوامل، فوجئنا عشية الهجوم الارهابي وغداته بمن ينذر بـ حرب البرابرة علي الحضارة الانسانية.
وليست رطانة من هذا القبيل بذاتها امراً خطراً طالما ان من المستبعد ان تدوم اجلاً اطول من دوام مشاعر الغضب والنقمة التي تولّدها اصلاً. غير انها لا تعدم الخطورة حينما تكتسي رداء نظرية او فرضية فكرية تزعم الاستناد الي معايير منطقية والاسترشاد بالبحث التاريخي نظير فرضية صدام الحضارات التي جعلت اصداؤها تتردد من جديد. وكانت هذه الفرضية تعرضت للكسوف بعد وقت قصير علي ظهورها، الي ان اطل علينا صاحبها صاموئيل هانتنغتون، إطلالة المنتقم، مذكّراً: ألم اقل لكم؟ .
وكان السيد هانتنغتون قد قال لنا ان نهاية الحرب الباردة نهاية صراع الايديولوجيات، لكنها حتماً ليست نهاية الصراع، وخلافاً لما سارع فرانسيس فوكوياما الي التبشير به، فإن انهيار النظم الاشتراكية لا يعني وصول قطار التاريخ الي محطته الاخيرة مؤذناً بإنتصار الليبرالية الغربية. فالصراع سيُستأنف، وإن ليس ايديولوجياً، او إقتصادياً ايضاً، علي ما زعم ليستر ثيرو، صاحب نظرية فانتازية اخري، ومؤلف تطاحن الرؤوس - وإنما ثقافياً. وان الصراع الثقافي وحده دون غيره ما سيحدد طبيعة النظام الدولي للقرن الواحد والعشرين.
فالعالم ينقسم، او هو آخذ بالانقسام، الي كيانات ثقافية: حضارات علي ما يسميها هانتنغتون معدداً ثماني منها. وهي كيانات عميقة الاختلاف طالما ان إختلافها ناجم عن عناصر راسخة شأن اللغة والدين والتقاليد والتاريخ. وبما اننا نشهد تطوراً إقتصادياً وإجتماعياً يُضعف الكيانات السياسية (الدول-الامم) فإن افراد الكيانات الجديدة سيعرّفون انفسهم ويحددون ولاءاتهم السياسية بهويتهم الدينية او الاثنية او المناطقية ، اي الحضارية، بالمعني الذي يذهب اليه هانتنغتون، لا علي اساس الإنتماء الي الدولة ذات السيادة.
اما بالنسبة الي الإزدهار الاقتصادي المرهون بمناطق محددة، او التطور التقني في مجال الاتصال والمواصلات، فإن اياً منهما لن يؤدي الي التقارب والتفاهم بفعل الهجرة وإمكانية التواصل الفوري، وإنما الي حدّة الوعي بالاختلاف الحضاري . وهذا الوعي الحاضر والحادّ بالانتماء الي حضارات مختلفة سيفضي الي صراع لا مهرب منه خاصة وان الغرب، او الكيان الحضاري الغربيّ ، بلغ من القوة ذروتها بما سيحضه علي الامعان في نشر قيمه ومعاييره، في حين ان نُخب الكيانات الحضارية الاخري مُجدة في العودة الي اصولها الحضارية وتحديد ولاءاتها السياسية علي اساسها.
وعلي رغم ما تعاني منه هذه الفرضية من لبس وغموض وإنعدام تماسك، وهو ما كان قد آل الي ايداعها صندوق الافكار المثيرة والعجيبة، الاّ انها، ولعيوبها هذه بالذات في ذروة تعاظم مشاعر الغضب والنقمة جراء ما جري في نيويورك، وما يجري اليوم في افغانستان، تنطوي علي إغواء لا يُقاوم.
فهي لئن إستجابت، من وجه، المشاعرَ الفائرة وما ينجم عنها من بلاغة تفيد بالتمييز الجوهري بين البشر، ساعية الي تكريس هذه البلاغة اساساً لوعي سياسي كوني، فإنها، من جهة اخري، توآزر غموض وانعدام تماسك البلاغة المذكورة بما فيها هي نفسها من غموض وتناقض. وكما يستجيب الغموض الذي يكتنف شعاري إخراج الكفار من ديار الاسلام و الحرب علي الارهاب - وهما الشعاران اللذان في ظلهما تجري جولة الصراع الجديدة- مشاعرَ الغضب والكراهية، كذلك يستجيب الغموض في نظرية هانتنغتون من حيث هو غموض نابع عن عجز في تعريف العوامل التي تحدد نهاية كيان حضاري وبداية آخر مختلف. فتعريف العدو، أكان الكفار ام الارهابين ، او الحضارة الاخري ، غامض ومبهم في الشعارين المذكورين والنظرية علي السواء، ولكن بما يتوافق مع الملامح الغامضة المنسوبة للعدو المزعوم. ولا يقل التناقض في نظرية هانتنغتون إستجابة لرافعي الشعارين المذكورين ولعامة الناس، خاصة ممن شملتهم مشاعر الغضب وجعلت تتحكم بكلامهم وافعالهم.
فعلي رغم انه يزعم ان الناس تحددها عوامل ثقافية راسخة، بما يجعلها تعي ذاتها وتحدد ولاءاتها في ضوئها، الاّ انه، وهو الذي لا يختلف عن بقية الناس من حيث انه ينتمي الي كيان ثقافي يكوّنه ويحدد هويته، لا يتواني عن تعريف ثقافات من لا ينتمي اليهم ويعرفهم حق المعرفة بحسب فرضيته هو نفسه. فكيف لمن ينتمي الي ثقافة محددة تكوّن وعيه وهويته ان يُفلح في تعريف وتحديد حضارات الآخرين ما لم يفترض السمو علي كافة الانتماءات الثقافية في الوقت نفسه؟
ير ان هذا وإن نمّ عن انعدام تماسك، بل تناقض، في الفرضية المذكورة، يتوافق مع رطانة من ينطلقون من الإلتزام بمعايير وقيم ثقافية محلية في حين انهم لا يتورعون عن سوق تعريف كوني لثقافاتهم وثقافات الآخرين. والادهي ان المتلقّي العادي، لا سيما العالم ثالثي، قد يضرب صفحاً عن مثل هذا التناقض نظير ما تنطوي عليه الفرضية المذكورة من وعد. فحتي وان لم يمل المتلقي العالم ثالثي الي القول بإنقسام العالم وإختلافه علي اساس الدين او العرق او المنطقة، الاّ ان نسبه الي إطار سياسي مساوٍ للإطار الغربيّ أمر مغرٍ، حتي وان كانت المساواة المزعومة محض مساواة صوريّة. فحيث ان الصراع لم يعد، بحسب هانتنغتون، ايديولوجياً او إقتصادياً وإنما حضارياً، فإن تعريف الهوية السياسية للدول والامم علي اساس نسبها الي العالم الاول او الثاني او الثالث، تبعاً للتمييز الشائع، يصير باطلاً. وهو اذ يرجح التمييز علي اساس الانتماء الي حضارات مختلفة فإنه بذلك يتملق اولئك المتعطشين الي المساواة مع الحضارة الغربية حتي وإن ادعوا عكس ذلك.
ومن نافلة القول ان هانتنغتون من طراز المثقفين الاميركيين الذين لا يصوّرون الامور كما هي عليه، وإنما يحددون كيفية النظر الي شؤون العالم ومن ثم صوغ سياسة خارجية (اميركية) موافقة لذلك. فهانتنغتون ليس محض مفكر غريب الاطوار حدث ان إستجابت فرضيته الي ما يعتمل المزاج العام، وانما هو ابن مؤسسة ذات تأثير كبير في صوغ الوعي السياسي لافراد النخبة الاميركية، لا سيما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية. والاخطر ان من الارجح الاّ تقف فرضية كهذه عند حدود تعيين وعي النخبة في بلدان اخري، لا سيما بلدان العالم الثالث، وبما يؤدي حتماً الي شيوع سياسة لا تستوي علي اساس التغاضي عن الغموض وانعدام التماسك فحسب وإنما المصادقة عليه ومجاراته.(الحياة اللندنية)
فبعدما حسبنا ان العالم المتعلم قد بلغ من الوعي طوراً لم يعد ثمة مكان فيه للغة تتوسّل التمييز الجوهري بين البشر علي اساس الانتماء الديني او الاثني او الجغرافي، او الي ما هنالك من عوامل، فوجئنا عشية الهجوم الارهابي وغداته بمن ينذر بـ حرب البرابرة علي الحضارة الانسانية.
وليست رطانة من هذا القبيل بذاتها امراً خطراً طالما ان من المستبعد ان تدوم اجلاً اطول من دوام مشاعر الغضب والنقمة التي تولّدها اصلاً. غير انها لا تعدم الخطورة حينما تكتسي رداء نظرية او فرضية فكرية تزعم الاستناد الي معايير منطقية والاسترشاد بالبحث التاريخي نظير فرضية صدام الحضارات التي جعلت اصداؤها تتردد من جديد. وكانت هذه الفرضية تعرضت للكسوف بعد وقت قصير علي ظهورها، الي ان اطل علينا صاحبها صاموئيل هانتنغتون، إطلالة المنتقم، مذكّراً: ألم اقل لكم؟ .
وكان السيد هانتنغتون قد قال لنا ان نهاية الحرب الباردة نهاية صراع الايديولوجيات، لكنها حتماً ليست نهاية الصراع، وخلافاً لما سارع فرانسيس فوكوياما الي التبشير به، فإن انهيار النظم الاشتراكية لا يعني وصول قطار التاريخ الي محطته الاخيرة مؤذناً بإنتصار الليبرالية الغربية. فالصراع سيُستأنف، وإن ليس ايديولوجياً، او إقتصادياً ايضاً، علي ما زعم ليستر ثيرو، صاحب نظرية فانتازية اخري، ومؤلف تطاحن الرؤوس - وإنما ثقافياً. وان الصراع الثقافي وحده دون غيره ما سيحدد طبيعة النظام الدولي للقرن الواحد والعشرين.
فالعالم ينقسم، او هو آخذ بالانقسام، الي كيانات ثقافية: حضارات علي ما يسميها هانتنغتون معدداً ثماني منها. وهي كيانات عميقة الاختلاف طالما ان إختلافها ناجم عن عناصر راسخة شأن اللغة والدين والتقاليد والتاريخ. وبما اننا نشهد تطوراً إقتصادياً وإجتماعياً يُضعف الكيانات السياسية (الدول-الامم) فإن افراد الكيانات الجديدة سيعرّفون انفسهم ويحددون ولاءاتهم السياسية بهويتهم الدينية او الاثنية او المناطقية ، اي الحضارية، بالمعني الذي يذهب اليه هانتنغتون، لا علي اساس الإنتماء الي الدولة ذات السيادة.
اما بالنسبة الي الإزدهار الاقتصادي المرهون بمناطق محددة، او التطور التقني في مجال الاتصال والمواصلات، فإن اياً منهما لن يؤدي الي التقارب والتفاهم بفعل الهجرة وإمكانية التواصل الفوري، وإنما الي حدّة الوعي بالاختلاف الحضاري . وهذا الوعي الحاضر والحادّ بالانتماء الي حضارات مختلفة سيفضي الي صراع لا مهرب منه خاصة وان الغرب، او الكيان الحضاري الغربيّ ، بلغ من القوة ذروتها بما سيحضه علي الامعان في نشر قيمه ومعاييره، في حين ان نُخب الكيانات الحضارية الاخري مُجدة في العودة الي اصولها الحضارية وتحديد ولاءاتها السياسية علي اساسها.
وعلي رغم ما تعاني منه هذه الفرضية من لبس وغموض وإنعدام تماسك، وهو ما كان قد آل الي ايداعها صندوق الافكار المثيرة والعجيبة، الاّ انها، ولعيوبها هذه بالذات في ذروة تعاظم مشاعر الغضب والنقمة جراء ما جري في نيويورك، وما يجري اليوم في افغانستان، تنطوي علي إغواء لا يُقاوم.
فهي لئن إستجابت، من وجه، المشاعرَ الفائرة وما ينجم عنها من بلاغة تفيد بالتمييز الجوهري بين البشر، ساعية الي تكريس هذه البلاغة اساساً لوعي سياسي كوني، فإنها، من جهة اخري، توآزر غموض وانعدام تماسك البلاغة المذكورة بما فيها هي نفسها من غموض وتناقض. وكما يستجيب الغموض الذي يكتنف شعاري إخراج الكفار من ديار الاسلام و الحرب علي الارهاب - وهما الشعاران اللذان في ظلهما تجري جولة الصراع الجديدة- مشاعرَ الغضب والكراهية، كذلك يستجيب الغموض في نظرية هانتنغتون من حيث هو غموض نابع عن عجز في تعريف العوامل التي تحدد نهاية كيان حضاري وبداية آخر مختلف. فتعريف العدو، أكان الكفار ام الارهابين ، او الحضارة الاخري ، غامض ومبهم في الشعارين المذكورين والنظرية علي السواء، ولكن بما يتوافق مع الملامح الغامضة المنسوبة للعدو المزعوم. ولا يقل التناقض في نظرية هانتنغتون إستجابة لرافعي الشعارين المذكورين ولعامة الناس، خاصة ممن شملتهم مشاعر الغضب وجعلت تتحكم بكلامهم وافعالهم.
فعلي رغم انه يزعم ان الناس تحددها عوامل ثقافية راسخة، بما يجعلها تعي ذاتها وتحدد ولاءاتها في ضوئها، الاّ انه، وهو الذي لا يختلف عن بقية الناس من حيث انه ينتمي الي كيان ثقافي يكوّنه ويحدد هويته، لا يتواني عن تعريف ثقافات من لا ينتمي اليهم ويعرفهم حق المعرفة بحسب فرضيته هو نفسه. فكيف لمن ينتمي الي ثقافة محددة تكوّن وعيه وهويته ان يُفلح في تعريف وتحديد حضارات الآخرين ما لم يفترض السمو علي كافة الانتماءات الثقافية في الوقت نفسه؟
ير ان هذا وإن نمّ عن انعدام تماسك، بل تناقض، في الفرضية المذكورة، يتوافق مع رطانة من ينطلقون من الإلتزام بمعايير وقيم ثقافية محلية في حين انهم لا يتورعون عن سوق تعريف كوني لثقافاتهم وثقافات الآخرين. والادهي ان المتلقّي العادي، لا سيما العالم ثالثي، قد يضرب صفحاً عن مثل هذا التناقض نظير ما تنطوي عليه الفرضية المذكورة من وعد. فحتي وان لم يمل المتلقي العالم ثالثي الي القول بإنقسام العالم وإختلافه علي اساس الدين او العرق او المنطقة، الاّ ان نسبه الي إطار سياسي مساوٍ للإطار الغربيّ أمر مغرٍ، حتي وان كانت المساواة المزعومة محض مساواة صوريّة. فحيث ان الصراع لم يعد، بحسب هانتنغتون، ايديولوجياً او إقتصادياً وإنما حضارياً، فإن تعريف الهوية السياسية للدول والامم علي اساس نسبها الي العالم الاول او الثاني او الثالث، تبعاً للتمييز الشائع، يصير باطلاً. وهو اذ يرجح التمييز علي اساس الانتماء الي حضارات مختلفة فإنه بذلك يتملق اولئك المتعطشين الي المساواة مع الحضارة الغربية حتي وإن ادعوا عكس ذلك.
ومن نافلة القول ان هانتنغتون من طراز المثقفين الاميركيين الذين لا يصوّرون الامور كما هي عليه، وإنما يحددون كيفية النظر الي شؤون العالم ومن ثم صوغ سياسة خارجية (اميركية) موافقة لذلك. فهانتنغتون ليس محض مفكر غريب الاطوار حدث ان إستجابت فرضيته الي ما يعتمل المزاج العام، وانما هو ابن مؤسسة ذات تأثير كبير في صوغ الوعي السياسي لافراد النخبة الاميركية، لا سيما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية. والاخطر ان من الارجح الاّ تقف فرضية كهذه عند حدود تعيين وعي النخبة في بلدان اخري، لا سيما بلدان العالم الثالث، وبما يؤدي حتماً الي شيوع سياسة لا تستوي علي اساس التغاضي عن الغموض وانعدام التماسك فحسب وإنما المصادقة عليه ومجاراته.(الحياة اللندنية)





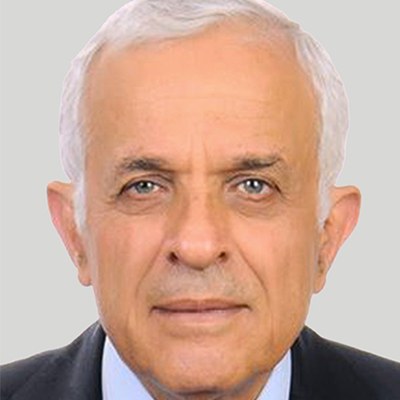















التعليقات