مايكل يونغ - ديلي ستار
غالبا ما تلجأ المؤسسات الراغبة في استخدام عاملين جدد إلى تقديم وعد من قبيل: quot;إننا نقدم اكثر من مجرد وظيفة.. إننا نقدم مهنةquot;. وكما ادرك رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قبل رحلته التي قام بها مؤخراً الى الشرق الاوسط، فإن عملية السلام الفلسطينية-الاسرائيلية قد أصبحت مهنة تقدم أشكالاً من القوة تصلح من حال الساسة ذوي الأحوال المتدهورة. لكن، وفي الوقت الذي يدور فيه حديث كئيب عن الحاجة إلى استئناف تلك العملية، فان الحقيقة هي ان لا الاسرائيليين ولا الفلسطينيين يتمتعون بظروف مواتية تمكنهم من اجراء مفاوضات جادة.
في المستقبل المنظور، يظل السلام الاسرائيلي-الفلسطيني أشبه بسراب يعيش على افتتان الدبلوماسيين بفكرة العملية السلمية. وعلى نحو ما، يعتقد هؤلاء المحترفون بأن المشكلة تكمن في ايجاد الجرعة المناسبة من التنازلات التي تعزز المفاهيم المتبادلة الصحيحة للأمن، بحيث يوضع كل شيء في مكانه بمنتهى السلاسة. ومع كل فشل جديد، يبدأ إجراء الحسابات مجددا في غمرة اعتقاد دائم بان مسار العلاقات الاسرائيلية-الفلسطينية يمكن مع ذلك ان يتحول الى ذهب الصداقة الدائمة.
ويرى اولئك الذين يقفون على كلا جانبي الانقسام حلاً يشترط أن يعتنق الطرف الآخر وجهات نظرهم بالكامل. غير أنه لا يوجد حتى الساعة، سواء في المناطق الفلسطينية او في اسرائيل نفسهما، اي اجماع مقنع على خطوط عامة لأي اتفاق نهائي، ناهيك عن اجماع على شيء يمكن ان يرضي الآخر. اضف الى ذلك حقيقة لا زالت تلقى الاستخفاف من جانب بائعي السلام المحترفين: وهي ان كلا من السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية تفتقران الى الدعم الشعبي المحلي والثقة اللازمة للاقدام على بذل التضحيات التي تتطلبها التسوية النهائية.
ثمة الكثير المستفاد من الحقيقة التي تقول بان الفلسطينيين يعدون العدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقبل حماس فيها بصيغة غائمة تلمح الى اعتراف الحركة بوجود اسرائيل. ويجب ان تعني الحكومة الجديدة اعادة فتح صنابير تدفق المساعدات الاجنبية على الفلسطينيين. وربما تساعد حتى في جلب حماس أقرب إلى القبول بقيام دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أن السؤال حول مدى مثل هذا الاقتراب يظل سؤالاً كبيراً، لكن ثمة شيئا واحدا لن تفعله، وهو جعل مباحثات السلام اسهل، لان مبدأ quot;الوحدة الوطنيةquot; سيعطي حماس على الأغلب حق نقض اي شروط تكون فتح اكثر ميلا لقبولها. كما انه سيكون لدى الحركة الاسلامية التي تتمتع باغلبية في البرلمان مبررا كافيا للدفاع عن خياراتها على اعتبار انها تتماشى مع الاولويات الفلسطينية.
للمرء أن ينظر مثلاً إلى تلك العقبة الكأداء التي تعترض سبيل أي اتفاق اسرائيلي فلسطيني، أعني حق الفلسطينيين في العودة. إن عرفات لم يكن راغباً على الإطلاق، حتى وهو في اوج قوته، في التوصل الى صفقة يمكن ان تفسر على أنها تنازل عن حق اللاجئين في العودة الى ديارهم داخل اسرائيل. لكن أي تفكير بمثل هذه العودة لا يعتبر أمراً مقبولاً بأي حال بالنسبة للاسرائيليين. ولا يبدو في الاثناء ان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الضعيف نسبياً سوف يقدم على تحدي حماس، ناهيك عن شعبه، من خلال اعادة تفسير ذلك الحق لصالح اسرائيل. كما ان اسرائيل لن تقبل بما تعتبره حصان طروادة الديمغرافي. وفي ذلك الخلاف في حد ذاته ووحده يكمن جمود عصي على الحل.
وعلى الجانب الاسرائيلي، كانت حرب لبنان الاخيرة كارثية بالنسبة لرئيس الوزراء ايهود اولميرت، ليس بسبب quot;انتصارquot; حزب الله وسط خرائب جنوب لبنان، ولكن بسبب تداعي خطاب أولميرت السياسي الانتخابي الذي كان السبب في حصوله على الشرعية كرئيس للحكومة، وتحديدا وعده بإجراء انسحاب اسرائيلي احادي الجانب من الضفة الغربية. وقد اظهر حزب الله ان إسرائيل مهما اعلت من تشييد الصروح والاسوار، فانه يمكن اطلاق الصواريخ من فوقها. وهو سبب يفسر لجوء اولميرت بحرص الى انتهاج الشدة في لبنان في البداية لردع اي هجمات مستقبلية قد يشنها الفلسطينيون ولانقاذ استراتيجيته. وقد أخفق في ذلك، وتم تعليق خطته، وليس من السهل التكهن بالسرعة التي سيعاد بعثها بها.
وعليه، ومع عجز الحكومتين الفلسطينية والاسرائيلية عن التقدم كثيرا جدا باتجاه السلام، فهل ينصح باستمرار الدبلوماسية؟ لقد دأبت الإجابة المهتزة على أن تكون quot;نعمquot;. ولكن يمكن القول بشكل مسوغ بأن جهود الوساطة ما دامت غير مجدية اليوم، فإن من الأفضل ترك النزاع يختمر حتى يجد الاسرائيليون والفلسطينيون انه لم يعد من خيار امامهم سوى الشروع في مفاوضات مجدية. اما الدبلوماسية، فإنها قد تنتهي في الحقيقة الى قتل المريض بدلاً من إنقاذه.
كما سبق وأن اتضح من لقاء كامب ديفيد بين عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك في تموز - يوليو من عام 2000، فان اي جهد لفرض حل على اطراف غير مستعدة له يمكن ان يفضي الى نتائج أوخم. حيث لم يكن عرفات في حينه راضيا عن سعي باراك نحو الذهاب الى حل نهائي قبل ان يكون الاسرائيليون قد اوفوا بعدة التزامات للفلسطينيين. وقد شعر عرفات، وكان محقاً في ذلك، بأنه كان يجري جره إلى الخروج عن المسار، فكانت ردة فعله مزيدا من التصلب، في القمة المذكورة وفي الجهود الدبلوماسية اللاحقة. وهو ما لم يكن أمراً طيباً بالنسبة للفلسطينيين. وفي النهاية، ظن بانه يمكن ان يحسن من وضعه عن طريق تسعير الانتفاضة، ففعل، وخسر كل شيء.
على نفس الشاكلة، لم يشعر باراك ابدا بقدر كاف من الشعور بالأمان لجهة ضمان الدعم الاسرائيلي المحلي للتوصل الى صفقة نهائية تتضمن الوفاء بوعود مؤقتة كانت اسرائيل قد قدمتها للفلسطينيين. ومع ذلك، فقد اخفى، مثل المقامر، ورقة كامب ديفيد، إما ليجني ربحاً مزدوجاً أو لا شيء على الإطلاق. وظن ان التوصل الى حزمة تشكل صفقة نهائية راديكالية يمكن ان تجمع الاسرائيليين حوله، وبغض النظر عن شكوكهم المبدئية. وربما كان لهذا ان يؤتي ثماره مع ابناء جلدته، لكن باراك لم يفكر ابدا فيما اذا كان القادة الفلسطينيون او المجتمع الفلسطيني سيوافقون على ذلك. وانتهى به المطاف هو ايضا الى خسارة كل شيء.
أما في الوقت الراهن، فان الابقاء على وهم عملية السلام حيا قد يؤدي وحسب الى استعجال مشابه، فيما يحاول دبلوماسيون في مرحلة ما اظهار شيء من جهودهم في وقت يحافظون فيه على ابقاء وتيرة التوقعات عالية، وبدرجة غير واقعية، لجهة التوصل الى نتيجة مشجعة. وتترافق مع هذه التوقعات حالة كبت اكثر حدة، خاصة لدى الجانب الفلسطيني. وفي الغضون، وعلى اساس يومي، يجري التوضيح بان الشروط الفلسطينية الدنيا نظير القبول بتسوية إنما تظل بعيدة أميالا عن نظيرتها الاسرائيلية.
سيرد الدبلوماسيون بالقول ان العمل بدأب ودون كلل يمكن ان يجلب الفلسطينيين والاسرائيليين الى كلمة سواء في نهاية المطاف. لكن الأمر الأكثر ترجيحاً لأن يجمعهما معاً هو حرمان الفرقاء من عملية سلمية، وبحيث يواجهان وحدهما صرامة خياراتهما. وعندما يرى كلا الجانبين انهما يجب ان يتعاملا مع بعضهما البعض بدلا من التعامل عبر مجموعة من محترفي تسويق الأوهام، فإن المفاوضات قد تجد عندها فرصة افضل لان تؤتي ثمارها. وستتحول عملية صنع السلام عندها الى مجرد وظيفة فحسب. ولكنها قد تكون وظيفة تم أداؤها كما ينبغي ولو لمرة واحدة.





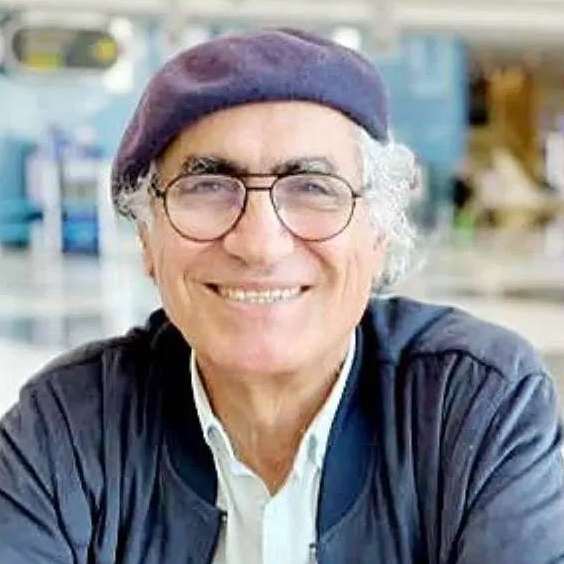











التعليقات