إمحمد مالكي
ليس ثمة شك في أن من أكبر تحديات الألفية الجديدة تلك الفجوة المعرفية المهولة التي وسمت البلاد العربية قياساً مع غيرها من أقطار المعمورة. ففي استطلاع لجريدة quot;لوموندquot; الثقافية الفرنسية قبل بضع سنوات (2005) تمت الإشارة إلى أنه في بحر عام 2004 وصلت مبيعات الكتب إلى 450 مليون نسخة، كما أصدرت المطابع 50.000 عنوان خلال السنة نفسها، ليتجاوز رقم أعمال المبيعات 2.5 مليارات يورو، أي بنسبة ارتفاع 4% مقارنة مع سنة 2003. وعلى صعيد المقارنة الأفقية، يقارب عدد الإصدارات في بريطانيا 80.000 عنوان، و70.000 في إيطاليا.
تكمن أهمية هذه الأرقام المعلنة من لدن quot;الاتحاد الوطني للنشرquot; بمناسبة معرض الكتاب المُقام في باريس أيام 18 ـ 23 آذار 2005، في كونها تعبر عن واقع المعرفة في البلاد الأوروبية عموماً وحجم انتشارها، كما تدل على القيمة المتزايدة المخولة للعلم والفكر في سُلَّم أولويات هذه الدول واستراتيجياتها الثقافية. فالمعرفة لم تعد وسيلة لتحصين الهوية والشخصية الوطنية والتفاعل الحضاري، بل غدت، علاوة على ذلك، أداةً لإنتاج رأس المال البشري وتنمية قدراته في البناء الوطني. بيد أن المقارنة العمودية، وهو ما نخاله أساسياً في هذا المقام، تدل على وجود هوة مُهولة في مجال المعرفة وآليات نشرها بين البلدان أعلاه والأقطار العربية، والحال أن quot;تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002quot;، الذي كُتِبت فصولُه بأقلام عربية، كان مُحقاً حين خَلُصَ إلى أن أكبر النقائص وأعمقها في البلاد العربية تكمن في العجز الحاصل في مجالات quot;المعرفة والحرية وتمكين المرأةquot;، ولعله كان موفقاً إلى حد بعيد، في تشخيص الفجوة المعرفية في تقريره الثاني لسنة 2003، فمن أبرز ما أشار إليه تشديده على أنه رغم ازدياد عدد الكتب المترجمة إلى العربية من 175 عنواناً خلال فترة 1970 ـ 1975، فإن ذلك لم يتجاوز خُمُسَ ما ترجمته اليونان على سبيل المثال، وإذا كان التقدير الإجمالي للكتب المترجمة إلى العربية منذ تأسيس quot;بيت الحكمةquot; على عهد الخليفة العباسي quot;المأمونquot; قد وصل إلى عشرة آلاف كتاب، فإن ما ترجمته إسبانيا خلال سنة 1999 وحدها تجاوز هذا الرقم. يُضاف إلى ذلك، أن متوسط الكتب المترجمة لكل مليون من سكان الوطن العربي لا يتعدى 4.4 كتب، أي أقل من كتاب واحد في السنة لكل مليون عربي، بينما بلغ المعدل 519 كتاباً في المجر، و920 كتاباً في إسبانيا. أما وتيرة نشر البحوث، فتُقدر بـ26 بحثاً لكل مليون فرد في العام، مقابل 840 في فرنسا، و1252 في هولندا، و1878 في سويسرا، والملاحظة نفسها تنسحب على النشاط العلمي، حيث ما زالت البلاد العربية بعيدة عن الدُّنُوِّ من إدراك المعدلات المنجزة في مجمل الدول الأوروبية والغربية عموماً. يُشار إلى أن مؤتمر فرانكفورت للعام 2004 الذي خصص دورته للاحتفاء بالثقافة العربية أبانَ عن محدودية الترجمة والنشر في جميع البلاد العربية، وقد بدا الحوار بين المثقفين العرب، على حضورهم الكثيف في معرض فرانكفورت، وكأنه حوار بين العرب أنفسهم، كما أشارت إلى ذلك الكثير من الدراسات النقدية والندوات الإعلامية المواكبة لانعقاد المؤتمر.
ليس قدر الأمة العربية أن تبقى سجينة هذا الواقع الموسوم بانحسار الفكر والثقافة والمساهمة الفعالة في العطاء الحضاري المشترك، بل أفقها أن تنخرط في دينامية إنتاج المعرفة ونشرها وتجديدها، غير أن ذلك رهين بمدى قدرتها على إعادة صياغة منظورات جديدة لنظام المعرفة المطلوب والمنشود. فمن الخطوات العملية المتدرجة على هذا السبيل إطلاق حريات الرأي والتعبير والاجتهاد على الصعيد النظري والفكري، بيد أن ذلك لصيق بدوره بالعديد من المتطلبات من قبيل تجديد النظم التربوية، والنهوض بالتعليم في مختلف مراحله وأسلاكه، وإيلاء عناية خاصة لتعليم الأطفال، وتوطين العلم وبناء القُدُرات الذاتية للبحث العلمي، وتوظيف المعرفة لتشييد اقتصاد عربي جديد، بُغية الوصول إلى إقامة نظام معرفي أصيل يتخلص من عملية الاقتباس السهل لمقولات من الشرق والغرب، وينشُد لنفسه أفقاً متحرراً ومستقلاً، فمن دون رسم استراتيجية واضحة العناصر، واعتماد وسائل واقعية وفعالة للإنجاز، والأهم حصول توافق بين القوى الحية في الأمة حول مقاصد هذه الاستراتيجيا، ستؤدي البلاد العربية غالياً ثمن تخلفها المعرفي، وهو بمقاييس القرن الجديد ثمن عام وشامل سيطال كلّ الصعد الاقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية.













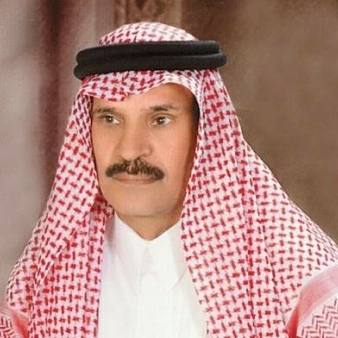
التعليقات