فرصة أخرى ضائعة!
هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى الذهن بمراقبة الانتخابات الفلسطينية المقبلة التي طال انتظارها. فعندما جرى الإعلان عن قرار إجراء الانتخابات لأول مرة، كان البعض منا يأمل أن توفر فرصة للفلسطينيين لمحاولة تحقيق 3 تغييرات في مسارهم السياسي؛ تنظيم تغيير الأجيال في المستويات العليا لصنع القرار السياسي، وصياغة الحد الأدنى من التفاهم بين الجماعات السياسية المتنافسة منذ فترة طويلة حول القواعد الأساسية للعبة، والأهم من ذلك تحويل إصداراتهم المختلفة من «القضية» إلى مشروع بناء دولة متجذرة على أرض الواقع.
بالحكم على المسار الذي سلكته الحملة الانتخابية الباهتة، والهيمنة المستمرة على مشهد اليوم من قبل رجال الأمس، لا يبدو أن أياً من هذه الآمال الثلاثة على وشك التحقيق. ففي شكلها الحالي، لا تزال السياسة الفلسطينية ضامرة ومتقوقعة في قضية تبدو خاسرة، تسير على منوال «الزومبي» لتقطع الطريق إلى «طاقات الإيجابية».
قبل أقل من عام، في رحلته الأخيرة إلى الخارج، أبلغ «المفاوض» المخضرم صائب عريقات جمهوراً صغيراً في منزل السفير الكويتي في لندن أن الفلسطينيين يستعدون لمحاولة عمل تغيير جذري في المسار، على أمل لتحقيق «سلام عادل».
وفي المناقشة التي أعقبت ذلك، رأينا أن استخدام أي خطوة مؤهلة للسلام قد يجعل تحقيق السلام مستحيلاً، لأنه بطريقة ما فإن السلام دائماً ما يكون غير عادل لطرف من الأطراف.
أصرّ عريقات على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام ما لم تتحقق 4 شروط.
أولاً، يجب أن توافق إسرائيل على العودة إلى خطوط وقف إطلاق النار لعام 1968. لقد تجاهل حقيقة أن خطوط وقف إطلاق النار موجودة في سياق هدنة، وليس سلاماً، وأنه إذا كان تحقيق السلام هو الهدف، فلا فائدة من اختيارها شرطاً لا غنى عنه في اتفاق تفاوضي.
على أي حال، لماذا اخترت عام 1968 كمؤشر؟ لماذا لم يكن 1948 أو 1048 حتى 68 ميلادية؟ علاوة على ذلك، فقد تم رسم خطوط وقف إطلاق النار هذه بين إسرائيل من جهة، و4 دول عربية من جهة أخرى، من دون إشراك فلسطين فيما بدا أبعد من فكرة رمزية غامضة. على أي حال، فإن خطوط وقف إطلاق النار هذه، مع مصر والأردن وسوريا ولبنان، خضعت لتغييرات - وبعضها له أهمية كبيرة - منذ عام 1968، ومحاولة إحيائها سيؤثر على استقرار المنطقة.
يتعلق «الشرط» الثاني لعريقات بـ«حق العودة» الذي يسمح للفلسطينيين الذين يرغبون في الاستيطان في أرض أجدادهم أن يفعلوا ذلك. إن «حق العودة» معترف به في القانون الدولي ويمارسه بشكل روتيني مئات الشعوب في عدة بلدان كل عام. ومع ذلك، هذا يعد حقاً فردياً وليس جماعياً، وتعتمد ممارسته على موافقة وقوانين الدول المعنية. بعبارة أخرى، لا يمكن لإسرائيل ولا لأي دولة أخرى أن تمنح حقاً جماعياً من شأنه أن يسمح لجميع الباحثين عن «العودة» بالقيام بذلك متى وكيف رغبوا. بمعنى آخر، يتعين على الفلسطينيين أولاً الاعتراف بإسرائيل كدولة شرعية، قبل أن يتمكنوا من العمل معها، للسماح لطالبي العودة بتحقيق هدفهم بموافقتها.
يتعلق «الشرط» الثالث بوضع القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المفترضة. وهنا أيضاً كان الموقف الفلسطيني مناسباً لمن تُعتبر فلسطين بالنسبة لهم قضية، وليست مشروعاً لبناء الدولة. وهنا يتوارد إلى ذهني مثل فارسي يقول «لا تحرق قيصرية من أجل منديل»، بما يعني أنه لا ينبغي التضحية بهدف أكبر من أجل اعتبار أصغر. فاستيعاب «عاصمة» لدولة فلسطينية مفترضة في مناطق القدس الكبرى يعتبر أمراً محتملاً منذ التسعينات.
وفيما يتعلق بـ«العواصم»، هناك كثير من الأمثلة غير النمطية، ناهيك عن الحالات الشاذة. كان من المفترض أن تكون «عاصمة» جمهورية ألمانيا الديمقراطية في برلين، لكن الأمر خضع لتدخلات وانقسام بين معسكري الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى. لكن في الواقع، كان النظام الشيوعي موجوداً في بانكو، إحدى ضواحي برلين. أيضاً هناك مدينتا كينشاسا وبرازافيل، وهما في الواقع توأمان حضريان على ضفتي نفس النهر، لكنهما عاصمتان لدولتين مختلفتين. كذلك تقع دولة الفاتيكان بأكملها في روما، عاصمة دولة أخرى هي إيطاليا.
من الممكن بالطبع دحض هذه الحجة، بالإشارة إلى «المكانة الخاصة» للقدس في المصطلحات الدينية، وليس المصطلحات الأسطورية. مثل هذا القلق يمكن فهمه إذا ظل المرء مجمداً مع فلسطين كقضية، وليس كمشروع لبناء الدولة. ومن المثير للاهتمام أن بعض الرواد الصهاينة واجهوا معضلة دولة أو قضية مماثلة. فقد عارض كثيرون قرار ديفيد بن غوريون قبول تقسيم ما تبقى من الانتداب البريطاني، الأمر الذي ترك لليهود بقايا الجبنة السويسرية من الأراضي التي لم تشمل القدس الغربية، ولم يذكر الكثير من المواقع الأخرى التي يوجد بها «أماكن مقدسة لليهود». فإذا كان إنشاء دولة إسرائيل هو الهدف الأسمى، فلا بد من النظر إلى جميع الاعتبارات الأخرى على أنها ثانوية.
كان الشرط الرابع لعريقات هو «التواصل الجغرافي» بين الضفة الغربية وقطاع غزة. واشتراط أن يكون الهدف هو بناء دولة، فهذا أيضاً يمثل مشكلة صغيرة يمكن حلها من خلال ممر تحت الأرض أو فوق الأرض عبر الأراضي الإسرائيلية. الأهم من كل شيء أن كثيراً من الدول تفتقر إلى التواصل الإقليمي، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والدنمارك. ففي عام 1947 لم تمنع حقيقة أن غرب باكستان وشرق باكستان يفصل بينهما حينها 1000 ميل، وتفصلهما دولة هندية معادية، مسلمي الهند من قبول الصفقة التي قدّمها لهم الإمبرياليون البريطانيون.
عندما انتهى الانتداب البريطاني في عام 1947، لم تكن هناك أمة فلسطينية بالمعنى المقبول عالمياً لمصطلح معاهدات «ويستفاليا» على الأقل، للمطالبة بدولة خاصة بها. في الواقع، تشير جميع وثائق الانتداب ووثائق الأمم المتحدة اللاحقة إلى «سكان» فلسطين الانتدابية المقدَمة على أنهم العرب واليهود والدروز والأرمن والبهائيون والأتراك وكثير من الطوائف المسيحية، بما في ذلك الآشوريون والكلدانيون. اليوم، ورغم ذلك، فإن الأمة الفلسطينية هي حقيقة تشكلت على مدار 8 عقود من الخبرة المشتركة.
هذه الأمة الحديثة التشكيل، لها ثقافتها الخاصة وأدبها، وموسيقاها، ونظرتها إلى العالم، والتي على الرغم من جذورها في التعويضات التاريخية الأعمق التي تندمج معاً، فإنها تختلف عن جيرانها العرب والإسرائيليين. يبدو أن جمهور الفلسطينيين مستعد للانتقال من قضية إلى دولة، ومع ذلك فإن شخصيات مؤسستهم السياسية في كل من فتح و«حماس» لا يزالون أسرى لاستراتيجية تنتمي إلى متحف القضايا المفقودة.
الواقع العادل أو الظالم اليوم يفتقر إلى وسائل تحقيق المثل الأعلى الذي يعرضه تجار فلسطين كقضية. ومع ذلك، قد يتساءل الفلسطينيون الأصغر سناً؛ ماذا كان بن غوريون سيقول؛ هل أقبل صفقة صعبة وأحصل على دولة أم أتشبث بقضية وأبقى بلا دولة؟
من غير المرجح أن تجيب هذه الانتخابات عن هذا السؤال.















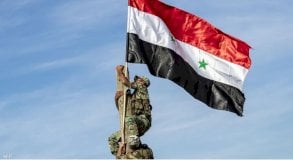


التعليقات