إن المتصفح لتاريخ الفلسفة العالمية سيدرك حتما فكرة مركزية ظلت ثابتة فيه، ألا وهي فكرة أهمية الفلسفة ذاتها- كنشاط فكري متميز- في حركة البعث والإحياء والتجديد renouvellement، وهي أهمية لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن إستراتيجية الفلسفة في عملية القلب والإحياء والتنوير lumiegrave;res كعلامة فارقة عن مجالات المعرفة الأخرى، وهي القدرة التي تغري التفكّر فيها والتساؤل عنها وفق السؤال التالي: من أين اكتسبت الفلسفة قدرة الهدم والبناء، وإحداث القطائع الإبستيمية بين مراحل الوعي البشري العام؟.
هو تساؤل اختلف حوله الفلاسفة والتيارات دون الوصول إلى تعين فكري خاص به إلى يومنا هذا؟، ونحن من خضم هذه الجدلية سنسائل أنفسنا عن أهمية الفكر الفلسفي الدائر في مجتمعنا الجزائري المعاصر وعلاقته بما يفرزه المجتمع في حركته اليومية من انشغالات معاشية مختلفة، وهو تساؤل نفسه الذي يشمل باقي دوائر التفلسف في العالم العربي نظرا لتقارب حركات التفلسف فيما بينها بنفس النمطية والنتائج، وعجز هذا النوع من الفكر عن خلخلة الواقع العربي كما كنا يأمل، وكما حدث في تاريخ الفلسفة الغربية.
المعروف في ثقافتنا الجزائرية وبما فيها العربية في بداية العشرية من القرن الحالي، أن سؤال التقدم والنهضة فيها، أصبح يحمله المجتمع بجميع أطيافه ولم يعد يقتصر على النخبة فقط، فقط اللغة المتدولة بينهما في هذا الموضوع تختلف، إلى درجة أنه صار همّا على الوعي الاجتماعي الجزائري، وما الحركات الاجتماعية الحاصلة في عالمنا العربي اليوم بألوان مختلفة يمكن قراءتها قراءة نهضوية من أجل كسر التقليد وبلوغ الأفضل، وهذا يدل على أن هذا الوعي بدأ يلتفت إلى نفسه ويعي ظروفه أكثر من أي وقت مضى، علامة تحيلنا مباشرة إلى التساؤل عن موقع الحراك الفلسفي عندنا من هذا الإشكال العام، وهو ما سينقلنا من إشكال النهضة الحضارية إلى إشكال نهضة الفلسفة ذاتها كشرط على قيام النهضة الاجتماعية المنشودة،عن طريق إعادة قراءة بعض مشاهد الفكر الفلسفي الدائر عندنا ورهاناته وتحدياته وقدرته على إنتاج المفهوم الذي يتطلبه الإحياء.
لقد مرّ الفكر الفلسفي في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا بثلاث مراحل، مرحلة الستينيات والسبعينيات، ومرحلة الثمانينات والتسعينات، ومرحلة العشرية الأولى من القرن الحالي الجارية، كانت لكل مرحلة منها مشهديتها وقضاياها ومفاهيمها الخاصة، وهي مكونات حدثت نتيجة تفاعل الوعي الجمعي مع ظروف المرحلة السائدة، وهذا الذي جعل المفكر يفكر تحت ضغط المعيش وما هو حاصل في راهنه، داخل سياقات اجتماعية وثقافية بارزة، وهي سياقات التي أنتج فيها أدب وفكر الستينيات والسبعينيات. فكر بطولي مزهو بإشراقات الاستقلال، متأملا في عظمة فعل صناعة تاريخ جديد للجزائر الحرة.
مثقفو هذه الفترة أظهروا مقدرة كبيرة في وصف الحدث الأعظم(الإستقلال)، وصف حملته الأعمال الروائية والنصوص التاريخية وبعض النصوص الاجتماعية، التي أسهبت في تحليل خصوصيات المجتمع الجزائري والفروقات الحاصلة بين ثقافة الريف والمدينة ، التي ظهرت بقوة في أعمال الروائي طاهر وطار والكاتب ياسين ومولود فرعون، ومحمد ديب وفي أعمال رشيد بوجدرة، وفي فكر عبد الله شريط ومصطفى الأشرف وقاسم نايت بلقاسم وغيرهم من مفكري العصر.
الفكر الجزائري وعاطفة المفهوم: إن الحماسة التي طغت على فكر مرحلة الستينيات والسبعينيات، ساهمت بشكل كبير في إنتاج إيديولوجيا التفكير العام للمجتمع الجزائري، وهي إيديولوجيا تكوّنت من كل ما يعارض فكر المستعمر الفرنسي ومن ما لا يمت أية سمة به. إيديولوجية فكر تناصر مقومات التحرر والعدالة الاجتماعية والمساواة الجماهيرية وإتيقا العمل المشترك، التي انتشلتها من مصادر لم يكن مجتمعنا متصالحا معها بالشكل اللازم، وهذه المصادر كانت موزعة بين روافد الاشتراكية والإسلامية، وأهملت صبغيات هوية الفرد الجزائري الخاصة التي تعود إلى ما قبل الإسلام.
واللافت للنظر في ما يتعلق بهذين المصدرين، هو أنهما سيدخلان في جدل حاد في المرحلة الموالية، وهما اللذان قادا المجتمع الجزائري في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي إلى فقدان الثقة في نفسه ودخوله في دوامة عنف حادة بهدف تصحيح تاريخ الأمة، الذي كان نتاج صراع إيديولوجية الدولة الروحية وإيديولوجية الدولة المادية. صراع الجماهير المؤمنة مع النظام الحاكم، بهدف إخراج الأمة من حالة الفراغ والاغتراب الذي عرفهما المجتمع الجزائري بعد الاستقلال. استقلال ولد بدون مشروع واضح المعالم لمجتمع فتي.
إن سرعة تشكّل السياقات الإيديولوجية عشية الاستقلال، راجع إلى حدة التنافس على ملئ الوعي ظل فارغا طيلة فترة الاحتلال بأطر متناقضة، من أجل بناء جغرافيا فكر موزع بين الإيديولوجية الاشتراكية والإيديولوجية الإسلامية، ولكل واحدة منهما مبرراتها وبرامجها تبتلع بها الذرات الفردية، والمفاهيم الأساسية التي تم توظيفها في هذا السياق هي كلها مفاهيم كانت جاهزة أصلا قبل الاستقلال، ولنقل أنها كلها مفاهيم تاريخية ساهمت في صناعتها شعوبا وأمما أخرى، الأمر الذي جعل من الخطابات الثقافية والفكرية التي أنتجت في هذه الفترة هي كلها خطابات مشحنة بالعاطفة، عاطفة بطولية تعبر عن النصر، وكيف للغبن والعبودية أن يقودا إلى المجد؟.
والغريب في الأمر أن العقل المثقف هو الآخر بات ضحية هذا الجدل، وبدلا له لأن يشارك في تصحيح المسار والمساهمة في بناء ثقافة العصر بشكل موضوعي بالنقد، تحوّل إلى أحد أدوات الصراع الإيديولوجي، بما يعرف بالعقل الإسلامي الذي أطر مؤتمرات فكرية إسلامية والذي اجتهد على إحياء التراث الإسلامي في الجزائر وقسنطينة بفضل نخبة قوية متماسكة، بعضهم ينحدر من الفلسفة، وبفضلهم ازدهرت الفلسفة الإسلامية بشكل لافت على غرار باكستان ومصر في الفترة، وتمت إحياء كل النصوص الإسلامية المتراكمة في التاريخ، في مقابل العقل الاشتراكي والشيوعي الذي فتح أفقا مغايرا للعقل الإسلامي وكان مقربا للنظام أكثر من اللزوم متناسين أن الأفكار الأساسية التي نادى بها كبار هذا التيار تنتقد النظام وتعريه مهما كانت طبيعته وانجازاته، فهم ينتقدون النظام بما أنه نظام، النظام الفكرة دون مراعاة انجازاته وقيمتها، وهذا ما جعل هذا النوع من العقل يكون أداة تبريرية للمسار الاجتماعي والسياسي ولصقل الوعي الاجتماعي الخاص بهذه الفترة، وكلاهما وظّف مفاهيم فارغة من مضمون واكتفوا بها شكلا بما أنها تملك قوة الشحن والتجييش.
وإذا ما قمنا بمراجعة المفاهيم الكبرى التي تشكلت منها خطابات هذا العصر بمختلف مجالاته، لوجدناها مفاهيم مستهلكة تاريخيا تلاءمت مع مكونات الخطاب الجزائري بفعل التاريخ، مما يعني أن العقل الجزائري النخبوي لم يشارك في نحت المفاهيم الخاصة به، والتي تحمل خصوصياته الثقافية والتاريخية، وهي عملية مهمة وإستراتيجية في بناء الرؤية الحضارية لمجتمع ما.
مالك بن نبي وسؤال المفهوم:
تناول مالك بن نبي إشكالية المفهوم وأهميته الثقافية والنهضوية في أكثر من عمل، وأهمها في محاضرة ألقاها في الجزائر العاصمة بتاريخ 24 فيفري 1991 وتم نشرها في جريدة الشعب سنة 1964.
عالج مالك بن نبي فكر المفهومية كحمولة تضم ثلاثة محاور: الديمقراطية والاشتراكية والسلام، وهي المحاور التي كانت تشكل الوعي البشري العام خلال هذه الفترة.
الديمقراطية، تمثل الفكر الليبرالي الغربي، والاشتراكية تمثل المعسكر الشرقي، ومفهوم السلام الذي تمثله دول عدم الانحياز.وتظهر أهمية تحليلات مالك بن نبي الفكرية في مناقشته الواقعية لأسئلة العصر، ولما يطرحه المجتمع من إشكالات، ولهذا كان بحق مفكر العصر من دون منازع، عبر عملية قراءة الأفكار العامة التي يصرح بها ممثلو المجتمع، يقول:gt;gt;لقد قال الرئيس بن بلة لشبيبة البلاد المثقفة المجتمعة في مؤتمر الطلبة الجزائريين سنة 1962: إننا نمتلك برنامجا، ولكننا لا نمتلك مفهومية، ومع تصريح الرئيس بن بلة نجتاز على وجه الدقة خطوة حاسمة، فبعد أن اجتزنا بصورة لا هي بالحسنة ولا هي بالرديئة، الطور الذي تمثل فيه الأشياء لدينا مقياسا لجميع المعطيات، ننتقل اليوم إلى الطور الذي تتحول فيه مراكز اهتمامنا من عالم الأشخاص إلى عالم الأفكار، وإذن نحن نخرج من البوليتيك(دجالو السياسة) إلى السياسة، ولكن مع امتلاكنا لبرنامج وافتقدنا للمفهوميةlt;lt;.
هذا تصريح يترجم رغبة مالك بن نبي في مراجعة منظومتنا العقلية السائرة في طور البناء مراجعة موضوعية، ومراجعة أيضا برامجنا الجديدة لبناء الأمة الجزائرية بناءا صحيحا، ولكن ماذا يقصد مالك بن نبي بالمفهومية؟.
يقصد مالك بن نبي بالمفهومية، بكل ما يكون دافعا حضاريا لمجتمع ما، ولهذا رأى أن الجزائر الفتية الخارجة من عصر الاستعمار هي بحاجة إلى الدافع المحرك لسياستها في علاقته الوظيفية بشروطها التاريخية الخالصة. وبتعبير آخر يجب عليها أن تنتج بجهدها الفكري الذاتي، الوسائل والطرق الملائمة لشروطها، وهذا بما أن المجتمع الجزائري لا يزال في مخبر الحضارة، فهو بحاجة إلى صناعة خصوصيته الثقافية بوسائله الخاصة، علما أن التاريخ يتم بالنشاط المشترك للأشياء ومن مكونات المجتمع قاطبة، الأفراد ومن الأفكار العامة المتداولة. هذه الفاعلية هي التي تكون سببا في نماء المجتمع أو في انهياره حسب توظيفها، وهنا يرى مالك بن نبي أن تنظيم النشاطات الفردية بالذات في كنف نشاط إجمالي مشترك، هو الذي يصنع على وجه الدقة مشكلة المفهومية.
وأهمية المفهومية بهذه الصورة، تعود إلى أهمية العمل المشترك، الذي يستلزم بالضرورة تنظيم وتنسيق جميع المعطيات وخاصة جميع الأفكار التي تنهض بالنشاطات الفردية، وهذا ما يعني أن المجتمع الجزائري يواجه مشكلة الأفكار على مستوى النشاط المشترك في مرحلة معينة من تاريخها.
يشير مالك بن نبي إلا فكرة جد مهمة حول أدوار المفهومية في صناعة الحدث، الذي كان متاحا وممكنا في عصر الثورة، وبفضله توصّل الشعب الجزائري إلى إدراك الحرية الذاتية التي تجلت بكل وضوح في الاستقلال، إذ كانت الرغبة في التحرر والتي كانت رغبة شاملة لا تخص فقط فئة معينة، هي التي صنعت الجهد البطولي للشعب الجزائري في عز الاستلاب، بفضلها التحمت جميع النشاطات الفردية في مصهر الثورة التحريرية، كانت مبررا لحركة الأفراد نحو تحقيق القصد الجمعي، فالحرية كانت مشروع الجزائريين وهاجسهم، الذي يتجلى في هدف بسيط، مفرد ومحدد، إنه الاستقلال.
وبمجرد تحقيق هذا المطلب، فقد المجتمع حسه المشترك والرغبة الشاملة، على حساب تنامي الأنانيات الفردية وتشذّر الطاقات الفردية، حيث أعلن خلاله الفرد انسحابه التدريجي من العمل المشترك ومن الحس العام، ولم تعد الإرادة العامة ممكنة في مقابل هيمنت الإرادة الخاصة واستفحلاها في مجالات ضيقة، مما نتج عنه ظهور نزعات فردية جديدة.
- آخر تحديث :
سؤال الفلسفة في الجزائر ومعضلة المفهوم (1): 1962-1989
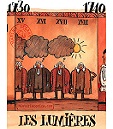
-









التعليقات