تأملات أولى
1
الشعر .. صناعة ُ العرب
: في أحيان كثيرة تختزل الثقافة العربية في شقها الأدبي إلى نشاط واحد وحيد هو الشعر، وعلى ما في هذا الإختزال من تحريف للواقع، إلاّ انّه في الوقت ذاته يشير إلى حقيقة كون العرب امة شعرية. وفي البدايات التي ترقى إلى مايزيد على الألف وستمائة عام لم يعرف العرب من فنون التعبير إلاّ الشعر، فالشعر كان "صناعتهم" الوحيدة، وصناعة الشعر تسمية استخدمها النقاد العرب القدامى بوفرة، فهناك كتاب بهذا الاسم "صناعة الشعر" كذلك " كتاب الصناعتين" والمقصود بهما الشعر والنثر وقد بلغ من تقدير إن لم أقل تقديس العرب للشعر، حد انهم كتبوا بعض قصائد شعرائهم بماء الذهب وعلقوها في أرفع مكان عندهم هو"الكعبة"، وهذه القصائد تُعرف بالمعلقات.
وما زلنا إلى اليوم نقرأ هذه القصائد بنفس اللغة التي كتبت أو قيلت بها، اريد أن أقول انّ الشاعر العربي، لا يزال الى اليوم يكتب باللغة ذاتها التي قيلت بها قصائد الملك امرئ القيس أو شاعر آخر مثل طرفة.
من هذا العمق الشعري، الذي يغدو مصفاة هائلة للغة ذاتها تطلع قصيدة الشاعر العربي الحديث. والشعر هو لغة اخرى بموازاة اللغة، إذ انّ الشاعر الحق هو من يجعل اللغة تتبدّى في أبهى صورها على الدوام، وهو من يكسوها نضارتها، عبر اجتراحه نظام علاقات جديدة يحكم الكلمات، ليكون هو صانعاً للغة لا مستهلكاً أو ُمراكماً لها، ولا أتذكر من الذي قال: انّ االأوذيسة هي التي صنعت الكلمات، وليس الكلمات هي التي صنعت الأوذيسة.
2
هل الشعر مسألة وجود؟
اتخذ علماءُ اللغة من الشعر معياراً، في عملهم، لضبط وتقعيد اللغة " واعتبر الشعر ممارسة قادرة على إضفاء الشرعية على الإستعمال الذي تراد بلورته، وهو استعمال لغة عربية موحدة"، كما يقول جمال الدين بن الشيخ في كتابه "الشعرية العربية ". وعلى الرغم من الوجهة النفعية البحت التي تبدو هنا للشعر، إلاّ اننا يجب أن لا نغفل أنه يجيء بموازاة القرآن في هذا الدور. وهذا يبيّن أهمية المرتبة التي يحتلها الشعر في الثقافة العربية.
لقد أطلق أبو العلاء المعري( 973 ـ 1075)، الشاعر الفيلسوف، على كتابه الذي تصدى فيه لتفسير ديوان المتنبي، "معجز أحمد"، ومثل هذه التسمية في الذاكرة العربية ـ الإسلامية تختصّ بالله أو الأنبياء أو كل ماهو غيبي، وهو ما قصده بالضبط أبو العلاء لشدة إعجابه وافتتانه بالشاعر المتنبي، فوفقا ً لعنوان أبي العلاء فإنّ ما أتى به المتنبي يعجز عن الإتيان به أيّ بشر سواه، انّه شيء يختصّ به وحده، انّ شعره هو معجزته، كما ان لكل نبي معجزة، أو عمل خارق. لكأنّ صلة العربي بالشعر، تغدو هنا روحية، أكثر مما هي علاقة بفن أو طريقة تعبير، بل على هذا تكون مسألة وجود. والشعر هو ديوان العرب، عبارة تجعل من حياة العربي و تاريخه ومنجزه عرضة ً للهباء خارج هذا الشعر، حتى وإن بالمعنى السجلّي، التدويني الذي تفيده العبارة ( لأن فيه علومهم وأخبارهم وحكمهم ) كما يقول ابن خلدون، وعلى حد عبارة ابن الشيخ فقد " تم اعتبار الشعر العربي، على الدوام مستودع هذه الثقافة وتاريخها، أي الأثر الذي يبلغ مرتبة تمجيد جماعةٍ، وحقل ممارسة وعي جماعي لا فردي".
3
الحداثة الشعرية وجذورها
لكن ماهي الصورة التي يبدو عليها الشعر العربي اليوم؟
حتى الحرب العالمية الثانية، بقي الشكل القديم الذي عرفناه لدى امرئ القيس وحتى ما قبله، هو الشكل الوحيد المتاح للتعبير الشعري عند الشعراء العرب عدا بعض المحاولات المتفرقة، التي حدثت في مختلف العصور، الي تعبّر عن الضيق بالشكل التقليدي الموروث. وقد سُـئل أبو نواس، ذات مرة، "أتنظم شعراً لا قافية له؟" فأجاب: "نعم" وروى شيئاً منه. كما انّ أبا العتاهية (748 ـ 825) قد خرج في العديد من قصائده على بحور الشعر المتعارف عليها، وحين اُخِذ عليه ذلك، قال: " أنا أكبر من العروض". لكن في نفس الوقت لا يعني الإستمرار بالتزام الشكل ذاته ان جوهر هذا الشعر كان تقليديا هو الآخر بل العكس هو الذي يصح ففي العصر العباسي حدث تجديد هائل في روح الشعر العربي على أيدي شعراء مثل " بشار بن برد"(714 ـ 784) و" مسلم بن الوليد"(747 ـ 823) و" أبو نواس"( 757 ـ 814) و" أبو تمام"(788 ـ 845)، فقد تمثل هؤلاء الشعراء التغيرات التي حدثت وانتقلوا بالشعر من فضاء الصحراء إلى مناخ المدينة فكانوا قريبين من روح عصرهم وإيقاع الحياة الجديدة التي عرفوها، وما سخرية "أبو نواس" من الأطلال والواقفين عليها، إلاّ علامة عصر جديد مختلف.
وعند هذه النقطة أي مسألة القديم والحديث بالمعنى الزمني وكذلك في ما يختص باستخدام الإسلوب ذاته، أودّ ان أستطرد قليلاً، انّ نصاً ما يُكتب، اليوم، لا يعني بالضرورة انّه أفضل من نص كُتب قبل ألف سنة إذ ليس نحن بصدد تطور علمي وكما يقول إرنستو ساباتو ان التقدم لا يحدث في الفنون والآداب انما ينحصر في العلوم على وجه الدقة. كما ان التخلي عن اسلوب قديم ما في كتابة أثر فني وبالتحديد هنا القصيدة، لا يجعل من هذه القصيدة ناجحة لمجرد ان شاعرها كتب بطريقة جديدة "مخالفة" للقديم، ويسعفنا في هذا الصدد مثال قيّم لطه حسين، حيث يقول :" بول فاليري لم يجدّد، وكان شاعرا حقاً. ليوبولد سنغور مجدد، إلا انني لم أستطع أن أكمل قراءة شعره". ويقول: " التجديد ليس غاية بذاته. الغاية هي الشعر. فالشرط الوحيد الذي يعطي التجديد معناه وضرورته هو أن يجيء بشعر جميل".
وحين يكون التجديد متأتياً عن حاجة حقيقية ومقرونا بموهبة كبيرة، فانّ النتائج ستكون تاريخية وحاسمة، كما تحقق على أيدي الشعراء العراقيين بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وبلند الحيدري ، فمحاولالتهم التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية قد غيّرت صورة ومشهدية الشعر العربي حتى النهاية. كان العالم العربي مثله مثل العديد من البلدان يتوق للتحرر في مجالات كثيرة، والثقافة كانت واحدة من هذه المجالات، والشعر بوصفه العنوان الأبرز في هذه الثقافة، ولكثرما وقع فيه الإجترار والتقليد فقد كان أرضاً خصبة للتغيير، والتخلص من إرث متداع ٍ تداولهُ الشعراء لأكثر من ألف وخمسمائة سنة. وسرعان ما انتشر الشكل الجديد الذي عرف بالعربية بالشعر الحر، وتلقفه الشعراء في مختلف الأقطار العربية، خصوصا سوريا ولبنان ومصر.
وفي فترة مقاربة لبداية حركة الشعر الحديث المتمرد على عمود الشعر، بدأ شكل آخر، أكثر تحرراً، على أيدي الشعراء اللبنانيين والسوريين: كأنسي الحاج، محمد الماغوط، توفيق صايغ وشوقي أبي شقرا، و بتأثير من الشعر الفرنسي .هذا الشكل هو قصيدة النثر . والتسمية كما هي متداولة بالعربية مترجمة عن الفرنسية، وإن مغلوطة أو محرّفة، فالتسمية الفرنسية Poeme en prose تعني القصيدة نثرا أو بالنثر ودلالتها تختلف عما تشير إليه الترجمة العربية التي تبنتها وأطلقتها في خمسينات القرن الماضي مجلة "شعر" اللبنانية. ومن المفارقات أيضاً أن تُطلق التسمية الخاطئة كذلك على قصيدة الرواد، حيث اُدرجت تحت مصطلح " الشعر الحر" والمعروف ان هذا النوع من الشعر متحرر من الوزن والقافية في الوقت الذي كانت فيه هذه القصيدة وفية ً تماما لهذين العنصرين.
4
الشعر العربي
صراع أجيال
ثمة تقليد ، في الأوساط الشعرية العربية، قلما نجد له مثيلا ً في أجزاء اخرى من العالم، وان كان ينحصر في البلدان التي كانت تحتكر تمثيل الشعر العربي على مدى عقود وهي العراق، سوريا، لبنان ومصر، والتقليد يقتضي ظهور جيل شعري كل عشر سنوات، حتى بدون مسوغات حقيقية، أي دون هذه الإضافات الفارقة، شعرياً، لمنجزالجيل السابق أو التقاطع معه، وهو ما يشير إلى خلل ما وإلى غياب التقاليد الثقافية وتحديداً غياب النقد الفاعل الذي يحد من مثل هذه الفوضى الأدبية أو يحجّمها، وأظن انّ مثل هذه الأمور أو ما يشابهها تحدث في كل مكان، فقد قرأت قبل سنوات عن تخصيص جائزة في المانيا لأسوأ قصيدة شريطة أن يكفّ صاحبها عن كتابة الشعر أو ما يظنه شعراً.
ان مصطلح " الجيل" قد اقترن بدايةً بما يعرف بالثقافة الشعرية العربية بـ "الرواد"، أي الأوائل الذين كتبوا القصيدة الجديدة
قصيدة "التفعيلة"، وهو أمر لا بدّ منه تمييزاً لهؤلاء الشعراء الذين شكّلوا قطيعة، على مستوى الرؤية والإنجاز، مع ما يقارب الخمسة عشر قرناً من الإمتثال لقوالب الشعر العربي القديمة، كذلك الحال مع "الجيل" التالي، جيل الستينات، الذي تمرّد على بلاغة "الرواد" وحداثتهم، وقد أسبغ هذا الجيل صفة التمرد على سلوكه ونتاجه، ولم يكن بعيداً، بأيّ حال من الأحوال عن التطورات والأحداث التي شهدها العالم في هذا العقد مثل ربيع براغ، تمردات الطلبة في اوربا وصعود اليسار الجديد. وعلى مستوى الإنجاز العلمي هناك الحدث الهائل وهوهبوط الإنسان على القمر وغيره من المنجزات. وقد وجدت مثل كل هذه الأشياء صداها لدى الكثيرمن الستينيين.
وإذا كانت الستينات قد اصطنعت فضاءاً ثانياً للحداثة الشعرية العربية، بحكم التصورات المغايرة لدى أهم شعرائها، وهو ماتخبرنا به تنظيراتهم، وقبل كل شيء نتاجاتهم، فليس بالضرورة أن يتحقق مثل هذا الأمر كل عشر سنوات، مثلما هو شائع الآن، في تقسيمات الأجيال، كالسبعينيين والثمانينيين والتسعينيين. و ما أراه، شخصياً، هو انّ هناك انجازاً فردياً مهماً خلال هذه العقود، لكن لم يأخذ صفة "الجيلية"، بمعنى ـ الموجة ـ أو ـ الحركة ـ أو ـ التيار ـ مثلما حصل في خمسينات وستينات
القرن الماضي، غير متناسين في الوقت نفسه طبيعة الظروف المحلية والعالمية التي تلعب، عادةً، دوراً مهماً في التأثير على طبيعة وحتى ولادة مثل هذه الحركات والتيارات أو بتسمية اخرى "الأجيال" التي هي محور هذه الفقرة.
5
حداثة؟ أم تخلف
هل يمكن أن يكون ثمة ما يشبه الفصام في الحياة العربية؟
أي أن نشهد تقدماً في جانب ما في الوقت الذي تكون بقية الجوانب غارقة في تخلفها وخرابها؟
الواقع يشير بالإيجاب على هذا التساؤل، ولنا في أمريكا اللاتينية مثال جيد أيضاً، فهذه القارة والتي كانت حتى سنوات قليلة خلت مثالاً للإنحطاط السياسي المنعكس على بقية مرافق الحياة بسبب من الديكتاتوريات الشرسة التي حكمتها، غير أنها في الوقت نفسه أعطت العالم أجمل الروايات، وأكثرها غنىً خلال الأربعة أو ثلاثة عقود الماضية على وجه الخصوص، حيث قال أحد النقاد الفرنسيين " انّ هذا العصر هو عصر رواية أمريكا اللاتينية ".
والعالم العربي المحكوم بدوره من حكام مزمنين لا يؤمنون بتداول السلطة، وما يعنيه ذلك من تخلف لكل مناحي الحياة العربية، إلا انه رغم ذلك يسعنا القول ان القصيدة العربية هي البضاعة الوحيدة التي يمكننا أن نعرضها للعالم دون وجل، أي ان النشاط الشعري يكسر القاعدة، هنا، ويتقدم على بقية "الصناعات". ألم أقل في بداية كلامي هذا انّ الشعر هو صناعة العرب الوحيدة، الصناعة المتقدمة بطبيعة الحال، وقد يكون هذا بسبب كون الشاعر العربي الحديث هو وريث تاريخ عميق من الممارسة الشعرية، بكل أنواعها، ما جعل منه متفاعلاً مع بقية التجارب العالمية، فمثلما كان لتجربة الشعر الإنكليزي أثرها الهام في بداية انطلاق ما يُعرف بالشعر الحر، في العالم العربي، على يد بدر شاكر السياب المتأثر بـ " ت. س. إليوت" و" أديث ستويل"، كذلك فانّ نموذج قصيدة النثر الذي يعكس الى حد كبير المشهد الشعري العربي الراهن، قد شاع أساسا بتأثير من النماذج الفرنسية لهذا النوع الشعري، لكن هذا لم يمنع اجتهاد الشاعر العربي، حتى قبل شيوع هذه القصيدة، ومحاولاته في التجريب والبحث عن الجديد ، بل انّ بعض الشعراء والباحثين يرجع قصيدة النثر الى اصول عربية تتمثل في نصوص المتصوفة التي انتجت قبل ألف عام تقريباً، كما لدى "النفّري"(توفي 965) في كتابيه الشهيرين: "المواقف" و"المخاطبات".
هذا المقال كُتب خصيصاً للأُمسية التي دُعي إليهاالشاعر :"أكثر من لغة ـ عن النثر والشعر العربي" ـ في: ضمن برنامج، "الشرق الأوسط هنا". ويؤخذ بنظر الإعتبار ان المادة موجهة بالأساس إلى الجمهور السويدي.




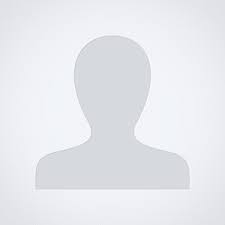
التعليقات