دأبت الشعوب، منذ القدم، في عقدها الاجتماعي، على إيلاء السلطة عناية خاصة، وصلت إلى حد التقديس أحيانا؛ فشهدت عهود الفراعنة والأكاسرة والقياصرة والأباطرة والخلفاء حكاما lt;lt;أرباباgt;gt;، وملوكا مفوضين من الإله، وأمراء حاكمين بأمر الله... صور متعددة لعقد واحد، يضمن الاجتماع ويصون البيضة ويقوم على مصالح الناس.
وأياً كان الأمر في هذا النظام أو ذاك، فإن الدارسين للقوانين الدستورية والمؤسسات السياسية يرجعون أغلب هذه النظم إلى قسمة ثنائية، شاعت على ألسنة الناس في العقود الأخيرة باسم lt;lt;الديموقراطياتgt;gt; وlt;lt;الدكتاتورياتgt;gt;. ولا يعنينا من تقصي أمرهما ههنا سوى مكانة الشورى، الآلية التي وصفها الإسلام لاتخاذ القرارات على كل المستويات تقريبا، وحض عليها في آيتين كريمتين معلومتين من كتاب الله العزيز، أولاهما قوله تعالى: lt;lt;وشاورهم في الأمرgt;gt;، والثانية قوله تعالى: lt;lt;وأمرهم شورى بينهمgt;gt;.
فأين موقع هذه الشورى من تلك القسمة الثنائية السالفة الذكر؟ وما موقف الإسلاميين الساعين إلى إعادة عروة الحاكمية التي نقضت منذ قرون، مما هو متاح أمامهم من خيارات؟ وأي الأساليب ينهج هؤلاء في الدعوة إلى الله فيما لو حكوا بالديموقراطية أو حكموا بها؟
للديمقراطيات الحديثة أنماط متباينة في سياسة الحكم، منها الرئاسي ومنها البرلماني ومنها المختلط ومنها غير ذلك... وجميع هذه الأشكال تجتمع على ضرورة تحكيم رأي الغالبية في إدارة الدولة؛ لتذعن الأقلية بعد هذا لرأي الأغلبية، التي باسمها تمرر المشاريع وتقر القوانين. وتقوم الأقلية، في مقابل ذلك، بدور المعارض المخلص في معارضته حيناً، والمغرض فيها أحياناً كثيرة. ولا تولي الديموقراطية الحديثة كبير الشأن لماهية الخيارات التي تنتجها هذه الغالبية أو تلك، بل القيمة في الأمر نسبة المنتخبين، ولو أسفرت النتائج عن واقع يخالف ثوابت الأمة وأسسها الاجتماعية، ليبقى المستقبل مشرّعاً على كل الاحتمالات، وما من ضمانة تقيه غائلة الانقلابات الكبرى في النظم والتوجهات غير العوائد والأعراف السياسية، التي تجعل من العلمنة أساساً للحكم مثلا، والكثلكة مذهباً للرئيس، وبياض البشرة سحنته الفارزة...
أما الشورى فهي نظام سياسي، حكم الخلافة الإسلامية في صدر الإسلام، وأداء شؤون الولاية العامة في خطوطها العريضة والتفصيلية، وظل الأمر كذلك حتى بداية العهد الأموي، الذي قلب فيه الحكم من خلافة راشدة على منهاج النبوة إلى ملك عضود، تقلبت بعده الأمة الإسلامية بين ألوان مختلفة من الدويلات أبقيت فيها معظم شعائر الدين قائمة، وأسقطت الشورى من الحكم؛ ليبرز الاستبداد السياسي عنواناً عريضاً للمرحلة، وإن تعددت المسميات.
وإذا تجاوزنا الخلاف الفقهي بين علماء الشريعة حول صفة الشورى: أهي ملزمة للحاكم أم معلمة له؟ لنتحاشى إلى حين الرأي القائل بأنها معلمة ولا تلزم الحاكم بشيء؛ لما في هذا الرأي من فتح لذريعة التسلط على الرقاب، وإمداد للمستبدين في الغي، وتشجيعهم على الطغيان، فنأخذ ساعتئذ بإلزامية الشورى لكل حاكم يستمد أصول حكمه من الإسلام ويحكم بشرع الله.
نخلص من هذه المقاربة العامة لمدلولي lt;lt;الديموقراطيةgt;gt;، كما هي في الأنظمة الغربية، وlt;lt;الشورىgt;gt;، على ما هي عليه في النظام الإسلامي، إلى القول بوجود نقاط التقاء بين المفهومين ونقاط افتراق. فكلا الآليتين مثاليتان في اتخاذ القرار إذا اختلف الناس، والناس بفطرتهم مختلفون؛ لذلك وجب ردّ الكلمة إلى إرادة الشعب، الذي سيعبر بجمهوره العريض عن قناعاته وتطلعاته، فيأمن الناس على عقدهم الاجتماعي من الانحلال أو الزوال أو العبثية، التي يؤدي إليها تحكم الأقلية في السواد الأعظم من الناس، وهو أمر حاصل في معظم دول العالم النامي.
وموطن الخلاف بين الشورى والديموقراطية، أن الشورى تأتي عقب التوافق على الأسس العامة للمجتمع، فلا تطمح بعدها إلى الالتفاف على قناعات الناس وتوجهاتهم، بل تسعى إلى تحقيق أهداف جزئية بدءا بالولاية العامة على المجتمع، ذات الشأو الكبير والخطر البليغ، ومروراً بما تبقى من قضايا، وما تبقى منها مجرد تفاصيل. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن رأي الغالبية لا قيمة له في النظام الشوري إذا كان هذا الرأي مخالفاً لأسس الحياة المتفق عليها، ونعني بها ههنا الحياة في ظل المبادئ الإسلامية. وما قام به الإمام الخميني من استفتاء، بعيد انتصار ثورته في إيران، كان من باب سدّ الذريعة ودرء المفسدة، التي قد تحصل له من المجتمع الدولي فيما لو طبق النظام الإسلامي غير مستند إلى تفويض شعبي صريح، وكان الرجل على يقين مسبقاً بالنتائج الإيجابية للاستفتاء، عندما طرح الصيغة الآتية على ورقة الاقتراع: lt;lt;هل تقبل بقيام دولة إسلامية في إيران؟ نعم/ لاgt;gt;.
لم يكن وعي الإسلاميين ناضجاً بما يكفي عندما شرعت قلاع المعسكر الشيوعي في التداعي، وما أعقب ذلك من ضغوط أميركية داعية إلى الدمقرطة وحقوق الإنسان، وهي دعاوى كان ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها من قبله العذاب. وبدا الإسلاميون حيارى واجفين أمام هذه الخطوب، فهم لم يعهدوا، طوال صحوتهم، غير أنظمة مستبدة، لبست لبوس الملكية والثورية والرأسمالية. ولطول العهد بهذه الأنظمة اكتسب الإسلاميون مناهج متنوعة في العمل، انطبعت غالبيتها بالسرية والتربية الحركية، ولم تمكنهم خبرتهم تلك، رغم انفتاح بعضهم على بعض في أكثر من موقع عربي وإسلامي، من استشراف مستقبل يعملون فيه بحرية؛ فأخلدوا إلى lt;lt;أرقمياتهمgt;gt; وأنظمتهم الخاصة، ولم تنجدهم قراءاتهم المتعددة للواقع المعاصر من اجتراح أساليب حديثة لوقائع مستجدة، كان من الممكن، لو أحسنوا التعامل معها، أن تقلب محنتهم إلى منحة، لطالما قرأوا عنها في السيرة والتاريخ، وتمنوا أن يفتح الله بها عليهم من جديد.
وأطلت الديموقراطية تحمل في محياها بشائر السعد والخلاص، فانبرى منظرون كثر لنسف هذه العقيدة المشبوهة من جذورها، ولم يوفروا في ذلك حتى رفقاء الدرب السابقين، الذين تكيفوا مع الأوضاع الجديدة بسهولة ويسر، فشكلوا جمعيات وأحزاباً، وأوغلوا في العمل السياسي بحيصه وبيصه، يحدوهم في ذلك شعار lt;lt;الخطأ أخ الإنسانgt;gt;. ولم تجد الغالبية الإسلامية المستوحشة من هذا التغيير السياسي والاجتماعي غير الموقف السلبي الرافض لأي مشاركة، قد تجر الناس إلى فقدان الثقة بالإسلام إن هم أخطأوا في الأداء؛ فتزول بذلك هيبة الإسلام من النفوس ويرمى بالوهن.
وشاءت الأقدار أن يستفيق الإسلاميون على محاسن النظام الديموقراطي، فيروا فيه خيراً لم يألفوه في ظل الاستبداد، وفضلا وسعة في العمل والنشاط قد يرقى بدعوتهم درجات وينقلها مفاوز ومسافات؛ فتنافسوا على السلطان، وتزاحموا على أبواب الحكام، رغم الفرضية الكفائية للعمل السياسي، وتساقط الكثير من هؤلاء بفعل الإغراءات الجمة، التي تبدت لهم على جنبات الطريق، ورقصت لهم في منعطفاتها. وهذا النوع من المفاتن لا يحفظ التوازن فيه إلا من اشتد عوده في الإسلام، وركز إلى ركن شديد من المبادئ والآداب.
وبمرور الزمن وتوالي الأيام، رجحت كفة الإسلاميين الذين انتظموا في جمعيات وأحزاب، بدأت تتوغل، عبر القنوات الدستورية، إلى عقول الناس ونفوسهم، فأبدعوا هنا وأخفقوا هناك، ودجنوا في هذا الموقع وضربوا هناك... ولا يزال حبلهم على الغارب، ولا يزال شأن الحاردين عن العمل في ظل الديموقراطية تتجاذبه جدلية الالغاء والالتقاء، التي تحكم علاقة الشورى، التي دعا إليها الإسلام، بالديموقراطية التي وفدت من وراء البحار.
نخلص من هذا كله إلى القول بأن ما أتيح من حرية ديموقراطية أمام الإسلاميين عقب استبداد جثم ليله طويلا، لم يكن ليقنعهم بمحاسن هذا النظام، فاستغلوه شعارا للعمل وبيّتوا الالتفاف عليه بليل. ولم يع الإسلاميون تلك المحاسن إلا بعد أن ضيّق عليهم وشوّهوا وأقصوا من جديد، ولو أدركوا ذلك لتريثوا في أكثر من مكان، ولم يعلنوا قناعاتهم مبكرين في lt;lt;الديموقراطيةgt;gt;، التي تنفس من خلالها الناس الصعداء من دون وعي بمزالقها؛ فراحوا يتحدثون عن الشورى بديلا عن الديموقراطية، متورطين في مآزق طرحت عليهم وما وجدوا لها حلاّ، كالحديث عن شرعية المعارضة في ظل الإسلام، ونوع الأحزاب المسموح بها في الدولة الإسلامية، وما مصير هذه الدولة إن اختار الشعب برنامجاً لا يقره الدين...؟ وما إلى ذلك من مشكلات في الفكر السياسي الإسلامي، الذي لم ينضج منظروه ولا مناصروه، إلا منذ وقت قريب، بدأنا نسمع فيه مقولة التعايش بين الدين والحرية، وسعة الإسلام لتقبل الفدراليات على أراضيه، وفوق ذلك كله، الاقتناع بالمرحلية في الدعوة إلى الله، وضرورة حماية مشروع الدمقرطة ولو كلف ذلك التداول على السلطة مع الخصوم، حتى يقتنع الناس بحاجتهم إلى الشورى نظاماً بديلاً عن الديموقراطية، الأمر الذي لم ينضج في حسّ الناس بعد.
سلك الإسلاميون إلى بلوغ أهدافهم طرائق قددا، تنوعت بين الإبداعية والارتجالية وبين التعقل والصدامية، وكأن لسان حالهم يقول: ما السبيل إلى أفضل العطاءات؟ وكيف الوصول إلى موقع الريادة، التي لا يزال دونها عوائق وعقبات؟
- آخر تحديث :










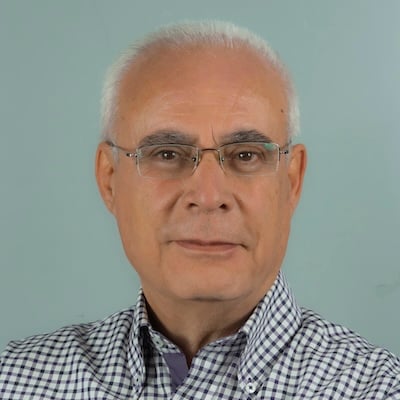




التعليقات