فتح انهيار جدار برلين الباب واسعاً امام لاعبين عولميين عابرين للأمم والحدود، فتغيّر المشهد الدولي على حساب الدولة التي فقدت الكثير من نفوذها وأدوارها. على هذه الخلفية ازدهر الادب السياسي حول انحطاط الدولة و أفولها او انكفائها وفقدانها سيادتها، قبل ان تبرهن تفجيرات 11 ايلول 2001 عن عجز الدولة (الاعظم في العالم) عن السيطرة على اولاد العولمة اللقطاء . وانكفأت النظرية الواقعية (هانس مورغانتو وريمون آرون...) التي كانت ترى أن النظام الدولي يقوم على دول ذات مصالح، لتزدهر نظريات (جيمس روزنو، برتراند بادي، جوزف ناي، سوزان سترانج...) تريد إثبات فشل الدولة في مهماتها الامنية وحلول الادارة او الحاكمية مكان السياسة، حتى في الساحة الدولية.
في كتابه مقاومة الدول * وبعد أن يشرح بقدر من التفاصيل كل من هذه النظريات يتساءل سامي كوهين (مدير البحث في مركز الدراسات والابحاث الدولية واستاذ العلاقات الدولية في معهد العلوم السياسية في باريس) هل يمكن العالم ان يستغني عن الدولة لتأمين قدر ادنى من الانتظام سواء في النزاعات الدولية او في مجالات البيئة والتفاوت الاقتصادي؛ اذا ضعفت الدولة او سارت في طريق الاختفاء من يتولى ادارة عمليات التنظيم والضبط الدولية الضرورية؟ المجتمع المدني الدولي؟ هل يستطيع الاخير الحلول محل الدولة؟ هل توصل اللاعبون العابرون للأمم بالفعل الى إضعاف الدولة وسلبها أدوارها؟ كيف؟ هل تترك الدولة مكانها لمجتمع مدني عالمي يهمين على السياسة؟ هل هذا المجتمع المدني العالمي موجود في الاصل؟ هل ان نفوذ المنظمات غير الحكومية على السياسات الدولية قوي الى هذه الدرجة؟
للاجابة عن هذه التساؤلات وغيرها اختار الكاتب العودة الى زيارة العلاقات بين الدول واللاعبين غير الدولتين العابرين للأمم والحدود: المنظمات غير الحكومية في فضاء المجتمع المدني؛ الارهابيون في نطاق العنف العابر للحدود؛ والشركات المتعددة الجنسية في المجال الاقتصادي. هؤلاء يشتركون في أنه تُنسب اليهم منافستهم للدولة في مجالها الخاص وهو الفعل الدولي. هذا المنهج الذي يقوم عليه الكتاب ينتج تقسيماً فيه انقطاع مفهومي بين الفصول، اذ تحتل المنظمات غير الحكومية اربعة فصول كاملة من اصل تسعة مع الجزر الاكبر من فصلين آخرين وذلك بذريعة أنها تشكل المنظار المثالي لمعالجة اشكالية الدولة. في المقابل لا يفرد الكتاب الا فصلاً واحداً قصيراً للشركات المتعددة الجنسية رغم ان عنوانه الفرعي (متحديات العولمة) يعد بحيّز واسع للمعالجة الاقتصادية.
وبالاضافة الى العمل الوثائقي يلجأ الكاتب الى عدد من المقابلات مع ناشطين بارزين في عالم الجمعيات والمنظمات والدوائر السياسية الادارية في سعيه لاثبات خطأ مقولات موت الدولة الأمة او نهاية السيادة او انتقام المجتمع المدني العالمي او بطلان السياسة الخارجية (عناوين كتب لاصحاب نظرية أفول الدولة). وهذه في رأيه ليست نظريات علمية بقدر ما هي أفكار مسبقة ومعتقدات وآمال مغرية ومشرعة بقدوم عالم أكثر ديموقراطية وانسانية.
في رأيه كان العالم مقسوماً دوماً بين حاكمين ومحكومين، وكان هناك دوماً لاعبون جدد من خارج الدولة يدخلون الى حلبة السياسة الدولية، ولا علاقة لانتهاء الحرب الباردة بهذه التحولات. ورغم التغير الذي طرأ على ميزان القوى، الا ان الدول لا تزال تحتفظ بقدرة هائلة على المقاومة، وبنفوذ واسع حتى على هؤلاء اللاعبين. والامثلة التي يقدمها الكتاب لدعم رأيه كثيرة ومفصلة. ثم ان عالم اللاعبين غير الدولتيين ليس متناغماً ولا متماسكاً بل تعصف به الانقسامات والتلاوين المتنافرة والمصالح المتعارضة.
وبعض المنظمات غير الحكومية تسدي خدمات للدول وتعينها على القيام بوظائفها لا بل إن بعضها يعمل بتوجيه من الدول. ومنها ما هو حكومي، او يكاد، في الحقيقة. والتضامن القائم بينها وبين الدول يربو على التضامن القائم بين المنظمات نفسها. وللشركات المتعددة الجنسية ايضاً علاقات اكثر صلابة مما نعتقد بدولها واوطانها الاصلية. وبعضها عاجز عن الفعل والحركة من دون دعم دولة او منظمة دولية تضم دولاً. اما المجتمع المدني العالمي فأسطورة محركة تلائم اولئك الساعين وراء عالم اكثر انسانية وديموقراطية.
وتدل استطلاعات الرأي ان المواطنين الاوروبيين يفاخرون بانتمائهم الى اوطانهم بقدر انتمائهم الى الاتحاد الاوروبي او اكثر، وان مشاعرهم تذهب اولاً الى المحلة او القرية (43 في المئة) ثم الى الوطن بكامله (30 في المئة) ثم المنطقة والعالم (10 في المئة) ثم اوروبا (5 في المئة).
ويذهب الكاتب الى حد رفض كل النظريات الكبرى السائدة في مجال علم العلاقات الدولية من واقعية و واقعية جديدة و ليبرالية وغيرها والتي تشكل، في رأيه، عائقاً أمام فهم العالم لانها تضخيمية تصويرية ثقيلة الحركة تعجز عن فهم الحقائق المعقدة التي يتهيكل حولها المسرح الدولي . وادعاؤها الكونية يضعفها اكثر مما يقويها بدليل انها فشلت غالباً في وصف طريقة عمل العالم بسبب ضخامة الهدف الذي حددته لنفسها. هذا عدا أن الواحدة منها تستبعد الاخرى وتتعامى عن وجود ممرات ولو ضيقة بينها. والاجدى، في رأيه، هو الابحار بينها دون حصرية او استثنائية.
ويخلص الى أن صعود اللاعبين غير الدولتيين لا يضعف الدول بل يقويها. فقد قادت ضغوط المنظمات غير الحكومية الى توسيع الدولة نشاطاتها وادوارها في مجالات كانت لا تلقى العناية الكافية منها. حتى الانترنت فانها لا تعمل بالضرورة ضد سيادة الدولة بقدر ما تساعدها على توكيد هذه السيادة. وفي الاقتصاد تقول استطلاعات الرأي ان 69 في المئة من الفرنسيين يعتقدون ان على الدولة صوغ قواعد الاقتصاد، في حين ان 26 في المئة فقط يثقون بقدرة منظمات المجتمع في هذا المجال. ويطلب مدراء الشركات على الدوام مساعدة دولهم عندما يشعرون بتهديد المنافسة الخارجية. وعندما تتعرض خيارات الدولة السياسية للانتقاد فهذا لا يعني ان سلطتها ووجودها نفسه في دائرة الخطر.
حتى الحركات الانفصالية التي تستخدم العنف فانها لا تهاجم الدولة في جوهرها بل تهدف الى اقامة دولة على جزء من الاراضي وقيادتها. انها تعبر عن رغبة متزايدة بـ الدولة ، دولتها هي، المتمتعة بحدود وسيادة واعتراف. ويتزايد عدد الدول باضطراد منذ انهيار جدار برلين. والدول التي اختفت تركت مكانها للمزيد من الدول عبر الانقسام او الانفجار (الاتحاد السوفياتي، تشيكوسلوفاكيا، يوغوسلافيا...). وتحكم الرغبة بالاستقلال في دولة ذات حدود وسيادة معظم الصراعات الحالية في العالم (كشمير، فلسطين، الاكراد، افريقيا...). وقد كان من نتائج تفجيرات 11 ايلول العودة القوية للدولة في البلد الاكثر ليبرالية في العالم.
كل ما هنالك ان دولاً ما قبل حديثة تعاني من الهشاشة والتخبط تحت وطأة لاعبين دون قوميين من عشائر وطوائف واتنيات وجماعات ارهابية وغيرها (افغانستان، افريقيا...) ودول عصرية انخرطت في دينامية العولمة بمحرك قومي او وطني ينطبق عليها تعريف ماكس فيبر الشهير للدولة المستأثرة بالعنف الشرعي، ودول ما بعد حديثة تتمتع بقدر كبير من المرونة والشفافية والانفتاح وتلجأ الى حل نزاعاتها بطرق مؤسسية وسلمية.
وكل من هذه التصنيفات ليس واحداً او جامداً، اذ ينبغي التفريق ما بين الخصوصيات داخلها. فالولايات المتحدة تنزع الى استخدام القوة والاكراه والهيمنة اما اسكندنافيا وكندا وسويسرا، مثلاً، فتحبّذ الديبلوماسية الاخلاقية والتعاون الدولي وحقوق الانسان والحريات، في حين ان فرنسا وبريطانيا قوى كولونيالية تاريخياً تتردد ما بين الحنين الى الماضي المجيد وممارساته والعمل على ترسيخ دولة القانون العصرية. وفي جميع الاحوال يمكن القول ان هناك دولاً وهنت وأخرى قويت بفعل العولمة وتعددية اللاعبين، ودولاً اخرى تفككت او اختفت، وأخرى ازدادت تماسكاً وصلابة، ولا يمكن تطبيق نظرية الافول بالقدر نفسه على كل هذه الدول بطريقة عشوائية او تعميمية.
وأزمات الحكم في الدول لا تعني أزمة شرعية مفهوم الدولة نفسه الذي لا يزال صامداً، وحتى مفهوم السيادة الملازم له لا يزال راسخاً هو الآخر. في المقابل تساهم الاحداث الدولية الراهنة في البرهنة على أفول نظريات أفول الدولة.







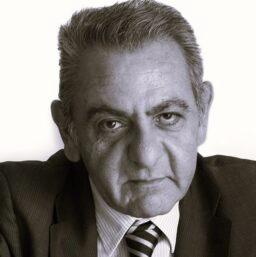


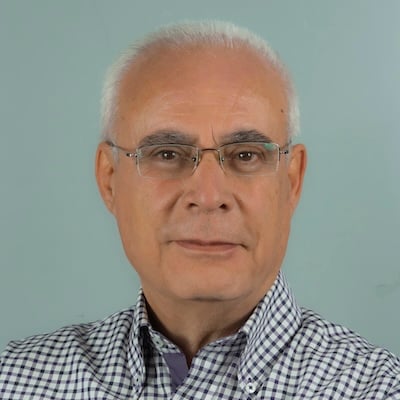




التعليقات