القاهرة من محمد أبو زيد: في هذه الحلقة يتكثف الجدل حول جيل الستينات في مصر.. فيربط الناقد فاروق عبد القادر انقلاب بعض رموز هذا الجيل على أنفسهم بالانقلابات السياسية المباغتة والتي برزت على نحو خاص في عصر السادات.
ويتهم الروائى محمد جبريل ـ الذي ينضوي تحت راية هذا الجيل ـ الستينيين بالشللية ورفض الآخر المغاير لهم، والاستعلاء على أي منطق للتواصل معه. وتؤكد الكاتبة بهيجة حسين على خطأ النظر إلى الستينات ككتلة وترى أن محاكمتهم الحقيقية تبدأ من داخل ابداعهم، وهو ما يشير إليه الروائي الشاب خالد اسماعيل حيث يرى أنه من الصعب وضع الستينات في سلة واحدة، ويغمز إلى أنه جيل هروبي يتحاشى المواجهة والصدام طالما ستضر بمصالحه، ويدلل على ذلك بهروب الكثير من رموزه خارج مصر في عصر السادات.. ويتفق معه إلى حد كبير القاص الشاب الطاهر الشرقاوي حيث يرى أنه جيل متقلِّب استطاع أن يتكيف مع لحظات الصعود والانكسار التي اعترت الآيديولوجية السياسية للنظام المصري، لذلك ينصب هذا الجيل نفسه حارساً على البوابة الثقافية في مصر، ويتوهم أنه وحده القادر على منح صكوك العبور من خلالها.. وفيما يلي الحلقة الأخيرة من التحقيق:
يبدأ الناقد فاروق عبد القادر قائلاً إن جيل الستينات تفتح وعيه على ثورة يوليو، وكان دون الوعي فيما يتعلق بالنظام السابق على الثورة، فجاء في الفترة التي تحقق فيها قدر كبير من أحلام الجيل السابق له مباشرة والذي يشار له بجيل 46 والذي لما قامت الثورة كان ناضجاً وعلى درجة من الوعي تمكنه من أن يكون أكثر فهماً للأحداث وأكثر تعاملاً معها ولم يتفتح وعي جيل الستينات إلا على فترة الزهو والصعود بدءاً من أحداث 54 والتي بدأ فيها عبد الناصر يمسك بزمام الأمور بأيد قوية وبدأ يعيد صياغة الواقع بجوانبه الواقعية والاقتصادية والسياسية، هذه الفترة التي استمرت إلى نهاية الخمسينات وبداية الستينات وتحققت فيها كثير من أحلام هذا الجيل، والتي بناها وناضل من أجلها الجيل السابق عليه بعد تحقق الاستقلال مثل القضاء على الاقطاع، وضرب قواعد الرأسمالية وتحديد الملكية، ولكن يبدو أن الدودة في أصل الشجرة كما يقولون فلم تستمر هذه الصحوة التي بلغت ذروتها في سنة 59 وانتهت في سنوات الستينات الأولى بفشل الاتحاد مع سورية، وهو ما وجه ضربة قوية لشعبية عبد الناصر وللمجد الجارف له في العالم العربي، بالاضافة إلى الصراعات التي احتدت داخل مجموعة يوليو، وظل هذا الواقع يتردى، وتزداد التناقضات حتى بلغت أوجها في هزيمة 1967 والتي كانت هي الرحم الحقيقي الذي خرج منه جيل الستينات، مشيراً إلى أن هذه الهزيمة لم تكن فادحة أو فاضحة على المستوى العسكري فقط، بل كانت هزيمة للجيل الذي تفتح وعيه على مرحلة الزهو والصعود والبناء، وهو جيل الستينات.
ويؤكد عبد القادر أن الصراعات الموجودة في ذلك الوقت والهزيمة الحاصلة انعكست وبقوة على كتابات ذلك الجيل، وحتى الكتاب الكبار الذين عانوا هذه الفترة ظهرت في أعمالهم فعند نجيب محفوظ مثلاً ابتداء من «اللص والكلاب» وانتهاء بـ«ميرامار» والتي ظهرت قبل النكسة بشهرين.
وقد أحس المثقف المصري عموماً مهما كان سنه بأنه مهان ومسؤول، عن مجمل هذه الظروف، وظهر تيار الستينات في التعبير الأدبي، هذا التيار ينظر للماضي بغضب وبسخط ولا يثق بالحاضر ولا يبدو له أفق في المستقبل، وبالتالي كان عليه أن يكتب أدباً يعبر عن هذا كله.
ويشير عبد القادر إلى أن هذا التيار لم يكن مقتصراً على مصر وحدها بل له أشباه ونظائر في الشام وفي العراق، كما أن هذا الجيل تجسد أكثر ما تجسد في القصة القصيرة وفي الشعر، مشيراً إلى أن هذا الجيل كان يمثل موجة عفية وقوية احتملت زبداً كثيراً، واستطاعت أن ترفع أسماء وأعمالاً قد لا يكون لها نفس الحجم والتأثير، بالاضافة إلى ضياع بعض الأسماء وتوقف بعضها، وشاء قدر عابث لا حيلة لأحد في رده أن يفقد هذا الجيل اثنين من ألمع رموزه هما يحيى الطاهر عبد الله ثم أمل دنقل، بالاضافة إلى محمود دياب، وتميز هذا الجيل بأنه ضرب برموزه في شتى الأراضي التي تخايلت لعيونهم من تناول الواقع لتناول الأسطورة وكانوا جماعة وفرادى.
ويرى عبد القادر أن انقلاب بعض رموز جيل الستينات على تاريخهم بدأ مع انقلاب السادات نفسه وبدئه ما يسمى الانفتاح، ومفاوضات الكيلو 101، وزيارة القدس، وكامب ديفيد، ودخوله في مرحلة جديدة فلم يعد بين أبناء الستينات ما يجمع بينهم، ومنهم من ركب الموجة، ومنهم من رفض، ومنهم من تم استغلاله، لأن السادات عمل على خلق واجهة بديلة بداية ببيان توفيق الحكيم 1972 واغلاق مجلتي «الكاتب» و«الطليعة»، وهو ما عكسته ادوار يوسف السباعي وصالح جودت وعبد الرحمن الشرقاوي في مرحلته الأخيرة، ورشاد رشدي، وأعلن السادات في ذلك الحين أن 99% من أوراق اللعبة في يد أميركا. لكن أقل القليل من هذا الجيل ظل محافظاً على ما كان عليه والتزم بالقيم، والتزم بالدور المستقل والفاعل لمصر في محيطها العربي.
* الوقوف على جثث الآخرين
* أما الروائى محمد جبريل فهو يعتقد أن تجربته مع جيل الستينات لم تكن جيدة، ويقول: «حاولت أن احتفظ بتماسكي في هذا الجيل من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات بيني وبين بعض أبنائه، لأن عدداً كبيراً منهم يتصورون أن الصراع ليس على تجويد الابداع وانما في الخصومات الشخصية، وأنا لا أجيد مثل هذا النوع، ومن هنا كان عزوفي عنه وحرصي على القراءة والتأمل، وربما من أعنيهم ليسوا كثيرين، لكنهم موجودون، ولهم تأثيرهم الذي يصعب أن يغفل، ولعل حوادث مقهى ريش وما كان يحدث فيها من خلافات والغمز واللمز والشللية ورفض الآخر والتعتيم عليه وحجب الرأي الجيد والتبرع بالرأي السيئ، والوقوف على جثث الآخرين وتصفية الحسابات، وكل الصفات التي يمكن أن نقولها في هذا السياق، كل ذلك يكشف سمات هذا الجيل.
ويضيف جبريل أنه لكل هذه الأسباب، وكل هذه الصفات التي يرفضها كان حريصاً على أن يصادق الجيل الأسبق للستينيات، وهو جيل الأربعينات وأصدر عنهم كتاب «آباء الستينات» ويصفه بأنه جيل لم تكن لديه عقد لأنه جيل حقق نفسه فلا توجد لديه الرغبة العنيفة في الوصول ولا حذف الآخرين، وانما كان همه التواصل.
ورغم اختلافه مع جيل الستينات، إلا أن جبريل يرفض وصف جيل الستينات بجيل الهزيمة معللاً ذلك بأنه جيل لم تصنعه الهزيمة، لأنها جاءت وهو موجود، وكان الجيل يتجه على مستوى الأمنيات والسياسة الى معايشة المشروع القومي الذي طرحه عبد الناصر، لكن جاءت النكسة فمثلت هزة عنيفة له، وهو ما لا يعيب الأديب.
ويشير جبريل إلى أن الأديب الذي لا يحمل هماً سياسياً لا يساوي شيئاً فيوسف ادريس صنعته السياسة في الخمسينات، ونجيب محفوظ كذلك في الأربعينات، حتى محمد عبد الحليم عبد الله الذي يصفه النقاد بأنه كاتب رومانسي تأثر بالسياسة في «سكون للعاصفة»، ولا يوجد جيل أدبي لم تؤثر فيه السياسة بشكل أدبي أو بآخر، وحتى جيل الرواد طه حسين ومحمد فريد أبو حديد، وابراهيم عبد القادر المازني كان مهموماً سياسياً ولم يحقق الاستنارة إلا من خلال تأمله الخاص.
* كل الأجيال مهمشة
* وترفض الروائية بهيجة حسين التعامل مع جيل الستينات ككتلة لأن هناك سمات فردية محددة لكل مبدع في هذا الجيل، وبرغم أن العطاء يكاد يكون عاماً وهو ما يجعلنا لا نستطيع التعامل بمعيار واحد مع هذا الجيل وأي جيل آخر.
وترى حسين أن الاغتراب أو الابتعاد عن السلطة سمة كل الأجيال فلا يوجد جيل يجلس بكامله على حجر السلطة، أو جيل يبتعد كل البعد عنه ملمحة إلى أنها ضد مقولة إن قرب جيل من السلطة قد يحجب إبداع جيل آخر، خاصة أن مصر تمر بأسوأ أوضاعها الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الآن، فكل الأجيال مهمشة وهناك خطة لإبعاد العناصر الجيدة، وحجب القدرة على التنافس لا يوجد شيء عفوي، أو يحدث بالصدفة، وانما يبدو أن هناك برنامجاً معداً لالغاء الذائقة الفنية والنقدية والاجتماعية لجميع المثقفين منبهة إلى أنه لا يهمها كثيراً اقتراب جيل الستينات أو ابتعاده من السلطة انما ما يهمها حقيقة هو ما يقدمونه باعتبارهم مبدعين يدافعون عن قضايا العدل والحرية والجمال، لكنها لا تستطيع أن تتهمهم بشيء.
وترى بهيجة حسين أنه قبل أن تتحدث عن جيل الستينات كأدباء أو كسياسيين أو كمؤسسين لمنظومة أخلاقية يجب أن نعود إلى مناخ وظروف الستينات التي شهدت أزهى عمليات البناء السياسي والثقافي، منبهة إلى أن هذه الفترة شكلت عمرها ووجدانها ووعيها على كل المستويات (الأخلاقي، والسياسي، والثقافي، والتذوق الأدبي) لأن الأحداث الكبرى وفوران العمل النضالي يترك بصماته كما يترك الأوكسجين أثره ونحن نتنفس.
وتقول حسين إن سبب ازدهار جيل الستينات أنه شهد ثورات حقيقية، بالاضافة إلى أن الأخبار العالمية كانت كذلك من استقلال الجزائر إلى نضال شعب فيتنام، وأحداث كوبا، وتوهج جيفارا كما أن هذه الفترة شهدت آخر ما تبقى من من ليبرالية الأربعينات وكان هذا في لغة الناس.
وتضيف بهيجة حسين أن النقلة الحقيقية في تاريخ جيل الستينات حدثت بعد هزيمة 1967 واستيقاظهم على حقيقة النكسة المفزعة، فهم الذين حملوا على أكتافهم كارثة النكسة كما أنهم هم الذين تشكل وجدانهم مع الانتصارات الكبرى، لافتة إلى أنها تعلمت منهم الكثير، وأهم ما تعلمته منهم المسؤولية، ان الأدب مسؤولية وان الدفاع عن الناس وعن الوطن مسؤولية، وهو ما استمر معهم حتى الآن فبهاء طاهر رغم أنه كتب روايته «الحب في المنفى» في التسعينات إلا أن هذه الرسالة الكبرى تتخللها تماماً، فالأدب رسالة كبرى وليس مجرد تهويمات وكذلك جميل عطية ابراهيم الذي يؤكد في كتاباته التاريخية على نفس المعنى.
* مع النظام في وجه الإرهاب
* الروائي والقاص خالد إسماعيل يقول إنه لا يمكن وضع جيل الستينات كله في سلة واحدة، لأن البارزين من أفراده ـ الموهوبين المشهورين ـ لهم قصص صعود متباينة الظروف والأسباب، فعلى سبيل المثال ابراهيم أصلان يختلف ابداعه ومشواره في الحياة عن الجميع، ولكن الذي حدث هو وجود صوت يساري تنظيمي استطاع أن يجعل من هذه الجماعة الكاتبة تشكل ورقة ضغط وعندما انهار النظام الناصري ـ الذي اعتمد على بعضهم في بناء منظومته الثقافية ـ هرب قطاع كبير من هؤلاء الذين يحملون خصائص الانسان الستيني.
ويضيف اسماعيل انه بقي بعد هذا فريق آخر مثل عبد العال الحمامصي ومحمد مستجاب، وهذان بالذات ظهرا في فترة الفراغ التي خلقها هروب اليساريين إلى بغداد وبيروت والعواصم العربية الرافضة لاتفاقية كامب ديفيد الأولى أو الصلح الانفرادي الذي وقعه أنور السادات، وبقي قطاع ثالث، ظهرت أهميته مع تنامي أصوات القنابل التي فجرها الاسلاميون، مثال بهاء طاهر والدكتور جابر عصفور ومحمود أمين العالم، لأن الصيغة التي نجح في فرضها تقول «من ليس مع النظام فهو مع قوى الظلام».
ويشير اسماعيل إلى أن المثقفين العلمانيين اختاروا الوقوف بجوار النظام في معركته ضد الارهاب، وبمجرد أن سكتت القنابل، استغنى النظام عن حالة التسامح التي اتسم بها سلوكه طوال فترة المعركة، وكان مهندس هذه العملية وزير الثقافة فاروق حسني وأعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة.
* حراس البوابة الثقافية
* القاص الشاب الطاهر شرقاوي يقول إنه بعيداً عن اتفاقنا أو اختلافنا حول مصطلح «جيل» سيظل الستينيون ونقصد بهم أولئك الذين بدأوا في نشر كتاباتهم في فترة الستينات، في وقت كانت فيه القومية العربية في أوج ازدهارها، وكان الاستعمار «بمفهومه الكلاسيكي» يضع عصاه على كتفه ويرحل من حيث أتى، سيظل هؤلاء الستينيون محل جدل ونقاش، بين من يرى أنهم مجددون وأنهم أحدثوا نقلة هامة في تاريخ الكتابة العربية وبين من يعتبر أنهم نتاج طبيعي للآيديولوجيات السياسية الصاعدة، والتي كانت تعج بها المنطقة في تلك الفترة ورغم سقوط هذه الآيديولوجيات وانحسار بعضها، كالشيوعية والقومية العربية ـ التطبيق لا النظرية ـ ورغم أنهم عايشوا فترات الصعود والانكسار والأحلام الكبرى والوحدات العربية والأحلاف العسكرية وغيرها ـ والكلام ما زال لشرقاوي ـ بقي الستينيون صامدين، يقاومون الزمن وتقلبات السياسة من الاشتراكية إلى الانفتاح حتى الخصخصة والاستعمار الجديد متصدرين في كل تلك الحالات الواجهة، وقابضين على رقبة المؤسسات الثقافية وما نحين لأنفسهم جوائزها فهم الفائزون والمحكمون أيضاً، مستمتعين في نفس الوقت باقامة جيتو يضمهم معاً (كتاباً ونقاداً)، متجاهلين عمداً أو سهواً أكثر من ثلاثة عقود تالية لهم إلا فيما ندر.
ويؤكد شرقاوي أن جيل الستينات ينصب نفسه حارساً على البوابة الثقافية والتي لا بد لأي مبدع أن يمر من خلالها وعن طريقها، ملمحاً إلى أن كل هذا لا ينفي ان الأجيال التالية استفادت من كتاباتهم كما استفادت من الأجيال التي جاءت من قبلهم، ومن بعدهم، ومن سيأتي فيما بعد أيضاً.
* رحيل عبد الناصر كان بمثابة «موت الأب» لجيل الستينات
* نشأ جيل الستينات في مصر في فترة مد قومي وعروبي، وكانت فيها مصر مؤثرة على مجريات الأمور في العالم العربي، ومن هنا لا يمكن عند الحديث عن تجربة جيل الستينات إغفال أثر التجربة الناصرية عليهم، وعلى تكوينهم وعلى أفكارهم، وعلى مستقبلهم فيما بعد أيضا، هذا الأثر الذين يبدو لي ملتبسا، ففي الوقت الذي كان فيه ازدهار مسرحي، وازدهار ثقافي، ونقدي، وعداء للصهيونية، وبناء في جميع مناحي المجتمع، وهو ما كان يتفق عليه جميع أبناء جيل الستينات، وأبناء التجربة الناصرية، الا انه كانت هناك معارضة في بعض الأمور مثل تجربة التأميم في سورية والوحدة المصرية ـ السورية لأن عبد الناصر كان يسعى للوحدة الدمجية، بينما كنا نحن ـ المثقفون اليساريون ـ نرى الا تتم الوحدة بشكل اندماجي ولكن بشكل فيدرالي مع استقلالية مسموحة لكل بلد، كان هناك صراع اذن بين أبناء هذا الجيل، وبين بعض أفكار جمال عبد الناصر، وهو ما فتح أبواب المعتقلات أمامهم، فقلما نجد كاتبا من جيل الستينات لم يدخل المعتقل أو لم يعش هذه التجربة، وهو ما تبدى بالتالي في كتاباتهم مثل صنع الله ابراهيم على سبيل المثال التي كانت أولى رواياته كذلك.
ثم جاءت هزيمة 1967 والتي غيرت الموقف تماما، وكان لها أشد الأثر على المثقفين وعلى جيل الستينات بالتالي الذي كان في بداياته لا يزال يحلم بمستقبل أفضل، ويسمع الأغنيات التي تتغنى بالثورة والحلم والقومية ويشاهد انجازات الثورة، هذه النكسة لم تكن هزيمة عسكرية فقط، ولا هزيمة للسلطة السياسية فقط، بل كانت هزيمة لأبناء هذا الجيل الذين رأوا حلمهم ينهار أمام أعينهم، وهو ما أدى الى عزلتهم وانخراطهم في كتابات جاءت متشائمة.
ولكن مع هذا تكشف هذه الهزيمة عن علاقة عبد الناصر بكتاب هذه الفترة وتقديره لهم، فقد اتصل بي عبد الناصر شخصيا قبل النكسة بيومين، وقال لي إن العدوان سيقع بعد يومين ويجب أن تسافر الى فرنسا مع لطفي الخولي للتأثير في الرأي العام الفرنسي، اذ كان عبد الناصر يؤمن بالثقافة والمثقفين، وربما زاد هذا الايمان بعد النكسة وبعد أن أدرك أن كل تحذيراتهم له صائبة.
لم يولد جيل الستينات من رحم الهزيمة، ولكنه شعر أن الهزيمة هزيمته انه هزم من الداخل، فبدأ في المقاومة وكان هذا على جميع المستويات حتى الجيش بدأ بعد الهزيمة ينشط وبدأت مرحلة حرب الاستنزاف، وتدمير المدمرة ايلات وغيرها، الهزيمة فجرت في المجتمع وبما فيه جيل الستينات روح التحدي والمقاومة، ولعل الاشعار والمسرحيات والقصص التي كتبت أثناء ذلك تتحدث عن ذلك.
وأعتقد أن النقطة الفاصلة في تاريخ جيل الستينات لم تكن هزيمة 1967، وانما كانت موت عبد الناصر، والذي مثل لهم موت الأب، وهدم الحلم الذي كان يبنيه خاصة ان ابناء هذا الجيل لم يكونوا ضد عبد الناصر رغم انهم سجنوا في عصره، كانوا يؤيدون عبد الناصر، لكنهم ينتقدونه في كتاباتهم. وفي كتابات صنع الله ابراهيم انتقادات لتجربة السد العالي رغم أننا نفخر بهذه التجربة، كان كتاب الستينات مع التوجه الاشتراكي العام، لكنهم ضد المعالجة المتبعة، وهذا يتضح في كتابات جمال الغيطاني ـ خاصة «الزيني بركات» ـ الذي يرفض الوضع الفوقي اللاديمقراطي، وأنا شخصيا كنت أضرب في السجن لكن لا استطيع أن اشتم في الوقت ذاته عبد الناصر، لأنني لست ضد التوجهات، لكن ضد طريقة التنفيذ، الى أن جاءت حركة السادات فأجهضت حركة المقاومة. مرحلة عبد الناصر هي أرقى مرحلة في تاريخ مصر بشعاراتها، بآلامها، بانتصاراتها، صنعت ثقافة حقيقية، وصنعت جيلا نتناقش حوله الآن، لكن ما حدث بموت عبد الناصر من انقلاب في الاتجاه الديمقراطي النقدي، وارتباط الاتجاه السياسي بـ «99% من أوراق اللعبة في يد اميركا» كما قال السادات، كل هذا جعل بعض أبناء جيل الستينات يتحولون، وربما ينقلبون على ماضيهم.
أهم ملامح كتابة جيل الستينات في تصوري الاهتمام بالعمق الاجتماعي الكبير حسب تنوعهم فمنهج ابراهيم اصلان في هذا الصدد، يختلف عن منهج محمد البساطي يختلف عن منهج جميل عطية ابراهيم. أيضا هناك الرؤية المختلفة للأمور عن الرؤية التي كانت سائدة في كتابات طه حسين والعقاد ومحمد عبد الحليم عبد الله، وغيرهم. أيضا هناك الروح النقدية العميقة التي تميز كتابات أبناء هذا الجيل، والرؤية المستقبلية، واللغة التي لم تعد مجرد لغة سردية وجمالية بالمعنى العادي، والبنية الروائية المختلفة من شخص لآخر، بل أصبحت هناك أبنية متعددة، جديدة مختلفة والآن اذا نظرنا الى هذا الأدب سنجده يترجم الى جميع اللغات الأوروبية وهو ما يكشف عن أهميته التي لا تقل عن أهمية الرواية الاميركية الجنوبية في مستواها الجمالي.
وعموما فلا استطيع أن أقول إن لي انتقادات عليهم، قد تكون هناك انتقادات على البنية الداخلية في بعض الأعمال، ولكن أعتقد أنهم يتناسلون بشكل أفضل، فجمال الغيطاني الآن أفضل بكثير مما كان عليه، وصنع الله ابراهيم الآن أفضل.
وأعتقد أن انقلاب بعض أبناء هذا الجيل على تاريخهم، وعلى ماضيهم يرجع الى الواقع الذي نعيشه، والى الميوعة الليبرالية التي نعيشها، والأقرب الى البلاء، لكن مع ذلك فالجيل كله لا يزال يسارياً لأن هناك فرقا بين أن تكون يساريا، وان تكون مناضلا. اليسار الذي أقصده بمعنى النقد الاجتماعي وتجاوز الواقع، وأحيانا تعبر مواقف جيل الستينات الآن عن امزجتهم اليسارية أو العكس.
وعموما فالرواية في مصر كلها انطلاقا من جيل الستينات وحتى الآن رواية يسارية لأنها تعبر عن النقد الاجتماعي، وحتى غنائية ادوار الخراط في الخمسينات كذلك، بل ان الأدب العربي كله الآن يساري، لأنه أدب تجاوزي متطلع للأفضل، يجدد في الرؤية ويدق على الأبواب من أجل المستقبل.
ووجود مواقف لبعض أبناء جيل الستينات فيها مهادنة للحكومة لا تعني موافقتهم على ذلك، فأنا مثلا عضو في لجنة الفلسفة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، لكنني لست موظفا، وأنا ماركسي شيوعي، والجميع يعرف هذا، ومواقفي تختف مع توجهات وزارة الثقافة وتوجهات المجلس، وعندما رفض صنع الله ابراهيم جائزة الرواية وكنت أحد المحكمين الواقفين على خشبة المسرح، كنت أول المصفقين له، وهذا الموقف موقف صنع الله، يكشف ان هذا الجيل لا يزال يحافظ على يساريته ويرفض مهادنة الحكومة، والوجود في الهيئات الحكومية لا يعني الموافقة على ما تفعله الحكومة، لكن يجب ألا نترك لها المجال، وأزعم ان الموقف العام لأبناء جيل الستينات هو الأقرب الى النقد العميق الكلي والجذري، وليس كل أبناء جيل الستينات يسيطرون على المؤسسات الثقافية، فهناك من لا يعمل في المؤسسة مثل محمد البساطي، واذا كان الأمر صحيحا انهم يسيطرون فأعتقد أن هذا بحكم الخبرة والسن، وأرى انهم جديرون بقيادة الحلم اليساري الثوري.










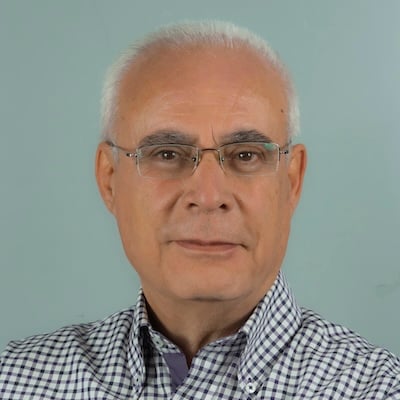


التعليقات