الكل يطالب بتعديل المناهج الدراسية خاصة مقررات التربية الإسلامية، وبرغم موافقة الدول العربية على هذا الأمر من خلال المبدأ، إلا أن واقع الحال يدل على ضعف بنيوي في فلسفة التعليم ذاتها. ومن الأخطاء الفادحة في هذا المجال اعتماد الدول العربية على مفاهيم التربية وليس التعليم. وإذا كانت كلمة Education الإنجليزية يقابلها مصطلح "التربية" عربياً، فإن الخطأ يكمن في عدم فهم مضمون المصطلح الإنجليزي الذي لا يقتصر على مفهوم "تربية" الفرد محل البحث، وهو مفهوم مادي بيولوجي على مستوى الأسرة من جهة التغذية ومتطلباتها الحياتية، ثم تطعيمها بالقيم والمفاهيم التي تريدها الأسرة في من تقوم بتربيته، بل يمتد مضمون هذا المصطلح إلى التثقيف الأكثر شمولية واتساعاً من التعليم. فعندما نصنف رجلاً ما من جهة مستواه الثقافي نقول (Education man)، ولا يقصد بذلك كونه مترجماً أم لا، لأننا لا نعلم شيئاً عن تربيته، لكننا نتعامل مع مستواه الثقافي.
وزارات التربية في العالم العربي أخذت على نفسها مهمة التعليم والتربية في بداية الأمر، ثم اقتصرت على التربية دون فلسفة واضحة. فوزارة التربية في الكويت تثبّت سلماً تعليمياً جديداً يزداد فيه عدد سنوات المرحلة الابتدائية دون أن تكلف نفسها شرح الفلسفة الكامنة وراء هذا التغيير: لماذا؟ وما هي النتائج المتوخاة من هذا السلم التعليمي الجديد؟ وحتى وهي تقوم بتغيير المناهج التعليمية، لا ندري كيف تصوغ هذه المناهج، ولأي هدف!
ولا تتوقف المشكلة عند صياغة المناهج والأهداف المطلوبة للمخرجات التعليمية، بل تتعداها إلى مشاكل أخرى مثل إعداد المعلم الجيد والمؤهل. فالنظام التعليمي العالي بدوره ليس كفؤاً خاصة في كليات التربية المسؤولة عن إعداد المعلم، كما أن هذا المعلم الذي يستلم مسؤولية التعليم لا يطوّر قدراته ووسائله التعليمية، ومع اتساع نطاق العمل الإداري أصبح ناظر المدرسة والمسؤولون في الوزارة يقومون بالعمل الإداري أكثر من تركيز عملهم على التعليم، دعْ عنك ما نلاحظه من أن معظم كبار المسؤولين في هذه الوزارة ليسوا من المختصين بالتربية والتعليم، إن لم يصلوا إلى هذه المناصب بسبب العلاقات الاجتماعية وليس العلمية والكفاءة.
ولو أضفنا إلى هذا كله عدم علاقة مناهج التعليم بالثقافة والواقع، لأصبحت لدينا مشكلة متعددة الأبعاد، ما عاد يفيد فيها مجرد التغيير لأجل التغيير ذاته. وبصراحة العالم العربي اليوم بحاجة إلى مختصين أجانب من المؤسسات الدولية مثل "اليونيسكو" لكي يحددوا كيفية التغيير دون أية حساسية، فوزارات التربية والتعليم في العالم العربي لا تملك الكفاءات المطلوبة. وتسنت لي قراءة بعض المراجع العلمية الحديثة حول أساليب التربية والتعليم، ووجدت أن كل النظريات العلمية الخاصة بهذا الموضوع المهم تعود لأصول غربية، فالإسهام العلمي العربي في هذا المجال يعادل الصفر.
من جهة ثالثة لا يزال النظام التعليمي العربي يعتمد على أسلوب التلقين بسبب انعدام الحرية الفكرية في مجال موضوعات الدين والعلوم الاجتماعية. وبدون حرية التفكير الداعمة للبحث والتقصي، لا مجال للتطوير. ويكفي أن نقارن مناهج التعليم الخاص بمناهج التعليم العام حتى نتلمس عياناً الفرق بين مخرجات الإثنين.










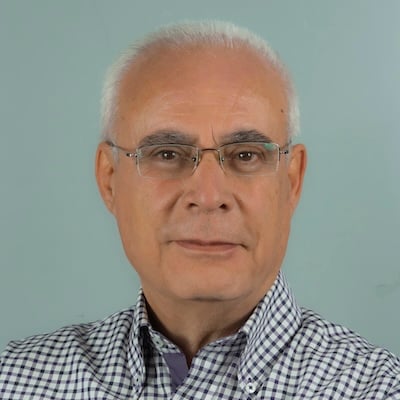


التعليقات