&
- 1 -
القنفذ موجود على الرغم من أنوفنا. تجده متكوراً. أشواكه من كل الجهات والأرض كروية. الحياة من كل الجهات... إذاً مد يدك إلى القنفذ من أية جهة تشاء، قد تقع إصبعك على الرأس.. أو على الفم تحديداً، قد تقع على البطن أو المؤخرة.. أو قد لاتصل مثل إصبع زوج عمتي التي ارتدت ـ قبل أن تصل ـ حين انتفش القنفذ وانتفض أمامه، فانتثرت الإبر الملونة في كل الاتجاهات، ومنها اتجاه بلعوم عجيل الذي ركض بنطٍ كنغري صوب البيت ودشاديش الصِبيّة ترفرف حوله مثل الأعلام التي ترفرف في التلفزيونات عند انتهاء البث ونوم أقداح الشاي بدبقها السكري... حينذاك لم يكن عجيل قد تزوّج عمتي ولا أبي زوجاً لأمي (فأين كنت أنا ؟) حينها كانت قاماتهم ـ جميعاً ـ تصل إلى سُرة جدي. كلهم صِبيّة بدشاديش مرفرفة كأعلام التلفزيونات. لحقوا بعجيل إلى البيت وأحاطوه ـ وهو يقف أمام أمه ـ بسور من عيونهم الجاحظة التي ازدادت اقتراباً واتساعاً لحظة اكتشافهم: أن الممسك ببلعومه لا يستطيع الرد على أسئلة أمه، وهي تدق صدرها بفجيعة، وأم عجيل ميتة الآن بعد أن كانت آخر كلمة لها قبل استلال الروح كالخيط من جروح المستشفيات: مسامير.. مسامير.. مسامير.. هكذا رددتها بخفوت ثلاث مرات وماتت. كانت تسأل ولدها عن الذي حلّ به ـ لأنها لم تكن تعرف أن الذي به هو إبرة قنفذ مغروسة في البلعوم ـ يجيبها بصوت مبحوح، ثلاث مرات: بح.. بح.. بح... ويشير بإصبع اليد الأخرى إلى جهة القنفذ، فتسأل الأولاد/ الدشاديش ولا يعرفون لأن عيونهم لم تر شيئاً. ترفع بكفها كفه القابضة على رقبته، فيبصر الصِبيّة خيط دم رفيع يصعد وينزل كلما أراد ـ الذي سيصبح زوج عمتي ـ أن يتكلم: بح.. بح.. بح. كل كلماته بحبحات، وكل الذين رأت عيونهم خيط الدم الرفيع الصاعد النازل مع تفاحة آدم، لم ينسوه حتى وهم يحيطون الآن بدِلال القهوة ويتحدثون عن السوق الأوربية المشتركة وتصريحات الرئيس الأمريكي وأفلام الكا../"بوي" / "رتون" ـ وعن دم الاغتيالات في الصحف، فيستعيدون خيط الدم الرفيع، النازف من تفاحة آدم، الذي أبصروه قبل سبعين عاماً ويتساءلون، على الفور، عن سبب عدم حضور الحاج عجيل إلى قهوة صباح هذا اليوم. انهم يفتقدون لمعان نظاراته الطبية بين نظاراتهم التي ذبلت وراءها تلك العيون التي كانت جاحظة قبل سبعين صيفاً، تلاحق أمه وهي تقتاده إلى أبيه المنهمك بقراءة القرآن تحت ظل النخلة، على الحصير المصنوع من سعفها... النخلة الوحيدة التي تشمخ جنوب فناء الدار. صَدّقَ الله العظيم على عجلٍ. قَبّل الكتاب وهبَّ بابنه إلى طبيب القرية. أخذه الطبيب إلى مستشفى المدينة. اصطحبه موظف الاستعلامات إلى الطبيب الخفر الذي كان يغازل الطبيبة الخفر، فوضعوا لعجيل نظارات عاجلة، وعاد مع أبيه إلى ظل النخلة فكنست أمه ذرق العصافير والحمام والفواخت والدجاج عن بقعة الجلوس ونُسيت إبرة القنفذ تقريباً فيما ظل عجيل يضع النظارات الطبية على عينيه حتى في ليلة عرسه، والعروس عمتي. أنجبت له قاسم الذي قضم الجرذ أذنه وهو نائم بعد أن حكها فور نهوضه شبعاً من صحن الثريد المنقوع بالسِمن الحيواني (دهن حُـر) سمن ذهبي اللون كالقمر استخلصته عمتي من حليب بقرتها التي بكت عليها حين ماتت.. عمتي هي التي بكت على البقرة وليس العكس، لأن البقرة ماتت قبلها، بعد رش المبيد الذي بعثت به وزارة الرعاية الاجتماعية لرعاية القرى في بداية صيف بعيد، يوم انتشرت في قريتنا فُرق من الرجال الغرباء، يحملون على ظهورهم براميل تمتد منها خراطيم طويلة تنفخ رذاذاً أبيض مثل الحليب ـ ولكنه ليس حليباً ـ لأنهم قالوا لنا أثناء رشهم لسقوف بيوت الطين: إنه سيقتل الأفاعي والجرذان والفئران والقنافذ والصراصير والقمل والقراد والدود والعناكب وأسماء أخرى نسيناها.
&& ثمة شاب كردي يرسم على حيطان أكواخ الدواب قلباً يخترقه سهم كلما لمح في الدار ـ التي يرشها ـ فتاة جميلة، وكانت وردة ابنة عمتي أجمل من فتيات الإعلان عن الصابون، فوسع الكردي من دائرة القلب ثم أنزل& سهماً طويلاً؛ من أعلى السقف ـ حيث أعشاش العصافير بين القصب ـ وحتى أرضية الكوخ المفروشة بالروث والطست.. أنزل السهم بعنف ولوعة، ناظراً إلى وردة، وهي تنظر إليه فنسي أن يوقف تدفق الأبيض من رأس العصا الحديدية المنتهية بخرطوم ممتد من البرميل على ظهره. اصطبغ الماء في الطست الذي تشرب منه بقرة عمتي. ابتسمت وردة لراسم القلب ودخلت تعدّ الشاي. خرج الشاب من الكوخ ودخلت البقرة. شربت من& طست شربها دون أن تفكر ببياض الماء، وهي لا تفكر لأنها بقرة وماتت. بكت عليها عمتي التي كانت تصنع من حليبها سمناً لذيذاً للثريد يحبه قاسم الذي حكَ أذنه بكفه الدسمة قبل أن يغسل يديه، ونسي أن يغسل أذنه، ثم بال، ثم نام، فجاء الجرذ من ثقب جحره المحفور في الزاوية المخفية تحت دكة حمل الفراش والسجادات.
&& يطيب للجرذ أن يخرج حين ينام الجميع. يتجول في أرجاء البيت، يتشمم الأرضية الترابية الرطبة، باحثاً عن حبة رز أو كِسرة خبز أو أي شئ من فتيت لُقَم عجيل الذي كان يخطئ أحياناً في وضع اللقمة في فمه فيدفعها إلى منخريه أو لحيته، لأنه لم يغير نظاراته الطبية التي أحبها بعد إبرة القنفذ الذي لم يجدوه أبداً بينما كانوا يرون الجرذ. يفاجئونه بدخولهم بعد غياب قليل، فيفر إلى جحره، حيث يتكاسل الجميع عن ملاحقته.لا أحد يفكر بتفكيك الدكة لمجرد البحث عن جرذ تافه... حتى استيقظوا ذات صباح وهم يتسابقون لتحطيم الدكة.. بل مستعدون لتحطيم الجدار الذي تتكئ عليه الدكة، وتحطيم الدار كلها لو استوجب الحال من أجل الظفر بذلك الجرذ الذي قضم أذن قاسم ـ في الليل ـ قضمة واحدة بعد أن تشمّم الدسم في أعلاها. ظلت أذن قاسم مقضومة من الأعلى حتى بعد أن تزوج وأصبح له أولاد بأسماء كثيرة منها: إبراهيم وإدريس وشيماء التي يتوقع الأطباء موتها بعد أشهر قليلة، وزوجها يقف جوارها مستعرضاً أرامل القرية في رأسه ليقدّر: أيهن ستصلح لتربية طفليه بعد شيماء ابنة قاسم الذي استطاع بعبقريته في تصليح الأجهزة الدقيقة والكهربائية وإتقانه صنوف الخط العربي، وفي اختراعاته وأحاديثه وهروباته من الجيش وذكائه: أن يُشغل الناس عن أذنه، لينسيهم السؤال عنها أو الضحك منها، وحتى النظر إليها... رغم تميز قاسم بهدوء طبعه إلا أنّه تزوج ابنة عمه السليطة اللسان، القادرة بشتائمها على تهجير مدينة، ذلك أنه لم يستطع مقاومة بياض ذراعها الذي رآه فجأة ذات فجر مفاجئ، حين أيقظته مثانته المكتظة بالبول فنفض غطاءه وهرول خارجاً باتجاه المرحاض المحفور جوار التنور في زاوية الحوش. تلفتَ إلى الفجر من حوله، وهو يضغط بكفيّه ما بين الفخذين، فأبصر ابنة عمّه من خلف السور الواطئ وهي ـ الأخرى ـ تهرول باتجاه مرحاضهم وتدفع بكفيها بين فخذيها متلفتة إلى الفجر من حولها، فأبصرا بعضهما وابتسمت.. كانت تلك أول مرة يرى قاسم فيها ابتسامة حسيبة، وأول مرة يرى فيها ذراعاً عارية لامرأة، فصعقه بياض اللحم... حينذاك كانت حسيبة مضطرة للخروج بقميص نومها الداخلي المعدوم الأكمام، ولم يحدث لقاسم أن رأى من النساء غير وجوههن والأصابع. فكل نساء القرية ملفلفات بطبقات الثياب كالبصل. وفي اللحظة التي وقف فيها مباعداً بين قدميه فوق فم المرحاض، مصوباً خيط بوله المندفع بلذة آلية ويتطلع من فوق الحائط، إلى مرحاض بيت عمه ـ حيث تَخَفَت حسيبة ـ فكر في بولها وتخيل اللحم الأبيض والذراع البيضاء، شعورها باللذة والارتياح ـ مثله ـ عند تدفق المحبوس، ووجد نفسه يغني:"هواك أنت يذكرني بفرات ودجلة يومياً / مثل قلبي ومثل قلبكَ تلاقن صافية النية ".. في تلك اللحظة بالضبط قرر أن يوحد مصادر بوليهما مهما يكن الثمن... في تلك اللحظة اندفعت حسيبة من مرحاضهم راكضة نحو باب الدار فطار شعرها في الهواء، ترجرج صدرها، التمعت ذراعها البيضاء وأوصدت الباب خلفها بعنف... أيعقل أن يكون لون اللحم أبيض إلى هذا الحد ؟؟!.. بضّاً إلى هذا الحد ؟؟!. وظل قاسم واقفاً، ممسكاً بقصبة بوله حتى طلعت الشمس وهو يكرر السؤال على نفسه بمصيرية: أيعقل أن يكون اللحم أبيض إلى هذا الحد؟؟!.. أيكون الذي يجري تحت جلدها حليباً أو لبناً أو سُماً وليس دماً؟... وأخذته الأسئلة إلى شاطئ النهر حذاء القرية. جلس على الحصى غارساً قدميه في الماء حتى حلّ الظلام. تذكر أنه لم يتناول فطوره ولا غداءه. لم يرسم شيئاً..
& لا يدري كيف مر النهار، ولكنه كان نهاراً أبيض كبياض ذراع حسيبة التي استعاد صورتها آلاف المرات؛ طيران شعرها الطويل مطارداً رأسها مثل ذيل طائر جميل. امتزجت في عينيه رجرجة صدرها برجرجة الأمواج على حافات الرمل. مدّ أصابعه إلى ارتفاعات الرمل يتحسس طراوة النهد ورخاوة الذراع الإسفنجية البيضاء، استدارت كفه حول حصاة مغسولة بحجم البرتقالة متحسّساً فيها نعومة استدارة كتف حسيبة:" آه.. ياحسيبة، لم أكن أعلم أنكِ تكنزين كل هذه الأنوثة وراء استرجالكِ المخيف..! ".
&& كان يخافها مثل الجميع، الذين يتحاشونها؛ إن لم يكن تجنباً لبذاءة لسانها فلتجنب تخميش أظافرها الذئبية، أو عصا الطَرّفة الحمراء التي تتأبطها دائماً لحمارها وأبقارها وللمتعرضين لها.. بل أن أكثر ما جعل قاسم يعتزل اللعب معها منذ الطفولة هو: متانة قدمها، أو هكذا تخيلها حين رآها تركل البرميل من تحت أخيها الذي صعد ليمد يده إلى عش عصافيرها في أعلى السقف، وقاسم كان يدرك بأنها ليست عصافيرها، ولكنها هي التي قالت ذلك، وأجابها ـ حينذاك ـ في نفسه سراً: بأن العصافير.. عصافير الفضاء.. عصافير الله.
& سقط شقيقها علي على الأرض وانكسرت ذراعه وتكومت أسنانه تحت وجهه في بركة دم، ودون أن تلتـفت إليه أوقفت البرميل وارتقت عليه، فيما علي يصرخ محاولاً استنهاض جسده، ورذاذ الدم ينفر من منخريه كلما صرخ متوجعاً. مدت حسيبة كفها في العش، استخرجت بيضتين وقالت:"بيضاتي" فقال قاسم ـ في نفسه سراً ـ:" إنها بيضات العصافير التي هي عصافير الفضاء الذي هو فضاء الله". ثم غادر بصمت ولم يلعب معها بعد ذلك أبداً رغم أن لعبها كان ممتعاً ومخيفاً كاللعب بالسكين أو النار.. وكم اشتد به الحنين إلى اللعب معها، حين كان ينظر إليها من نافذة بيتهم، وهي تبتكر الألعاب العجيبة، تتسلط على بقية الصغار، تتحكم بهم بشراسة نمرة.. إلا أنه كان قد عزم على عدم اللعب معها منذ رآها تركل البرميل من تحت علي بعنف القنبلة. ظل يتجنب الالتقاء بها وهما يكبران، يكبران إلى أن تفجر حنينه المتراكم ـ دفعة واحدة ـ في ذلك الفجر الأبيض كذراعها.. لقد أذهلته الدهشة وهو يسمع الحاج والده يطلب له يدها من الحاج عمه.. فكيف عرف أبوه بأنه يريد ذراع حسيبة وليس حسيبة؟! أو الأهم هو الذراع ثم ـ بعد ذلك ـ يأتي الكتف الشعر، تأتي حسيبة. لقد دوّخته هذه المسألة كثيراً.. فهل أن والده يقرأ أفكاره إلى هذا الحد؟!.. هل لوالده كل هذه الفراسة؟! أم أنه هو الآخر قد رأى ذراعها ذات فجر؟.. أم أنه قد سمعه هاذياً ببياض ذراعها للنهر أو وهو نائم؟... ظلت هذه الدهشة المتشظية إلى أسئلة تموج في دواخل قاسم إلى أن أطلع عليها حسيبة ذاتها بعد فترة من زواجهما، فانفجرت بالضحك ثم أجابت بتهكم:" الجميع يقولون ذلك عندما يتقدمون لخطبة فتاة يا فهيم.. يا مجنون حسيبة.. يا حمار" وهي لا تشتمه إلا حينما يكونان وحدهما، أما أمام الناس فتتصنع انقيادها له ولا تناديه إلا بـ "أبو شيماء" أو " أبو إبراهيم". هذا ما صرّح لي به قاسم نفسه بعد ما يقارب الخمسة وعشرين عاماً من زواجهما فسألتُه: وما الذي جعلك تتورط معها كل هذه السنين؟. قال: إنها رائعة يا ابن خالي.. إنها امرأة دائمة الاشتعال.. دائمة التحفز.. دائمة الاقتتال.. دائمة التوَهّج.. دائمة الخضرة، وأنا فنان، أحب المغامرة ولا أجد لذة الحياة إلا في تلك الأجواء الخطرة بجمالها. مثل متسلق الجبال، أو مصارع الثيران، أو مثل لاعب السيرك، فمتعة الماشي على الحبل هي المتعة الحقيقية، لأنه إن لم يكن حاضر التركيز بكل حواسه وكيانه سيقع ويموت، ومثله اللاعب مع الأسود والنمور.. إنه معَرّض للافتراس في أية لحظة، وهنا تكمن قيمة حياته الحقيقية وثمنها المكرس في لحظة ..وحسيبة نمرة لا تهدأ.. تجعلني أعيش السنوات كتلك اللحظة.. باحتراق دائم.. على حافة الدوام والانفصال، البقاء والزَّوال.. هكذا في النقطة المتحركة الحرجة دائماً... وكشف لي عن معلومات أعرفها من قبل ـ كأغلب أبناء القرية ـ وهي أن حسيبة لا تخاف منه ولا من أي شئ أو من أي شخص في هذا العالم مطلقاً، إلا من والدها فقط.
&& تقول:" هو الوحيد الذي أخاف منه في هذه الدنيا، أخاف منه حتى أكثر من خوفي من الله ". فوالدها ـ حين يعاقبها ـ كان يعذبها بأساليب تتناقلها القبائل وتفشل في ثنيه الوفود والوجاهات.. بل أنه يهدد بذبحها إذا ما ألحَّ المفاوضون عليه، فقد أدار وجهها ـ ذات مرة ـ إلى القِبلة ولوى ذراعيها خلفها، داسهما بجزمته ومد السكين إلى رقبتها ليذبحها كما تُذبح الدجاجة لولا أن توسّل به المفاوضون ووقعوا على يده يقبلونها ليتخلى عن نية الذبح وأنهم سيغادرون، فعدل بعد صمت طويل، ثم ركل البنت على رأسها بشدة فتدحرجت غائبة عن الوعي، فيما جلس هو في الظل على صفيحة وراح يدخن سيجارته بعد أن أمر زوجته المرعوبة/المسربلة بدمعها؛ أن تُعد له شاياً ثقيلاً... وحسيبة هي الفتاة الوحيدة لسبعة أشقاء، كلهم أخذوا الارتعاب والخوف والبرود والاهتزاز عن أمهم، وانفردت هي بوراثة الجسارة الجنونية عن أبيها، فحين تصرخ باخوتها غاضبة. كانوا يقسمون؛ أنهم يبصرون شرر النار يقدح من عينيها فتبتل سـراويـلـهـم.
&& ثمة شاب كردي يرسم على حيطان أكواخ الدواب قلباً يخترقه سهم كلما لمح في الدار ـ التي يرشها ـ فتاة جميلة، وكانت وردة ابنة عمتي أجمل من فتيات الإعلان عن الصابون، فوسع الكردي من دائرة القلب ثم أنزل& سهماً طويلاً؛ من أعلى السقف ـ حيث أعشاش العصافير بين القصب ـ وحتى أرضية الكوخ المفروشة بالروث والطست.. أنزل السهم بعنف ولوعة، ناظراً إلى وردة، وهي تنظر إليه فنسي أن يوقف تدفق الأبيض من رأس العصا الحديدية المنتهية بخرطوم ممتد من البرميل على ظهره. اصطبغ الماء في الطست الذي تشرب منه بقرة عمتي. ابتسمت وردة لراسم القلب ودخلت تعدّ الشاي. خرج الشاب من الكوخ ودخلت البقرة. شربت من& طست شربها دون أن تفكر ببياض الماء، وهي لا تفكر لأنها بقرة وماتت. بكت عليها عمتي التي كانت تصنع من حليبها سمناً لذيذاً للثريد يحبه قاسم الذي حكَ أذنه بكفه الدسمة قبل أن يغسل يديه، ونسي أن يغسل أذنه، ثم بال، ثم نام، فجاء الجرذ من ثقب جحره المحفور في الزاوية المخفية تحت دكة حمل الفراش والسجادات.
&& يطيب للجرذ أن يخرج حين ينام الجميع. يتجول في أرجاء البيت، يتشمم الأرضية الترابية الرطبة، باحثاً عن حبة رز أو كِسرة خبز أو أي شئ من فتيت لُقَم عجيل الذي كان يخطئ أحياناً في وضع اللقمة في فمه فيدفعها إلى منخريه أو لحيته، لأنه لم يغير نظاراته الطبية التي أحبها بعد إبرة القنفذ الذي لم يجدوه أبداً بينما كانوا يرون الجرذ. يفاجئونه بدخولهم بعد غياب قليل، فيفر إلى جحره، حيث يتكاسل الجميع عن ملاحقته.لا أحد يفكر بتفكيك الدكة لمجرد البحث عن جرذ تافه... حتى استيقظوا ذات صباح وهم يتسابقون لتحطيم الدكة.. بل مستعدون لتحطيم الجدار الذي تتكئ عليه الدكة، وتحطيم الدار كلها لو استوجب الحال من أجل الظفر بذلك الجرذ الذي قضم أذن قاسم ـ في الليل ـ قضمة واحدة بعد أن تشمّم الدسم في أعلاها. ظلت أذن قاسم مقضومة من الأعلى حتى بعد أن تزوج وأصبح له أولاد بأسماء كثيرة منها: إبراهيم وإدريس وشيماء التي يتوقع الأطباء موتها بعد أشهر قليلة، وزوجها يقف جوارها مستعرضاً أرامل القرية في رأسه ليقدّر: أيهن ستصلح لتربية طفليه بعد شيماء ابنة قاسم الذي استطاع بعبقريته في تصليح الأجهزة الدقيقة والكهربائية وإتقانه صنوف الخط العربي، وفي اختراعاته وأحاديثه وهروباته من الجيش وذكائه: أن يُشغل الناس عن أذنه، لينسيهم السؤال عنها أو الضحك منها، وحتى النظر إليها... رغم تميز قاسم بهدوء طبعه إلا أنّه تزوج ابنة عمه السليطة اللسان، القادرة بشتائمها على تهجير مدينة، ذلك أنه لم يستطع مقاومة بياض ذراعها الذي رآه فجأة ذات فجر مفاجئ، حين أيقظته مثانته المكتظة بالبول فنفض غطاءه وهرول خارجاً باتجاه المرحاض المحفور جوار التنور في زاوية الحوش. تلفتَ إلى الفجر من حوله، وهو يضغط بكفيّه ما بين الفخذين، فأبصر ابنة عمّه من خلف السور الواطئ وهي ـ الأخرى ـ تهرول باتجاه مرحاضهم وتدفع بكفيها بين فخذيها متلفتة إلى الفجر من حولها، فأبصرا بعضهما وابتسمت.. كانت تلك أول مرة يرى قاسم فيها ابتسامة حسيبة، وأول مرة يرى فيها ذراعاً عارية لامرأة، فصعقه بياض اللحم... حينذاك كانت حسيبة مضطرة للخروج بقميص نومها الداخلي المعدوم الأكمام، ولم يحدث لقاسم أن رأى من النساء غير وجوههن والأصابع. فكل نساء القرية ملفلفات بطبقات الثياب كالبصل. وفي اللحظة التي وقف فيها مباعداً بين قدميه فوق فم المرحاض، مصوباً خيط بوله المندفع بلذة آلية ويتطلع من فوق الحائط، إلى مرحاض بيت عمه ـ حيث تَخَفَت حسيبة ـ فكر في بولها وتخيل اللحم الأبيض والذراع البيضاء، شعورها باللذة والارتياح ـ مثله ـ عند تدفق المحبوس، ووجد نفسه يغني:"هواك أنت يذكرني بفرات ودجلة يومياً / مثل قلبي ومثل قلبكَ تلاقن صافية النية ".. في تلك اللحظة بالضبط قرر أن يوحد مصادر بوليهما مهما يكن الثمن... في تلك اللحظة اندفعت حسيبة من مرحاضهم راكضة نحو باب الدار فطار شعرها في الهواء، ترجرج صدرها، التمعت ذراعها البيضاء وأوصدت الباب خلفها بعنف... أيعقل أن يكون لون اللحم أبيض إلى هذا الحد ؟؟!.. بضّاً إلى هذا الحد ؟؟!. وظل قاسم واقفاً، ممسكاً بقصبة بوله حتى طلعت الشمس وهو يكرر السؤال على نفسه بمصيرية: أيعقل أن يكون اللحم أبيض إلى هذا الحد؟؟!.. أيكون الذي يجري تحت جلدها حليباً أو لبناً أو سُماً وليس دماً؟... وأخذته الأسئلة إلى شاطئ النهر حذاء القرية. جلس على الحصى غارساً قدميه في الماء حتى حلّ الظلام. تذكر أنه لم يتناول فطوره ولا غداءه. لم يرسم شيئاً..
& لا يدري كيف مر النهار، ولكنه كان نهاراً أبيض كبياض ذراع حسيبة التي استعاد صورتها آلاف المرات؛ طيران شعرها الطويل مطارداً رأسها مثل ذيل طائر جميل. امتزجت في عينيه رجرجة صدرها برجرجة الأمواج على حافات الرمل. مدّ أصابعه إلى ارتفاعات الرمل يتحسس طراوة النهد ورخاوة الذراع الإسفنجية البيضاء، استدارت كفه حول حصاة مغسولة بحجم البرتقالة متحسّساً فيها نعومة استدارة كتف حسيبة:" آه.. ياحسيبة، لم أكن أعلم أنكِ تكنزين كل هذه الأنوثة وراء استرجالكِ المخيف..! ".
&& كان يخافها مثل الجميع، الذين يتحاشونها؛ إن لم يكن تجنباً لبذاءة لسانها فلتجنب تخميش أظافرها الذئبية، أو عصا الطَرّفة الحمراء التي تتأبطها دائماً لحمارها وأبقارها وللمتعرضين لها.. بل أن أكثر ما جعل قاسم يعتزل اللعب معها منذ الطفولة هو: متانة قدمها، أو هكذا تخيلها حين رآها تركل البرميل من تحت أخيها الذي صعد ليمد يده إلى عش عصافيرها في أعلى السقف، وقاسم كان يدرك بأنها ليست عصافيرها، ولكنها هي التي قالت ذلك، وأجابها ـ حينذاك ـ في نفسه سراً: بأن العصافير.. عصافير الفضاء.. عصافير الله.
& سقط شقيقها علي على الأرض وانكسرت ذراعه وتكومت أسنانه تحت وجهه في بركة دم، ودون أن تلتـفت إليه أوقفت البرميل وارتقت عليه، فيما علي يصرخ محاولاً استنهاض جسده، ورذاذ الدم ينفر من منخريه كلما صرخ متوجعاً. مدت حسيبة كفها في العش، استخرجت بيضتين وقالت:"بيضاتي" فقال قاسم ـ في نفسه سراً ـ:" إنها بيضات العصافير التي هي عصافير الفضاء الذي هو فضاء الله". ثم غادر بصمت ولم يلعب معها بعد ذلك أبداً رغم أن لعبها كان ممتعاً ومخيفاً كاللعب بالسكين أو النار.. وكم اشتد به الحنين إلى اللعب معها، حين كان ينظر إليها من نافذة بيتهم، وهي تبتكر الألعاب العجيبة، تتسلط على بقية الصغار، تتحكم بهم بشراسة نمرة.. إلا أنه كان قد عزم على عدم اللعب معها منذ رآها تركل البرميل من تحت علي بعنف القنبلة. ظل يتجنب الالتقاء بها وهما يكبران، يكبران إلى أن تفجر حنينه المتراكم ـ دفعة واحدة ـ في ذلك الفجر الأبيض كذراعها.. لقد أذهلته الدهشة وهو يسمع الحاج والده يطلب له يدها من الحاج عمه.. فكيف عرف أبوه بأنه يريد ذراع حسيبة وليس حسيبة؟! أو الأهم هو الذراع ثم ـ بعد ذلك ـ يأتي الكتف الشعر، تأتي حسيبة. لقد دوّخته هذه المسألة كثيراً.. فهل أن والده يقرأ أفكاره إلى هذا الحد؟!.. هل لوالده كل هذه الفراسة؟! أم أنه هو الآخر قد رأى ذراعها ذات فجر؟.. أم أنه قد سمعه هاذياً ببياض ذراعها للنهر أو وهو نائم؟... ظلت هذه الدهشة المتشظية إلى أسئلة تموج في دواخل قاسم إلى أن أطلع عليها حسيبة ذاتها بعد فترة من زواجهما، فانفجرت بالضحك ثم أجابت بتهكم:" الجميع يقولون ذلك عندما يتقدمون لخطبة فتاة يا فهيم.. يا مجنون حسيبة.. يا حمار" وهي لا تشتمه إلا حينما يكونان وحدهما، أما أمام الناس فتتصنع انقيادها له ولا تناديه إلا بـ "أبو شيماء" أو " أبو إبراهيم". هذا ما صرّح لي به قاسم نفسه بعد ما يقارب الخمسة وعشرين عاماً من زواجهما فسألتُه: وما الذي جعلك تتورط معها كل هذه السنين؟. قال: إنها رائعة يا ابن خالي.. إنها امرأة دائمة الاشتعال.. دائمة التحفز.. دائمة الاقتتال.. دائمة التوَهّج.. دائمة الخضرة، وأنا فنان، أحب المغامرة ولا أجد لذة الحياة إلا في تلك الأجواء الخطرة بجمالها. مثل متسلق الجبال، أو مصارع الثيران، أو مثل لاعب السيرك، فمتعة الماشي على الحبل هي المتعة الحقيقية، لأنه إن لم يكن حاضر التركيز بكل حواسه وكيانه سيقع ويموت، ومثله اللاعب مع الأسود والنمور.. إنه معَرّض للافتراس في أية لحظة، وهنا تكمن قيمة حياته الحقيقية وثمنها المكرس في لحظة ..وحسيبة نمرة لا تهدأ.. تجعلني أعيش السنوات كتلك اللحظة.. باحتراق دائم.. على حافة الدوام والانفصال، البقاء والزَّوال.. هكذا في النقطة المتحركة الحرجة دائماً... وكشف لي عن معلومات أعرفها من قبل ـ كأغلب أبناء القرية ـ وهي أن حسيبة لا تخاف منه ولا من أي شئ أو من أي شخص في هذا العالم مطلقاً، إلا من والدها فقط.
&& تقول:" هو الوحيد الذي أخاف منه في هذه الدنيا، أخاف منه حتى أكثر من خوفي من الله ". فوالدها ـ حين يعاقبها ـ كان يعذبها بأساليب تتناقلها القبائل وتفشل في ثنيه الوفود والوجاهات.. بل أنه يهدد بذبحها إذا ما ألحَّ المفاوضون عليه، فقد أدار وجهها ـ ذات مرة ـ إلى القِبلة ولوى ذراعيها خلفها، داسهما بجزمته ومد السكين إلى رقبتها ليذبحها كما تُذبح الدجاجة لولا أن توسّل به المفاوضون ووقعوا على يده يقبلونها ليتخلى عن نية الذبح وأنهم سيغادرون، فعدل بعد صمت طويل، ثم ركل البنت على رأسها بشدة فتدحرجت غائبة عن الوعي، فيما جلس هو في الظل على صفيحة وراح يدخن سيجارته بعد أن أمر زوجته المرعوبة/المسربلة بدمعها؛ أن تُعد له شاياً ثقيلاً... وحسيبة هي الفتاة الوحيدة لسبعة أشقاء، كلهم أخذوا الارتعاب والخوف والبرود والاهتزاز عن أمهم، وانفردت هي بوراثة الجسارة الجنونية عن أبيها، فحين تصرخ باخوتها غاضبة. كانوا يقسمون؛ أنهم يبصرون شرر النار يقدح من عينيها فتبتل سـراويـلـهـم.
&
&


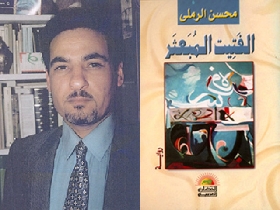





التعليقات