رحبت الأوساط الثقافية ببريطانيا، ترحيباً مفرطاً، بترجمة الشاعر الإنكليزي ستيفن ميتشل الجديدة لملحمة جلجامش على الرغم من أنّها مترجمة سابقاً، أكثر من دزينة من المرّات، وهو إلى ذلك، لا يعرف اللغة السومريّة أو الأكدية بشقّيها البابلي أو الآشوري. ما فعله بالضبط، أنّه قارن موازناً، بين ستّ ترجماتٍ قديمة، ثمّ صاغ منها نصّاً جديداً نثريّاً كمرحلة أولى، ثمّ "بدأ عمله الفعلي" كما يقول، ليصوغها صياغة شعريةً بمصاف الشعر الإنكليزي. (المقدمة: ص 65- 66).
ليست طريقة ستيفن ميتشل هذه، صنعةً لا أختَ لها في الترجمات الإنكليزية عموماً، وفي ترجمة ملحمة جلجامش على وجه الخصوص. فقد صدرت من قبل مثلاً، ترجمة ديفد فيري FERRY في عام 1992 ولم يكن يعرف هو الآخر، اللغة أو اللغات التي كُتِبتْ بها جلجامش. جاء في المقدمة التي كتبها وليم ل. موران لهذه الترجمة :"لقد اعتمدَ على ثلاث ترجمات سابقة… دعنا نقول عاجلاً إن هذي الترجمة هي قصيدة ديفد فيري… فبدل إعطائنا ترجمة- كما يُفهَم من هذا المصطلح- أعطانا تحويلاً أو استحالة لها: Transformation (ص:x1).
اتبع هذه العادةَ في اللغة العربية عبد الحق فاضل. إذ ترجم هذا الأديب المبرّز نفس الملحمة شعراً من قبل، وهو لم يكنْ يعرف من لغاتها الأصلية شيئاً، إنّما اعتمد على مصدرين فقط عربي وإنكليزي. (حتى هذا المصدر العربي لجلجامش – الطبعة الأولى _كان قد ترجمه طه باقر عن الإنكليزية مع بشير فرانسيس) ذكر عبد الحق في مقدمته: "فتكون الملحمة مناصفة بينه (أي المؤلف) وبيني. ملحمة داخل ملحمة. ملحمة عصرية داخل ملحمة أثرية. هو كتب لأبناء جيله وأنا أكتب لأبناء جيلي". ( المقدمة: ص:25) يقيناً ما دفع ستيفن ميتشل إلى ترجمته الجديدة هو خيبته من الترجمات السابقة، وهي تقريباً نفس الخيبة التي برّر بها عبد الحقّ فاضل ترجمته.
يقول ستيفن ميتشل:"لقد شرعتُ في هذه النسخة المعدّلة (Version) (أيْ لم يُسَمِّها ترجمةً عن عمد) من جلجامش لأنني لم أكنْ مقتنعاً أبداً بلغة أية ترجمة من ترجماتها التي قرأتها. أردت أن أوجد للقصيدة صوتاً أصيلاً: كلمات لدنة وقويّة بما فيها الكفاية لتوازي متانة القصّة". بينما يقول عبد الحق فاضل :"فتشت عن أيّ كتاب يتناول فنيّة الملحمة في دراسة شاملة تفصيلية فلم أجدْ. واتصلتُ ببعض المكتبات العالمية فلم أفُزْ بطائل. فحصل عندي ما يشبه القناعة بأن مثل هذه الدراسة التفصيلية لا وجود لها". (المقدمة ص:13). لا ريب؛ إنّ لمترجميْنا هذين أسوة بالمترجم الآشوري سين - ليقي- أونني الذي ترجمها عن البابلية، ربما حوالي 1250 ق. م. فغيّر وقدّم وأخّر، وأضاف وحذف، وهو عين ما فعله مترجمانا. وبعدُ: لماذا كلّ هذا الاهتمام العالمي بهذه الملحمة؟
يقول آرثر أيْ. براون في كتابه: "السرد، ومعنى الحياة، وملحمة جلجامش": "نقرأ ملحمة جلجامش بعد أربعة آلاف سنة لأننا علماء وأشباه علماء، ونودّ أن نتعلم شيئاً عن التأريخ البشري، ونقرأها كذلك لأننا نريد أن نعرف معنى الحياة". إلاّ أنّ مكانة جلجامش لا تقتصر على أهميتها الدينية، أو الثقافية، أو الفيلولوجية فقط، وإنما، وبالدرجة الأولى - بالنسبة لنا كقرّاء - على تقنياتها في فنّ التأليف الأدبي. هذه التقنيات هي التي حدتْ بالشاعر الألماني البارز رينر ماريا ريلكه على القول في إحدى رسائله عام 1916:"ملحمة جلجامش مذهلة، أعتبرها من بين أهم الأشياء التي يمكن أن يصادفها إنسان". "لقد غمرت نفسي بها، فخبرتُ في تلك الكسر الهائلة من الألواح الطينية المفخورة أنظمة وأشكالاً تنتمي إلى الأعمال الأدبية المجوّدة التي أنتجتها (الكلمة) الساحرة في كلّ تأريخها". يعلّق ستيفن ميتشل على قول ريلكه هذا :"ومثلما ظهر قصر "علاء الدين" (المسحور) من لا مكان بلمح البصر، هكذا ظهرت ملحمة جلجامش لأوّل مرّة كتحفة من تحف الأدب العالمي" (المقدمة ص:3).
مع ذلك، ما من ناقد – على حدّ علمي- حاول دراسة هذه الملحمة من حيثُ تقنياتها التأليفية دراسة نقدية تشريحية، تلك التقنيات التي ما أن يمرّ بها المرء حتى يطير النوم من عينه.
إذنْ أدناه محاولةٌ أوليةٌ لسدّ هذا الفراغ، متناولاً تقنيات التشابيه التي برع بها شاعر هذه القصيدة الملحمية، لدرجة قد لا يكون لها مثيل في مكان آخر. تدلّل التشابيه في هذه القصيدة الملحمية على قدرة شاعرها على تقمّص الكائنات الحية والجامدة واستبطانها، وهذا ما يندر وجوده في الشعر العربي، كما تدلل على سعة وشموليّة الذهنيّة التي تقف وراءها، بحيث يصبح المشبَّه والمشبَّه به توأميْن يولدان وينموان معاً، ولا يكمل وجود أحدهما إلاّ بوجود الآخر كما سنرى. يصبح التشبيه حصيلة طبيعيّة. لنا أن نعجب بقدرة آمرء القيس، أو قيس بن الخطيم، أو المتنبي، على التشبيه في الشعر العربي، أو حيويّته لدى شيكسبير الإنكليزي، وييتس الإيرلندي، في الشعر الإنكليزي. ولكنّ تشابيه لورنس دَرُلْ، في النثر الإنكليزي تبقى حالة نادرة. بالمقارنة، كثيراً ما يأتي التشبيه لدى أحمد شوقي، ومحمد مهدي الجواهري، على سبيل المثال لا الحصر، في القافية أو مؤدياً لها. وبتوقيته الاضطراري هذا، كثيراً ما يعتوره التمحّل. إنه عملية قيصرية لإنقاذ القافية المضنية في كثير من الأحيان. هنا قد لا نجد للتشبيه صلة بما قبله وما بعده. خلاف ذلك، تمرّ عمليّة التشبيه في ملحمة جلجامش بثلاث مراحل متواشجة. المرحلة الأولى احتفالية تمهيدية له، هي كالآحتفالية بولادة طفل قبل مجيئه في حالة الفرح، وكالوصية تحسباً للموت في حالة الحزن. بعد تلك الاحتفالية الأولى، وقد تطول، يولد التشبيه ولادة عفوية وحتميّة في آنٍ واحد. أما المرحلة الثالثة فيبدأ فيها التشبيه بالعمل داخل الصور الشعرية اللاحقة. بكلمات أخرى لا ينقطع، وبالتالي لا يتوقف مفعوله، تماماً كما لا ينقطع الطفل عن تفاعله مع والديه. قبل أن نعطي أمثلة عن خصائص التشبيه في ملحمة جلجامش، قد يكون من المفيد أن نقدّم نموذجاً، لا على التعيين، من تشبيهات معروف الرصافي.
قال في قصيدة "وقفة في الروض":
ماء ٌ قد انعكس الصـفاء بوجهه
وصـفا فـلاح كـأنّه بـلّورُ
وتسلسلت في الروض منه جداولٌ
بين الزهور كـأنّهنّ سـطورُ
حيث الغصون مع النسيم موائلٌ
فكــأنهنّ معاطفٌ وخصـورُ
في هذه الأبيات الثلاثة موجودات جامدة. بلا نبض. الماء الأوّل بلا نبض وذلك لتنكيره، وكأنه أيّ ماء بلا تمييز. تنكيره كذلك يدلّ على قلّته الزهيدة. ماء جامد لا يسري ولا يعكس حتى نوراً أو حركة غيم، أو ظلاًّ. البلّور جامد. السطور جامدة لا يتوازى همودها مع تسلسل الجداول. أما تعبير:"في الروض" فقد جعل الصورة ضيّقة ومحدودية الجغرافية. فهي لا تشرك أحداً غيره وهي لا شكّ فضلة وزنيّة. بكلمات أخرى لم يجعل الجداول تعكس عالماً أوسع يؤدي إلى مشهد أشمل، ولم يرمّزه ليجعله أعمق ثقافة ودلالة.
الحركة في البيت الثالث :"حيث الغصون…موائل"، انتقال مفاجئ بحاسّة البصر من الجداول، أي الأرض إلى أعلى أي الغصون، بدون مبرر أو حيلة فنية. لا بدّ من حيلة فنية، وإلاّ لماذا نسمّي الشعر صناعة؟. هذه الآنتقالة السريعة مُفْسِدة. أوّلاً لأنها تتناقض مع الجمود الأوّل، وثانياً لأنها توحي بأنّ الشاعر لم يكنْ متأملاً حقّاً. ثمّ لا أدري صادقاً ما معنى هذا التشبيه: "فكأنهنّ معاطف وخصور"
معاطف! ما المقصود؟
أليس المفروض أن تُشبَّه لدانة الخصر بالغصن وليس العكس؟ هل أراد الشاعرُ الخصورَ فعلاً، أي إدخال مادّة اللحم حتى إذا ملحت في عين رائيها، في مشهد نباتي خالص؟ أم أنّ القافية ضللته، فَهَدَتْه إلى المعاطف التي لا تنمو نموّ النبات. لنتمعّن قليلاً في التشبيهات الثلاثة :كانّه بلّور، وكأنّهنّ سطور، كأنّهنّ معاطف وخصور.
التشبيه ب "كأنّ" هو غير التشبيه بالكاف من حيث الحالة النفسيّة. الأولى تدلّ على بطء واع، وكأنّ الشاعر راح يفتش عن تشبيه. أي أنّ التشبيه هنا لم يكنْ استبطاناً وتلبّساً، ويأتي عفو الخاطر، لا سيّما حين دخلت نون النسوة، حيث انفصل الشاعر عمّا يصف، انفصالاً كلّياً. أولاً لأنها أصبحتْ أكثر بطءاً بكأنّ وثانياً لتأنيثها بنون النسوة، فأصبح جنسها غير جنسه، أيْ هما منفصلان. يعتقد مصطفى السحرتي أنها:"من أجود قصائد الرصافي في وصف المشهد الطبيعي… وهي… لا تخلو من أصالة في بعض صورها" (معروف الرصافي - شاعر العرب الكبير- ص 215).
من الواضح أن التشابيه أعلاه لم تأت إلا في العجز من البيت، وهو نفس ما درج عليه الجواهري، وخاصّة إذا كانت القافية مكسورة، مما يجعل التشبيه في هذه الحالة تمحلاً وتكلفاً. لنأخذْ على سبيل المثال، قصيدته "سائلي عمّا يؤرقني" المنشورة في الجزء السادس (وزارة الإعلام العراقية-1977) وهي من القصائد التي يؤثرها الجواهري.
مطلع القصيدة:
"سائلي عمّا يؤرقني
لا تسلْ عنّي ولا تلم
يقول الجواهري في البيت الثالث:
وانطوتْ دنياي في كفني
وتقضى العمر كالحلم
أوّلاً جاء التشبيه في آخر البيت، وثانياً لقد استهلكه الرومانسيون، وانتخمت به الأغاني المصرية الخدرانة. أكثر من ذلك فمرور الحياة كالحلم يدلّ على أنها كانت مليحة وسعيدة وهذا ما يتناقض مع جوّ القصيدة، فليس فيها ما يوحي بانّ الشاعر كان يعيش نيرفانا من نوع ما. بعد أن يقرر الجواهري انه لم يجدْ وتراً واحداً في العود "يقوى على نغمي"، وأنّه حمل فوق همّه همّ الناس، يقول:
"وأحاسيس أنبّشها
كانتباش الدود في الرمم
كلّ شوهاء كأنّ بها
كلّ قبح الكون من قدم
من طيوفي ترتعي مزقاً
كارتعاء الذئب في الغنم
لا شكّ إنّ الأحاسيس التي ينبّشها الشاعر ميتة لأنّ التنبيش عادة لا يكون إلا في الأشياء المهجورة. الغريب انّ الشاعر استعمل كلمة أنبّش وكأنْ بمعناها العامّي العراقي: أيْ أفتش عن سوالف عتيقة، وربّما يُعنى بها الصغائر من الأمور. لكن حتى لو كانت هده الأحاسيس ميتة ومطمورة، فإنّها، لا شكّ، غير مادية ، غير ملموسة، ممّا لا يتناسب مع صورة: "الدود الذي ينبّش في الرمم"، ذلك لأنّ صورة الدود نابشاً، صورة مادّية توحي بالتفسخ والرائحة الكريهة. لماذا شبّه الشاعر نفسه بالدود الساعي إلى قوته أيْ ديمومة حياته؟ ما الذي كان يعاني منه الشاعرفي تلك الأيام؟ لا سيّما وقد ذكر في البيت التالي كلمة: "شوهاء"التي كما قال عنها إنها جَمَعَتْ من قديم الزمان: "كلّ
قبح الكون".
أمّا البيت الثالث:
"من طيوفي ترتعي مزقاً
كارتعاء الذئب بالغنم"
فانتقال من صورة سكونية إلى صورة ذات حركة. البيتان الأولان يصوّران الخمود والانطمار والتشوّه فكيف انتقل إلى الغنم وهي مخلوقات حية. همّ الدود، الدخول إلى مخّ العظم. بينما همّ الذئب، الطرَد والصيد. لا تماثل، كما يبدو بين حركة محدودة إلى داخلٍ جامد، هي حركة الدود، وحركةٍ انتشارية في الخارج هي حركة الذئب. يبدو أنّ ما جمع: الرمم، والقدَم، والغنم، هو اضطرار القافية. بعد ذلك يصف الشاعر الدنايا: موزّعة، مثل بقايا لحم على خشبة القصّاب التي يُقطّع عليها اللحم:
"لمسفّات موزّعة
كمشاش العظم في الوضم"
كيف، ولماذا شبّه الشاعر الدنايا- وهي تتوزّع -، ببقايا اللحم في العظام ، واللحم ثابت وآيل إلى التيبس ، أيْ اللا حركة؟ ولماذا خصّ الشاعر بقايا اللحم في العظام فقط، وليس كل لحم؟ ولماذا خطرت ببال الشاعر خشبة الوضم؟لا ريب إنّ القافية في بعض الأحيان تجرّ الشاعر جرّاً، إلى كلمات قلقة ومحرجة. وإلاّ ما وجه التشابه في الصورة أعلاه بين المشبّه والمشبّه به، إنْ بصراً أو سمعاً أو ذوقاً أو لمساً؟ مع ذلك فقد جاءتْ في هذه القصيدة ثلاثة تشبيهات في بداية الأبيات. لنمتحنْ موقعها إذن. هل تختلف عن التشبيهات في نهاية الأبيات؟ "فانا كالموج منصرماً
في عباب غير منصرم
وأنا كالبرق منطلقاً
فات حتى خيل لم يَشُم
وأنا كالعود يقضمه
سارب من سارح النّعم"
الأبيات اعلاه ليستْ مما عوّدنا عليه الشاعر من تجويد. يبدو أنّ الجواهري كان يمرّ بأزمة نفسية حادة. هل كانت عصيّة على فنّه، أم أنّها أصبحت أكبر من فنّه؟ هل هيّأ الجواهري بعض القوافي قبل الكتابة؟ (لدينا دليل على أنّه كان يفعل ذلك). "فغير منصرم" هي التي جاءتْ بالموج، و"لم يشم" هي التي جاءت بالبرق، و"سارح النعم" هي التي جاءت بالعود. من التشبيهات الأخرى ما جاء في قصيدة حبيبتي (الجزء السادس- ص 229)حين يصوّر السهام (والمتنبي : النصال)، وهي تتساقط كسراً، فيقول:
كبرا صمدنا لها فاسّاقطتْ كسراً
كما تساقط حول الأيكة الورقُ
هل بالامكان تشبيه السهام الحاملة للموت بالورق المتساقط الذي يدلل على بدء دورة جديدة لتجديد الحياة. السهم آلة ميتة حتى وهو متحرك، والورقة حيّة حتى وهي عاطلة على الأرض، لأنها ستتفاعل من جديد مع التربة.كيف يختلف التشبيه في ملحمة كلكامش؟ لنأخذ التشبيه التالي في وصف البطل كلكامش:
"أنّه موجةُ طوفانٍ عاتيةٍ تُحطّم حتى جدران الحجر"
أوّلاً خصّ الشاعر الموجة بموجةٍ طوفانية لا غيرها، وخصّ الجدران بالجدران الحجرية، لا غيرها. بهذه الحيلة الفنية البارعة، في تخصيص الأشياء، قرّب الشاعر، المعلومة الشعرية من اليقين والواقع، مبعداً إيّاها في الوقت نفسه، عن الخيال. لكن قبل ذلك كان التأكيد في الأبيات السابقة على مآثر جلجامش في بناء أسوار أوروك التي "تومض كالبرونز"، وعلى الحجر المفخور، وعلى الأسس القوية للبناء. بالإضافة إلى ذلك فإنّ عملية البناء بحدّ ذاتها تدلّ على بداية تحضّر الإنسان. ملحمة كلكامش لا ريب معنية عموماً - من بين ما تُعنى به - بالصراع ما بين العصر الرعوي، وعصر الاستيطان والتحضر. فجدران الحجر مؤثرة لأنّها مبنيّة بجهود بشرية وماتحطمها، إلاّ كارثة حضارية واقتصادية في آن واحد. يمكن قراءة التشبيه على ضوء آخر. فالموجة العاتية هي الظاهرة الطبيعية التي تتغلب على القوة البشرية. هذه الثيمة في الصراع بين قوى الطبيعة والبشر ستستمرّ إلى نهاية الملحمة. أكثر من ذلك، لقد سبق تشبيه كلكامش بموجةِ طوفانٍ عاتية، تشبيهٌ آخر بأنّه ثور نطّاح، ثمّ قال:
"إنّه المقدّم في الطليعة
وهو كذلك في الخلف
إنه المظلّة العظمى حامي (أتباعه) من الرجال
إنه موجة طوفان عاتية"
يبدو أن الشاعر أراد أن يوهمنا بأنّ كلكامش أصبح ظاهرة طبيعية خارقة أو هو شبيه بها. فالثور لدى السومريين والبابليين قوة سماوية، وهو بلا شك أحد البروج. بهذة القدرة الخارقة يستطيع أن يكون في المقدّمة وفي المؤخرة بلمح البصر. هاتان الصفتان هما صفتا كلّ موجة، لأنها في المقدمة وفي المؤخرة، في الوقت نفسه، بالنسبة إلى موقعها بين الأمواج الأخرى. حتى وصْفُهُ لجلجامش بنطح الثور لا يبتعد كثيراً عن الموجة. فهو مثلها يقتحم ثمّ يعود إلى الخلف ليستجمع طاقة أخرى للهجوم ثانية.( في كتاب ر. س. كلوغر: Kluger: The Archetypal Significance Of GILGAMESH معلومات ميثولوجية مفيدة عن الثور والحيوانات الأخرى الوارد ذكرها في ملحمة كلكامش). لنأخذْ مثالاً آخر. يصف راويةُ الملحمة في أولَ مشهد يظهر فيه الإنسان المتوحش أنكيدو. يقول:
"يكسو جسمه الشعر
وشعر رأسه كشعر المرأة
ونمتْ فروع شعر رأسه جدائل كشعر "نصابا"
كانت هذه صورة أنكيدو قبل أن يدخل في مرحلة التحضّر. تأتي أهمية التشبيه أعلاه من الترميز للتوحش وللمرحلة الرعوية، بالشَّعَر المتروك على طبيعته. لا سيّما إذا قارنّا تلك الجدائل، بشعر جلجامش، وهو ابن المدينة حينما عاد إلى أوروك بعد قتل العفريت خمبابا في غابة الأرز:
"غسل (كلكامش) شعره الطويل وصقل سلاحه
وأرسل جدائل شعره على كتفيْه"
إنّ كلمة: غسل و صقل و أرسل تدلّ على أفعال إراديّة، بعكس شعر أنكيدو. قلنا إنّ التشبيه لا ينقطع مفعوله في ملحمة جلجامش. رأينا أوّلاً كيف قابل شاعر الملحمة، الشَّعَر الكثّ بالشّعَر المرسل على الكتفيْن. وثانياً لتهويل التوحش، أحضر الشاعر شخصية صياد في المشهد. لا بدّ أنه رأى أنواعاً مختلفة من الوحوش إلاّ أن أنكيدو وحش نادر جعل وجه الصيّاد "يمتقع من الخوف". عندها يدخل الصياد مع حيواناته إلى بيته. وحتى تكبر صورة الخوف جعل الشاعر الخوف يلازم الصيّاد حتى وهو داخل بيته:
"وهو لا يزال مشلولاً مذعوراً
اضطرب قلبه، وامتقع وجهه
حلّ بقلبه الرعب وصار وجهه
كمَنْ جاء من سفر بعيد"
لماذا التشبيه بالسفر البعيد؟ لم تكنْ المسافة بين الصيّاد وبيته مسافة بعيدة. ولكن لأن خوف الصيّاد كان عظيماً، باتت المسافة على قصرها طويلة. ولزيادة التوكيد على الخوف وامتقاع الوجه جعل الشاعر ذلك الصيّاد شابّا لا خبرة له في الحياة. يذهب "فاغراً فاه" إلى أبيه :
"يا أبتي رأيت رجلاً عجيباً قد انحدر من التلال"
ثمّ يسرد عليه صفات أنكيدو. ثمّ يذهب إلى كلكامش ويعيد عليه صفات أنكيدو. وهكذا بتعدد المرايا، يتعدد الحدث الواحد، ولكنّ صفرة الوجه تبقى ثابتة حتى النهاية. أكثر من ذلك لننظر في التشبيه: "كالطفل" بصورة أوسع. كانت المومس المقدسة قد أقنعت أنكيدو بالذهاب معها الى أوروك حيث ﮔلـﮔـامش. يقول راوية الملحمة:
"وأمسكت به من يده وقادته كما يُقاد الطفل"
لماذا كالطفل؟ كيف مهّد الشاعر لولادته؟ كيف سينمو؟ وكيف سيتصادى فيما بعد؟ بدأ التمهيد للتشبيه بالطفل، حينما كانت المومس المقدسة قد علّمت أنكيدو "فنون المرأة". أوّلاً لم يجربْ أنكيدو من قبل، الجنسَ مع أنثى بشرية . وهذا طور جديد أو ولادة جديدة، أو طفولة تدرج على التعلم. ونتيجة لهذا الجنس يقول الراوية: "لقد نسي انكيدو المكان الذي ولد فيه في البراري". هل هذه ولادة جديدة، ينقطع فيها الإنسان عن رَحِمِه؟ تقول المومس المقدسة عن هذه الولادة الجديدة:
"كلما نظرت إليك يا انكيدو بدوتَ لي مثل إله"
لا أدري لماذا تذكّرني هذه الصورة بمريم و المسيح. لا سيما حينما تمسك المومس المقدسة بيد انكيدو وتأخذه "الى كوخ الرعاة، الى موضع الحظائر". على أية حال، كان انكيدو عارياً قبل دخول المدينة، والعري يدلّ على الطفولة. وهنا تشقّ المومس المقدسة ثوبها شّقين، فتلبسه واحداً، وتكتسي هي بالآخر". هكذا لبس الطفل ثوباً لأوّل مرّة. بعد هذا يأتي التشبيه كالطفل كنتيجة طبيعية:
"وأمسكتْ به من يده وقادته كما يُقاد الطفل"
لكن أنكيدو سرعان ما يشبُّ عن الطوق ويكون ندّاً لـﮔلـﮔـامش إلاّ قليلاً. الغريب أن انكيدو بينما كان يدرج ليبلغ كامل رجولته، نرى جلجامش في هذه الأثناء يعود سنينَ الى الوراء، فيظهر عليه العناد الطائش وروح المغامرة، فيتوسل توسل انسان يائس بالإله شَمَشْ ليعينه في قتال عفريت الشرّ خمبابا. وحينما لم ينتصح بأقوال شيوخ أوروك، يتمنون له أن يقف الإله لوكال -بندا الى جانبه فيحقق رغبته:
"ومثل الطفل عساك ان تحقق امنيتك"
كان الصراع بين جلجامش وانكيدو عضلياً في اوّل لقاء، ولكنه الآن اختلاف في الطموح والنظرة للحياة. فبينما حقق انكيدو امنيته، نرى جلـجامش يتحرق الآن لتحقيق أمنيته. مهما يكن من أمر، فإن العري الأول الذي جاء به انكيدو قبل دخول الى المدينة مع المومس المقدسة، وهو رمز اللا تحضّر، يعود ثانية بصورة معاكسة تماماً. فقد حلم انكيدو أنه بين السماء والارض، فإذا بشخص بشع الخلقة، أظفاره كمخالب نسر يعريه من لباسه:
"لقد عرّاني من لباسي
وأخذ بخناقي حتى خمدت أنفاسي
(.. خروم)
لقد بدّل هيئتي فصار ساعداي مثل جناحيْ طائر
مكسوّتين بالريش
ونظر إليّ وأمسك بي وقادني الى دار الظملة
الى مسكن إراكلاّ،
الى البيت الذي لا يرجع منه مَنْ دخله.." إلخ
هذا الحلم نقيض تماماً، للمشهد الذي دخل فيه انكيدو الى اوروك، هناك، كانت المومس المقدسة هي الآسرة، وهنا شخص له وجه كوجه طير الصاعقة زو. هناك تستره المومس المقدسة ليدخل دنيا حيّة، وهنا يعرّيه عن ذلك التحضر، ويهيئه للموت عارياً. هناك أرته ﮔلـﮔـامش والأعياد والموسيقى والرقص، وهنا يريه إراكلا ودار الظلمة، "دار الصدّ ماردَّ". هناك بداية، وهنا نهاية. رأينا أعلاه كيف أمسكت المومس المقدسة بيد انكيدو وقادته كما يقاد الطفل. تعود الآن صورة طفل شبيه بالطفل انكيدو، على لسان سيدوري صاحبة الحانة، التي تحدثت ببساطة عن استحالة خلود الانسان. اقصى ما يفعله البشر امتلاء المعدة واقامة الفرح والرقص وارتداء الملابس النظيفة والاستحمام، و..،:
"وأغسل رأسك واستحمّ في الماء
ودلّلْ الصغير الذي يمسك بيدك
وأفرح الزوجة التي في حضنك
وهذا هو نصيب البشرية"
الجانب الواقعي من الصورة أعلاه، ان سيدوري أرادت ان تلفت نظر جلجامش الى زوجته وابنه –اللذين لم يذكرهما- راوية الملحمة قط. أمّا الجانب الفني، فهي محاولة سيدوري الى إعادة جلجامش الى حظيرة التحضر، وهذا عكس ما كان عليه الأمر بالنسبة الى انكيدو. ثمّة عريٌ هائل آخر، هو عري جلجامش مرتيْن. الأول حين عبر مياه الموت. رأينا سابقاً كيف كسر جلجامش، وهو في حالة غضب، الصارية والشراع، وكيف صنع مائة وعشرين مردياً، "طول كل منهما ستون ذراعاً". هذه أدقّ رحلة بحرية في تاريخ الأدب والبشرية. كل قطرة من بحر الموت هذا كافية –إن مسّتْ مجرد مساس- جلد إنسان قتلته، ولو كان بحجم جلجامش وجبروته. لا يدري جلجامش اثناء وبعد هذه الرحلة هل سيدخل في الحياة أم في الموت؟ هل هذا طريق "الصدّ ما ردّ" الذي حلم به انكيدو في العالم السفلي، أم انها كرحلة سفينة اوتو-نفشتم (وهي سفينة نوح) التي كانت ممتلئة بالأمل وتجديد الحياة؟
انتهت المرادي المائة والعشرون، وتوقفت السفينة بين الموت المائي والحياة، كما توقف انكيدو من قبل في حلمه بين الأرض والسماء. على الفور، نزع جلجامش ثيابه ونشرها على يديه "كالشراع". ها هو جلجامش عارٍ. العري صفة الميت. هل أعدّه الأجل للموت؟ وهل هذا الشراع بمثابة يديْ انكيدو اللتين كساهما رسول الموت البشع بالريش، فأصبحتا "مثل جناحي طائر". أغرب جنحين يأخذان صاحبهما الى "دار الظلمة". هل سيأخذ الشراع ﮔلـﮔـامش الى الموت؟ العري الآخر كان يوم التقى جلجامش بالإنسان الخالد أوتو-نفشتم. نصح أوتو-نفشتم، جلجامش أن يُقْلِع عن فكرة الخلود. ثم أعطاه وصفة لتجديد الحياة بتجديد الملابس ونظافة البدن. قال أوتو-نفشتم، لملاّحه أور-شنابي:
"خذه يا أور-شنابي، وقدْه الى موضع الاغتسال
ليغسل في الماء أوساخه حتى يصبح نظيفاً كالثلج
لينْزع عنه جلود الحيوانات
وليرمها في البحر حتى يتجلّى جمال جسمه
ودعه يجدد عصابة رأسه
وليلبسْ كسوة تستر عريه"
يبدو أن شاعر، أو شاعرة الملحمة في المقطع أعلاه في أقصى حالات الفطنة في التأليف والحذق في التعبير.
أولاً لا يُدفن الميت إلاّ بعد أن يغسل. ولكن ما يبعث على الاستغراب هو وصفه كالثلج. هل يرمز الثلج أيضاً إلى برودة جثة الميت؟ ربما، لاسيما إذا تمعنّا في البيت الأخير: "ويلبس كسوة تستر عريه". قد لا تكون هذه الكسوة إلاّ الكفن ففيه بياض الثلج والجدّة وستر العري. اللون الأبيض كذلك لون ماتميّ، لدى الأقوام القديمة.
قلنا في مكان آخر، إن الملابس في هذه الملحمة تقوم بعدة أدوار خطيرة، للتعبير عن التحضر والترحّل والتريّف، للتعبير عن الولادة والتجدد والموت، ولكن أخطرها جميعاً بالنسبة الى جلجمش وربما الى البشرية، هو حينما ذهب ليغتسل في "بئر باردة الماء"، فجاءت الحية واختطفت نبات الخلود الذي سماه ﮔلـﮔـامش "يعود الشيخ الى صباه كالشباب":
"فشمّت الحية رائحة النبات
فتسللتْ واختطفته
ثم نزعت عنها جلدها"
العري، هو بلا شكّ للموت كما هو للولادة. وعري الأفعى تجديد من نوع ما. ربما لم يرَها جلجامشوهي عارية، كما لم يرَها وهي تزدرد النبات، ولكن بالتأكيد رأى جلدها، فأدرك أن الشرّ هو الخالد:
" وعند ذاك جلس ﮔلـﮔـامش وأخذ يبكي
حتى جرت دموعه على وجنتيه"
هذه أفجع صورة لطفل دامعٍ باكٍ، فََقََدَ أعزَّ لعبة، ولا يدري كيف يستردّها. فاجعة جلجامش أكبر من رأسه ومن مسقطه معاً، لأنه يعرف تماماً أنّ من المستحيل استرداد لعبة الحياة التي فقدها. وبذلك البكاء، وبتلك الدموع الجارية على وجنتيه، رجع جلجامش الى أوروك طفلاً ممزّقاًً، لا تنفع معه كلّ مناحات نساء الأرض.




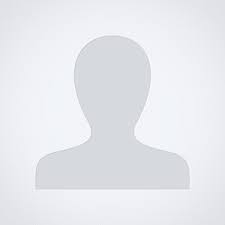
التعليقات