رضوان زيادة - الحياة
يعد laquo;الميثاق التعاقديraquo; خطوة بالغة الأهمية والحيوية في عملية التحول الديموقراطي، ذلك انه يضع الأسس لحل وسط انتقالي، ربما يمتد لفترة طويلة ويتعلق ذلك بمستوى الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي، هذا الحل يكون محل تفاوض واتفاق تتفق بموجبه القوى على امتناع كل طرف عن استخدام قوته لإيذاء الآخر ومصالحه الحيوية.
إن الميثاق التعاقدي هذا يعتبر لب ما يسمى laquo;الديموقراطية الوفاقيةraquo; أو laquo;التوافقيةraquo; وجوهرها، إذ هو يضبط حدود هذا الوفاق والتوافق بالنسبة الى كل الأطراف، ويعكس في الوقت نفسه التوازنات الدقيقة بينها، وربما يكون هذا الميثاق موقتاً، أي انه يحتاج الى مفاوضات جديدة وخصوصاً عندما تتغير الأوضاع ويدخل لاعبون جدد الحلبة السياسية، لكن، تبقى بعض عناصر الميثاق أساسية ودائمة في ترتيبات التحول، وغالباً ما تغدو علامات دائمة تسم النظام السياسي وتدخل في صلب هيكليته.
لكن المفارقة تكمن في التناقضات التي ربما يحملها الميثاق، اذ تسعى نحو تحقيق شكل من اشكال الديموقراطية بوسائل لاديموقراطية، اذ يحصل التفاوض والاتفاق في شأن الميثاق بين قلة من اللاعبين، مما يخفض مستوى التنافسية المسؤولية عندما تحاول تأطير اجندة الشؤون السياسية عبر خرق أو حرف مبدأ مساواة المواطنين كما يذكر غرايم جيل في كتابه عن laquo;ديناميات السيرورة الديموقراطية والمجتمع المدنيraquo;.
وعلى رغم ان فكرة الميثاق أو laquo;الاتفاق التعاقديraquo; تحمل اعترافاً ضمنياً بالدينامية الاجتماعية والفاعلية السياسية لعملية التحول إلا انه يصبح بعد فترة من الفترات عقبة أساسية امام عملية التحول الديموقراطي ذاتها، إذ ان هذه الدينامية تصطدم بممانعات او حواجز رُسّخت عبر الميثاق نفسه الذي اعترف بها وأكدها كجزء من التسوية السياسية (Compromise) لكنه وفي شكل ما خلّدها أو أبّدها عندما اعطاها اعترافاً شرعياً وقانونياً، خصوصاً اذا كانت هذه الحواجز طائفية أو عرقية/ اثنية يصعب تجاوزها او في الحقيقة يستحيل تخطيها، ولم تستطع ثقافة المجتمع السياسية المرور فوقها خلال عملية التحول الانتقالية لأسباب مختلفة ربما لمصالح نفعية خاصة للقائمين عليها، وربما لعوامل خارجية قهرية استفادت من ترسيخ هذه الحواجز لضمان الاستفادة المباشرة وغير المباشرة، وربما لأسباب داخلية تعود الى انعدام قدرة النخب السياسية والمدنية على التبدل ودخولهم في دائرة مفرغة من الالتزام القانوني بالميثاق الذي اتفقوا عليه لأن خروجهم عليه يعد خروجاً على منطق الدولة أو النظام السياسي الذي ارتأوا العيش ضمنه، وفي الوقت نفسه عدم السماح لثقافة ديموقراطية حقيقية بالولادة والنشوء على أنقاض هذا الميثاق التعاقدي، عندها يصبح هذا الميثاق ابدياً وتصبح مسألة الخروج منه ذات حساسيات تاريخية ربما تفتح نحو الدخول في نزاع او صراع مسلح او حرب اهلية من جديد.
فالديموقراطية الوفاقية المؤسسة على الميثاق التعاقدي هي أشبه بالمرحلة الانتقالية التي تخلف حرباً اهلية أو فترة من الديكتاتورية الشمولية تمر بعدها بمرحلة فراغ دستوري وقانوني يعكس اضطرابات القوى السياسية والاجتماعية الفاعلية، وهو ما حدث في كولومبيا وفنزويلا في عامي 1957 و 1958 حيث جرى تفاوض على اتفاقات صريحة وواضحة بين الأحزاب ذات المصلحة، في حين توصلت الحكومة والمعارضة في إسبانيا الى اتفاق على إطار دستوري لديموقراطية جديدة، وفي الأوروغواي عقد قادة القوات المسلحة والحزب laquo;ميثاق النادي البحريraquo; في آب (اغسطس) 1948.
تتسم هذه laquo;المواثيق التأسيسيةraquo; التي تشكل جوهر مرحلة laquo;الديموقراطية الوفاقيةraquo; بعدد من السمات الرئيسة التي تدشن مرحلة تأسيسية على قاعدة الضمانات المتبادلة للمصالح الحيوية للأطراف المشاركة تتجلى في:
1- الشمولية: إذ يجب ان تضم كل القوى او اللاعبين السياسيين الفاعلين على الساحة كي تتم ضمانة احترام هذا التعهد من كل الأطراف وكي لا يجرى اختراقه أو إفشاله.
2- التضمينية للقضايا المركزية والجوهرية: بحيث ان المواثيق التي تتسم بالاتفاق على القضايا الإدارية او الإجرائية غالباً ما لا تحمل صفة الديمومة او الاستمرارية، كما انها يجب ان تتميز بأنها ذات توجه عريض من الاهتمامات اكثر منها راسمة للقواعد والإجراءات اللحظية الآنية.
3- التمثيلية: أي إعادة الاعتبار لكل القوى ذات الوزن حتى التاريخي منها والتي كانت مهيمنة تقليدياً وذلك كي يجرى إشعارها بأن مصالحها الحيوية مصانة، وغالباً ما يكون لهذه القوى دور في إعطاء laquo;الشرعيةraquo; لميثاق جديد يتجاوز دورها التاريخي، وبصمتها هنا تكون واضحة لضمان ثقة الأطراف الدولية.
إن مثل هذه laquo;المواثيقraquo; في حاجة ايضاً الى ضمان التوقيت المناسب لتأكيد سلامة تطبيقها، كما انها في حاجة الى تأكيد ثقة الأحزاب المشاركة في المفاوضات على ان التزامها بهذا الميثاق سيلزم أتباعها، وبأنهم سيتقيدون بأي اتفاقات يتم التوصل إليها، ذلك ان الاتفاقات التي تلقى معارضة واسعة من القواعد او تقابل بنفور شديد غالباً ما يكون مصيرها الفشل.
كما ان احدى السمات التي تتطلبها هذه الاتفاقات هو ميزة laquo;الاعتدالraquo; لدى قادة القوى السياسية المشاركة في التفاوض، وربما يكون الاعتدال احياناً ثمناً للمشاركة أو بحسب تعبير هنتنغتون laquo;مقايضة المشاركة بالاعتدالraquo;، وهذا ما يضمن توسيع حدود المشاركة في النظام السياسي بإشراك القوى السياسية المستثناة سابقاً مقابل تخليها عن مواقفها الراديكالية كما حصل في الأرجنتين حين وافقت المؤسسة العسكرية على مشاركة البيرونيين في النظام، وفي إسبانيا عام 1977 عندما حصل اعتراف من سلطة الحكم بالحزب الشيوعي، والأوروغواي عندما اعترفت في عام 1984 بما يسمى laquo;الجبهة العريضةraquo;.
لكن، السؤال الذي يطرح نفسه مجدداً، كيف يمكن لهذه laquo;المواثيق التعاقديةraquo; ان تنقل البلد من مرحلة اللااستقرار الى عتبة التحول الديموقراطي ثم تفتح الباب واسعاً امام الدخول في نمط من الديموقراطية السياسية التشاركية الحقيقية كما حصل في إسبانيا واليونان.
وكيف، في المقابل، يمكن ان تتحول هذه laquo;المواثيق التعاقديةraquo;: الى تأبيد لحواجز الغيتوات ذاتها وتخليدها بحيث ان بقاءها يصبح عقبة امام التحول الديموقرطي الحقيقي، وإلغاءها يعيد البلد الى الحرب الأهلية ذاتها التي كانت هذه المواثيق ضمانة لخروج البلد منها، إنه النقاش السياسي والشعبي الذي نشهده يومياً في لبنان على سبيل المثال في ما يتعلق باتفاق الطائف.
فالمؤمنون به يدافعون عنه بلا حدود بوصفه السبيل الأمثل لضمان بقاء الدولة ومؤسساتها، ولاستمرار سبيل laquo;العيش المشتركraquo;، بيد أن منتقديه يرون أنه ثبّت نموذج laquo;الديموقراطية الطائفيةraquo; اذا جاز هذا التعبير، ورسّخ الزعامات العائلية والطائفية التقليدية وحوّل كل اللاعبين السياسيين الطموحين الى مجرد أقمار يدورون في فلك هذه الزعامات ورئاستها.
ربما يحاجج البعض في أن laquo;الطائفraquo; لم يطبق بحرفيته وروحه، وذلك لحسابات اقليمية تتعلق تحديداً بسورية وانسحابها المتأخر جداً من الأراضي اللبنانية، وهذا صحيح ولا نقاش فيه، بيد أن بنوداً أخرى لا تتعلق بسورية لم تجد سبيلها الى التطبيق أو حتى النقاش الجدي والعلني والصريح لآليات التنفيذ المستقبلية وأولها laquo;إلغاء الطائفيةraquo;. مما يعني أن هذا laquo;الميثاق التعاقديraquo; التاريخي الذي أخرج لبنان من حربه الأهلية صكّ لبنان على صيغة طائفية نهائية ومطلقة على صيغة laquo;الديموقراطية الوفاقيةraquo;.
لا جدال في أن هذا النوع المجازي من الديموقراطية يبقى أفضل بمئات المرات من laquo;الحالة اللاديموقراطيةraquo; سواء أكانت ديكتاتورية أو الفوضى السياسية المطلقة، لكنها في المقابل لا يمكن حتى الزعم بأنها تمثل ديموقراطية ناجزة ومكتملة، إنها تحمل الكثير من العيوب والمساوئ الجوهرية والشكلية أولها بالطبع عدم ضمان المساواة المطلقة بين المواطنين والتعامل معهم على أساس أصولهم غير القابلة للاختيار سواء أكانت طائفية/دينية أو عرقية/ إثنية، وبالتالي تجعل قدرة المواطن على المساءلة والمشاركة ومن ثم التغيير من داخل النظام (System) الحكومي ضعيفاً ومحدوداً وأحياناً بلا طائل، وهو ما يولد بالضرورة إحباطاً متزايداً ومتراكماً كما نجد ذلك متبلوراً في صيغة laquo;الإحباط المسيحيraquo; اليوم، وهذا بدوره سيخلق أو يعيد إنتاج أزمات تاريخية وربما اصطناعها في حين كان هذا النظام السياسي يعتقد بأنه تجاوزها وأودعها التاريخ المنسي، لكن، مكر التاريخ الذي تحدث عنه هيغل ربما يطل مستقبلاً عبر بومته التي تحمل الشؤم والكثير من الدمار.
ويكاد الكلام ينطبق ذاته وبحرفيته على الحالة العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، فإذا أخذنا في الاعتبار كل الأخطاء الأميركية والبريطانية التي ارتكبتها قوات احتلال بعد دخولها الى بغداد لوجدنا أن هذه القوات ذاتها اصطدمت بفكرة رئيسية وهي شكل الديموقراطية العراقية التي يمكن بناؤها في المستقبل، فالمجتمع المدني على عكس لبنان في هذه الزاوية هش وضعيف للغاية، إذ لم يكن صدام حسين بالطبع ليسمح له بالنمو أو حتى التشكل وسياسة سحقه تعد جزءاً من ضمان بقاء واستقرار نظامه، أما القوى السياسية والأحزاب المعارضة التي أدارت العملية السياسية بعد سقوط النظام العراقي والتي تتحمل الجزء الأكبر من عملية الفشل التي نشهدها اليوم فإنها أشبه laquo;بالطوائف الحزبيةraquo; أو laquo;الاحزاب الطائفيةraquo; مع إدراكنا الكامل للتناقض المفاهيمي والسياسي الذي يتشكل منه هذا التعبير أو المصطلح. وبالتالي فإنها أعادت تنضيد المجتمع العراقي على أساس هويته الطائفية والعرقية وهو ما يشكل حاجزاً أو مدماكاً حقيقياً لبناء الديموقراطية.
قد يقول البعض إنها الواقعية السياسية التي تشترط التعامل مع القوى الموجودة للبناء نحو الأفضل معها وهو ما وجدناه في تحقيق مبدأ laquo;التمثيليةraquo; المتوازنة في مجلس الحكم الانتقالي على سبيل المثال لكل الطوائف والأعراق والأحزاب السياسية، هذا صحيح من زاوية سياسية آنية ولحظية لكن الخطأ التاريخ كان في تأبيد الشكل القانوني لمجلس الحكم هذا، بحيث جرى اعادة استنساخ النموذج اللبناني وإسقاطه في العراق، وهو ما استمر حتى بعد تشكيل الحكومات العراقية المختلفة، وهي العقلية ذاتها التي رعت كتابة الدستور والوثائق الرسمية الأخرى القائمة على احترام laquo;المحاصصة الطائفيةraquo; لانعدام البدائل الأخرى وفقدان القوى السياسية والمدنية التي يمكن أن تعيد صوغ المشهد السياسي.
إن القبول بالأمر الواقع لا يشترط، بل لا يجب قوننته من أجل تأبيده، يجب قبوله والتعامل معه على اساس لحظيته وزمنيته وليس تقعيده وتخليده وبناء هيكلية النظام السياسي عليه.
وعلى ذلك فلا يجوز اعتبار laquo;الديموقراطية الوفاقيةraquo; شكلاً نهائياً للديموقراطية يجرى الدفاع عنه بوصفه المخرج أو افضل الممكن، انها ما يمكن الدفاع عنه ndash; بكل تأكيد ndash; في وجه الديكتاتورية التسلطية او الفوضى، لكنها في الوقت نفسه يجب ألا ننسى ndash; ولو للحظة واحدة ndash; انها مرحلة انتقالية لا بد من المرور أو العبور فوقها نحو افضل منها، انها ربما افضل شكل تاريخي لإدارة الصراع السياسي في لحظة من اللحظات، لكنها تصبح في لحظات اخرى أسوأ آلية لإدارة مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية لأنها تتضمن بكل تأكيد مآزق أو افخاخ الشللية التي تحمل من داخلها القدرة التعطيلية الدائمة لمصلحة أحد أصحاب الفيتوات الكثيرين والعديدين مما ينتهي بالدولة الى الشلل دائماً وعدم قدرتها على الاستجابة لطموحات مواطنيها، وعندما لا يحمل النظام صفة القدرة على المرونة والتغير من داخله وبالوسائل السلمية فإنه سيتفجر من داخله بكل تأكيد استجابة للحراك الدينامي الاجتماعي والسياسي والشبابي المستمر وعندها يدخل البلد من جديد في دوامة من البحث عن laquo;ميثاق تعاقديraquo; جديد يستجيب للتوازنات السياسية المستجدة والمتغيرة.
إن مبدأ laquo;الديموقراطية تصحح نفسها بمزيد من الديموقراطيةraquo; يكاد يكون قاعدة ذهبية في انطباقه على laquo;الديموقراطية الوفاقيةraquo; التي لا بد من اعتبارها مرحلة انتقالية وليس حلاً نهائياً، ولتحقيق انتقاليتها لا بد وخلال عملية بنائها من توازيها مع عملية تاريخية تتمثل في ما يسمى laquo;العدالة الانتقاليةraquo; التي تتيح للدولة لإعادة تأسيس شرعيتها على أسس جديدة قائمة على أساس العدالة واحترام القانون وبناء المساواة بين جميع المواطنين في الواجبات والمسؤوليات والحقوق.






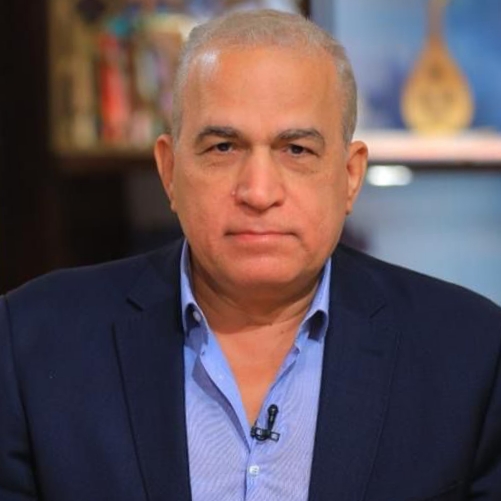








التعليقات